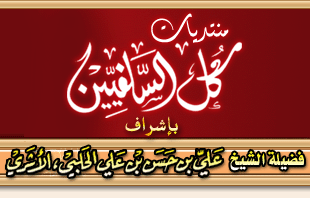

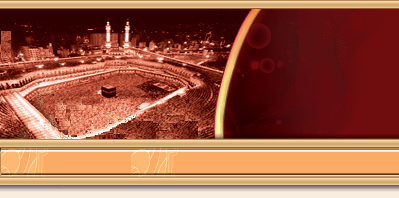
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
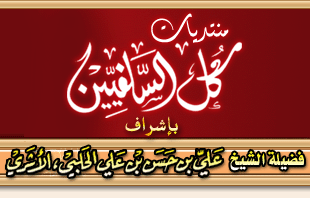 |
 |
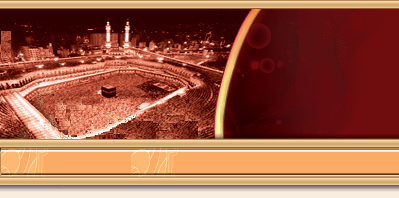 |
|||||
|
|||||||
| 31710 | 81299 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
20 جمادى الأولى 1436 المُسند، والمرفوع، والموقوف، والمقطوع الأبيات 119- 133 * الحديث المسند هو الذي جمع وصفين لا ينفك أحدهما عن الآخر: - مرفوع إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-. - موصول أو متصل؛ وهما شيء واحد. * (المُسنَد) له استعمالات عند علماء الحديث، وأشهرها: وصف الكتاب الذي رتَّبه مؤلفه على أسماء الصحابة –رضي الله عنهم-؛ مثل: «مسند الإمام أحمد» الذي هو أشهر المسانيد في الإسلام، كما قال الإمام أحمد لولده: يا بُني! احتفظ بهذا «المسند» فإنه سيكون للناس إماماً. وهذه التسمية أغلبية، وإلا فالإمام الطبراني في «المعجم الكبير» رتَّبه على أسماء الصحابة ولم يُسمِّه مسنداً. وهناك كتب سُمِّيَت بالمسند دون أن تكون مرتبة على أسماء الصحابة؛ مثل: «سنن الدارمي»، و «مسند الشهاب القُضَاعِي»، و «مسند الفردوس»، فهذه الكتب مسندة بمعنى أنها تَروي بالأسانيد، وهذه التسمية ليست اصطلاحية، وإنما هي إشارة إلى مُحتوى الكتاب، وهذا من باب التوسُّع؛ لأن جميع الكتب الحديثية تَروي بالأسانيد. * (المُسنِد) هو العالِم الذي تكون عنده الأحاديث مرويَّة بالسند، وله روايات متميِّزة. واليوم –للأسف الشديد- خرج لقب (المُسنِد) عن حدِّه العلمي، وأصبح يتطاير هنا وهناك وهنالك بمجرد أن فلاناً –صغيراً كان أو كبيراً- له إجازات وسماع لبعض الشيوخ! وهذا تفريغ لهذا المصطلح من حقيقة معناه التي استمرَّت بعليائها وبهائها وسنائها عبر التاريخ العلمي الحديثي عند علماء الإسلام. * تعريف (المُسنَد) بأنه المرفوع المتصل؛ يُخرج نوعين من أنواع العلوم الحديثية: الأول: ما ليس مرفوعاً؛ كالموقوف والمقطوع. الثاني: ما ليس متصلاً؛ كالمنقطع والمعلَّق والمعضل والمرسل. * (المرفوع) و (المتصل) ألقاب حديثية يُستفاد منها تمييز السند أو المتن، ولا يُستفاد منها صحة أو ضعفاً. * قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الألفية»: «المسند هو المرفوع إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالمسند المتصل ولو ظاهراً». قوله: «ولو ظاهراً» كأنه يقول: (إذا ظهرت لنا علة خفية)، لكن هذه العلة الخفية غير ظاهرة بطبيعة الحال، تخرج معنا عند بحث جديد متعلق بصحة السند، وقولنا: (مُسنَد) هو حكم أَوَّلي للتمييز قبل النظر في الصحة والضعف. * لا اعتبار للوصل في المرفوع والموقوف؛ لأنهما لَقَبَين لتمييز القول، فإذا كان قول النبي –صلى الله عليه وسلم- فهو مرفوع، وإذا كان قول الصحابي فهو موقوف. * استعمل أهل العلم (المقطوع) بمعنى المنقطع، وبمعنى قول التابعي، ويُعرف ذلك من خلال السياق. * يجوز إطلاق (الموقوف) على قول التابعي إذا قُيِّد بهذا التابعي؛ كأن نقول: موقوف على ابن سيرين. * الذي يُروى عن الصحابة من أقوالهم، ويُعطى حُكم الرفع في أرجح أقوال أهل العلم؛ أنواع: - قول الصحابي: «مِن السُّنة كذا». - قول الصحابي: «أُمِرنا» أو «كُنَّا نَرى في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم- » أو «كُنَّا نَرى» بدون إضافة لعهد النبي –صلى الله عليه وسلم-، لكن «كُنَّا نَرى» أغلبية، قد تحتمل شيئاً آخر، وهو احتمال ضعيف. مثاله: قول جابر بن عبدالله –رضي الله عنه- عند البخاري: (كُنَّا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا)، فلم يُذكر فيه النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولم يُذكر فيه العهد النبوي، ومع ذلك جعل العلماء هذا من السُّنن. - ما كان مما لا يخفى على النبي –صلى الله عليه وسلم-؛ لاشتهاره وظهوره وكثرة فاعليه في عصر النبوة، وهذه سنة تقريرية، وبعض العلماء يسميه: (تقرير الوحي) بعدم تبليغه إنكار الفعل. - التصريح بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- عَلِم بالفعل أو رآه وأقرَّه، ومثاله: قرع الصحابة لباب النبي –صلى الله عليه وسلم- بالأظافير، وخالف فيه داود بن علي الأصبهاني، وفيه دليل على أن الخلاف من داود خلاف مُعتبر. - ما ورد عن الصحابة من الأقوال مما لا يُقال مثله بالرأي ولا بالاجتهاد؛ كان يكون في أمر غيبي أو لا يُعرَف إلا بالنص، بشرط أن لا يكون الصحابي ممن حملوا عن أهل الكتاب، وأما قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: «حدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» فهو متعلق بقصصهم وتاريخهم وأخبارهم مما لا يُسمى مرفوعاً بأي نوع من الأنواع، ونحن نتكلم عما هو مرفوع حكماً مما يُنسَب إلى الشريعة الإسلامية. وذكر العلماء شرطاً آخر: أن يكون قول الصحابي خاصاًّ بالعقيدة الإسلامية، لا من عقيدة أهل الكتاب. - ما ورد من الصحابة في التفسير متعلِّقاً بسبب النزول أو متعلِّقاً بما لا يُقال بالرأي. وقال الحاكم في «المستدرك»: كل ما ورد من التفاسير عن الصحابة فهو مرفوع؛ وهذا غلط، فنرى في تفاسير الصحابة ما يخالف فيه بعضهم بعضاً، كلٌّ بحسب ما علِم. إلا أن الحاكم في «معرفة علوم الحديث» خص التفسير بما كان متعلِّقاً بسبب النزول أو بما لا يُقال بالرأي. - قول الصحابي: «من فعل كذا فقد عصى أبا القاسم». - إذا جاء بعد ذِكر الصحابي في الإسناد: (يرفعه) أو (يَنْمِيه) أو (رواية) أو (يبلُغ به) أو (يرويه) أو (يُسنِدُه) أو (يَأثِرُه). * كُلُّ ما ذُكِر في المرفوع الحُكمي إذا جاء عن تابعي فهو مرسل، ولا يُستثنى من ذلك أسباب النزول كما قال السيوطي: (لا رابعٌ جَزْماً لَهُم)؛ لأن الكل مرسل ولا فرق. * قول السيوطي: ............... ، والأوَّلُ (الأوَّل) هو قول الصحابي: «مِن السُّنة كذا»، فإذا قال التابعي: «مِن السُّنة كذا» قال النووي أنه موقوف، وقال غيره أنه مرسل، والخلاف فيها معتبر.صَحَّحَ فيه النووي الوَقْفا |
 |
|
|
 |
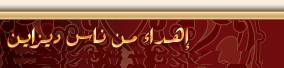 |