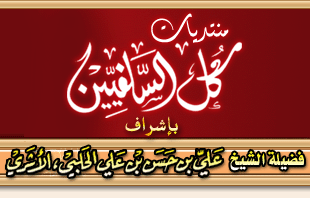

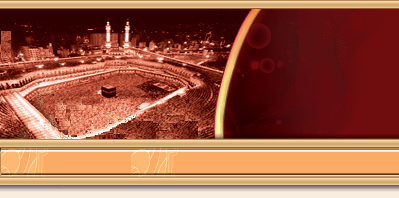
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
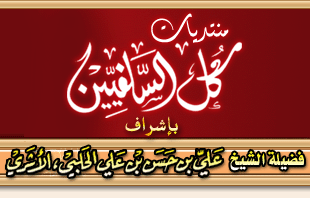 |
 |
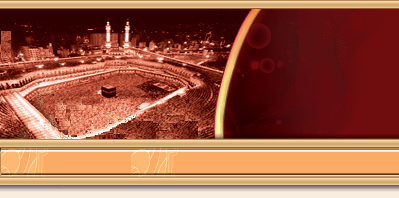 |
|||||
|
|||||||
| 55248 | 88259 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
رسالة الثلاثة أصول وأدلتها للإمام المجدد شيخ الإسلام/ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- شـــــرح فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي - حفظه الله - بسم الله الرحمن الرحيم إِنّ الحمدَ للهِ؛ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إليه، ونَعُوذُ باللهِ مِن شُرُورِ أنْفُسِنا، ومِن سَيِّئاتِ أعْمالِنا، مَن يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ لَهُ. وأشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشْهَدُ أنّ نَبِيَّنا محمّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وبَارِكْ على عَبْدِكَ ورَسُولِكَ محمّدٍ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ أجْمَعِينَ.أمّا بعد : فنحن على موعد مع دراسة كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدِّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- وممّا لا يخفى على طلاب العلم أهميّة هذا الكتاب وهذه الأهمية حصلت من جهتين: الجهة الأولى : موضوع الكتاب: فإن هذا الكتاب اشتمل على الأصول الثلاثة العظيمة التي يُسأل عنها العبد في قبره، وهي أول ما يُسأل عنها العبد، فإن أجاب ووفِّق كان هذا دليل السعادة والتوفيق وإنْ لم يوفّق فهذا دليل الخذلان وعدم التوفيق. والسؤال في القبر إنما هو ثمرة عمل، وليس بمقدور الإنسان أن يجتهد بالإجابة على هذه الأسئلة بالعلم دون العمل ، وليس الأمر مبناه على ما عليه الإنسان في الدنيا وإنما هو انتقال إلى الدار الآخرة ،فالقبر هوأول منازل الآخرة وهو يلحق بالآخرة من جهة انقطاع العمل ، وأنْ الإنسان يُجازى بعمله ، ومن هنا يتبيّن أنَ هذه الأسئلة وإن ظهرت في سورة الإمتحان- يعني- وأنّ الإنسان يمتحن فبناءً على هذا الإمتحان يكون الجزاء الثواب، إلا أنّ في الحقيقة الثمرة للعمل فمن كان موفقاً للعمل بهذه المسائل يوفق للإجابة ومن هنا لا يُشكِل أنّ القبر هو دار جزاء وانقطاع للعمل فكيف يكون هناك عمل؟! وإنما هذا لإظهار توفيق الله –عزوجل- لمن عمل بهذه الأصول فيظهر من كرامتهم أن الله يوفقهم للإجابة ولا يُوفِّق المفرِّط الذي فرّط في هذه الأصول. فهذه الرسالة مبناها على هذه المسائل الثلاث التي يُسأل عنها العبد في قبره من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك ؟. وقد وفق الشيخ - رحمه الله - في تأليف هذه الرسالة وما اشتملت عليه من المسائل العظيمة التي تلقّاها أهل العلم بالقبول وأثنوا عليها وصرَّحوا بأنّه لا يَستغني عن هذه الرسالة لا عالِم ولا متعلِّم ، فالكلّ محتاجٌ إليها لعظم ما اشتملت عليه من المسائل. وأما الجانب الثاني: لأهمية هذه الرسالة : فهي للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ،ومعلوم منزلة الرجل ومكانته من الدين وما أجرى الله – عزوجل - على يديه من الخير والتوفيق فكلّما كان العبد أتقى لله – عزوجل - وأقوم بدينه كلما نفع الله – عزّ وجلّ - بعلمه ولا يزال الله – عزّ وجلّ - يجعل في هذه الامة من العلماء المجدِّدين ما يرفع الله – عزّ وجلّ - به درجاتهم وهم في سيرتهم أشبه ما يكون بالسلف. وإنّ من قرأ كتب هذا الإمام كأنه يقرأ كتب السلف في القرون الثلاثة المفضلة، لسهولة عبارتها وبُعدها عن التكلف ولما اشتملت عليه من فقه عظيم وحسن ترتيب في التأليف. وكذلك عظم العناية بالموضوعات التي ألَّف فيها - رحمه الله - ولهذا، كتاب التوحيد لم يُؤلف مثله في بابه، وكذلك كتاب الأصول الثلاثة، وكشف الشبهات، وكذلك الكتب الأخرى النافعة التي كان - رحمه الله - يصنِّفها لمقاصد الدعوة والتوحيد، حتى كتاب مختصر السيرة فهو يتضمن استنتاج الفوائد من سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو أيضاً فريدٌ في موضوعِهِ وفي عَرْضِه. ولد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في العيينة سنة 1115هـ، وكانت حياته حافلة بالعلم، تلقّى العلم على والده الذي كان قاضياً في العيينة، وحفظ القرآن وأكمله ولم يبلغ عشر سنين، ثم ارتفعت همّته بعد أن تلقّى العلوم عن أهل بلده إلى الهجرة في طلب العلم، فارتحل إلى المدينة، وإلى مكة، وتلقى فيهما عن الأشياخ وارتحل الى البصرة وأخذ عن بعض أهل العلم؛ ثم عاد إلى بلده، وانتقل الى حُرَيْمِلاء، وبقي عاكفاً على العلم والتأليف، وصنَّف كتابه الجليل كتاب التوحيد في حريملاء وقيل إنّه في البصرة. وبدأ دعوته العظيمة في همّة عالية فريدة، وعرض نفسه على الأمراء واحداً تلو الآخر، وقد بادر بعضهم في بداية الأمر بنصرته، لكن لما كثُر الخصوم تخلّى عنّه بعض الأمراء، حتى عرض نفسه على أمير الدّرعيّة الإمام محمد بن سعود فناصره في دعوته، وكانت هذه المعاهدة والمناصرة هي بداية خير لهاتين الأسرتين اللتين نشر الله – عزّ وجلّ - بهما العلم والدعوة والتوحيد بقوتين : بقوة العلم والبيان، وبقوة السلطان، فرفع الله - عزّ وجلّ - ذكرهما، ومكّنَ لهما في الأرض. وكان من ثمار هذه الدعوة : هذه الدولة المباركة التي نشأت على التوحيد وما زالت عليه، وتكاد تخلو العصور المتقدمة بعد عصور السلف من مثل هذه الدولة في صفاء دعوتها للتوحيد، وقيامها بأمر الدين وتحكيمها للشريعة، وتقريبها للعلماء، وسعيها في نشر العلم، حتى نُشرت كتب السلف وحُقِّقت، وكانت المراكز؛ مراكز البحوث والمؤسسات تقوم بتوزيع هذه الكتب على طلاب العلم حتى عمّت أقطار الأرض، وازدهر العلم وانتشر وعاد الناس إلى السّنّة، وبلغت هذه الدعوة المباركة أصقاع الأرض فلم يبق موطن في العالم إلا ووصلته هذه الدعوة. وهذا من توفيق الله – عزّ وجلّ - للإمامين محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود، وإنما هذه عبرة وموعظة، فإن مَنْ نصرَ دينَ الله نصرَهُ وَوَفّقه. وكان في أول لقاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالإمام محمد بن سعود أن وعدهُ إن نصر دين الله فإنّ التمكين في الأرض سيكون حليفه، فحصل هذا على ما وعد الشيخ، وهذا من كرامته على ربه – عزّ وجلّ - أن أنجز له ما وعد به وتحقق النصر لهذه الأسرة، وقامت الدولة السعودية على هذه الدعوة المباركة. ولا يزال العلم في أسرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، ففيهم العلماء والقضاة ولا يكاد يخلو منهم العلم، وما زال المُلك في أسرة الإمام محمد بن سعود بتمكين الله – عزّ وجل - وهذا من توفيق الله – عزّ وجلّ - لهاتين الأسرتين. ومن منّةِ الله – عزّ وجل - على هذا العالم بأسره،أنْ كانت هذه الدعوة المجدِّدَة لدينِ الله – عزّ وجلّ - تقوم على هذا الصفاء العظيم في العقيدة، حتى أنّ الناس اليوم بعد انتشار العلم يعرفون عقيدة أهل السنّة وتفاصيلها، ودقائق الأمور، حتى إنّ طلاب العلم الصغار يعرفون هذه العقيدة. ولو قارنّا هذا بما حصل في عصور مضت كالعصر الذي سبق شيخ الاسلام ابن تيميّة، فإنّه يُدرَك الفرق، فإن العقيدة خفيت على كثير من النّاس وكان الكثير من العلماء والقضاة من اتباع الأئمة الأربعة فضلاً عن غيرهم، ما كانوا يعرفون هذه العقيدة، وكانت الخصومات بينهم في هذه المسائل. ولا تكاد تُعرف إلّا عقائد أهل الكلام، حتى وفق الله – عزّ وجلّ - شيخ الإسلام ابن تيمية بنصرة دين الله - عزّ وجلّ، ونصرة العقيدة، فازدهر العلم بعده، وتربّى الناس على السنة إلى قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فعاد النّاس إلى ما كانوا عليه من الجهل وعَمّتْ هذه الجزيرة الكثير من المخالفات الشرعية، بل انتشر الشرك الأكبر، وعُبدت الأصنام والأحجار من دون الله – عزّ وجلّ - وأصبح الكثير من الأعراب يسخرون بالدين، ويستهزءون به، وهذا ثابت بالنقل المتواتر عن كبار السن أنّه لا يكاد يُعرَفُ الدين، وإذا ذكر الدين يُسخر به ويُستهزء به، وأهل التديُّنِ الذين هم على الدّين، كثير منهم يقع في الشرك الأكبر - إلا من رحم الله -،من قلّة قليلة ممن تمسك بالعلم. فأقام الله – عزّ وجلّ - هذا الدين بهذه الدعوة المباركة، وبارك في هذه الدعوة حتى عَمّت أقطار الأرض، ونحن في هذا العصر الذي انتشر فيه العلم وَعَمّ فيه أقطار المسلمين، نحمد الله - عزّ وجلّ - على منّته وكرَمِهِ وَلطفِهِ أن جعلنا في هذه العصور التي هي عصور العلم والازدهار. وندعو لمن أجرى الله - عزّ وجلّ - على يديه الخير من الإمامين، الإمام محمد بن عبدالوهاب، والإمام محمد بن سعود، ونعترف لهما بالفضل، فإنه لا يَشكُرِ الله من لا يَشْكُرِ الناس، وندعو لهما ولذريتهما فإن هذا من حقهما على المسلمين. هذه الرسالة عُرفت عند أهل العلم بالأصول الثلاثة لِما اشتملت عليهِ من الأصول المتقدّم ذكرها، وهي : معرفةُ العبدِ ربّه ونبيّه دينَه، وقبل ذلك قدَّم المصنف بمقدمة بيّنَ فيها ما يجب على العبد أن يتعلّمَهُ، وذكَرَ ما يتعلق بهذه المسائل ثم انتقل الى تقرير الأصول الثلاثة بأدلتها. ونشرع في قراءة هذه الرسالة التي نسأل الله - عزّ وجلّ - أن يرزقنا الفهمَ الصحيحَ لما جاء فيها من النصوص والتوجيهات العظيمة، ولعل الله - عزّ وجلّ - أن يوفق وأن ييسر لنا إكمالها في هذه الدروس التي نسأل الله - عزّ وجلّ - أن تكون نافعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله وسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد : قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الأجر والثواب. {{المتن}} {{اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلُّم أربع مسائل : الأولى : العلم : وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالإدلة}}. {الشرح}: ابتدأ المصنِّف - رحمه الله - رسالته وكتابه بالبسملة، تأسياً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولِما جاء أيضاً في كتاب الله - عزّ وجلّ فإن كتاب الله ابتدأه الله - عزّ وجلّ - بالبسملة. والبسملة في كتاب الله - عزّ وجلّ - في كل سورة من سور القرءان عدا سورة التوبة واختُلف في البسملة هل هي آية من القرءان أم لا ؟ ثمّ اختلف هل هي آية من كل سورة أم أنّها آية واحدة في بداية سورة الفاتحة؟. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه ومواعظه بالبسملة وبحمد الله وبالثناء عليه، ومازال العلماء المتأسون بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتتحون كتبهم بالبسملة، وبحمد الله، والثناء عليه، ومنهم المصنف - رحمه الله - الذي كان عظيم التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم-. قال : " اعلم رحمك الله" كثيراً ما يبدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب كتبه ورسائله بهذه الكلمات العظيمة " اعلم رحمك الله"، "اعلم أرشدك الله"، " اعلم وفقك الله"، وهذا من فقهه، فإنّه يقدم بين يدي كتبه بالدعاء للمتعلِّم وللقارئ، فيجمع بين التعليم وبين الدعاء وهذه كانت طريقة السلف. ويُروى أن أحد المسرفين على نفسه في عهد عمر - رضي الله عنه -، كان قد نُصِحَ فلم ينزَجـِر، فبلغ ذلك عمر - رضي الله - عنه ، فكتب له كتاباً يعظه ويدعو له، فما قرأه حتى تاب من فعله، وهذا دليل على أثر الدعاء مع التعليم في المتعلمين، وما يحصل لهم من التوفيق، وهذا من الأسباب التي يظهر بها نجاح دعوة الشيخ - رحمه الله - أنّه كان يجمع بين التوكل على الله – عزّ وجلّ - في الدعاء للمتعلمين وبين التعليم، وعرض المسائل بالأدلّة حتى تكون بيّنة وواضحة. قوله : "اعلم" أي كن عالماً بهذا الأمر، إعلم فعل أمر من العلم، أي كن عالماً بهذا الأمر الذي سَيُلقى إليك، وجاء في هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يَقرُبُ من هذا كما قال في وصيته لابن عباس "يا غلام إنّي أعلمك كلمات" وهذا فيه تنبيه للمتعلم أن ما سيُلقى عليه هو من العلم العظيم. ولهذا يعتني الناس إذا ما سمعوا هذه الكلمة " اعلم "أو " فاعلموا " فيكون هذا من حُسن الخطاب، التنبيه إلى ما سيُعرض "اعلم رحمك الله"، وهذا دعاء من المصنِّفش للمخاطـَبِ وللقارئ بالرحمة، ومن رحمه الله - عزّ وجلّ - وفقَهُ، ومن وفقَهُ أرشده للعلم كما جاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث معاوية - رضي الله عنه -(من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين). فمن رحمه الله وأراد به خيراً رزقَهُ الفقه في دين الله - عزّ وجلّ " أنّه يجب علينا تعلُّم أربع مسائل". " أنه يجب" الوجوب هنا من جهة الشرع، أي أن الشارع أوجب علينا، والضمير في قوله علينا، أي على المسلمين، وهذا ما دلت عليه النصوص كما سيبيّن المصنِّف - رحمه الله - ومن هنا يتبيّن أن العلم الذي سيُلقيه المصنف هنا هو من العلم الواجب وإنه من العلم النفل وليس من فضول العلم، ولهذا كان - رحمه الله - معتنيا بهذا العلم، فعامة كتب الشيخ كانت في أصول الدين ومن العلم الواجب، فدراسة هذه الكتب مهمة جداً لتعلقها بالعلوم الواجبة على المسلمين، ونحن نلاحظ أن الكثير من أهل العلم في عصور مضت صنفوا كتب مطولة لربما كانت في بعض المسائل التي قد لا يُحتاج إليها كثيراً، أو في بعض المسائل التي قد يقال إنها من فضول العلم بل في بعض المسائل التي كان ينهى عنها السلف مثل تفريع المسائل والمسائل الفرضية التي كان يصنف فيها بعض الفقهاء ، وقد كان السلف ينهون عن هذا وكانوا إذا ما سئلوا عن مسألة من هذه المسألة قالوا دعوها حتى تقع فإذا وقعت تكلفنا لها فكانت طريقة الشيخ - رحمه الله - على خلاف هؤلاء معتنياً بالعلم الواجب بل بأصل العلم بالتوحيد،أنه يجب علينا أي على المسلمين تعلّم أربع مسائل وهذا أيضاً مأخوذ من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه أوجز الكلام، وبيّن أنه يجب تعلم أربع مسائل والمسائل الأربع ليست بكثيرة، وهذا كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس : (إني أعلمك كلمات) ولهذا قالوا : "من آثار قبول النصيحة أن تكون موجزة"، وكذلك كانت وصايا النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت موجزة. {{المتن}} الأولى : العلم . هذا المسألة الأولى وهو أصل هذه المسائل، والعلم هو الأصل في العبادة ،فإنه لا عبادة ولا عمل إلاّ بالعلم والعلم يُبدأ به قبل كل شيء، لأنّ العبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا إذا وافقت السنة ولا سبيل لمعرفة السنة إلا بالعلم، العلم الصحيح والعلم إذا أُطلق في كلام الله وفي كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفي كلام العلماء إنما يُراد به العلم الشرعي. ولهذا قال العلماء أن كل ما جاء في فضل العلم فالمراد به هو العلم الشرعي (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)، فالعلم هنا هو العلم الشرعي. والعلم من جهة مصادره ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال بعض السلف (العلم قال الله، قال رسوله ،لا أدري). فهذان مصدرهما : قال الله ، وقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -،المصدر الأول القرءان والثاني السنّة، وهذا من جهة التفصيل، والإ فالكتاب والسنة هما مصدر واحد يَرجع إلى الوحي، ولا يُفرّق بين الكتاب والسنة من جهة الاستدلال، فإن السنة وحيٌ كما أنّ القرءان وحي، فالعلم من جهة القسمة مصدره إمّا إلى العلم بكتاب الله وبسنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - والمصدر الثالث هو : الإجماع. ولهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية : " إنّ أهل السنّة يقيسون الناس والأقوال بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع"، هذه مصادر العلم. ثمّ إن العلم من حيث مرتبه ودرجته في التشريع ينقسم إلى قسمين : 1)العلم الواجب. 2)العلم النفل . فالعلم الواجب هو العلم بما أوجب الله - عزّ وجلّ - من العمل فكل ما أوجب الله من العمل فتعلُم هذا الواجب هو من العلم الواجب ، والعلم النفل هو المتعلق بالعلم بالنوافل فكل ما شرعه الله عزوجل من النوافل فتعلّمه من النفل ، ولهذا فالعلم كالعمل، منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل، وأول ما يبدأ طالب العلم يبدأ بالعلم الواجب فكما أنه لا يتنفل في العمل قبل تأدية الواجب فكذلك ليس له أنْ يطلب العلم النفل قبل العلم الواجب، والعلم هو الأصل في العمل والعلم من جهة النفع به ينقسم إلى قسمين : إمّا أن يكون حجة لصاحبه أو عليه ، إمّا أن ينتفع به فيكون حجة له وشاهداً له ، وإمّا أن يكون حجة عليه وشاهداً عليه، ومن هنا يتبيّن أنّ العلم إذا تحقق فإنه ليس دليل توفيق حتى يقترن به العمل، ثمّ إن العلم من جهة مراتبه فهو أيضاً على مراتب فهناك : 1- علم اليقين 2- وعين اليقين 3- وحق اليقين وهي مراتب متفاوتة أعلاها حق اليقين، ثمّ الذي دونها عين اليقين ثمّ علم اليقين، وهو ما يعرف بالحواس، ما تسمعه من العلم يكون من علم اليقين، فإذا رأيت الشيء فيقال هذا عين اليقين. ولهذا يُقال ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى الشيء كمن سمع به، من رآه له درجة في العلم فوق من سمع. ولهذا عندما يرى الناس يوم القيامة ربهم يؤمنون به جميعاً حتى الكفار، {تَاللهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}، يَرون الرب - عزّ وجلّ -، ويحصُل لهم عين اليقين، وهذه مرتبة فوق المرتبة الأولى. ثمّ المرتبة الثالثة هي حق اليقين وهي أعلى الدرجات، وقد مثّل لها شيخ الإسلام لهذه المراتب بالعسل، فإذا سمع الرجل بهذه المادة وأن هناك عسل يكون هذا من علم اليقين به، وإذا رآه كان من عين اليقين، وإذا أكله كان من حق اليقين. لأن عين اليقين العين قد تُخدع وقد يصيبها ما يصيبها في النظر إلى الحقائق ولهذا الآن يعرف الأطباء أن البصر قد يرى الأشياء على غير حقيقتها ويحصل من التخييل في السحر ما يُخيل للمسحور أنّه يرى الشيء وهو لا يراه، كما قال الله - عزّ وجلّ - : {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} لأنهم يُخيلون لموسى، وأمّا حق اليقين، فهذا الذي لا يمكنْ أن يُلبّس به وهو أنْ يرى الشيء ويجد طعمه ويمازجه ويخالطه، ولهذا يحصل لأهل الجنّة من اليقين عندما يدخلون الجنّة ويمازجون النعيم، كما قال شيخ الإسلام يدخل فيهم ويدخلون فيه ،يدخلون في القصور ويدخل فيهم من المأكول والمشروب. فهذه من جهة مراتب العلم ودون العلم الظن، والظن هو دون العلم ودونه الشك، ودونه الجهل، فالجهل ثمّ الشك ثمّ الظن ثمّ العلم، أمّا الجهل فلا يجوز العمل به وكذلك الشك، فالشك إذا جاء بعد اليقين فإنه يُطّرح، ولهذا يذكُر العلماء أنّ ما ثبت باليقين، لا يُزال بالشك، مثل من كان متطهراً يعلم هذا بيقين فشك في الطهارة فالأصل هو الطهارة فلا يُرفع اليقين بالشك. وأما الظن فإنه على مراتب ،فإنه قد يستوي الطرفان فهذا من مراتب الشك، وقد يتغلب أحد الأمرين، وغلبة الظن يُعمَل بها كما هو مقرر ومعلوم أنّ من غلب على ظنّه شيء فإنه يجوز العمل بغلبة الظن، مثل من شك في صلاته في الرباعيّة مثلاً فشك في ركعة، هل هي الثالثة أم الثانية فغلب على ظنه أنها الثالثة، فيعمل بغلبة الظن، ولكن إذا شك هل هي الثانية أم الثالثة ولم يترجح له شيء، فإنه يبني على اليقين ويعتد بها أنها الركعة الثانية ثم يأتي بالثالثة ويسجد بعد ذلك. فهذا من جهة العلم وما يتعلق به من مراتب، وما يسبقه من مراتب، حتى يحصل العلم، ولا شك أنّ العلم أيضاً من جهة مصادره على مراتب : فهناك العلم بشهادة الشهود، وبنقل خبر العدل الضابط فهذا يحصل به العلم واليقين، وقد يضعُف هذا العلم لضعف النقلة وضبطهم، وهذا مرجعه إلى علم المخلوق للمخلوق، ما ينقله المخلوق للمخلوق وهم مراتب العلم. وأقوى مراتب العلم هو ما بُني على الوحي، فليس هناك أقوى في العلم من الوحي، ولهذا اليقين الذي يحصل لأهل العلم لا يحصل لغيرهم، وبهذا يبرز هؤلاء في الدين ويكون لهم الصبر والجَلَد واليقين بما عند الله – عزّ وجلّ -. مثل دعوة الشيخ محمد، رجل يخرج في نجد لا حول له ولا قوة، ليس له مُعين ولا مناصر - إلا الله - ثم يعرض نفسه على الأمراء، ويقول من نصر دين الله فهو منصور، بأي شيء يحصل هذا باليقين في وعد الله - عزّ وجلّ - ولهذا بهذه المرتبة مرتبة اليقين مع الصبر تحصل الإمامة للرجل في دين الله – عزّ وجل -. فالمرتبة الأولى هي مرتبة العلم : قال:{{هي معرفة الله}} العلم أيضاً من جهة المعلوم على مراتب، فمن مراتبه العلم بالله، وهذا أشرف علم، والعلم يشرُف بشرف المعلوم فأشرف العلم هو العلم بالله، كما ذكر هذا الإمام ابن القيّم قال : " إنّ باب الأسماء والصفات هو أشرف علم لتعلقه بالرب - عزّ وجلّ - فهو أعز مطلوب، والعلم به أشرف علم ،فهذه المرتبة الأولى وهي معرفة الله عزّ وجلّ - وهذا بما أخبر الله – عزّ وجلّ - به عن نفسه، وبما أخبر به رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا سبيل لمعرفة الله – عزّ وجلّ - إلا بهذا . و{{معرفة نبيه }} وهذه المرتبة الثانية من مراتب العلم ، العلم بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أنْ يعرف المؤمن نبيه الذي أرسله الله إليه، ويُصدِّق برسالته، ويؤمن بذلك، ويؤمن بكل ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذاً هنا ثلاثة علوم ،علم بالله وعلم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وعلم بدين الإسلام، هذه هي العلوم النافعة التي ينتفع بها العبد، وما سوى هذه الأقسام من العلوم فهي إما وسائل لخدمة هذه العلوم الثلاثة، وإما أن تكون مضادة لها، فإن كانت مضادة لها فلا خير فيها فهي شر، وإما كانت من الوسائل المفضية إلى تحقيقها فهي ممدوحة بقدر ما تُحقق بها من العلم المطلوب، من العلم بالله، ومن العلم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعرفة الإسلام. وهنا ينبّه الإمام - رحمه الله - على مسألة مهمة في قوله{{ معرفة دين الإسلام بالأدلة}} وأنّ الأصل في هذا أنّ كل مسلم يجب عليه أن يعرف دينه بالأدلة، وهذا هو الأصل. وأما المرتبة الثانية من هذه المراتب وهي مرتبة التقليد فإنه لا يُلجأ إليها إلا عند العجز كما قال الله – عزّ وجل - : {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} وإلّا بالأصل أنّا مخاطبون بالعلم، فيجب علينا أن نتعلم. والعلم هو أنْ يعرف المسلم دينه بالأدلة وأن يعرف الأدلــّــة الدالــّــة على ما يُعبَد الله – عزّ وجل - به، وبهذا يحصل له اليقين، بخلاف الذي يبني علمه على فتوى، فإن الفتوى قد تعارضها فتوى أخرى، ولهذا لا تجدون اليقين الذي يحصل لأهل العلم يحصل للعوام، لأن العوام مبنى كلامهم على الفتاوى، مبنى علمهم على الفتاوى، فإذا أتيت لِعامي يَعبدِ الله أربعين سنّة وقلت له : لمَ تفعل ؟، قال: سمعت الشيخ فلان يُفتي بكذا، فقد يُرفع هذا العلم عنده إذا قلت له : فلان العالم الجليل يُفتي بخلاف كذا، فيبدأ الشك لديه، بخلاف ما أتيت لرجل يَعبدِ الله - عزّ وجلّ - بعبادةٍ يعرف الدليل عليها فقلت له : فلان أفتى، فقال : لديّ دليلٌ لا يعارضُهُ كلام المخلوقين، فمن هنا يتعين على كل مسلم أن يجتهد في معرفة دينه بالأدلــّــة، وأن يعرف الأدلــّــة الدالــّــة على الدين، وليس المقصود بهذا هو التفريعُ بالعلم ومعرفةُ دقائق المسائل، وإنما العلم الواجب، أنْ يعلم الطهارة والدليل عليها، ويعلم الصلاة والأدلة عليها وما يتعلق بها من أركان وواجبات وهكذا. ثمّ ذكر المسألة الثانية وهي العمل. قال رحمه الله :"الثانية العمل به" المسألة الثانية : العمل به ، أي العمل به وهذه هي الثمرة فإن العلم لا خير فيه إن لم يصحبه العمل، فالعلم وسيلة والعمل غاية، والغاية مطلوبة لذاتها، والوسيلة مطلوبة لغيرها، وإن كان العلم عبادة لأنه تتحقق به العبادة، وإلا فالعلم بدون عمل لا ينفع، وهو حجة على صاحبه والعلم الذي هو حجة لصاحبه العلم الذي قارنه العمل والناس في هذا على مراتب : منهم من يعمل بعلمه فهم الموفقون وهم الرسل وأتباعهم والمؤمنون الذين هم على طريقهم. ومنهم من يعلم ولا يعمل وهؤلاء علماء السوء الذين يتعلمون العلم ولا يعملون به، وهؤلاء فيهم شبه من اليهود أهل علم بلا عمل. والقسم الثالث هو من يعمل ولكنه بغير علم، وهذا هو فعل العوام، وأهل الجهل الذي يعبدون الله بغير علم، وهؤلاء فيهم شبه من النصارى، ولهذا يُروى عن سفيان أنه قال :"من كان فيه انحراف من علماءنا ففيه شَبَهٌ من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عُبّادِّنا ففيه شَبَهٌ من النّصارى". ثم القسم الرابع : من لا علم له ولا عمل وهؤلاء هم أشبه الناس بالدّواب الذين ليس لهم همّة لا في العلم ولا في العمل، وإنما هممّهم في قضاء الشهوات وقضاء الأعمار فيما لا ينفع ، لا علم ولا عمل، وهؤلاء شر الأقسام، بخلاف الأقسام الأولى فإن فيها من الخير، وإن كان الخير لم يتحقق من طرفين إلا من أهل العمل والعمل ،والعمل بالعلم هو أن يمتثل العالم علمه ويعمل به،وقد نبّه العلماء على أنّ مما يرسخ العلم هو العمل، كما قال علي - رضي الله عنه - :"هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل ". وكانوا يَرونَ العلم أنه للعمل، كما قال مالك بن دينار :"من تعلّم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس، فإن حاجات الناس لا تنتهي ". والمقصود بالعلم هو العلم وأن يمتثل علمه، كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتجاوزون عشر آيات من القرءان حتى يعملوا بها، فتعلموا القرءان والإيمان وجمعوا بين القرءان والعمل، فكانوا في كل يوم يزدادون علماً وإيماناً، فكان سادة الناس في العلم والعمل في جمعهم بين العلم والعمل، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين، فإنهم يفصلون بين العلم والعمل حتى أن بعض الطلبة الآن يقول : أبدأ بالعلم حتى إذا فرغتُ منه أتفرغ للعبادة، فالأمر يصل أحياناً إلى التفريط في بعض الواجبات أو التكاسل عن بعض النوافل المهمة مثل السنن الرواتب، فهذا قصور فلا شك أن همة طالب العلم في طلب العلم كبيرة ولكن لا ينبغي له أن يفرّط في هذه الأمور. لا بدّ أن يكون لطالب العلم امتثال للعبادة ولايقدم عليها شيء، العبادة الواجبة، ثم كذلك السنن الرواتب التي لا تشغل عن العلم، بل هي بركة وعلم، كذلك الأذكار، أذكار الصباح والمساء، وكذلك أن يكون له حظ من الصيام، وأن يكون له حظٌ من نفع المسلمين، وأن يكون له حظٌ من الدعوة إلى الله - عزّ وجل -. هو يتعلم أما التسويف في هذه الأمور قد يموت وهو لم يعمل ولم يدعو فلا بدّ من مراعاة هذه الأمور، وهذه الأمور لا تشغل عن العلم بل هي بركة وزيادة توفيق، ومما يرسّخ العلم في القلب أن يعمل به، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنّ للعلم عندما يُتعلم لأول مرة وقعٌ عظيمٌ في النفوس، فإذا تباطأ في العمل يُخشى أن لا يُوَفقَ إليه، ولهذا يقولون وهذا أيضا مشاهد وملاحظ كما دلت عليه النصوص : " أن أفضل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أسبقهم إلى الاستجابة الى النبي، ولهذا لما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة قال : ما منكم - ذكر الناس - إلاّ وقد تباطأ أو كلمة قريبة من ذلك إلا أبا بكر، فإنّه لما دعاه لم يتردد، ولهذا كان أفضل الأمة بسبقه إلى الاستجابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ومن امتثل العلم لأول مرة يسمع به أنّه يُوَفـّق للمداومة عليه، ويُخشى إن أخـّر أن لا يُوَفـّق إليه بعد ذلك. فعلى على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذا الأمر العظيم، ومن هنا يتبيّن أنه لا ينبغي أن يُكثر من العلم بدون عمل، لأن العلم كما قال العلماء : " أنه له شهوة " حتى العلم له شهوة، قد يغالب الإنسان في طلب العلم والتفريع في المسائل، فإن لم يصحبه العمل، قد يقسو القلب بعد ذلك، فالذي يكسر الشهوة في كل شيء هو الاعتدال والتمسك بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبهدي السلف. قال رحمه الله - تعالى - :{{الثالثة الدعوة إليه}}. المسـألة الثالثة :"الدعوة إليه" الى العلم. وهو أن يدعو إلى دين الله |إلى دين الإسلام وأن يدعو إلى الله وأن يدعو إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظوا أن هذه المرتبة هي انتقال من نفع الإنسان لنفسه إلى نفعه غيره فهو يتعلم لنفسه ثم يعمل لنفسه ثمّ اذا تحقق له العلم والعمل تعدّى في نفعه لغيره، فدعا الناس إلى الخير الذي هو عليه ، فيدعوهم إلى العلم والعمل، فيدعوهم إلى العمل بعلم على بصيرة من الله – عزّ وجل - فإذا رأى الناس فيه الامتثال أثّر فيهم بدعوته، فإنّه يجمع بين العلم والعمل فيكون مؤثراً،والدعوة إلى الله - عزّ وجلّ - وإلى دينه هي من أعظم أبواب الخير، ويكفي فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الدال على الخير كفاعله) ،كتب الله - عزّ وجلّ - له من الأجر بمثل ما عملوا، ولا يعلم الإنسان إلى أي حد ينتهي العمل بهذا العلم فالعلم مبارك وليس هناك أعظم بركة من العلم إذا صاحبه الإخلاص لله - عزّ وجلّ -، ونشره الرجل بإخلاص وانتفع الناس به فإنه تحيا الناس بالعلم، وتقام السنن وترد البدع، وتحيا القلوب بالعلم، فيكون لهذه الدعوة المباركة أثرها العظيم في رفع درجات ذلك الداعيّة. ومن هذه المسائل يتبيّن لنا أنه لا يمكن أن تكون إلا بعد العلم والعمل، لأنه ذكر هذه المسائل، فقدم العلم ثم العمل ثم الدعوة، فلا يمكن لداعي أن يدعو الناس وهو لا يعلم أو أن يدعو الناس وهو لا يعمل، ومن هنا يتبيّن أن من شرط الداعية أن يكون عالماً عاملا ، فهذا الذي ينفع الله - عزّ وجل - به . قال رحمه الله الرابعة :"الصبر على الأذى فيه" . الصبر على الأذى فيه : أي في الدعوة إلى الله - عزّ وجلّ - لأنه لا بد للداعية الذي يدعو إلى الخير أن تحصل له أذيّة، وأن يحصل له اعتداء،أن يعتدى عليه، كما حصل للأنبياء والرسل، الأنبياء ما سلموا اتهموا بالسحر والجنون والكذب والشعوذة، وهددوا بالقتل وقتل منهم من قُتل، أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طُعن فيهم وتُكلِّم فيهم، ومازال العلماء يُطعن فيهم، هذا الإمام المجدد أول ما بدأ دعوته طـُعن فيه، واتُهم بأنه أتى بدين جديد، وأنّه انحرف عن طريق العلماء مع أنهُ ما كان يتكلم في المسائل الخلافية، وإنما كان يتكلم في أصل الدين الذي يُجمع عليه عامة العلماء. ولهذا كان يقول في بعض رسائله : أنا أناظر كل من أراد المناظرة من الكتاب والسنّة بكلام أئمتهم، فمن كان حنفياً ناظرته بكلام الحنفيّة، أومالكياً أو شافعياً أو حنبلياً، لأن الذي يدعو إليه هو محل إجماع العلماء هو التوحيد وأمّا المسائل الخلافية فهو وغيره يتكلمون فيها، ولكنهم لا يأثمون مجتهداً في مسألة، ولكن الخطورة عندما يُخالَف أصل الدين. فهذا الإمام طـُعن فيه من أقرب الناس إليه، ورُميَ بالعظائم حتى نصرهُ الله - عزّ وجلّ -، وهذه عاقبة الصبر، مع الدعوة إلى الله - عزّ وجلّ -، فلا بدّ من الصبر. ومن أخطر الامور أن الداعيّة إذا ما دعا إلى الله - عزّ وجلّ -، فإذا تعرض النّاس له فإن بعضهم ينصرف من الدعوة إلى الانتصار للنفس، وكم يخُذل في هذا الموطن وَيَنقطِع من يَنْقطِع !! فلا ينبغي للإنسان أنْ يعتني، عرضه في ذات الله - عزّ وجلّ -، ما يُتكلم فيه في مجال الدعوة في مقام الدعوة فهو في ذات الله - عزّ وجلّ -، يحتسب عرضه ونفسه لله - عزّوجلّ -، فهي هينة عليه ، ولكن همه في أن يقوم الناس دين الله ولهذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما كان ينتصر لنفسه وهو الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أن أذيّة النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفر، ولكنّه مع هذا كان يعفو في حياته - عليه الصلاة والسلام -، فينبغي للداعية أنْ لا يعتني بهذا، وينبغي أن يعلم الداعية أن كل الناس خصومٌ له - إلا ما شاء الله -، أهل الغلو خصوم له، وأهل التفريط والكسل خصومٌ له، وأهل البدع بكافة طرقهم هم خصومٌ له، وما أكثر البدع وما أكثر الضلالات، أهل الدنيا الذين يريدون الدنيا ويوجهَهُم إلى الخير، ويمنع من اعتداءهم على الأموال والأنفس خصومٌ له، فكل الناس خصومٌ للداعية الى الله - عزّ وجلّ - لأن الدعوة إلى الدين تخالف الشهوات وتتجلى بها وترتفع بها الشبهات،والناس يألفون ما كانوا عليه من الشبهات والشهوات، ويَعز عليه مفارقة هذه الأمور فإذا جاء من يصرفهم عنها عادوه وخاصموه وتكلموا فيه وتمالئوا عليه، يفترقون إلى أن يجتمعوا على عداء هذا الداعيّة الذي يدعو إلى الله - عزّ وجلّ - ولهذا مهمة الدعوة مهمة عظيمة تحتاج إلى صبر وتحمّل، وهي إذا ما احتسب العبد الصبر، فإنه يوفـّق ويكون النصر قريب، لأنه مع الله - عزّ وجلّ - ومن كان الله معه فإنه منصور،ولكن هذا يحتاج إلى إخلاص وصبر ويقين،وأن لا يُرضي الناس بسخط الله - عزّ وجلّ -. بل يلزم السنّة وينبّه على الأخطاء ولا يخشى في الله لومة لائم، لكن مع العقل والفهم لا يكون متجرئأً يبادر الى التخطئة دون تفقهٍ وعلم، وإذا ما بيّن الخطأ لا يكون أيضاً سيء الأدب لا يُحسن التعامل مع الناس، وإنما يكون على سمت وأدب مع التزام السنّة فإذا كان على هذا الهدي فإنه لا يضره بعد ذلك من خالفه، وأنه منصور بإذن الله ، وسير العلماء فيها عبر ومواعظ فطلاب العلم الذين هم صغار الآن غدا علماء كبار، أئمة يُقتدى بهم، فمن سلك على الطريق منذ حداثة السنّ خصوصاً صغار طلابِ العلم إذا سلكوا هذا الطريق منذ حداثة السن وبداية الطريق، فإنه يُرجى لهم خير عظيم إذا ما لازموا هذا الامر، وقاموا بدين الله - عزّ وجلّ -وحققوا هذه المسائل . رحم الله شيخنا الفاضل محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى مأواه. وجزى فضيلة الشيخ د. إبراهيم بن عامر الرحيلي خير الجزاء وبارك في جهوده ونفع بعلمه. ================================= * سيتبع -إن شاء الله تفريغ الاسئلة كاملة في نهاية الشرح - إن كان في العمر بقية -. * تفريغ الأخوات في اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني - رحمه الله - فجزاهنّ الله خير الجزاء. هذا والله أعلم. أسأل الله - تعالى - التوفيق والسداد للجميع.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم تفريغ الدرس الثاني شرح الثلاثة أصول لفضيلة الشيخ د.ابراهيم بن عامر الرحيلي-حفظه الله- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب أجزل الله له الأجر والثواب : {{المتن}} اعلم -رحمك الله- أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى: العلم، وهو معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة:الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله - تعالى - بسم الله الرحمن الرحيم : ((وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)) {الشرح} : الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: سبق التنبيه على ذكر المسائل الأربعة التي ذكر المصنف هنا وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. ثمّ إنّ المصنِّف - رحمه الله - استدل لهذه المسائل الأربعة بسورة العصر وهي قول الله - عزوجل -:((وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)). وهذه السورة اشتملت على هذه المسائل الأربعة وقد أقسم الله -عزوجل- فيها بالعصر،والعصر قيل هو الدهر وهي الأيام التي يحصل فيها الخير والشر من أعمال العباد فناسب الإقسام بالعصر الذي هو وقت العمل لما بعده من هذه المسائل وقيل إنّ العصر هو العشي ، وهو آخر النهار . والذي رجحه ابن كثير - رحمه الله - هو الأول، وأما الطبري فذكر أن العصر يشمل الدهر، ويشمل العشي، ويشمل الليل والنهار، وقال : إذا شمل هذا الاسم هذه الأمور فليس هناك ما يخصص أحدها دون غيره، وعلى هذا فيكون الإقسام يشمل كل ما ذكر في معنى العصر، والله - عز وجل - يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوقون فليس لهم أن يقسموا إلا بالله - عز وجل -، وإقسام الله - عز وجل - بالعصر هو بما الدهر والله - عز وجل - هو الذي خلق الدهر، وهو الذي يقلّب الليل والنهار. وأقسم بالعصر لمكانته عند العامل، فإن حصاد العبد هو بساعات الليل والنهار، والزمان حجة للإنسان أو عليه كل يوم يمر وينقضي هو حجة للإنسان أو عليه، فإما أن ينتفع في ساعاته ويقضيها في الطاعات، وإما أن يقضيها في اللعب واللهو أو في المعاصي فتكون حجة عليه. "إنّ الإنسان لفي خسر" الإنسان هو جنس الإنسان، وليس المقصود به إنسان معين، والذي يدل على هذا أن الله - عز وجل - استثنى منه "إلا الذين ءامنوا"، والذين ءامنوا هم خلق كثير من هذا الجنس، أي من الناس، فالإنسان هو جنس الإنسان، وهذا أيضا يشمل الثقلين، وإنما ورد هنا على سبيل التغليب، لأن الجن مخاطبون بما خوطب به الإنس، ولكنه ورد هنا مورد التغليب فكل من أمره الله - عز وجل - بالرسالة فهذا حاله، إما أن يكون من المؤمنين العاملين، وإما أن يكون من الخاسرين الذين تركوا العمل. " إن الإنسان لفي خسر" أي في خسارة والخسارة هي خلاف الربح، والتجارة هي تجارتان : تجارة في الدنيا والناس فيها ما بين رابح وخاسر، وتجارة الآخرة والناس فيها ما بين رابح وخاسر، والمقصود بالخُسر هنا هو : خسران الآخرة وأن هذا الجنس وهو الإنسان أنه في خسارة وهلاك إلا من استثنى الله - عز وجل - "إلا الذين آمنوا" أي ءامنوا بالله وبرسله والإيمان بالله وبما جاء به نبيه - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا بالعلم، ومن هنا قال العلماء : أن الإيمان هنا يتضمن العلم. واستدل المصنف بهذه السورة على هذه المراتب، وقد ذكر في المرتبة الأولى : العلم فالإيمان يتضمن العلم، لأنه لا إيمان صحيح إلا بالعلم "وعملوا الصالحات". وعطفُ العلم الصالح على الإيمان لا يدل على المغايرة كما فهمَ من فهمَ من المرجئة، وإنما هو من عطف الشيء على بعضه. فالإيمان يشمل العمل الصالح ولكنه قد يعطف الشيء على بعضه لأهميته فالعمل الصالح من الإيمان، ولكن إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح كان الإيمان هو أعمال القلوب والأعمال الصالحة هي ما يكون من أعمال الجوارح. فالإيمان هو عمل الباطن والإسلام هو عمل الظاهر كما فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث جبريل فذكر الأعمال القلبيّة وذكر أنّها أركان الإيمان، وذكر أعمال الجوارح وأخبر أنّها اركان الإسلام. من الواجبات والمستحبات وما عداها فهو ليس من الأعمال الصالحة فالعمل الصالح ينقسم إلى قسمين : إلى واجبٍ ومستحب، ويجمعهما المشروع، ويضاد المشروع البدعة، فالأعمال باعتبار المشروعية وعدمها، إما مشروعة وإما مبتدعة. والمشروع ينقسم إلى قسمين : إلى واجب وإلى مستحب "وتواصوا بالحق" أي تواصوا بالدين، وقيل بالقرءان ولا تعارض بينهما، أي أنهم تواصوا بالحق، ودين الإسلام حق، فكل ما شرع الله - عز وجل - لعبادِهِ فهو من الحق، والتواصي به هو من الدعوة إليه، قال الله - عز وجل - "وتواصوا بالحق" أي يوصي بعضهم بعضا. والتواصي مفاعلة،أي : أن أهل الإيمان يتواصَون به يوصي بعضهم بعضا، وهذا الدليل على أن النصيحة تكون من كل إنسان لإخيه، وليست هي مختصرة على العلماء، وإنما يُناصَح كل من قصّر وفرّط، ومن هنا كانت النصيحة عامة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : ِللهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ". فكلّ مؤمن هو مطالب بالنصح، أن ينصح، وبأن يقبل النصح إذا نوصح، فيحصل التواصي، أي يوصي بعضهم بعضا، " وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" وذلك أن الاستقامة على الحق تحتاج إلى الصبر، والصبر على مراتب ثلاث : 1-صبر على طاعة الله . 2-وصبر عن معصية الله. 3-وصبر على أقدار الله. يصبر على الطاعة ويؤديها، يصبر على أداء الطاعة، ويصبر عن المعصيّة ويتجنبها، ويصبر على الأقدار إذا ما أصابته، فإذا حقّق هذه المراتب كان من الصابرين. ومن أنواع الصبر ،الصبر على الدين في استقامته عليه، والصبر أيضاً في دعوته الناس إلى هذا الدين، ولأن الداعية يحتاج إلى صبر في الدعوة، وإلى صبر على أذية الخلق إذا ما تعرضوا له، فهذه الأمور الأربعة التي ذكرها الله - عز وجل - هي الصفات التي مَن حققها كان من أهل النجاة، وكان ممن سلم من الخُسر، وإلا فهو خاسر. ولاحظوا أن الأصل في الإنسان كما جاء في هذه السورة أنه موصوف بالخسران إلا من استثنى الله وهم أهل هذه الصفات، وهذا كما جاء في الحديث القدسي :"يا عبادي كلكم ضال إلاّ من هديته " فالأصل أن الإنسان ضال إلا من هداه الله ووفقه، والهداية لهذا الدين وأن يثبته عليه فهو يحتاج إلى هدايته إلى أصل الدين، وهو محتاج إلى هدايته إلى إكمال الواجبات وإلى الثبات على دين الله - عز وجل -. {{المتن}} قال الشافعي - رحمه الله تعالى -:( لو ما أنزل اللهُ حجةً على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ). {الشرح} هذا قول الإمام الشافعي – رحمه الله - وهو مما يدل على فقهه وسعة فهمه لكلام الله - عز وجل -، فإن العلماء يفهمون من كلام الله وما ورد في النصوص ما لا يفهمه غيرهم، ولهذا ذكر الإمام الشافعي أن الله لو لم يُنزل إلا هذه السورة لكفت الناس في دلالتها على الخير، وأن من تمسك بها فإنها كافية له في النجاة لأن الله - عز وجل - ذكر أن الناس أهل خسران إلا من اتصف بهذه الصفات، فمن حقّق هذه الصفات وامتثلها فهي كافية له في العلم، وإذا امتثلها فهي كافية له في العمل فيتحقق بذلك نجاته عند الله - عز وجل - . وكلام الله - عز وجل - مبناه على القوة والمتانة، ولهذا كلما تأمل المتأمل فيه تبيّن له من الفوائد العظيمة التي تخفى على كثير من الناس، فيُلاحَظ أن الإيمان اشتمل على كل شُعَبِ الإيمان. والعمل الصالح جاء مؤكداً لامتثال حقيقة الإيمان حتى لا يتوهم متوهم من أن المقصود هو إقرار القلب ثم التواصي بالحق، وهذا ما يحتاج إليه الإنسان فإنه قد يضعف، والتواصي بالصبر فإنه أيضاً قد يأتيه الخلل من جهة عدم الصبر، فإذا حقق هذه الأمور تحققت له السعادة، تحققت له النجاة بتوفيق الله . {{المتن}}: قال - رحمه الله تعالى - وقال البخاري - رحمه الله تعالى - :باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله - تعالى - : ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ) [محمد:19]. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. {{الشرح}} هنا أيضاً المصنف كلامه بالترجمة التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وهذه ترجمة تدل على فقه الإمام البخاري، ومن هنا استفاد المصنّف - رحمه الله - منها في تقرير هذه المسألة. وهذه طريقة العلماء عندما يستدلون، فإنّهم يعززون استدلالهم بالنصوص من كلام أهل العلم، وهذا لا يعني أن النصوص مفتقرة لكلام الأئمة والعلماء، ولكن هذا إنما هو للإستئناس بكلامهم في الفهم. وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس، يظن أنّه إذا نظر في الآية أو في النص من القرءان أو من السنة أنه يكفي أن يتأمل النص ويستنبط منه ما يرى من الأحكام، وهذا خطاً لأن الإنسان قد يرد عليه الوهم، فعليه أن يرجع إلى كلام أهل العلم وأن يستنير بأقوالهم وأن يرجع إلى اجتهادهم فلهم قدرة على الفهم، وقد منحهم الله من التوفيق ما لم لا يحصل لغيرهم، فلا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، وهذه الترجمة ذكرها الإمام ا لبخاري في الدلالة أن العلم يتقدم القول والعمل، والقول والعمل من الإيمان ولكن لا بد قبل ذلك من العلم. ثمّ استدل الإمام البخاري في هذه الترجمة قال:" باب العلم قبل القول والعمل " والدليل قوله - تعالى -( فاعلم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) استدل بهذه الآية على هذه الترجمة، كذلك المصنف هنا نقل كلامه في الترجمة، والدليل الذي استدل به، قوله - تعالى -( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ). فإن هذه الآية تضمنت أمرين : الأمر الأول :الأمر بالعلم. والأمرالثاني: الأمر بالاستغفار. وقدَّم العلم قبل الاستغفار "فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فقدم العلم على العمل ،ثم إنه أمَرَ بالعلم العظيم الذي هو أصل علم، ( فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ). وكل شعب الإيمان متفرعة عن هذا الأصل العظيم، أن الله – عز وجل - هو المستحق للعبادة ولهذا كل العبادات تصرف لله - عز وجل - ولا يجوز صرفها لغير الله - عز وجل -. ثم جاء الركن الثاني من الشهادتين وهو : أنّ محمد رسول الله - عليه الصلاة والسلام - مقررة في المتابعة، وهو أنّه ليس هناك عبادة يُتقرَب بها إلى الله -عز وجل - إلا بما شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولهذا يقول العلماء في الشهادتين : أنهما تضمنتا توحيد المُرْسِل وتوحيد المُرسَل ،فالمُرسِل هو الله وتوحيده بإخلاص العبادة له، وتوحيده هو بأن لا يُعبَد الله إلا بما شَرَع، ويعنون بتوحيده أي توحيدُهُ بالرسالة لا بالعبادة، أي أنه هو الوحيد المبلَغ عن الله، فلا دين إلا ما شَرَع رسول الله - صلى عليه وسلم -. وتوحيد الله بالعبادة، توحيد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمتابعة، وتوحيد الله - عز وجل - بالعبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بحق إلا الله، وإلا فالآلهة الباطلة التي عُبدت من دون الله كثيرة، ولهذا تقدير الخبر هنا أن لا إله موجود هذا باطل فإنه هناك آلهة كثيرة عبدت من دون الله، ولو قيل أنه لا إله موجود فهذا يتضمن أنه ليس هناك شرك وهذا معنى باطل فالآلهة التي اتخذت من دون الله كثير ولكنها ليست بحق فإذا قُدِّر الخبر هنا أنه لا إله بحق إلا الله ، أخرج هذا القيد كل الآلهة الباطلة التي عبدت بغير حق ،واستغفر لذنبك هذا هو العمل،وهذا يتضمن وجود الذنوب والاستغفار منه وأن الإنسان مهما اجتهد في العمل، فإنه لا بدّ أن يُقصّر، فاستغفر لذنبك فانه متضمنة الإتيان بالعمل، وإذا قصّرت فاستغفر لذنبك ولتقصيرك . {{المتن }}: فبدأ بالعلم قبل العمل قال : فبدأ بالعلم قبل العمل، هذا تعليق من المصنِّف - رحمه الله - على الآية أنّ الله -عزوجل- بدأ بالعلم قبل القول والعمل وهو الاستغفار والاستغفار عمل وهو يتضمن القول أيضاً . {{المتن}} اعلم - رحمك الله - أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، تعلم هذه الثلاث مسائل، والعمل بهن: الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولاً، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله - تعالى - : (( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً)) [المزمل:16- 15]. ثم قال المصنِّف "اعلم رحمك" وهذا أيضاً من التعليم المقرون بالدعاء بالرحمة للمتعلم، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. وكل من خاطبهم الله - عز وجل - بهذا الدين يجب عليهم تعلّم ثلاث مسائل ، كما يجب أيضاً عليهم العمل بهن وهذا مما يدل على المقارنة بين القول والعمل فالتعلم ثم العمل ، فالعلم ثم العمل. الأولى :أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملاً ، هذه المسألة الأولى وقد تضمنت هذه الجملة نِعم الله - عز وجل - على عباده، وذكر هنا ثلاثة أصناف من النّعم : النعمة الأولى : نعمة الخلق، أن الله هو خلقنا هو الخالق المتفرد بالخلق. النعمة الثانية : نعمة الرزق، والعلماء يسمون النعمتين يقولون النعمة الاولى نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية نعمة الإمداد، نعمة الإيجاد من العدم أن خلقنا من العدم. والنعمة الثانية هي : نعمة الإمداد وهو ما تقوم به الحياة وهو الرزق . والنعمة الثالثة : أنه عندما خلقنا وأمدنا بالرزق وقامت الحياة في الدنيا فإنه لم يتركنا هملاً، بل أرسل إلينا رسولاً، وهذه نعمة الهداية للدين . فمن حقق هذه الأمور اكتملت في حقه النّعم، نعمة الخلق، ونعمة الرزق، ونعمة الهداية إلى دين الله -عز وجل -. قوله : ولم يتركنا هملاً، الهمل هو : الإهمال كما ذكر ابن فارس هو : التخلية بين الشيء ونفسه، يقال : أهملت الشيء، أي : خليت بينه وبين نفسه، ومنه قيل في الإبل التي لا راعي لها أنها همل، كما جاء في حديث الشفاعة "فلا أرى يخلُص منهم إلا مثل همل النعَم"، ولا يطلق الهمل على الغنم، وإنما يطلق على الإبل لأنها هي التي تبقى بلا راعي، وأما الغنم فإنها تهلك، فالهمل من الإبل هي التي لا راعي لها ، وكل ما تُرك ولم يُعتنى به فقد أُهمل. والله - عز وجل - خلقنا ولم يتركنا هملاً، أي أنه لم يخلي بيننا وبين أنفسنا، بل هدانا ووفقنا وأرسل إلينا الرسول الذي يبين لنا طريق السعادة ويحذرنا من طريق الشقاء،ولهذا جعل المصنف هنا معنى أنّ الله - عز وجل - لم يتركنا هملاً أنه أرسل إلينا الرسول، لهذا قال بعض أهل العلم : أن الله لم يترك الخلق هملاً بل أمرهم بالطاعة ، ونهاهم عن المعصية. وإرسال الرسول يتضمن هذا بل أرسل إلينا رسولاً، قال : فمن أطاعه دخل الجنّة، ومن عصاه دخل النار، وهذا بعد قيام الحجة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، وهذا كما قال الله - عز وجل - :(( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ )) [ النساء 13 -14]. فمن أطاع دخل الجنّة ومن عصى دخل النار، كل من أطاع الله - عز وجل - الطاعة الواجبة فيما أوجب على عبده دخل الجنة، وهذا هو الإيمان الواجب الذي إذا ما حققه العبد دخل الجنة، كما قال الله - عز وجل - : (( قد أفلح المؤمنون)). وأمّا المعصية فإنها على مراتب. قوله ومن عصاه دخل النار، كل من عصى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه مُستحق لدخول النار، ولكنّ المعصيّة تتفاوت ،فالمعصية باعتبار حكمها تنقسم إلى قسمين : 1-معصية كفر 2-معصية هي دون الكفر فالمعصية التي هي كفر : هي التي توجب خلود صاحبها في النّار، وهذا كما تقدم في الآية :(( وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)). فالخلود لصاحب هذه المعصية. ومن هنا يتبيّن أنّ معنى قوله – عز وجل - :(( مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )) المقصود بالمعصيّة هنا : الكفر، فإن بعض من يكفّر بالذنوب يستدل بهذه الآية على تكفير العصاة، والمعصيّة تطلق كما في هذه الآية على الذنب الذي دون الكفر، كما قال الله - عز وجل - : (( حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ)) هذه نزلت في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، عندما نزل الرماة عن الجبل، وظنوا باجتهاد منهم أن المعركة قد انتهت، كان النبي - صلى عليه وسلم - عَهِدَ إليهم أن لا يتركوا الجبل، فسمّاها الله - عز وجل - معصيّة وذنب. وهذه من المعصيّة التي دون الكفر، كما يحصل للمؤمنين، فالمؤمن يعصي المعصيّة التي دون الكفر، وأما المعصية التي هي الكفر فهي لا توجد مع الإيمان، فالمعصية التي هي كفر موجبة لدخول النار والخلود فيها، والمعصية التي دون الكفر يستحق صاحبها دخول النّار، وإذا دخلها فإنّه لا يخلد فيها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :(يخرجُ من النارِ من كان في قلبهِ مثقالُ ذرةٍ من إيمان ) يعني من بقي في قلبه شيء من الإيمان ولو مثقال ذرة فإنه يخرج من النار، ثم هؤلاء العصاة هم تحت مشيئة الله، فإنّهم وإن كانوا يستحقون دخول النار، فلا يُقطع لكل واحد منهم أنه يدخل النار، ولهذا عقيدة أهل السنة في اصحاب المعاصي أنهم تحت مشيئة الله كما قال الله – عز وجل- (( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء)) [النساء 48]. فأخبر الله – عز وجل - أنه لا يغفر الشرك، ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك لمن يشاء، وهذا لمن مات على ما هو عليه من المعصية، فإن مات على الشرك فإنه لا يُغفر له، وإن مات على المعصية، فإنه تحت المشيئة، أما إذا تاب فإن الله - عز وجل - يتوب على الجميع. ولكن الكلام هنا في من مات على معصية أو كبائر الذنوب أو ما هو دونها، فإذا مات على المعصية، فهو تحت مشيئة الله، ثم إنه دلت الأدلة على أن هؤلاء الذين يموتون على المعاصي فإنه يدخلون النار ويطهرون منها، ثم يخرجون ويدخلون الجنة، ومنهم من يدخل الجنة ابتداءً مع استحقاقه للعقوبة، إما برحمة الله، وإما بشفاعة الشافعين، وإما بما يُكَفّر الله - عز وجل - عن بعضهم من التوحيد كما جاء في حديث صاحب البطاقة. ولكن هل صاحب الكبيرة الآن في الدنيا يُقطع فيه بأنه ممن يدخل النار أولا يدخل؟ لا يُقطع فيه، ولكن نحن نعلم أنه باعتبار المآل والعاقبة أن أهل الكبائر ينقسمون إلى قسمين : منهم من يدخل النار ويطهر بعذاب الله - عز وجل - له في النار ثم يخرج إلى الجنة، ومنهم لا يدخل، وهذا في حق أهل الكبائر، وأمّا الصغائر فيُرجى لصاحبها إن مات عليها وهو من أصحاب الأعمال الصالحة أن يكفّر الله - عز وجل - عنه كما قال الله - عز وجل - :(( إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيماً )) [النساء 31]. السيئات هي الصغائر وهذه تكفرها الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والحج والعمرة. فالمقصود بالمعصية هنا هي معصية الله – عز وجل - ولكن حكمها يتفاوت، ولهذا ينبغي التفريق بين الأقسام، وأكثر ما يحصل الخطأ من عدم التفريق بين الأقسام، فالمعصية ليست على درجة واحدة، فالذي يعمّم الحكم لربما نزّل بعض الأحكام على غير منازلها، فينبغي أن يتأمل سياق ما دلّ عليه فيتبيّن المقصود بالمعصية، فإذا ذكِرَت المعصية، وذكِرَ أن عقوبتها خلود في النار فهي الكفر، وإذا ذكِرَت ووصِفَت بأنها من الذنوب التي يكفّرْها الله - عز وجل - أو أنّه يعذب عليها ثم يدخل الجنة فهي من الذنوب التي دون الكفر. ثم قال والدليل قوله تعالى:(( إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً )) [المزّمّل 15 - 16]. وهذا دليل أن من أطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يدخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فإن الله أخبر أنه أرسل إلينا الرسول كما أرسل إلى فرعون الرسول وهو موسى - عليه السلام - الذي أرسله الله إلى فرعون، ولكن الله – عز وجل - لم يذكر العقوبة لمن عصى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكنّها مفهومة من عقوبة من عصى فرعون، فكما أن الله أرسل الينا رسولا، كما أرسل إلى فرعون رسولا وبيّن لنا عقوبة فرعون الذي عصى موسى فكذلك العقوبة لمن عصى النبي - صلى الله عليه وسلم -. في قوله :(( فأخذناه أخذا وبيلا )) أي شديداً، والوبال هو الشدّة وما يشق على الإنسان، وهذه المادة تُطلق على كل شيء شديد كما قال الله - عز وجل - في وصف المطر :(( كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ )) [سورة البقرة 265] قالوا : بل هو المطر الشديد المتتابع، وكذلك العقوبة إذا وصفت بالوبال، أو أنها شديدة، أي وبيلة. وكذلك قول الله - عز وجل - :(( فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ )) [سورة التغابن 5]. أي عقوبتهم الشديدة، والوبال هو : كل ما يعقب العمل من الشدة، وكل مُخوّف في المستقبل. يُقال هذا وبال الفعل، أو أنه ما أفضى إليه . {{المتن}} : قال - رحمه الله تعالى - : الثانية : أن الله لا يرضي أن يُشرك معه أحد في عبادته لا مَلَكٌ مُقرّبٌ ولا نبيٌ مُرْسَل والدليل قوله - تعالى - : (( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً)) [الجن:18] هذه المسألة الثانية : وهي أن الله - عز وجل - لا يرضى أن يُشرَكَ معه أحدٌ في عبادته لا ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌ مٌرسَلٌ. قوله : " إنه الله لا يرضى "، الرضى هو في معنى الإرادة الشرعية، فإن الإرادة الشرعية مستلزمة للرضا، وكل ما رضيهُ الله فإنه أرادهُ الشرع ، ولا يلزم أن ما رضيهُ الله يريده كوناً، بل الإرادة الكونية إما أن يرضاها الله إذا كانت متعلقة بالشرع. وإما أن لا يرضاها الله إذا كانت متعلقة بالكُفر، ومن هنا أشكل هذا الأمر على بعض من ضلّ في القدر، فظن بعضهم أن الرضا ملازم للإرادة، فكل ما أراده الله – عز وجل - كوناً رضيه، وليس الامر كذلك بل إن الله -عز وجل - يقدِّر الكفر على الكافر ولا يرضاه، ويقدِّر الإيمان على المؤمن ويأمر به ويرضاه ويحبه، فالرضا ملازم للإرادة الشرعية كل ما أراده شرعاً رضيه - سبحانه -، ولذا قال الله - عز وجل - : (( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا )) [المائدة 3]. فرضي لنا الإسلام ولم يرض لنا الكفر، وأما في الإرادة الكونية فإن الله - عز وجل - أراد كوناً أن يكون هناك الإيمان والكفر ولكن المؤمن يؤمن ويطيع بمشيئته واختياره، والكافر يكفر ويعصي بمشيئته واختياره، والعبد هو المؤمن والكافر والله هو المقدِّر للكفر والإيمان والله يرضى الإيمان ولا يرضى الكفر، ويأذن بالإيمان الإذن الشرعي، ولا يأذن بالكفر أن يُشرَكَ معه أحد في عبادته، وهذه قاعدة مضطردة، إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، وسواء كان هذا المعبود هو ملكٌ مقربٌ من الملائكةِ المقربينَ أو نبيٌ مرسل، فإذا كان الله لا يرضى أن يشركَ معه أحدٌ من الملائكة المقربين أو نبيٌ مرسلٌ الأنبياء المرسلين، فكيف بمن هو دونه ؟؟، لأن العبادة حق لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك، والملائكة المقربون ما نالوا ما نالوا من الفضل إلا بعبادتهم لله، والأنبياء والمرسلون ما نالوا ما نالوا من الفضل إلا بعبادتهم لله، فأصل فضلهم هو عبادتهم لله، فكيف يَعبُد العبد ؟؟ – يعني أعظم الناس تحقيقاً للعبودية - هم الملائكة والأنبياء والرسل فما نالوا هذه المنازل إلا بعبادتهم لله - عز وجل -، فكيف يُعبَد من هو أعظم الناس عبودية لله - عز وجل -. ولهذا فمقام العبودية هو أعظم المقامات ولهذا امتن ّ الله - عز وجل - على نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن وصفه بأعظم الأوصاف في مقام العبودية : قال:(( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ )) [ الإسراء 1]. وقال :(( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ )) [ الكهف 1]. وقال:(( وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ )) [ الجن 19]. فوصفه بالعبودية في مقام الوحي وفي مقام الإسراء وفي مقام العبادة والصلاة. وأشرف اسم للإنسان هو أن يكون عبداً لله، وأبخس اسم وأحقره أن يكون نداً لله، ولهذا لما قال الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - ( ما شاء الله وما شئت ) قال:(أجعلتني لله ندا) فتبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم أن يكون لله نداً . وقال صلى الله عليه وسلم:(لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله ). ليس هناك أشرف من هذا المقام، مقام العبودية، وأن يكون عبداً لله - عز وجل - ولهذا هذا الباب لا يجوز أن يُصرف لغير الله، وقد ذكر المصنف - رحمه الله - في كتاب كشف الشبهات وغيره من الكتب أن الشرك يتساوى أهله في صرف العبادة لغير الله - عز وجل - سواء صُرفَتْ للملائكة أو للأنبياء أو للاحجار أو للأصنام كله شرك، ولم يأت من النصوص أنه من أشرك مع الله - عز وجل - في الأنبياء أو في الملائكة أنه ليس كالذي أشرك في الأصنام، كلهم في نار جهنم خالدون مخلدون فيها ، لأن هذا المقام هو مقام الرب - عز وجل - لا يجوز أن يُصرَف لغير الله. وما من نبي وَوَلِي ومَلك إلا وهم يتبرأون من عبادة الناس له، ولهذا فأشد الناس عداوة لهؤلاء الذين يَعبُدونهم من دون الله هم أولئك الصالِحون، ولهذا قال علي - رضي الله عنه -:( اللهم إني أبرأ إليك من الغلاة براءة عيسى من النّصارى )وعيسى يتبرأ من النّصارى يوم القيامة، وكذلك كل صالح فهو يتبرأ من عبادة هؤلاء الذين عبدوه من دون الله. قال والدليل قوله - تعالى - : (( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) [الجن 18]. وأن المساجد قيل : هي البيوت المبنية لذكر الله، وقيل المساجد هي : مواطن السجود لأنه يُسجّد عليها، والمقصود أن العبادة لا تُصرف إلا لله – عز وجل -، فالمساجد التي أقيمت لعبادة الله لا يجوزأن يعبد فيها غير الله، والسجود الذي شرعه الله لنا وهو أجل العبادات، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لا يجوز أن يُصرف لغير الله - عز وجل -. ومن صرفه لغير الله فقد أشرك،لا يجوز أن يؤدى السجود لا على وجه التحية، ولا على وجه التوقير، ولا يجوز أن يُؤدّى لمخلوق، وضابط هذا الأمر أنّ من سجد السجود الذي يكون لله لغير الله فقد أشرك وكذلك إذا ركع الركوع الذي يكون لله، لغير الله فقد أشرك. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا كما يفعله بعض الجهلة، عندما يلقى الرجل الرجل يركع له، أو ينحني له، الإنحناء مكروه، وقد يكون محرم، وأمّا إذا بلغ بالانحناء إلى درجة الركوع، فقد صرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذه العبادات كلها لله - عز وجل - وهو المستحق لها. ومن صرفها لغير الله فقد أشرك ،وهذا الشرك محبطٌ للعمل كما قال الله - تعالى -: ((وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )) [الزمر 65]. نوع واحد من انواع الشرك يُحبط العبادة الدهر كله، ليس من صفة المشركين أنهم مشركون في كل شيء، بل من وقع في نوع من أنواع العبادة فهو مشرك، وإلا كفار قريش كانوايعبدون الله، ولكنهم ما أخلصوا العبادة لله، فالخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامَهم في هذا الأمر، وإلا ما من مخلوق إلا وهو يعبد الله - عز وجل - ولهذا قال الله - تعالى - في ابراهيم أنه قال :(( فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ )) [الشعراء 77]. لما استثنى رب العالمين، لأنهم يعبدونه فتبرأ من آلهتهم إلا الله - عز وجل -، فكانوا يعبدون الله وما كانوا يخلصون العبادة لله، وبعض الجهلة الآن من المسلمين يظن أن العبادة هو أن يعتقد أن هذا الذي يعبده هو خالق ورازق، وأنه إذا صرف نوعا من أنواع العبادة لا تضر، ليست هذه بعبادة، هذا فهم المشركين الذين كانوا يقولون إن الله هو الخالق الرازق وأن العبادة لا تضر في توحيدنا، ولهذا أخبر الله - عزوجل -أنهم كانوا يقرون بالربوبية، وكانوا يعرفون الله - عز وجل -، ولكنهم ما كانوا يُخلصون العبادة لله - عز وجل - فهذا الأمر هو الفرقان بين أهل التوحيد وأهل الشرك، بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفر، بين أهل الجنّة وأهل النّار ، من لقي الله بالتوحيد فهو من أهل الجنة، ومن لقي الله بالشرك فهو من أهل النار والعياذ بالله. الثالثه : أن من أطاع الرسول ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى:(( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [المجادلة:22]. المسألة الثالثه: أن من أطاع الرسول ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حادّ اللَ ورسولَه، ولو كان أقربُ قريب. هنا نلاحظ أنه جمع بين رُكنَيْ الشهادة طاعةَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوحيد الله ،أنه من حقــّــقَ هذين الأمرين وهما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله - عليه الصلاة والسلام -. لا يجوز له موالاة من حادّ الله ورسوله، لا يجوز له أن يتولى المحادّين لله ورسوله. المحادّون لله ورسوله هم الكفار، والمحادّة : هي من الحد، وهو أن يكون الرجل في حدّ ومن يحادّه في حدّ آخر، فالمؤمنون في حدّ، والكفار في حدّ، والذين حادّوا الله ورسوله هم الذين انصرفوا عن دين الله - عز وجل - وكانوا هم في حدّ والمؤمنون في حدّ، لأن مبناها على أصل عظيم ينبغي أن يُنظر في تحقِّقه فيمن يوادّ، لأن هذه الموالاة إنما تكون لله، فمن والى الله فهو وليٌ لكل مؤمن، ومن حاد الله ورسوله وجب على كل مؤمن أن يحادّه وأن يبرأ إلى الله من محبته ومن مودّته". قال : والدليل قوله - تعالى - : (( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ )) [المجادلة 22]. لا تجد قوما يؤمنون بالله -أي أنه لا يوجد في الواقع - وهذا خبر من رب العالمين وهو دليل اجتماع الأمرين الإيمان بالله واليوم الآخر ووموادّة من حادّ الله ورسوله وهذا خبر متضمن النهي عن هذا بل إنه دليل على أنه لا يقع فإذا وُجد فلا بد أن يكون هناك نقص في الإيمان، أما إذا وجد الإيمان بالله وباليوم الآخر فلا بدّ أن توجد البراءة من هؤلاء المُحادين لله ورسوله، وإذا وادّهم وأحبّهم فهذا دليل على نقص إيمانه أو أنه لا يعرفهم كأن يجهل حالهم أما إذا عرفهم أنّهم من أهل الكفر والمحادّة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يمكن أن يوادّهم ويحبهم ويتولاهم ومن هنا تبرأ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أقربائه الذين كانوا من أقرب الناس إليهم تبرأوا منهم وبعضهم قتل أباه وبعضهم همّ بقتل أبيه طاعة لله ولرسوله ومحبة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، قال - تعالى -: (( وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ )) هذه أعظم ما يسعى الإنسان في التقرب إليه من هذه الأصناف الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة، لأنهم عوْن للإنسان وأقرب الناس إليه، فهذا امتحانٌ عظيمٌ أن يُبتلى الإنسان بهذه القرابات وهم على الكفر، فعند ذلك يظهر صدق الإيمان، فإذا عاداهم في الله فهو من المؤمنين بالله وباليوم الآخر، وإذا وادهم ارتكس في الكفر وخرج من الدين، ومودة الكفار كُفر إذا أحبهم المحبة التي نهى الله - عز وجل - عنها، ولهذا أخبر أن الإيمان لا يوجد هنا مع هذه المودة، ثم بيّن الله - عز وجل - وصف هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ولم يُوادوا هؤلاء قال : (( أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) [المجادلة 22]. والكتابة هنا أي قدَّر ذلك كوناً وشرعاً لهم ، فهم مؤمنون بالله وقد كتب الله - عز وجل - ذلك لهم ومما قضى به كوناً وقدراً فهم من أهل الإيمان، وهم الذين حققوا الإيمان الشرعي، واستجابوا لأمر الله الشرعي بالإيمان. (( وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ )) قيل : معنى أيدهم بروحٍ منه : أي بنصره وتأييده وقيل بروحٍ منه أي : بالقرءان وقيل بالقرءان وبِحُجَجِه. وإنما سمّاه روحاً لأنه به تحصل لهم الحياة بنصر الله وبتوفيقه، والروح تطلق على القرءان، كما قال الله - عز وجل - :(( وكَذَلِكَ أوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا )) فالروح هنا هو القرءان. وتطلق على جبريل كما قال الله - عز وجل - :(( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ )) [الشعراء 193]. قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : [القرءان سمّي روح لأنّ به حياة الإنسان، وجبريل لأنه ينزل بالوحي، والروح الذي هو القرءان هو صفة الله، وكلام الله من صفاته، والروح إذا اطلقت على جبريل فهو خلق الله، ومن هنا يتبيّن أن الروح تطلق على الصفة، وتطلق على المخلوق، فجبريل مخلوق وهو روح الله، والإضافة هنا إضافة تشريف. ويطلق على القرءان من باب إضافة الصفة إلى الموصوف والمقصود أن الله أيّده بالقرءان وَبِحُجَجِه حتى استقر في قلوبهم . (( وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا )) هذا أيضاً من صفاتهم، والدليل ما يكون لهم من العاقبة وتكون الجنة ثم أيضاً وصفهم بأنهم " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ" وهذه أعظم المراتب وهو أن يرضى العبد عن ربه، ويرضى عنه الرب - عز وجل -. ورضا العبد عن ربه هذا يتحقق لكثير، ولكن الشأن في أن يرضى الرب عن العبد، ولهذا وصف الله - عز وجل - أصحاب النّبي - صلى الله عليه وسلم - بأنّه - رضي عنهم ورضوا عنه - وأما من هو دونهم فإنه قد يرضى عن الله، ولكن الله -عز وجل - لا يرضى عنه، ولهذا كان بعض السلف يهاب أن يسأل الله الرضا، ولكنهم يسألون الله المغفرة، لأن الرضا درجة عالية وهو أن يرضى الله - عز وجل - عن العبد وهذه المنزلة لا تُنال الا بتوفيق الله مع الاجتهاد في العمل. (( أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ )) والمقصود بحزبِ الله : الفريق الذين أطاعوا الله - عزوجل - واضافهم الله - عز وجل - اضافة تشريف. والحزب هم : الشيعة والمناصرون للرجل، فإذا أضيف قيل : حزب فلان، أي شيعته ومناصروه، وحزب الله إذا أضيف إلى الله - عز وجل - إضافة تشريف - أي أنهم في الفريق الذين أطاعوا الله - عز وجل -. ثم بيّن وصف هؤلاء قال:(( أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )) أي : أنه تحقق لهم الفلاح بطاعتهم لله - عز وجل -. كما وصف المؤمنين بذلك قال الله - عز وجل - :((قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ)) [المؤمنون 1 - 2]. فالفلاح هو دخول الجنة . نسأل الله التوفيق،هذا والله - تعالى - أعلم .
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#3
|
|||
|
|||
|
وفقكم الله -أيتها الفاضلة-، ونفع الله بهذه الجهود المبارَكة، وأجزل الله لكم المثوبة والأجر، ويسر لكم إتمام هذه المشروع الطيب.
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
آمين ... آمين، وإياكم ابنتي الغالية " أم زيد " ولكم بمثل وزيادة، رؤية وجه الله الكريم في جنة عرضها كعرض السموات والأرض.
شكر الله لك المرور والدعاء وبارك فيك وعليك، ونفع بك وبعلمك. وشكر الله للأخوات الفاضلات في اللجنة النسائية بمركز الإمام الألباني - رحمه الله تعالى -، وبارك فيهن وفي أعمالهن، وعمر بالصالحات أعمارهن، وإياكم. وجزى فضيلة الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي خيرًا وبارك في علمه وعمله. ورحم الله شيخنا العلامة محمد بن عبدالوهاب - رحمة واسعة وجعل الفردوس الأعلى ماواه -.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#5
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم تفريغ الدرس الثالث شرح الثلاثة أصول لفضيلة الشيخ د.ابراهيم بن عامر الرحيلي-حفظه الله- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: {المتن} قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدِّد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: اعلَمْ -أرشدَكَ اللهُ لطاعتِه- أنَّ الحنيفيةَ: مِلَّةَ إبراهيمَ، أنْ تعبدَ اللهَ وحدَهُ مخلصًا له الدِّين، وبذلك أَمَرَ اللهُ جميعَ الناس وخلَقهم لها، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾[الذاريات:56]، ومعنى ﴿يَعْبُدُونِ﴾ يوحِّدونِ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد،،، {الشرح} يقول المصنِّف -رحمه الله- (أعلمْ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ) وهذا على ما تقدم بيانه بأنه من جمع المصنِّف -رحمه الله-بين التعليم والدعاء للمتعلم بالتوفيق، والرشد هو خلاف الضلال والغي والرشد يقع على نوعين كما هو الشأن في الهداية فإن الهداية تنقسم الى قسمين هداية دلالة وارشاد وهداية توفيق . وكذلك الرشد فإن الرشد يقع على المعنى الأول وهو الدلالة الى الدين بإرسال الرسل والرشد بهذا المعنى تحقق لكل الأمة فما من رجل أو امرأة بلغته دعوة الإسلام إلا وقد تحقق له الرشد وذلك ببيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين. وهذا الرشد هو بمعنى هداية الدلالة ولهذا تسمى هذه الهداية هداية الدلالة والارشاد أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالدين وبينه ووضحه. والمعنى الثاني هو الرشد الذي بمعنى التوفيق وهذا كما حصل للمؤمنين في قول الله -عزوجل- :" وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ "فهؤلاء وصفهم بالر شد ،وهو الرشد الخاص الذي امتن به الله على هؤلاء وهذا كما قال الله –عزوجل-:" مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا" ،لن تجد له وليا مرشدا إلى التوفيق وقبول الحق. وإن كان الإرشاد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تحقق لكل من بلغه وهو الذي تقوم به الحجة على الخلق فالرشد الذي تقوم به الحجة على الخلق هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والرشد الذي هو من توفيق الله –عزوجل- هذا خص الله -عزوجل- به المؤمنين ووفقهم وهداهم بسبب ما بذلوا من اسباب الهداية وبتوفيق الله -عزوجل-. والرشد المقصود للمصنِّف هنا هو المعنى الثاني وإلّا فالمعنى الأول فهو متحقق للأمة كلها ،أن الله أرشدها إلى الدين وبينّه لها ولكن الرشد الخاص الذي دعا به المصنِّف هو أن يكون الرجل راشداً في قلبه وهذا لا يملكه إلا الله -عزوجل- ومن هنا فإن الإنسان محتاج إلى أن يوفقه الله لهذا الرشد . ( أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ) أي وفقك وهداك لطاعته ولا شك أن أعظم التوفيق هو توفيق الله –-عزوجل-- للعبد في طاعته وهناك توفيق آخر أن يوفق في مطالب الدنيا لكن التوفيق الأعظم الذي هو دليل السعادة توفيق الله للعبد في آخرته وفي الأعمال الصالحة. (أنَّ الحنيفيةَ: مِلَّةَ إبراهيمَ، أنْ تعبدَ اللهَ وحدَهُ مخلصًا له الدِّين) الحَنَف في اللغة هو الميل والحنيفيّة هي ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحنيف أي أنه كان مائلا عن الشرك كما قال الله -عزوجل- "ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا" ،أي أنه مائلاً عن الشرك إلى التوحيد مستقيماً على طاعة الله -عزوجل- والحنيفيّة هي الشريعة التي بعث الله -عزوجل- بها إبراهيم وهي التي بعث بها محمداً صلى الله عليه وسلم ، والرسل متفقون في أصل الشريعة وهو تحقيق عبادة الله --عزوجل-- والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وهذان الأمران بعث الله -عزوجل- بهما كل نبي كما قال تعالى :" (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت" وما من نبي إلا دعا قومه الى هذه الكلمة :" يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إلَهٍ غَيْرُهُ" فالكل دعا إلى اخلاص العبادة لله -عزوجل- أما الشرائع فإنها متفاوتة بحسب أحوال الأمم وهذا من حكمة الله -عزوجل- (أنْ تعبدَ اللهَ وحدَهُ مخلصًا له الدِّين) هذه هي الحنفية وهو تحقيق عبادة الله -عزوجل- مع الإخلاص لله -عزوجل- في العبادة وان لا يُعبد إلا الله -عزوجل- وهذه متفق عليها بين كل الأنبياء لكن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الحنفية التي بعث الله -عزوجل- بها ابراهيم . قال:(وبذلك أَمَرَ اللهُ جميعَ الناس) يعني بهذا الأصل أصل الدعوة وأصل دعوة الأنبياء بعث الله به كل الرسل ،وأمر الشرائع فإنه متفاوتة ومن هنا كانت الصلاة في بني اسرائيل ليست كالصلاة التي شرعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من أحوالها وما يشترط لها ولهذا خص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا ولم تجعل لمن قبله ،وهناك أحكام أخرى كما في التوبة أيضاً فإن من شروط قبول التوبة في بني اسرائيل أن التائب لا بدَّ أن يقطعَ شيئا من أعضائه فهذه نسخها الله -عزوجل- فكانت هذه الحنيفيّة السمحة التي بعث الله -عزوجل- بها نبينا صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء من الآصار والأغلال التي كانت على بني اسرائيل،وكذلك الغنائم أحلت لنبينا صلى الله عليه وسلم ولم تحل لنبي قبله بل كانوا يجمعونها في مكان فإذا احترقت عرفوا ان الله -عزوجل- قد قبلها. قال (وبذلك أَمَرَ اللهُ جميعَ الناس وخلَقهم لها) أي خلقلهم لاخلاص العبادة كما قال تعالى :" ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ أي أن الله -عزوجل- خلق الجن والإنس لهذه الغاية وهي تحقيق عبادة الله -عزوجل-، وقد جاء في كلام بعض أهل العلم وخصوصا المتأخرين أنهم يقولون الحكمة من خلق الجن والانس هو تحقيق العبادة والذي جاء من بعض كلام المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد الامين الشنقيطي-رحمه الله- أنهم يقولون الغاية من خلق الجن والإنس هو تحقيق العبادة وهذه الكلمة الثانية أدق لأن الحكمة متحققة في خلق المؤمن والكافر فهل الكافر إذا خرج عن حكمة الله -عزوجل- فالله بحكمتة خلق المؤمن والكافر فكل تحقق به الحكمة ومن هنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ما من مخلوق لله -عزوجل- إلا وله فيه حكمة ،والله -عزوجل- لا يخلق الشر المحض حتى خلق إبليس فإن فيه حكمة وهو وجود الكفر وبناء على ذلك يوجد الجهاد وتحصل الأذية للمؤمنين فترتفع درجاتهم عند الله -عزوجل- ،فالحكمة متحققة في خلق هذا وهذا، وأما الغاية التي خلق الله -عزوجل- لها الثقلين فهي تحقيق العبادة التي تحققت في المؤمنين وهذا مما يدل على أن ما قضى الله -عزوجل- به كوناً أنه لا يخالف الحكمة فقد يقول قائل ما الحكمة من وجود الكفر؟ نقول هذا لله -عزوجل- فيه حكمة، ومن هنا يتبين أنّا لو قصرنا الغاية على خلق الإنس والجن وقلنا هي الحكمة فيلزم من عاد أن كفر الكافر قد خرج عن الحكمة وهذا غير صحيح، فالحكمة متحققة في خلق هذا وهذا. وأما الغاية فهي التي خلق الله -عزوجل- الثقلين وهي العبادة وأما وجود الكفر في الكافر فهو وإن كان خلقه الله -عزوجل- بحكمته فهو به لم يأذن به شرعا ولم يأمر به ولا يحبه، ولكنه بمقتضى حكمته خلقهم فما من موجود ومخلوق إلا ولله -عزوجل- فيه حكمة متحققة في خلق الجميع ،ولهذا الأنسب في هذا أن يقال الغاية من خلق الجن والإنس هي تحقيق العبادة وهذا هو المستقيم من ناحية اللغة فإن العلماء يقولون أن الأشياء إما وسائل أو غايات فالوسيلة هي الطريق إلى الغاية . فالله -عزوجل- خلق هذه الخليقة لغاية وهي تحقيق عبادة الله –عزوجل- وهذه الغاية التي أرادها الله -عزوجل- شرعاً قد تتحقق في بعض الناس كحال المؤمن وقد تتخلف في بعض الناس كحال الكافر ، وكفر الكافر وإيمان المؤمن كله بحكمة الله -عزوجل- فلله -عزوجل- الحكمة في هداية من هدى وفي إضلال من ضل وفي ثواب من أطاع وفي عقوبته لمن عصى فإن لله -عزوجل- الحكمة في كل شي. قال :(ومعنى ﴿يَعْبُدُونِ﴾ يوحِّدونِ) وهذا كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"كلما وردت العبادة في كتاب الله فهي بمعنى العبادة "فكل ما جاء الأمر بالعبادة فهو بمعنى التوحيد وهذا كما جاء في حديث معاذ بن جبل عندما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس قال: "فليكن أول ما تدعوهم اليه أن يعبدوا الله وفي بعض الروايات (أن يوحدوا الله) "فهذا دليل أن معنى العبادة بمعنى التوحيد،ولا تستقيم العبادة إلا بالتوحيد فالشرك إذا دخل في العبادة احبطها وأفسدها ولم يبق لها أثر ومن هنا فالتوحيد هو العبادة. قال المصنف (وأعظمُ ما أَمرَ اللهُ به التوحيدَ) هذا الأمر يتفاوت أمر الله -عزوجل- هل يتفاوت فيقال هذا اعظم ما أمر الله به وهذا دونه؟هنا تفصيل ينبغي التنبّه له، أما من جهة المتكلم والآمر وهو الله -عزوجل- فكلام الله -عزوجل- لا يتفاضل باعتبار المتلكم به لأن الكل من كلام رب العالمين وأما باعتبار المأمور به فإن الأوامر تتفاضل باعتبار ما أمر الله -عزوجل- به فأمر الله بالتوحيد أعظم من أمره بما هو دونه من الواجبات وهذا مرجعه إلى ما يتضمنه الأمر، وكذلك أمر الله -عزوجل- بالواجبات هو أعظم من أمر الله -عزوجل- بالمستحبات فهذا من جهة المأمور به فالواجب فوق المستحب، والتوحيد فوق سائر الأعمال، والتوحيد أصل والأعمال والأعمال شعب للتوحيد ولهذا اذا وجد أصل التوحيد ارتفع الشرك ،فإذا تحقق التوحيد بعد الشرك فإنه يزيل الشرك فكل من وحد الله بعد الشرك فقد تاب من الشرك وانتقل الى الإسلام،فالتوحيد أمره عظيم ولهذا فأمر الله -عزوجل- بالتوحيد أعظم من أمره ببقية الواجبات فأمر الله بالشهادتين أعظم من أمر الله -عزوجل- بالصلاة لأن الشهادتين متضمنة للتوحيد والصلاة محققة له فهي من الاعمال والشعب التي يتحقق بها التوحيد لكنها شعبة، وشهادة ان لا اله الا الله هي الأصل ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة من الزمن وهو يدعو إلى شهادة لا أن لا إله إلا الله وهذا دليل على عظم هذا الأمر واهميته،لأن من حقق الشهادتين سهل عليه بقية الواجبات. قال :(وأعظمُ ما أَمرَ اللهُ به التوحيدَ وهو: إفرادُ اللهِ بالعبادة) بأن لا يعبد إلا الله -عزوجل- تُخلص العبادة لله وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو الذي يضاد التوحيد ،فالتوحيد أصل عظيم والشرك أصل يقابل التوحيد فإذا وجد الشرك بعد التوحيد ارتفع التوحيد وإذا وجد التوحيد بعد الشرك،وشهد الرجل شهادة أن لا إله إلا الله فإنه تكون هذه له توبة من الشرك ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك عمن قال لا اله الا الله ولوكان في وقت يسير ليس بينه وبين قول هذه الكلمة إلا ان يلوذ بشجرة بل يقاتل على الشرك ويضرب بسيفه فإذا قال لا إله الا الله عصم الله بها دمه،وهذا دليل على عظم هذه الكلمة. ومن هنا عظم العلماء أمر المسلم ولم يسارعوا إلى الحكم على من قال لا إله الا الله بمجرد الظن بل قالوا من ثبت إسلامه باليقين فلا يزال عنه إلا بالشك ،ولا يزال عنه إلا بيقين ،لا يزال عنه بالشك لأن قول لا إله إلا الله هذا من اليقين في دخوله في الإسلام فإذا صدر منه شيء من الأعمال والأقوال التي قد يحصل منها ما هو من جنس الشرك فإنه لا يسارع إلى تكفيره لأنه قد يكون متأول او جاهل فلا يقطع بكفره حتى يثبت أنه فعل الشرك وهو عالم به عند ذلك يُحكَم عليه. {المتن} قال : (وأعظمُ ما نهى عنه الشركُ؛ وهو دعوةُ غيرهِ معهُ، والدليل قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾النساء:36 وهنا عبر المصنف بالدعوة ولم يقل العبادة والدعاء بمعنى العبادة لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين : *دعاء مسألة *ودعاء عبادة وهذا كما قال الله -عزوجل-:" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ "فأمر بالدعاء ثم قال الذين يستكبرون عن عبادتي ،فأطلق العبادة على الدعاء وهذا يرد في كتاب الله -عزوجل- ،وقول المصنِّف هو موافق لما جاء في النصوص من أن الدعاء يطلق على العبادة. دعاء غير الله معه بمعنى قوله عبادة غير الله معه قال :والدليل قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ وهذا مؤكد لما أراد المصنف وأنه لم يرد الدعاء الذي هودعاء المسألة وإنما أراد دعاء العبادة ولهذا استدل بهذه الآية التي هي صريحة بالأمر بالعبادة ووجوب اخلاص العبادة لله -عزوجل- والبراءة من الشرك ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ وهذا يدل على الركنين العظيمين من أركان الاسلام شهادة أن لا إله إلّا الله عبادة الله مع البراءة من الشرك فالعبادة قد لا تسلم من الشرك فإذا دخل عليها الشرك أحبطها وأفسدها،فلابد من البراءة من الشرك مع عبادة الله،عبادة الله مع البراءة من الشرك ،والله -عزوجل- لا يقبل من العمل الا ما كان خالصاً ،كما جاء في الحديث في صحيح مسلم :" أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه "،فالعبادة لا تنفع إذا خالطها الشرك والله أغنى الاغنياء عن هذه العبادة. {المتن} قال- رحمه الله- فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثلاثةُ التي يجبُ على الإنسانِ معرفتُها؟ فقُلْ: معرِفةُ العبدِ رَبَّهُ، ودينَهُ، ونبيَّهُ محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف الأصول الثلاثة التي هي مقصده من تأليف هذه الرسالة وذكر بعض الشرّاح أنّ ما سبق مما مضى من هذه الرسالة لم يكن من صنيع المؤلف وإنما أدخله بعض تلاميذه لأهميته ولا شك أن المسائل المتقدمة عظيمة وهي مسائل محررة ودقيقة والفاظه فيها دقيقة في التعبير عما اراد ولهذا ادخل كما ذهب إلى هذا بعض الشراح أن هذه المسائل لم تكن من صنيع المصنف –رحمه- الله ولكنها من كلامه الموجود في كتبه. قال:(فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الأُصُولُ الثلاثةُ التي يجبُ على الإنسانِ معرفتُها؟) هذه الاصول الثلاثة التي أرادها المصنّف فقل معرفة العبد ربه ودينهِ ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم،هذه الأصول الثلاثة هي الأصول العظيمة التي عليها مدار الإسلام التي من حققها كان من السعداء الموفقين ومن أخل بها كان من الكافرين ولهذا يسأل عنها العبد أول ما يسأل في قبره عنها عن هذه المسائل الثلاث عن ربه ودينه ونبيه . ويمكن أن يستدل لهذه الأصول مجتمعة زيادة على ما ذكره المصنف -رحمه الله- على وجه التفصيل كما سيأتي بما جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً " فدل هذا على أن هذه أصول الإيمان لأنه قال ذاق طعم الإيمان يعني وجد حلاوة الإيمان ووجد لذة الإيمان ،فدل على أنها من الإيمان وجعل اللذة وطعم الإيمان معلق بهذه الأصول وهذا لا شك دليل على عظم أثرها وعلى قوتها في الإيمان، فهي أصل عظيم من أصول الإيمان وعليها مدار الإسلام. فإذا حققها العبد دخل في الإسلام وإذا أخل بواحد منها فإنه لا يدخل في الإسلام ولو أتى ببعضها ومما أيضا استشهد له من الأدلة لهذه المسائل الثلاث على سبيل الإجمال أيضا ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي في أذكار الصباح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من قال حين يصبح ، و حين يمسي ، ثلاث مرات : رضيت بالله ربا ، و بالإسلام دينا ، و بمحمد نبيا ، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة " فدل هذا على عظم هذه الكلمة، وأن من قالها وحافظ عليها في الصباح والمساء كان له عند الله -عزوجل- عهد أن يرضيه يوم القيامة . ومن المعلوم أن منزلة الرضا رضا العبد يوم القيام منزلة عظيمة فإن الناس يسعون في النجاة وكان بعض الصالحين يقول لا نطمع في الرضا يعني رضا الله عزو جل ولكن نطمع في المغفرة فكون العبد يرضى بما يجازيه الله -عزوجل- به يوم القيامة دليل على عظم الثواب والجزاء الذي لا ينتهي لحد ولهذا يرضى العبد يوم القيامة إذا حافظ على هذه الكلمة وهذه الكلمات العظيمة يُرجى لمن راعى ما دلت عليه النصوص في الإيمان بها أن يافق في الإجابة عليها في القبر. ومما يراعى في هذه الكلمات : أولا: أن يعتقدها فلا بد من صحة اعتقادها وأن يكون العبد معتقداً لها الاعتقاد الجازم الصحيح وأنه يعتقد أن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن محمداً صلى الله عليه وسلم نبيه فإذا اعتقد هذا الاعتقاد يكون محققا لها ثم يزيد على ذلك بأن يرضى بها وهذا من دل عليه الحديث" ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً " ومعلوم أن الرضى فوق الاعتقاد ولهذا فهذا الحديث يدل على وجوب اعتقادها والرضا بها. ثانياً :كما أن مما يعين على تحقيقها هو أن يحققها المسلم كما يحققها بقلبه أيضاً يتلفظ بها متذكراً لها محققاً لها ، ومن هنا شُرع لنا أن نقولها في الصباح وفي المساء وهذا من عظمة الدين أن يُذكر المسلم في الصباح وفي المساء بهذه الكلمات ولم يأت التشريع بقولها مرة وإنما جاء بقولها ثلاث مراتيرددها حتى تكون أقوى ثباتاً في قلبه فإذا غفل عن بعض كلماتها استذكره في المرة الثانية او الثالثة ومن هنا المحافظة على هذا الذكر يرجى لصاحبه الخير العظيم ،ومن ذلك أن يرضيه الله -عزوجل- يوم القيامة وأن يثبته عند السؤال. ثالثاً :كما أن من لوازم اعتقادها العمل بها وهو ان يعمل العبد بها وان يكون عاملا بها ولا يكفي أن يعتقد أن الله ربه ويخالف في العبادة وأن يعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسوله ونبيه ثم يعبد الله بغير ما شرع ولا يطيعه في أوامره ولا ينتهي عما نهى عنه ولا يكفي ايضا ان يعتقد ان الاسلام دينه ثم لا يمتثله فلا بد من العمل فلهذا اذا اعتقدها وامتثل بها، فلا بد أن يكون منقادا لها في العمل وأن يكون محققا لها ومن هنا كان الإيمان عند أهل السنة مركب من هذه الأمور الثلاثة من الاعتقاد والقول والعمل وهذا دليل على أن هذه الاشياء الثلاثة لا بد من الاعتقاد بها والرضى بها وهذا من الاعتقاد ولا بد من النطق بها كما ورد في أذكار الصباح والمساء وهذا من قول اللسان ولا بد من امتثالها في الجوارح وهذا من عمل الجوارح ،فكل هذه الأمور الثلاثة لا بد من امتثال هذه الأصول . كما أن أيضاً مما يستلزمه الإيمان بهذه الأصول الثلاثة أن يثني العبد على ربه وأن يحمد الله أن وفقه إليها فإن هذه منّة عظيمة امتنّ الله بها على أهل الإسلام فلو تأمل العبد كيف أن الله خصك بأن تكون له عبداً وجعل الإيمان في قلبك وحببه إليك في حين أنه صُرف كثير من الخلق عن هذا الامر، خلق كثير يعبدون البشر ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الأصنام يعيش الرجل السنين الطويلة ولم يقل رب اغفر لي، يموت على الكفر والشرك فمن الذي هدى العبد ووفقه ؟هو الله عزو وجل، ومن هنا يستوجب الإيمان بهذه الأصول أن يثني العبد على ربه، وأن يعرف منة الله عليه أن وفقه لذلك فإن الله -عزوجل- هو الموفق وإلا فالإنسان ضعيف،الذين يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام ليس لهم عقول؟؟؟! لهم عقول ولهم أفهام ولهم ذكاء وفطنة ولكنهم صُرفوا عن هذا الأمر وأنت هديت إليه والذي يدل على هذا -يعني وجوب الثناء غلى الله -عزوجل-الحديث القدسي:"فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلاّ نفسه" فأي خير أعظم من هذا الخير وهو أن يوفق العبد للإيمان بالله -عزوجل- ولا يشرك معه أحد من المخلوقين ثم أيضا تستحضر المنة الثانية وهو أن جعلك الله -عزوجل- من اتباعهذا النبي صلى الله عليه أشرف الأنبياء والمرسلين اصطفاك أن تكون من اتباعه من المؤمنين به من المستقيمين على طريقته ثم نجاك من البدع إلى السنة و وهداك إلى العمل فهذه منة من الله كثير من الأذكياء الذين صنَّفوا الكتب المطولة وبرعوا في كثير من العلوم لم يهتدوا إلى هذا الأصل عامة مباحث الفلاسفة والمتكلمين في توحيد الربوبية ما عرفوا توحيد الربوبية وبهذا قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء فأنت هديت أوتيت ذكاء وزكاء بل يكون بعض من نقص ذكاؤه هداه الله -عزوجل- إلى هذا الإيمان . ولهذا عز على قريش وعلى صناديد قريش ان اهتدى للإيمان بعض من يحقرون من الأعراب ومن الموالي الذين كانوا يحقرونهم وهم سادات الناس فحملهم هذا على التكذيب كمن مات على الكفر والعياذ بالله حسدا للمؤمنين . كما أن المنّة الثالثة أن هداك الله -عزوجل- إلى الإسلام وهي الحنيفية السمحة وهو أعظم دين وأكبر شريعة ما هناك شريعة كملت هذا الكمال الذي شرعه الله -عزوجل- لنبيه صلى الله عليه وسلم فليتأمل العبد هذه المنّة العظيمة من الله -عزوجل- على عباده أن هداهم إلى أن يوحدوه وإلى أن يكونوا من اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى أن يكونوا على الإسلام وسلمهم من الفتن التي تصرف الناس عن الهداية وعن الاهتداء بهذا الدين كما ان الله -عزوجل- امتن على هذه الأمة بأنها هي آخر الأمم وهي أول الأمم يوم القيامة وأول من يدخل الجنّة وهم أكثر اهل الجنّة وهم الشهداء على الأمم وهم الأمة الوسط وهم الذين شرع الله -عزوجل- عبادتهم في أصقاع الأرض يعبدون الله في كل مكان بخلاف الأمم الماضية فإنه لا تصح عبادتهم إلا في أماكن العبادة فهذه منن عظيمة تستحق الشكر وأن يلهج العبد بالثناء على الله -عزوجل- وأن يستشعر منة الله عليه ،فإنه لولا هداية الله ما اهتدى العبد وما استقام على طاعة الله فإذا حقق المسلم هذه الأمور واستشعرها اعتقاداً ورضىً أن يرددها بلسانه وأن يثني على الله -عزوجل- بها وأن يسأل الله الثبات عليها حتى يلقى الله وهو على هذه الأصول العظيمة فإنه من أهل الجنة بلا شك لأن من وحد الله ولم يشرك به وأطاع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعصه واستقام على الإسلام ولم يفرّط فهو من أهل الجنّة مقطوع بدخوله الجنة ولكن الإنسان يخشى من تقصيره وإلا فمن حقق هذه الشروط فهو من أهل الجنة بلا شك . {المتن} فإذا قيلَ لكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فقلْ: ربيَّ اللهُ الذي ربّاني ورَبَّى جميعَ العالمينَ بنعمِهِ، وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواهُ، والدليلُ قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾([1]) وكلُّ ما سِوَى اللهِ عالَمٌ وأنا واحدٌ من ذلكَ العالَمِ. في تفصيل هذه الأصول على طريقة السؤال والجواب وقد سبق أن نبهنا في شرح الأحاديث أن هذه من الأساليب التي استخدمها النبي صلى وكان يعلم اصحابه بهذه الطريقة كقوله عليه السلام:" ما تعدون المفلس فيكم "ثم يجيبهم وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل احيانا و يجيب من الصحابة، فالسؤال والجواب مما جاء به الشرع بل جاء أيضاً في الحديث العظيم من حديث جبريل وذلك الحوار العظيم الذ ي بين جبريل وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ينفرد بما لا ينفرد به غيره من النصوص أنه بلغ الامة عن طريق الرسولين عن جبريل وعن نبينا صلى الله عليه وسلم فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ،وجبريل يصدِّق . فهذا من الأساليب التي جاءت بها النصوص وكذلك ما أخبر الله -عزوجل- في كتابه :" يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ " يسألونك عن الخمر والميسر " كل هذه الأساليب دلت عليها هذه النصوص وبعض الناس يرون أن هذا مما لا يتناسب مع الكبار وأنه يناسب الصغار ويترفعون عن هذه الأمور وهذا من نقص العقل والفهم فأسلوب جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يترفع عنه الإنسان ويجد من نفسه شيء بل هذا هو طريق العلماء ولهذا كان الشيخ -رحمه الله- مما تميز بهذه الأساليب التي وجدت في كتبه بعد أن اصبحت مهجورة عند كثير من المتأخرين،مثل ما تقدم من الدعاء للمتعلم وابتداء الكلام بأن يقول أعلم ارشدك الله، وفقك الله، رحمك الله، ثمّ بهذا الأسلوب الشيق الذي هو ممتع وأيضاً يلفت النظر إلى هذه المسائل ثم كان من توفيق الله -عزوجل- أن قُررت هذه الرسالة العظيمة في المراحل الابتدائية في هذه البلاد منذ أن نشأ التعليم والمناهج فجرب الناس خيراً عظيما بما حصل من الخير العظيم ،وترسيخ العقيدة الصحيحة في نفوس الناس في هذه الرسالة فهي لا تحتاج إلى تكلف يعرفها الكبير والصغير والعالم والمتعلم مع ما اشتملت عليه من مسائل عظيمة وأصول نافعة فجرب الناس من هذه الرسالة وتلقي الصغار لها أنها نافعة عظيمة ونفعها قد لمسناه بحمد الله وكلنا درسنا هذه الأصول وما زلنا نجد آثارها بحمد الله في النفس وكل من درسها عرف قدرها وهذا مما يدل أيضاً والله -عزوجل- أعلم بما في القلوب من قوة اخلاص الإمام -رحمه الله- فإن هذا الخير لا يكاد ينتشر ويحصل إلا لقوة اخلاص صاحبها ولبعده عن التكلف الذي وجِد كلام بعض المتأخرين مثل ما ساد في العصور المتوسطة إلى ما قبل العصر الأخير هذا ،ولا تكاد الكتب تخلو من السجع المتكلف الذي يحمل صاحبه على غير ما يريد، المهم أن يسجع ، وأن يأتي بالسجع حتى يكون الكلام له أثر في الأسماع و إن كان هذا السجع لربما حمل المؤلف غير ما يريد فالمصنِّف -رحمه الله- بعيد عن هذه الاساليب وهو سهل الأسلوب مع جزالة الألفاظ وقوة العبارات حتى أن الذي ينظر في هذه العبارة لا يكان أن يقول لو أن هذه العبارة لو جعلت مكان كذا أو اختصرت أو زيد فيها او نقص منها وهذا من توفيق الله -عزوجل- . يقول: (فإذا قيلَ لكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فقلْ: ربيَّ اللهُ الذي ربّاني ورَبَّى جميعَ العالمينَ بنعمِهِ). الرب يطلق في اللغة عل ثلاثة معان على السيد المطاع وعلى المالك وعلى من يصلح غيره، ومنه يقالرب الشيء ربه إذا اصلحه كما تربى الآنية إذا اصلحت والرب في اللغة يطلق على السيد المالك ومنه قول يوسف عليه السلام :" إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ"أي سيده . ويطلق على المالك، كما يقال رب الدار رب الحديقة. ويطلق على المصلح لغيره كما يقال رب الإناء أي اصلحه . وهذه المعاني كلها متحققة في الله -عزوجل- على أكمل وجه فالله –عزوجل- هو المالك وهو الذي أصلح عباده بنعمه بل إن الله -عزوجل- له حكمة عظيم باصلاح العبادة بأن يبتليهم بالخير والشر ويبتليهم بالغنى والفقر كما جاء في الحديث :"وان من عبادي من لايصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لافسده ذلك، وان من عبادي من لايصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك" فهذا من حكمة الله ،من الناس من لا يصلح الا الفقر ،ومن الناس من لا يصلحه الا المرض ومن الناس من لا يصلحه الا الغنى والجاه. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخاطب السادة المطاعين في أقوامهم أنه كان يقرهم على رئاسته ويخاطبهم بهذا ويقرهم على ما هم عليه، دليل على أن الإسلام جاء بمراعاة هذه الأمور وأن من كان على سيادة وعلى رياسة فإن الإسلام لا يمنع هذا بل يقره على ما هو عليه ، ولهذا اذا دخل بلد في الاسلام وعليه رئيس مطاع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقره على هذا وكان أيضا يُوجه إلى ان يٌقدم أهل الشرف والفضل في أقوامهم كما جاء في الحديث "خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقِهُوا " وخيار أهل قريش الذين كانوا سادة الناس وأعقلهم خيارهم في الإسلام فكان أبو بكر من السادة المطاعين كذلك عمر كذلك حمزة ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان معروفاً بأمانته ونزاهته قبل البعثة ثم منّ الله -عزوجل- بهذه المنة العظيمة وهي الرسالة. فالله -عزوجل- يصلح عباده بما يقدِّر لهم وقد يكره الإنسان الشيء وله فيه مصلحة ولله -عزوجل- الحكمة في هذا فهو حكيم كل ما يقدر لعباده لهم فيه مصلحة يعطي ويمنع وإلا لو أغنى الناس لبغى بعضهم لبعض :"إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى " فلله الحكمة في أن يبتلي الناس بعضهم ببعض ويبتلي بعضهم بالفقر ويبتلي بعضهم بالغنى وكل ما قدَّر الله -عزوجل- على عبده شيء فإنه يستوجب شكر هذه النعمة أو الصبر على البلاء ومن هنا فالصبر على البلاء له أجر عظيم والشكر على النعماء له اجر عظيم ، فالله -عزوجل- مستحق هذا الاسم من كل وجه على المعنى العظيم الذي يليق به ولهذا لا يطلق الرب معرّفاً إلا على الله -عزوجل- فلا يصح أن يقال في مخلوق الرب ، وإنما يطلق مقيداً يقال رب الدار رب الحديقة وأما إذا اطلق الرب فلا يصلح إلا لله -عزوجل- ولهذا لا يجوز أن يُسمى الرب ، لأن هذا مما اختص الله -عزوجل- به لأن له المعنى المطلق المستغرق لمعاني هذه الكلمة من كل وجه . (فقلْ: ربيَّ اللهُ الذي ربّاني) رباني بمعنى أصلحني فالله -عزوجل- يربي عباده ، والتربية هي الإصلاح كما أن الإناء إذا رب بما يصلحه فإن توجيه الناس لما فيه صلاحهم من التربية. (ورَبَّى جميعَ العالمينَ بنعمِهِ) النعم التي أنعم بها على عموم الثقلين وهي النعم ، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد من الرزق وغيره ، وإن كان الله -عزوجل- امتن على المؤمنين بنعمة أخرى بأن أصلح شأنهم في الدين وهداهم إلى هذا الدين . قال :(وهو معبودي ليس لي معبودٌ سواهُ) هو معبودي ليس معبود سواه أي هو الذي اخصه بالعبادة وليس معبود سواه وهذا المعنى يطلق على الأمر الشرعي أن الله -عزوجل- معبود بحق ، ويطلق على المعنى الخاص وهو أن يقول الإنسان الله معبودي ، أما الأمر الشرعي فإنه لا معبود بحق إلا الله وهذا هام في كل الخلق من آمن به ولم يؤمن فإن هذه مسألة متقررة أنه لا معبود بحق إلا الله وأما قول الإنسان الله معبودي فإن هذا إما أن يكون صادقاً فيما قال وإما أن يكون كاذباً ، فمن كان صادقاً هو الذي اخلص العبادة لله -عزوجل- ولهذا عندما يقول المؤمن الله معبودي فهو يعني ما يقول كما ذكر المصنف هنا هذه الكلمة ، وهو يقرر التوحيد ويرشد من يتعلم هذه الرسالة ان يردد هذه الكلمة هو معبودي أي هو الذي أخصه بالعبادة ولا أشرك معه غيره . قال والدليل قوله تعالى:"الحمد لله رَبِّ الْعَالَمِينَ" الحمد هو الثناء على الله -عزوجل- بالمحامد وبصفات الكمال وهو فوق الشكر لأن الشكر هو الثناء على الإحسان ، والحمد هو الثناء على الأفعال وعلى الصفات . ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ هم كل من سوى الله -عزوجل- وهي عوالم كثيرة والله -عزوجل- رب الخلق كلهم لأنهم ما من مخلوق إلا والله ربه وخالقه فالوجود ينقسم إلى قسمين إلى رب ومربوب فالله -عزوجل- هو الرب الذي لا شريك له في خلقه ، ولا شريك في إلهيته وما سواه فهو معبود مربوب والله -عزوجل- هو الخالق لجميع الخلق لا شريك له في ذلك . (قال وكل من سوى الله عالم ) لأن الوجود ينقسم إلى قسمين إلى رب وإلى مربوب فكل ما سوى الله مربوب وهو من العالم الذي أضافه الله -عزوجل- لنفسه وانه ربه وخالقه قال(وأنا واحدٌ من ذلكَ العالَمِ) أي أنا فرد من ذلك العالم الذي خلقه الله عزو جل {المتن} قال رحمه الله :فإذَا قيلَ لكَ: بِمَ عرفْتَ ربَّك؟ فقُل: بآياتِه ومخلوقاتِه؛ ومِنْ آياتِه الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ، ومِنْ مخلوقاتِه السمواتُ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبع ومَنْ فيهنَّ وما بينهما، والدليلُ قولُه تَعَالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾[فصلت:37]، وقولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾[الأعراف:54]. الشرح قال فإذَا قيلَ لكَ: بِمَ عرفْتَ ربَّك؟ ما هو الدليل على هذا العلم وعلى هذه المعرفة ، فقُل: بآياتِه ومخلوقاتِه. والآيات تنقسم إلى قسمين آيات كونية وهي المخلوقة وآيات شرعية وهي كلام الله -عزوجل- الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ومنه كلام الله -عزوجل- الذي أنزله على الرسل ومن ذلك قول الله -عزوجل- :" تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ " فهذه الآيات الشرعية هي كلام الله -عزوجل- وكلام الله صفة من صفاته وأما الآيات الكونية المذكورة هنا في هذه الآيات فهي مخلوقة لله -عزوجل- فقُل: بآياتِه ومخلوقاتِه ذكر هنا الآيات والمخلوقات ، والمخلوقات هي سائر المخلوقات التي خلقها الله -عزوجل- لكنه قد يفرَّق بين الآيات الكونية هنا على ما سيأتي في الأدلة والمخلوقات بأن الآيات هي العلامات التي تدل على عظمة الله ، والمخلوقات هي المخلوقات المحسوسة ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الآيات هي التي تُرى بالعين مثل الظلام والنور ومثل ضياء الشمس والقمر ومثل تعاقب الليل والنهار ومن هنا سماه الله -عزوجل- آياته أنها دالة على عظمته والمخلوقات التي يباشرها الناس وهي موجودة في تلك الأرض والسماء التي يرونها والشمس من حيث هي والقمر فهي من مخلوقات الله وهي من آياته . قال:(ومِنْ آياتِه الليلُ والنهارُ والشمسُ والقمرُ، ومِنْ مخلوقاتِه السمواتُ السَّبْعُ والأَرْضُونَ السَّبع ومَنْ فيهنَّ وما بينهما) هذا أيضاً في التفريق كما تقدم بين الأيات التي هي علاماته تعاقب الليل والنهار وكذلك الشمس والقمر وجود الضياء المنبعث من الشمس ومن القمر والمخلوقات هي الأجرام المعروفة كالسموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما فهي من مخلوقات الله -عزوجل- وكلها تدل على عظمة الله -عزوجل- فهذه الآيات كلها تدل على عظمة الله وعلى أنه الرب المتصرف هو الخالق ولهذا خاطبهم الله -عزوجل- بهذا قال :" (ام خلقوا من غير شيئ ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات و الارض بل لا يوقنون) " فلا يمكن لهم أن يقولوا أنهم خلقوا أنفسهم ولا يمكن أن يقولوا أنهم خلقوا السموات والأرض ولهذا قال بعض أهل العلم توحيد الربوبية الأدلة عليه فطرية وعقلية بل قال بعض أهل العلم أنه لم يأت في القرءان آية تدعوا الى توحيد الربوبية والصحيح أن هناك آيات جاءت بدعوة توحيد الربوبية وتقرير توحيد العبادة بناءً على هذا قال والدليل قوله تعالى : " وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " هذه الآيات متضمنة ذكر هذه الآيات أن من آيات الله الليل والنهار الليل بظلامه والنهار بضوءه والشمس والقمر وهما الآيتان العظيمتان فالشمس تطلع في النهار والقمر في الليل والشمس مرتبطة بالنهار والقمر مرتبط بالليل ، ثمّ بعد أن بيّن الله -عزوجل- أنَّ هذه من آياته الدالة على عظمته نهى أن تصرف العبادة إليها قال :" لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ " وذلك لأن بعض من فُتن بعبادة الكواكب عبد الشمس والقمر ولما رأوا من عظيم صنع الله وحكمته وكيف أن الشمس لها تأثير على النبات وعلى سائر المخلوقات وكذلك القمر وكذلك كانوا يعرفون الأوقات التي تصلح فيها الأرض للزراعة من غيرها وجريان الأفلاك ونزول الامطار وكانوا يعرفون هذا بالحساب ،فظنّ بعض الجاهلين أن هذه متصرفة بنفسها ، والله -عزوجل- أخبر أنّها من آياته التي تدل على عظمته وهذا دليل على سفه هؤلاء فإذا كان الله -عزوجل- هذه الآيات العظيمة وما فيها من اتقان دليل على عظمة خالقها فكيف تصرف العبادة إليها من دون الله -عزوجل- ! ومن هنا قال الله -عزوجل- :" لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " هنا حجتان:*الحجة الأولى :اسجدوا لله لأنه هو المستحق للعبادة. *والثاني الذي خلقهن لانه هو الخالق لهن وما فيهن من عظيم الصنع والاتقان فهو من الله ليس من ذات الشمس والقمر (إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) أي إن كنتم تريدون عبادة الله -عزوجل- أو تزعمون أنكم من عباد الله -عزوجل-،وإلا فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك وقوله تعالى :" إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ " أخبر عن خلقه السموات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها ثم استوى على العرش، واستوائه على العرش من الصفات الفعلية الثابتة لله -عزوجل- ، والإستواء كان بعد خلق السموات والأرض وأما عند خلق السموات والأرض فلم يكن مستوياً ،ثمّ استوى بعد أن فرغ من خلق السموات والارض قال شيخ الإسلام :"وأما قبل خلق السموات والأرض -يعني قبل أن يشرع في خلق السموات والأرض- فلم يرد في النصوص ما ينفي أو يثبت الإستواء" فإذاً الموطن الأول وهو قبل أن يشرع الرب -عزوجل- في خلق السموات والأرض لم يرد في النصوص ما يثبت أو ينفي الاستواء وقد جاء في النصوص ما يدل على وجود العرش وأنه أول المخلوقات. وأما عند خلق السموات والارض فلم يكن مستوياً لحكمته ولعظمته، ثمّ استوى بعد خلق السموات والأرض ولهذا الاستواء صفة فعلية تقوم بذات الله -عزوجل-،وهي متعلقة بمشيئته والعرش في اللغة هو سرير الملك والعرش المضاف إلى الله -عزوجل- هنا عرش الرحمن الذي استوى عليه وهو مخلوق عظيم ، والكرسي دونه بكثير والكرسي أعظم من السموات والأرض بكثير كما جاء في الحديث:" ما السموات و الارض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة "والكرسي وما الكرسي في العرش إلّا كذلك كما جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث فالعرش عظيم والرب -عزوجل- مستو على العرش من غير حاجة للعرش واستواء الله لا يمكن أن يكيَّف كما يبحث عن هذا بعض أهل الجهم فكما أنا لا نعلم كيفية ذاته -عزوجل- كذلك لا نعرف كيفية استواءه واستواء الله على العرش ليس كاستواء المخلوق على المخلوق كما ذكر شيخ الإسلام :"استواء المخلوق على المخلوق لحاجة المستوي على المستوى عليه " وإذا سقط المستوى عليه سقط المستوي وأما ربنا -عزوجل- فهو مستو على العرش ،والعرش محمول بقدرته وهو مستغن عن العرش واستواءه لا يمكن للعقول أن تكيّفه ، ومهما أُعملت العقول فإن لا تجني في النهاية الا الحيرة والشك،ومن هنا وجب الإيمان بالاستواء على ما يليق بجلال الله -عزوجل- ومازالت الأمة تردد إجابة الإمام مالك الإجابة العظيمة عندما سأل الرجل عن الاستواء قال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الإمام مالك وهذا يروى عن ربيعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا ما كان عليه السلف ولهذا يجب على المسلم أن يثبت هذه الصفة لله -عزوجل- كما يليق بجلاله من غير بحث عن الكيفية . { يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا } يغشي أي يغطي الليل النهار ، يغطي بظلمة الليل ضوء النهار ، ويغطي بضوء النهار ظلمة الليل كما قال المفسر، والغشاء هو الغطاء وغشى الشيء الشيء إذا غطاه ومنه الغشاوة التي تكون على العيون ، أو الغشاء الذي يكون على الوجه ، وهذا من حكمة الله -عزوجل- أنه يغشي الليل النهار ، ويغشي النهار الليل،وهذا من حكمته . (يَطْلُبُهُ حَثِيثًا) أي أنه يطلبه سريعا لا يتأخر هذا وإنما هم متعاقبان لا ترى في ذلك خللاً ، ولا يتأخر الليل عن وقته ، ولا النهار عن وقته بحكمة الله -عزوجل- والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره،كلهم مسخرات بأمر الله -عزوجل- جريان الشمس منذ أن تطلع إلى أن تغيب وتأملوا كيف حرارتها بالنسبة إلى الأرض متفاوتة عند طلوعها وكذلك ضوءها ومن هنا من حكمة الله -عزوجل- أن من النبات وكذلك الإنسان ما يصلح حاله بهذا التنقل للشمس ، فهي أول ما تطلع يكون ضوءها ضعيف ثم يقوى شيئاً فشيء وكذلك حرارتها |إلى وقت الظهيره ثم بعد ذلك تغيب وتتدرج في خفة ضوءها وحرارتها حتى تغيب وهذا من حكمة الله -عزوجل- ولهذا بعض النباتات تقوى وتشتد بقوة الشمس وبعضها بوجودها في الظل ،وهذا من حكمة الله -عزوجل- وكم يكتشف الآن الناس من الحكم العظيمة في طلوع الشمس بهذه الطريقة وكذلك طلوع القمر ، وهذا من حكمة الله -عزوجل- وهذه الأشياء كلها مسخرة لله -عزوجل- لا يمكن أن تخرج عن قدرة الله وعن أمر الله وعن أمره الكوني مع عظم هذه المخلوقات . { مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ } أي بأمر الله -عزوجل- وبخطابه لها فإنه يأمر الأشياء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون قد جاء في الحديث أن عطاءه كلام ومنعه كلام يأمر فالخلق كله مسخر لطاعته ولم يخرج مخلوق عن طاعة الله -عزوجل- إلا من أعطاه القدرة على ذلك من الثقلين أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية وإلا لو شاء الله -عزوجل- ما استطاع أحد أن يعصي الله ولو شاء الله -عزوجل- ان لا يطاع ما استطاع أحد أن يطيع الله فهذا من حكمته . (أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ) هنا ذكر الخلق والأمر والخلق هو بمعنى المخلوق لأن الخلق يطلق ويراد به الفعل من خَلَقَ يخلُقُ وهذا فعل الله -عزوجل- وأفعال الله ليست مخلوقة ويطلق ويراد به المفعول وهو ما يقع عليه الخلق فتقول هذا خلق الله بمعنى مخلوق الله ،وإذا نظرت في السماء تقول خَلقَ الله السموات فخلق فعل الله القائم بنفسه هو متعلق بمشيئته وعندما تقول هذا خلق الله بمعنى مخلوق الله . والأمر كذلك ينقسم إلى قسمين : *يطلق الأمر على المخلوق *ويطلق الأمر على الأمر الذي هو صفة الله -عزوجل- والأمر هنا هو من كلام الله -عزوجل- ومن هنا ذكر الخلق والأمر قال :" ألا له الخلق والامر"فالأمر هنا من كلامه أي أنه يخلق ويأمر له الخلق فليس له شريك في خلقه وله الأمر وليس هناك معقب لأمره ، والأمر أيضاً يطلق على المخلوق ويطلق على كلام الله -عزوجل- فالأمر الذي هو من كلام الله هو هنا كقول الله -عزوجل- :"ألا له الخلق والأمر" ومنه قول الله -عزوجل- :" إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " بمعنى من كلامه -عزوجل- وأما الأمر الذي هو بمعنى المخلوق فهو المذكور في قول الله -عزوجل-" وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا "فالأمر هنا مقدور ،والمقدور مخلوق فالأمر ينحل عن الفعل من أمر يأمر وهذا فعل الله -عزوجل- القائم بنفسه وهو كلامه ويطلق على المأمور كما تقول عندما ترى مثلاً شيئاً موجود في النّاس تقول هذا أمر الله عندما يفعل الإنسان شيئاً يقول هذا أمر الله وفعل العبد مخلوق ويقول أمر الله فهل يقصد أنّ الله -عزوجل- أمر بهذا؟! لكن يقصد أن الله خلق هذا. (تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) نزّه الله -عزوجل- وأنه المبارك لغيره وأنه رب العالمين وأن كل ما سوى الله عزو وجل فهو مخلوق مربوب . هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#6
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم [size="5"][b][font="system"]الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .تفريغ الدرس الرابع شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ د.إبراهيم الرحيلي -حفظه الله- قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآء بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[البقرة: 21، 22]. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمّا بعد : بعد أن ذكر المصنّف -رحمه الله- الآيات الكونية والمخلوقات الدالة على اثبات الربوبية لله -عزوجل- وأنه الرب الخالق انتقل هنا الى تقرير توحيد العبادة والى استحقاق الله -عزوجل- للعبادة بهذه الجملة التي ربط فيها بين المقدمة الأولى وهي الدليل الدال على أنه هو الرب وبين ما سيأتي وهو المقصود وتقرير أن الله -عزوجل- هو المعبود المستحق للعبادة ولهذا قال المصنّف والرب هو المعبود وقد ثبتت الأدلة وتقررت أنه هو الرب فإذا كان هو الرب على ما دلت على ذلك الآيات الكونية والمخلوقات الدالة على ربوبيته فهو المعبود وهذه الجملة أخذها من الآية التي استدل بها وذكرها وهي قول الله -عزوجل- :" {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَآء بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } [البقرة :21 - 22]. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ}. اعبدوا ربكم أي الرب هو الذي يستحق العبادة وهذه الآية دعا الله -عزوجل- فيها إلى توحيد العبادة بتوحيد الربوبية بما هو مقرر عندهم أنه هو الرب هو الذي أنعم عليهم فوجب أن يكون هو المعبود لأن الرب هو المستحق للعبادة وهذا من دقيق فهم المصنف -رحمه الله- فإنه قرر أولاً ما هو معلوم بالعقول والتأمل من الآيات الكونية الدالة على ربوبيته ثم بعد ذلك ربط بين ما قرره من أنه هو الرب وهو الذي تفرد بتصريف الأمور فكذلك هو الذي يجب أن يُفرد بالعبادة . قال: وَالرَّبُ هُوَ الْمَعْبُودُ فإذا تقرر بأنه هو الرب ؛فالرب هو المستحق للعبادة والدليل قوله تعالى :" ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ) هذه الآية قال العلماء هي أول آية في المصحف والمقصود بها في ترتيبها في المصحف لا كما يظن البعض أنها أول أمر في القرآن أي في تركيب المصحف لأن الله -عزوجل- يعني ذكر هذه الآية في سورة الكهف وهي من الأوامر العظيمة التي كانت هي أول الأوامر في كتاب الله -عزوجل- في ترتيب المصحف. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) لأنه هو الخالق لكم ولمن قبلكم لا شريك له في ذلك، ثم ذكّرهم الله -عزوجل- ببعض هذه النعم فهو كما اوجدهم خلق لهم من المخلوقات ما ينتفعون بها" الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً" هذه نعمة عظيمة أي أنه أفرشهم هذه الأرض ومهدها لهم يستقرون عليها ويبنون عليها ويجلسون عليها فهي كالفراش لهم وقد جعلها الله -عزوجل- ثابتة مستقرة وأرسى هذه الارض بهذه الجبال العظيمة التي استقرت بها الارض وهي من آيات الله -عزوجل- أن جعل هذه الأرض ثابتة وأن الناس ينتفعون بها ولهذا تلاحظون نعمة الله -عزوجل- في استقرار الأرض أنه لو حصل بسيطة في الأرض كم تتساقط من المباني ويحصل ما يصيب الناس من المصائب العظيمة وهذه نعمة من الله -عزوجل- ولهذا عندما يريد الله بحكمته العقوبة لبعض من يفسد في الأرض ولا يصلح فإنه يعاقبهم بالخسف ويعاقبهم بتحرك الأرض ويصيبهم ما يصيبهم من جراء ذلك فهذه نعمة عظيمة ان جعل الله -عزوجل- الارض فراشا. " وَالسَّمَآء بِنَآءً " أي أنها مبنية وهي كالقبة فوق الأرض والسماء تطلق على معنيين على السماء المبنية ومن هنا أخذ العلماء في قولهم السماء المبنية " وَالسَّمَاءَ بِنَاءً " وقال" وَالسَّمَآءَ بَنَيْنـهَا بِأَيْيْد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ "فالله -عزوجل- بنى السماء؛ والسماء هنا هي السماء المبنية المخلوقة وهي السموات السبع وتطلق السماء على معنى العلو من سما يسمو فالسماء تطلق على السماء المبنية وتطلق على السماء وهي كل ما ارتفع فهو سماء من سما يسمو، والمقصود هنا السماء المبنية التي بناها الله -عزوجل- وجعلها كالقبة فوق الأرض. (وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآء) فهذا على القول أن المطر يكون من السحاب والذي نراه وهو بين السماء والأرض كما أخبر الله -عزوجل- في قوله "والسحاب المسخر بين السماء والارض" فتكون السماء هنا بمعنى العلو أي أنزل من السماء من العلو ماء وعلى المعنى الأول أن المطر هنا ينزل من السماء المبنية قد جاء في الحديث" تعرضوا له فإنه قريب عهد بعرش الرحمن " ونزول المطر من السماء التي هي السماء المبنية ومن تحت العرش الله -عزوجل- اعلم بكيفية ذلك وهذه الامور لا تخضع أإلى ما يقرره الآن بعض من يتكلم الآن بالتخرص والظن فإذا ثبث شيء في كتاب الله -عزوجل- فإنه يُقرر. وهذه لا مجال للخوض فيها في الدين فإذا دل الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الحقائق الكونية فإنه يجب أن يُعتقد وإلا فكون السماء المطر ينزل من تحت العرش أو من فوق السماء أو من السحاب الذي هو مسخر بين السماء والأرض هذه ليست من مسائل الدين ولكن الله -عزوجل- عندما ذكر هذا يمتن على عباده بهذه النعم فإذا ثبت في كتاب الله -عزوجل- شي أخبر الله عنه وجب أن يعتقد سواء كان من الدين أو من الدنيا . ومن هنا كل ما جاء في كتاب الله يجب أن يصدق وإذا سارعت العقول إلى التكذيب أو أنه شق عليها التصديق بذلك فإن العقول القاصرة ؛ولهذا قال عمر -رضي الله عنه- "اتهموا الرأي عن الدين"فالرأي متهم والعقل متهم ونحن لا نعلم عن كيفية تكون هذا السحاب كيف يتكون ولكنا نشاهد أنه ينزل المطر من هذا السحاب، ولكن تكّون هذا السحاب كيف يكون الله -عزوجل- أعلم بذلك. {فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ} وهذه منة أخرى أنه اخرج لكم من السماء ماء ثم اخرج به من الثمرات التي هي رزق للعباد وجعلها الله -عزوجل- متفاوتة في الوانها وطعومها ومنافعها وهذه من منة الله -عزوجل- على خلقه . {فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} اندادا أي شركاء في العبادة وانتم تعلمون انه هو الذي خلقكم ورزقكم وأنزل لكم المطر وأنبت لكم الثمر،هو المتفرد بهذا فكما أنه هو المتفرد بالخلق والرزق فكذلك يجب أن يُفرد بالعبادة . {{المتن}} قال -رحمه الله- تعالى قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ ـ -رحمه الله- تَعَالَى: الخَالِقُ لِهَذِهِ الأَشْيَاءَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. هذا من أوجه استحقاقه للعبادة وإلا فالله -عزوجل- مستحق للعبادة من كل وجه من جهة انه الخالق لأنه خلق هذه الأشياء فالخالق هو المستحق للعبادة الذي خلق هو الذي يستحق أن يُعبد ويُشكر وهو مستحق للعبادة لأنه* هو الذي يملك النفع والضر ولهذا مقتضى العقول أنه إنما يُعبد من بيده النفع والضر وهذا من أيضاً الأمور الدالة على استحقاقه للعبادة وهو مستحق للعبادة من جهة الكمال الذي هو عليه بل إنه ما من اسم من أسمائه إلا وهو متضمن صفة هو مستحق أن يعبد عليها وكذلك هو مستحق للعبادة من كل وجه ومن أشرك مع الله --عزوجل-- غيره فإن الشرك باطل من أوجه كثيرة ،من أن هذا الذي يُشرك به لا يخلُق ولا يرزق وأنه لا يسمع ولا يبصر كما قال ابراهيم " إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًاً"إذاً هذا دليل على بطلان عبادة غير الله عزو وجل أن هذه الإلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تستطيع نصرة من يدعوها وأنها لا تغني عنهم شيئا فما من مسألة تدل الأدلة على بطلانها أعظم من دلالة الأدلة على بطلان الشرك. وأعظم مسألة دلّت الأدلة على صحتها وعلى حقيقتها الأدلة على استحقاق الله -عزوجل- للعبادة ولهذا اعظم الحقائق التي هي مقررة بالعقول والفطر والشرع هو استحقاق الله -عزوجل- للعبادة وأعظم الحقائق التي هي منافية لهذا أن من عبد غير الله -عزوجل- فإن عبادته باطلة من كل وجه ولهذا أعظم الظلم الشرك :"إن الشرك لظلم عظيم " ليس هناك ظلم أعظم من الشرك لأن الظلم الذي دون الشرك هو ظلم جزئي وهو أن يظلم الرجل الرجل في بعض حقوقه وأما الظلم الذي هو من قبيل الشرك وهو أن يشرك مع الله -عزوجل- غيره فهذا ظلم من كل وجه ولهذا هو أعظم الظلم واستحق صاحبه عليه الخلود في النار بخلاف الظلم الأصغر وهو ظلم العبد لنفسه وظلمه لغيره فإنه تحت مشيئة الله -عزوجل- . {{المتن}} قال -رحمه الله- تعالى:وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا مِثْلُ: الإِسْلامِ، وَالإِيمَانِ، وَالإِحْسَانِ، وَمِنْهُ: الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَالْخَشْيَةُ، وَالإِنَابَةُ، وَالاسْتِعَانَةُ، وَالاسْتِعَاذَةُ، وَالاسْتِغَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلَكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا. كُلُّهَا للهِ تَعَالَى. ذكر المصنّف بعد أن قرر هذه القاعدة العظيمة وأنّ الله -عزوجل- هو المستحق للعبادة كما أنّه هو الرب المتفرد بالربوبية فهو الإله المتفرد بالألوهية ثم نبّه على بعض أنواع العبادة وإنما ذكر هذه الأنواع لكثرة ما يقع فيها من الخطأ وإلا فأنواع العبادة كثيرة وابتدأ أنواع العبادة بالأصول الثلاثة العظيمة التي ترجع إليها العبادة والمراتب الثلاث التي ما من عبادة إلا وهي راجعة إليها وهي مرتبة الإسلام والإيمان الإحسان وهذه مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل أن جبريل سأل النبي صلى عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ثم قال في نهاية الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم إن الإسلام تحته أركان وشعب وكذلك تحته أركان وشعب والإحسان هو هيئة للعبادة وهو أن يعبد العبدربه كأنه يراه مراقبة لله -عزوجل- وسيأتي تفسير هذه المراتب ثم ذكر بعض أنواع العبادات التي شرعها الله -عزوجل- وسيأتي التفصيل فيها وذكر الأدلة عليها وبيان حقيقة كل نوع من هذه الأنواع عند ذكر الأدلة عليها . {{المتن}} قال -رحمه الله- تعالى: وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾[الجن: 18]. الدليل على العبادة وعلى استحقاق الله -عزوجل- للعبادة قوله تعالى : ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً ﴾ والمساجد هنا اختلف في المقصود بها فقيل المساجد المبنية وقيل هي مواضع السجود والمقصود هو اخلاص العبادة لله -عزوجل- فهذه المساجد إنما بنيت لتوحيد الله -عزوجل- فلا يجوز أن يشرك مع الله -عزوجل- غير ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ": لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فبيّن أن هذا الفعل ينافي ما بنيت له المساجد من توحيد الله -عزوجل- فإنهم اتخذوا القبور مساجد وعظموا القبور ومن هنا جاء النهي في الإسلام أن تبنى المساجد على القبور ولهذا لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر ، وأفتى العلماء من الفقهاء المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أنه إذا اجتمع قبر ومسجد أنه يزال المتأخر فإذا كان القبر هو المتأخر فإنه ينبش ويجعل في مكان آخر وإذا كان المسجد هو المتأخر وهو الذي بني على القبر فإنه يهدم ويبنى في مكان آخر ولا شك أن المسجد الذي أسس على قبر فإن الصلاة في لا تصح لأنه ليس بمسجد شرعي وإنما هي مقبرة ومن هنا قال النبي صلى للمسيء ارجع فصل فإنك لم تصل فهنا الصلاة التي فعلها الرجل يظن أنها صلاة ولكن الحقيقة الشرعية أنها ليس صلاة وكذلك هذا الذي بنى المسجد على القبر يظن انه مسجد وهو في الحقيقة ليس بمسجد ولهذا لا تصح الصلاة فيه ثم إن العلماء فرقوا بين هذه الصورة وهو أن يبنى المسجد على القبر فيكون الحكم للمقبرة والمسجد طارىء فليس له حكم المسجد وبين عندما يكون الأصل هو المسجد فيُجعل القبر فيه فقال بعض أهل العلم أن الصلاة في هذا المسجد صحيحة لأنه في الاصل أنه مسجد والقبر طارىء فتحرم الصلاة فيه ولكن من صلى في هذا المسجد فصلاته صحيحة مع التحريم حتى يزال القبر، وهذا إن لم يُقصد بهذه الصلاة عبادة القبر او التوجه للقبر أما إذا قصد بالصلاة التوجه للقبر أو عبادة القبر فهذا شرك اكبر سواء حصل في هذا المسجد أو في أي مسجد اخر من صلى لقبر ولصاحب قبر فإنه أشرك مع الله -عزوجل- في هذه العبادة العظيمة ومن هنا قال العلماء انه ينبغي أن تُزال القبور من المساجد وإن كان الأصل هو المسجد فيزال القبر من المسجد . وكذلك أفتى بعض اهل العلم بأن المسجد الذي في ناحية القبلة من قبر فإنه لا يصلى فيه لأن الناس يتوجهون إلى القبر وينبغي أن يُزال هذا القبر أو أن يجعل بينه وبين المسجد حائط غير حائط المسجد وكل هذا من حماية جناب التوحيد واخلاص العبادة لله -عزوجل- ولهذا كانت هذه الشريعة أعظم الشرائع من حماية جناب التوحيد ،حتى أن ما شرع لغيرنا من التحية لم يُشرع لنا ،فالسجود كان تحية في بني اسرائيل ولكنه نُسخ في ديننا حماية لجناب التوحيد والسجود في ديننا عبادة لا يصح صرفها لغير الله عزو وجل. {{المتن}} فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ؛ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ؛ وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال : فمن صرف منها شيئا الضمير في منها يعني يرجع الى العبادة من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك ، من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك؛ إذاً هنا لا بد ان تُعرف العبادة فإذا عرفت العبادة وهي كل ما شرعه الله -عزوجل- ان يُتقرب به إليه فلا يجوز صرفه لمخلوف ومن صرفه لمخلوق فقد اشرك لأن العبادة حق لله؛ والمخلوق لا يجوز له ان يُصرَف حق الله -عزوجل- وإنما يُعطى المخلوق حقه فإن كان من أهل الفضل يعرف له قدره كما أن الأنبياء والرسل يُعرف لهم قدرهم يصلى على نبينا عليه الصلاة والسلام ومحبته تُقدم على محبة النفس ويُوقر ويُعرف قدره ويُتبع دينه ويُلتزَم ما جاء به وأما صرف العبادة فلا يجوز صرفها لغير الله -عزوجل- ومن هنا قرر العلماء قاعدة عظيمة في هذا الباب أن باب العبادة لا واسطة فيه بين الخالق والمخلوق بخلاف التبليغ فإن الواسطة بيننا وبين الله -عزوجل- هو نبينا صلى الله وعليه وسلم نحن ما عرفنا هذا الدين من الله -عزوجل- خاطبنا به مباشرة وإنما خاطبنا بهذا الدين عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله -عزوجل- لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل ومنه ماكان الوحي مباشرة كفرض الصلوات فالواسطة بيننا وبين الله هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو واسطة في التبليغ، وأما العبادة فليس هناك نوع من أنواع العبادة تُصرف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون الواسطة بيننا وبين الله كل العبادات تصرف لله -عزوجل- لأن الله -عزوجل- سميع بصير وهو يعلم حال العبد أعظم من معرفة البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لا يعلم ما في قلوب المنافقين وربنا -عزوجل- من فوق عرشه أخبر عما في قلوبهم ومن هنا فالعبادات القلبية لا يعلمها إلا الله -عزوجل-. ولهذا فهو المستحق للعبادة ومن صرف نوعا من أنواع العبادة للمخلوقين مهما كانت درجتهم فهذا من ضعف العقول ومن سفهها أن يتقرب لمن يغفل عنه أو لا يعلم عبادته أما الله -عزوجل- فهو مطلع على العباد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حقق التوحيد وسد ذرائع الشرك وعندما جاءه رجل وقال: "ما شاء الله وشئت قال :أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده"فلم يرض النبي صلى الله عليه وسلم أن تُثبت له هنا المشيئة مع أنه له مشيئة كما قال الله -عزوجل- :(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ)لكن كره الرسول صلى الله عليه وسلم ان تجعل مشيئته مقابل مشيئة الله لأنه تبع لمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ولهذا عندما نريد شيئا في المستقبل لا نقول ان شاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقول إن شاء الله ،ولهذا تعلق الأمور في المستقبل على مشيئة الله لأنه لا قدرة للعبد على شيء إلا بمشيئة الله -عزوجل- فهذا الأصل العظيم يجب أن يحقق وأن تصرف العبادة ظاهراً وباطنا لله -عزوجل- ومن صرفها لغير الله فقد أشرك وهذا الأمر يجب على المسلمين أن يعتنوا به وأن يهتموا به وأن يراقبوه الليل والنهار وأن يتعهدوا من لهم عليهم ولاية من الأبناء والنساء والأقارب وهذه مسألة عظيمة نحن نلاحظ بعض المسلمين الذين لا يشك في اخلاصهم وأنهم يحبون الدين ويحبون الخير ويحبون النبي وإذا جاؤوا إلى هذه الأماكن جاؤوا للحج أو للعمرة تسمع منهم الشرك الأكبر يتوجهون بدعائهم للنبي يصرفون بعض العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم يخشعون عند القبر خشوعهم لله بل أعظم هذا امر عظيم ويجب على أهل الإسلام أن يقوموا بنصح هؤلاء وتنبيههم على خطورة هذا الامر ليس الامر ما يتعلق بمعصية هي تحت مشيئة الله وإنما هو الشرك الأكبر الذي من لقي الله -عزوجل- به فإنه لا ينتفع بشيء من عمله. قال والدليل قوله تعالى على وجوب اخلاص العبادة لله -عزوجل- :" ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إلهاً آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ ومن يدعو مع الله إلها آخر والدعاء هنا بمعنى العبادة أن يعبد مع الله إلها آخر ،ولاحظوا هنا قال مع الله أي أنه يعبد الله، ولكنه يعبد مع الله إلها آخر فجمعوا بين عبادة الله وبين عبادة غيره ثم قال الله -عزوجل- :" لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ " قال العلماء هذا وصف لازم لأنه ما من معبود يُعبد من دون الله -عزوجل- إلا والحجة قائمة على بطلان هذه العبادة وليس هناك برهان يستطيع أن يتمسك به من عبد غير الله -عزوجل- ولهذا هذا وصف لازم أنه ما من عابد يعبد غير الله -عزوجل- ويكون له برهان على ذلك ، ليس له برهان،ما من عابد يعبد غير الله -عزوجل- إلا والحجة منقطعة في عبادته ليس له برهان فمن هنا يُقال انه وصف لازم لا برهان له به أي أنه وصف لازم لكل من عبد غير الله ليس له برهان بهذه العبادة والبرهان هو الحجة القاطعة وأخذ من برهان الشمس وهو ما يحيط بها من الشعاع لأن كل الناس يرونه فسميت الحجة إذا استبانت ووضحت برهاناً كما أن برهان الشمس وما يحيط بها واضحاً بيناً. (لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ) هذا ورد مورد التهديد فإن الله سيحاسبه على هذا وسيجازيه ومن هنا قال" أنه لا يفلح الكافرون" أي أنه لا يحصل لهم فلاح ولا فوز مادام أن الوصف قائم بهم وهو الكفر وهذا مما يدل على إطلاق الكفر على الشرك فإنه ذكر الشرك ثم قال بعد ذلك إنه لا يفلح الكافرون والذي حصل منه هو الشرك ولكنه من الكفر الأكبر ومن هنا يقال أن الكفر يطلق على الشرك لأن الكفر هو مضاد لأصل الإيمان والشرك كذلك هو مضاد لأصل التوحيد . {{المتن }} وَفِي الْحَدِيثِ: ( الدُّعَاءُ مخ الْعِبَادَةِ ). وَالدَّلِيلُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾[غافر: 60]. بعد ذلك بدأ المصنف -رحمه الله- في ذكر الأدله على أنواع العبادة التي ذكرها وبدأ بالدعاء قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وهذا الحديث ورد بلفظ آخر وهو أصح من هذا( الدُّعَاءُ مخ الْعِبَادَةِ)بل ضعّف بعض المحققين هذا اللفظ وإن كان المعنى صحيح وهو في معنى الأول لأن مخ الشيء هو حقيقته فاللفظ الصحيح هو الدعاء هو العبادة وهذا يدل على أن الدعاء هو حقيقة العبادة فإن أصل العبادة هي طلب، ما من عابد إلا وهو يطلب وكذلك الداعي ومن هنا قال العلماء إن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة والدعاء هو من أجل العبادات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله -عزوجل- وهو الذي عليه الأنبياء والرسل وقد ذكر الله -عزوجل- في كتابه توجه الأنبياء والرسل إلى الله -عزوجل- بالدعاء والدعاء من الأبواب العظيمة التي يستجلب بها الخير من كل وجه فلاحظوا أنه ما من نوع من انواع العبادة إلا وهو في نوع خاص وأما الدعاء في كل شيء ،بل إن الدعاء هو الطريق لتحقيق العبادة ولهذا نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنّه قال :"ما أعرف شيئا من الدعاء أعظم من دعاء الله-عزوجل- الاستقامة على الدين" فهذا هو أصل الأمر وهو سعادة العبد في الدنيا والآخرة أن يوفقه لعبادته ولهذا اشتمل في سورة الفاتحة اشتملت على هذا الاصل العظيم كما في قوله -عزوجل-" إياك نعبد وإياك نستعين" فلا تحقيق للعبادة إلا بالاستعانة ولهذا الف الإمام الهروي "كتابه منازل السائلين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين" لأن أعمال العباد هي بين هاتين المنزلتين من الاستعانة بالله إلى تحقيق العبادة وأعلى درجاتها وهو الكتاب الذي شرحه وهذبه وشرحه ونبّه على ما ورد فيه من بعض الأخطاء ابن القيم في مدارج السالكين وهذا الكتاب قد يقال أنه أفضل من أصله فإن الأصل في الكتب انها تبع لأصولها وأما هذا الكتاب هو افضل من أصله فهو لإمام جليل هو الإمام ابن القيم وفيه فوائد عظيمة ولكن ينبغي أيضا لمن قرأه أن يكون على معرفة بما ورد فيه من بعض الكلمات والمصطلحات فإن اصل الكتاب ليس لإبن القيم وانما هو تقريب لكتاب الهروي ،والهروي امام من ائمة اهل السنة لكنه ورد في كتابه بعض المصطلحات التي خرجه الامام ابن القيم تخريجاً صحيحاً. ومن الأدلة قَوْلُهُ تَعَالَى:﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ هذا توجيه من الله -عزوجل- وأمر من الله -عزوجل- بدعائه( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) يعني طلب من الله -عزوجل- وخبر بأنه يستجيب لمن دعا ثم حذر من ترك هذا الأمر قال:( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) فأطلق العبادة على الدعاء، قال: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )ثم قال:(إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) فدل على أن العبادة هي الدعاء وهذا من دقيق فهم المصنف، يعني لاحظوا أورد هذه الآية مستدلا بها على معنى الحديث تماما "الدعاء هو العبادة "وهنا قال الله -عزوجل- وقال (ربكم ادعوني) ثم قال( إن الذين يستكبرون عن عبادتي) فدل على أن الدعاء هو العبادة ثم قال:( سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ أي صاغرين أذلاء وهذا في مقابل عملهم والجزاء من جنس العمل لما استكبروا عن عبادة الله -عزوجل- استحقوا دخول جهنم صاغرين ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-" كل ما ورد في كتاب الله -عزوجل- من العذاب المهين فهو في حق الكفار" لأن عذاب المؤمنين ليس مهين وإنما العذاب المهين هو عذاب الكفار الذين يهانون لعظم استكبارهم عن طاعة الله -عزوجل- وكلما كان العبد متقربا إلى الله -عزوجل- متذللا خاضعاً لدين الله -عزوجل- كلما كان اشرف له عند الله -عزوجل-،ولهذا أعظم درجة عند الله -عزوجل- هي درجة نبينا صلى وهو أعبد الخلق لله واعظمهم تواضعا على مرتبته الشريفة فهو كان متواضعاً عليه الصلاة والسلام يقول :" «لن يُدْخِلَ أحدَكم الجنةَ عملُه، قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته»فمقام العبادة يتنافى مع الكبر فكلما كان العبد أعبد لله كلما كان أذل وأخضع لله -عزوجل- وأعظم تواضعاً لخلق الله وكلما وجد الكبر في النفس والعياذ بالله كلما كان ابعد عن العبادة وأعظم الناس خذلاناً يوم القيامة المتكبرون الذين يحشرون كالذر يطأهم الناس بأقدامهم في أرض المحشر . {{المتن }} وَدَلِيلُ الْخَوْفِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾. قال ودليل الخوف؛ هذه هي العبادة الثانية وهي الخوف والخوف عرفه العلماء بأنه الفزع والوجل والصحيح أن بينهما فرق، ولكن هذه العبادات القلبية خصوصاً كالخوف والمحبة والخشوع والخشية فإن العلماء ذكروا كما ذكر الإمام ابن القيّم أنها لا تفسر بغير ما عُرف من حقيقتها وعامة ما يأتي في كتب اللغة وفي كلام الناس هو من تقريب هذه المسائل أو من بعض ولوازمها كأن يقولون المحبه هو ميل القلب هو نتيجة للمحبة أو يقولون الغضب غليان الدم في العروق ،غليان الدم في العروق هو نتيجة الغضب في حق المخلوق وغضب الله -عزوجل- ليس كغضب المخلوق ،فهذه الأمور لا تفسر بأكثر من حقائقها المعروفة ولهذا القاعدة يقولون المعروف لا يُعرف يعني تفسير الشيء المعروف لا يزيده إلا إيهاما لو قل لشخص فسر لي الماء لربما أغرق في التفسير حتى الذي يعرف الماء يُشكل عليه أو قلت له فسِّر لي الهواء أو فسِّر لي المحبة. ومن هنا الذي لا يعرف هذه الحقائق فتفسير بعض المفسرين له لا تزيدها إلا إيهاما فالخوف معروف ومن هنا من قال أنه الفزع أو الوجل فإنه ليس بمرادف للخوف وإنما هو تقريب لهذه الصورة وقيل أيضا إن الخوف توقع مكروه على أية مظنونة أو معلومة وقيل أن الرجاء توقع محبوب على آية مظنونة او معلومة وهذا كله تقريب للصورة لـأن توقع المكروه ليس هو الخوف ؛وإنما الخوف يحصل عندما يحصل هذا الأمر والخوف لا يُفسر بغير ما هو معروف عند من عرفه وما من انسان إلا وهو يعرف الخوف ويعرف المحبة ويعرف الخشوع لأنه تقوم به ويفرق بها وإن كان هو مع معرفتها يكون عاجزا عن معرفة حقيقتها لأنه ليس كل من عرف الشيء يكون قادرا على وصف حقيقته ولهذا فعلم البيان هو علم مستقل يعني الفصاحة علم مستقل ، يعني عن العلم الذي في القلب فكم من انسان في صدره علم لا يستطيع أن يخرجه ليس لأنه جاهل لأنه يفقد القدرة على البيان ومن هنا لما كان نبينا صلى عليه وسلم أمره الله -عزوجل- بتبليغ الرسالة والأحاديث النبوية هي من تعبيرالنبي صلى وإن كانت متضمنة الوحي من الله -عزوجل- اعطاه الله -عزوجل- من القوة في هذا المقام ما لم يعطه لمخلوق آخر ولهذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وإنكم لاحظتم خلال شرحنا الأربعين نووية أنه في جلسة واحدة لربما تستغرق ساعة او يزيد في شرح حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا بتجاوز السطر في الطباعة ومع هذا تبقى مسائل يغفل عنها الناس وما يزال العلماء يستنبطون من هذه الاحاديث الأحكام بعد أن يعرفوا هذه المسائل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أعطوا الطريق حقه " جاءت الآن الأنظمة في المرور والطرق كلها داخلة تحت هذا الأمر فكل من خالف واعتدى على الطريق فقد خالف هذا الهدي والنبي صلى أتى بعبارة موجزة فالطريق له حق لا يجوز لاحد أن يعتدي عليه ،بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم،فالمقصود أن البيان هو أمر فوق العلم ولهذا قال شيخ الاسلام :"إن العلم يرجع إلى ثلاثة اصول: إلى قوة العلم وإلى قوة البيان وإلى قوةالإرادة قوة العلم أن يكون العلم صحيحاً لا يتطرق إليه الشك وأقوى العلم ما يقوم على الوحي ولهذا أرسخ الناس في العلم هم أعرفهم بالأدلة من الكتاب والسنة فكلما كان العبد أعرف بكلام الله -عزوجل- ورسوله صلى الله عليه وسلم كان أرسخ في العلم وكلما ضعف الناس عن فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما جاءت الأوهام ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعرف الناس بكلام الله ورسوله فيأنه نزل بلغته ونزل عليهم فهذا قوة العلم . وأما قوة البيان فهو الفصاحة والقدرة على التعبير على العلم ،ومن فقه السلف أنهم لما أدركوا هذه الحقيقة كانوا لا يعبرون عن المعاني الشرعية إلا بالألفاظ الشرعية لا تكاد تجد في كتب المتقدمين كثرة الكلام الذي ينشئونه من أنفسهم وإنما يقتصرون على ما ورد، ولهذا لاحظوا تراجم الإمام البخاري كلها او عامتها إما من النصوص أو بعض الآثار عن السلف لشدة تمسكهم بالنصوص،وكذلك كثير من الأئمة كانوا يتمسكون بهذا الأصل العظيم وهو التمسك بالألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية ولما استحدث الناس بعض الألفاظ الجديدة المحدثة وجد الوهم ووجد الاختلاف واصبح الناس يتنازعون في مسائل كثيرة بسبب هذه الألفاظ المجملة التي نبّه عليها العلماء، وكذلك الأسئلة نحن دائماً نوجه الاخوة الذين يسألون أنه ينبغي أن تكون الألفاظ واضحة بيّنة لا يسأل عن شيء يعني مجمل لا يعرف ومن الأمور الطريفة العجيبة أذكر أن أحد السائلين مرة يعني سأل عن حكم النظر في السوق؟ فظننت أنه ير
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#7
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم تفريغ الدرس الخامس شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ د. إبراهيم الرحيلي-حفظه الله- [المتن] قال -رحمه الله تعالى- :ودليل الإنابةِ قوله تعالى: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾[الزمر:54]. [الشرح] [...]*مرة بعد أخرى ،قال ومنه النائبة وهي الحادثة التي تصيب الإنسان وتجمع على نوائب يقال نوائب الدهر يعني حوادث الدهر، لأنها ترجع مرة بعد أخرى ومنه قول الناس فلان انتابه المرض أي عاوده المرض والإنابة هي الرجوع إلى الله -عزوجل- والمنيب هو الذي يرجع إلى الله -عزوجل- كلما أذنب فالـذنوب متجددة والإنابة مستمرة إلى الله -عزوجل- ولهذا الإنابة هي الاستغفار مرة بعد أخرى والرجوع إلى الله -عزوجل- بعد وجود الذنب . ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ هذا دليل على أن الإنابة إلى الله -عزوجل-، والإنابة إلى طاعته بالرجوع عن المعصية إلى الطاعة وبالاستغفار والتوبة. [المتن] قال -رحمه الله تعالى- :ودليل الاستعانة قوله تعالى ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الشرح] الإستعانة أيضاً من العبادات العظيمة والاستعانة هي طلب العون والاستعانة تقع على نوعين: نوع جائز مباح ،وهو الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ كأن يقول الرجل للرجل أعني على كذا كما يقول الرجل للآخر أعني على قضاء الدين ،كما سألت بريرة عائشة -رضي الله عنها-أن تعينها على قضاء عتقها، وأن يستعين الرجل بالرجل في أمر من الأمور التي يقدر عليها ،وهذه جائزة وإن كان الأكمل هو تركها لقول النبي –-صلى الله عليه وسلم-- لابن عباس :"إذا سألت فاسأل الله وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ» . فهناك مرتبة كمال وهي الإستعانة بالله -عزوجل- وحده وعدم الإستعانة بالمخلوقين وهناك مرتبة جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه . وأما الاستعانة الشركية فهي الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ،والإستعانة بالله -عزوجل- من أعظم العبادات وهي أيضاً بحسب متعلقِها إما أن تكون الاستعانة بالله -عزوجل- على أمر الدين وهو أن يسأل الله -عزوجل- العون له على دينه وعلى طاعته وأن يسأله الثباب وأن يسأله" العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر "كما ثبت عن النبي --صلى الله عليه وسلم-- أو يستعين بالله -عزوجل- في الأمور الدنيوية وهي عبادة ولهذا كان بعض السلف يقول إني لأسأل الله -عزوجل- كل شيء حتى الملح بالطعام. والإستعانة هنا تكون عبادة لأنها طلب من الله -عزوجل- ،وإظهار الفقر إليه كما أخبر الله -عزوجل- في الحديث القدسي في نداءات الرب لعباده أنهم فقراء إلى خالقهم في كل شيء فحاجتهم عند الله عزوحل،وطلب الله -عزوجل- هو من شدة حاجتهم لله -عزوجل- قال ودليل الاستعانة قوله تعالى :﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ أي نخلص لك العبادة عبادتنا لك واستعانتنا بك وهذه من أعظم منازل العبادة أن يكون العبد عابداً لله -عزوجل- مستعينا لله على عبادته. هناك مرتبة عظيمة وهو أن يستحضر العبد عون الله -عزوجل- على طاعته كما قال -عزوجل- جاء في بعض الأخبار عن بعض بني إسرائيل أن الله قال لداوود اشكرني فقال كيف اشكرك وشكري من نعمك علي فسماه الله شكورا. كذلك جاء عن موسى عليه السلام أن قال :"ياربي إن بلغت رسالتك فمنك وإن ذكرتك فمنك" فهذا دليل على أن هؤلاء يستشعرون أن ما أدوا من العبادات أنها من الله -عزوجل- وهذا له ثمرة عظيمة وهي إظهار الفقر إلى الله -عزوجل- في كل شيء وهذا يكسر أيضاً العجب الذي يحصل في نفس العابد إذا ما ظن أنه حقق شيئاً من العبادة فإذا عرف أن هذه من منة الله عليك واظهر فقره لله -عزوجل- وأنه لا يستطيع أن يشكر الله لأنه كلما شكر الله كلما استحق الله -عزوجل- شكراً آخر لما وفَّق إليه من الشكر الثاني فإذا قال الحمد لله فهذه منة من الله عليه أن وفقه للحمد ،فهو يحتاج أن يشكر الله فكلما شكر الله كانت هذه من منة الله عليه ،وهذه من المشاعر اللطيفة التي يغفل عنها كثير من الناس لأن بعض الناس إذا عبد الله ظن أنه من نفسه وأنه هو القادر على العمل وأنه هو الذي حقق هذا ،وهذا أيضاً يكسر بعض الكبر الذي يحصل في نفوس بعض العابدين وينظرون إلى العصاة كأنهم لا عقول لهم ويتعجب بعضهم وهذا لا شك أن النظر لصاحب المعصية بكونه عصى الله -عزوجل- لا شك أن هذا ظاهر وأن الإنسان يستشعر نعمة الله عليه ولكن كون الإنسان يزدري الناس وكأنه لا عقول لهم فعليه أن يتأمل أن الهداية من الله -عزوجل- وأنه كما أن هذا عصى فهو له معصية كما ان لهذا معصية فللإنسان له معصية ,فكيف الإنسان يقدم على المعصية وهو له عقل ونحن لا نشك في الوعد ولا الوعيد ولا الجنة ولا النار كل هذا دليل على أن الهداية من الله -عزوجل- وأن كل انسان يحب نجاة نفسه ولا نشك في الجنة ولا النار ولا نشك في الموت ومع هذا توجد الذنوب بسبب الضعف الذي يكون في النفوس وضعف العلم لأنه ما عصى الله أحد من الله إلا في حال الجهل فإذا الانسان استشعر منة الله عليه فإنه لا يزال عابداً مواصلاً لعبادة الله وهذا ايضاً يغرس المحبة في قلوب العبد لله -عزوجل- كيف أنه من عليه في العبادة وهداه لها وصرف عن هذه العبادة كثير من الخلق . قال رحمه الله تعالى وفي الحديث :" وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ» هذا من وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس رضي الله عنهما وهي الوصية العظيمة الجامعة وفيها يقول النبي –صلى الله عليه والسلام-:"إذا سَألتَ فاسْألِ الله وإذا استَعنتَ فاستَعِن بالله" ولكن الاستعانة الجائزة هي دون ذلك؛ والكمال أن يستعين بالله ولا يستعين بغير الله -عزوجل- . [المتن] قال -رحمه الله تعالى- ودليل الاستعاذةِ قوله تعالى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾[الفلق:1]، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾[الناس:1]. [الشرح] الاستعاذة هي طلب العَوذ لشيء مكروه ،والمستعاذ هو من يقدر على كشف الأمر أو على دفع المكروه والعياذ يطلق لدفع المكروه واللياذ يطلق لجلب المحبوب فيقال عاذ بفلان أي استعاذ به من المكروه وإذا قال لاذ بفلان أي التجأ إليه في تحقيق المحبوب . والاستعاذة بالله --عزوجل-- من المكروهات ومن الشرور من أعظم أنواع العبادة ،ولهذا لها الأثر العظيم في دفع ما يكرهه الإنسان، وقد نزلت هاتان السورتان العظيمتان وهما سورة الفلق وسورة الناس في الاستعاذة من شرور الأشرار وقد ذكر العلماء أن هاتين السورتين اشتملتا على الاستعاذة من كلِّ شر كما ذكر هذا الإمام ابن القيّم. ودليل قوله تعالى : ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ أعوذ يعني ألوذ وألتجئ واعتصم برب الفلق والفلق هو الصبح، كما قال الله -عزوجل- :"فالق الإصباح"فالفلق هو الصبح ، وذكر بعض أهل العلم أن مناسبة الاستعانة برب الفلق أنه كما يقلب الليل والنّهار ،يعاقب بين الليل والنهار ويغيّر من حال إلى حال فإن الاستعاذة به في تغيير المكروه وفي دفع الشيء المترقب أنه مناسب لهذا المقام وهذا من التوسل لله -عزوجل- بما يناسب المقام. والإستعاذة في هذه السورة كما ذكر الإمام ابن القيّم أنها الاستعاذة بالله -عزوجل- من الشرور العظيمة في قوله :"قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق" وهذا من شر كل مخلوق خلقه الله -عزوجل- "ومن شر غاسق إذا وقب" وهو الليل إذا غطّى بظلامه النهار وما فيه من الشرور ،"ومن شرالنفاثات في العقد" وهن السواحر اللواتي يسحرن في العقد" ومن شر حاسد إذا حسد "من كل ما يضر بإذن الله -عزوجل- بنظره وبالعين والعين حق ولهذا قال ابن القيم أن الاستعاذة هنا بالله عزو جل استعاذ بالله -عزوجل- في أربع من الأمور فالمستعاذ به الله عزو جل والمستعاذ منه أربعة أمور بخلاف ما جاء في سورة الناس فإن الاستعاذة بالله -عزوجل- بثلاثة من صفاته "من شر الوسواس الخناس" وهو الشيطان كما قال الله -عزوجل- "قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس" فهنا ثلاث صفات برب الناس وملك الناس وإله الناس ومن أهل العلم هذه أسماء مركبة . من شر الوسواس الخناس بخلاف سورة الفلق فالمُستعَاذ هو الله -عزوجل- والمستعاذ منه أربعة من الشرور وأما في هذه السورة فالمستعاذ به الله -عزوجل- بثلاث من صفاته أو من أسمائه والمستعاذ منه هو الشيطان . قال "قل أعوذ برب الناس" والاستعاذة برب الناس أي أنه هو خالقهم وقال "ملك الناس" أي أنه مالكهم "إله الناس" الذي هو إلههم ومعبودهم ،ومن هنا ذكر هذه الصفات العظيمة صفة الربوبية وصفة الملك وصفة الألوهية والخلق لا يخرجون عن هذه الصفات فمن كان من أهل الدين فإنه فلا يخرج عن صفة الألوهية أنه يعبد الله -عزوجل- مخلصاً العبادة له ومن كفر فإنه لا يمكن أن يخرج عن مقام العبد المخلوق المقهور الذي الله -عزوجل- ربه ومالكه. [المتن] قال -رحمه الله تعالى- ودليل الاستغاثة قوله تعالى :"إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم " [الشرح] هذا دليل الاستغاثة ،الاستغاثة هي طلب الغَوث وطلب الغَوث في حال الشدة ومن هنا كانت الاستغاثة طلب الاستسقاء عند وجود الجدب وانقطاع الأمطار ولهذا يسمى المطر غيث لأنه يكون من الله -عزوجل- يرفع به الشدة ويحصل به نزول الأمطار اخضرار الأرض ووجود النعم . والاستغاثة تكون بالله -عزوجل- وهي من أجل العبادات وتجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان المستغَاث به حاضرا يقدر على إنقاذ من يستغيث به ودليل الاستغاثة قوله تعالى :" إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم" فدل على أن الاستغاثة لله -عزوجل- وأنها تكون من الله في كل شدة وفي كل كرب وأن الله -عزوجل- يستجيب لعباده إذا ما استغاثوا به . [المتن] قال -رحمه الله تعالى- ودليل الذبح : ودليل الذَّبْحِ قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾[الأنعام:162-163]، ومِنَ السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ». [الشرح] الذبح عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله -عزوجل- كما جاء في هذه الآية وفي قول الله -عزوجل- "فصل لربك وانحر" فإنها عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله -عزوجل- . وبهذه المناسبة أذكر أقسام الذبح وتنوع الأقسام باعتبار حكمها لأنه يكثر حقيقة السؤال عن هذه الأقسام وهناك فوارق دقيقة بين أنواع الذبائح،قد يتوهم بعض من لم يضبط هذه المسألة بعض الأوهام في هذه المسألة فالذبح الذي يظهر والله أعلم باعتبار حكمه أنه ينقسم إلى ثمانية اقسام وكل قسم من هذه الأقسام له حكمه الذي يغاير حكم القسم الآخر : القسم الأول: الذبح الذي هو الشرك أكبر وهو الذبح للأصنام وللجن وللمخلوقين على وجه التعبد فهذا ذبح من الشرك الأكبر وهو محبط للعمل هذا إذا كان بنية التعبد أو ذبح للأصنام أو للمقبورين أو للأولياء فإن هذا من الشرك الأكبر القسم الثاني: الذبح الذي هو من جنس الشرك الأصغر وهو أن يذبح الذبيحة وظاهر الأمر أنها صدقة ويخالط هذا الرياء فإن قلنا أن الرياء كله من الشرك الأصغر فإذا ذبح رياءً فهو من الشرك الأصغر وإذا قلنا انه من الأكبر فإنه يكون من الأكبر ولكن يسير الرياء ذكر العلماء أنه من الأصغر ،فإذا خالط الذبح الذي ظاهره الصدقة خالطه يسير الرياء فهذا من جنس الشرك الأصغر وهو يسير الرياء الذي يخالط العمل على تفاوت على قدر هذه المخالطة وما يمكن دفعه منه وما لا يمكن دفعه . القسم الثالث :الذبح الذي هو من جنس البدع وحكمه أنه بدعة كالذبح للاجتماعات البدعية كالموالد وبعض ما يجتمع له بعض أهل البدع كالاجتما ع للأوراد فيستعينون بهذه الذبائح على المعاصي ولربما ظنوا أنها من أفضل القرب فهذه الذبائح من البدع المحدثة التي أستحدثها الناس ومن البدع الإضافية المتعلقة بهذا أن يلتزم الرجل يوماً من الأيام من السنة أو وقتاً من الأوقات يذبح فيه؛ فهذه بدعة إضافية مثل أن يخصص يوماً في السنة يذبح فيه أو أن يلتزم في كل نهاية شهر أن يذبح ذبيحة والالتزام هذا بنية التعبد فإن التزام العبادات المطلقة من البدع الإضافية وأما الذبائح التي تحصل في الاجتماعات البدعية فهذه ظاهر أنها من البدع المحضة . القسم الرابع: الذبائح المحرمة وهو أن يصحب الذبح فعل المحرم كالذبائح للاجتماعات المحرمة مثل الاجتماع على اللهو وعلى المعاصي كالاجتماع على شرب الخمر وتقديم الذبائح ولهذا الاجتماع فإن هذه الذبائح هي محرمة إذا كانت لهذا الاجتماع. وكذلك الذبح الذي يكون لفعل المحرم كالرشوة مثل أن يذبح الرجل للرجل يريد التقرب بهذه الذبيحة له لينال له حظوه وتكون بمثابة الرشوة وهذه إما أن تخالطها نية الكرم كأن يقدم الرجل على الرجل وله جاه فيذبح بنية الإكرام وبنية التقرب له ومن تكون له منزلة ومكانه فهذه تكون رشوة أو أن تكون رشوة محضة مثل أن يذبح الذبيحة لرجل لا يقوم حاله شيء من الاحوال التي يذبح له ويتقرب إليه مثل أن يذبح الذبيحة ويرسلها لأحد الموظفين الذين له عنده معاملة أو له عنده عمل فيتقرب بهذه الذبيحة له فتكون هذه من الذبائح المحرمة لأنها رشوة والرشوة محرمة. القسم الخامس:الذبح المكروه وهو الذبح الذي فيه تكلف في إطعام الضيف فإن التكلف في إطعام الضيف مكروه وهذا مثل تكلف الفقراء الذي يستدينون ويثقلون أنفسهم بالديون وقد يصل إلى محرم إذا ترتب عليه الديون والعجز عن السداد والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن التكلف للضيف . القسم السادس:وهو الذبح الواجب كالذبح لهدي التمتع ولهدي القران فإن المتمتع يجب عليه أن يهدي وكذلك القارن فإن هذا من الذبح الواجب وكذلك الذبح الذي لا يتحقق الواجب إلا به كالذبح لإطعام من تجب عليه نففته ولا يقوم هذا إلا بالذبح فإن هذا من الذبح الواجب . القسم السابع :هو الذبح المستحب وهو كالصدقة يذبح الرجل الذبيحة ليتصدق بها على الفقراء فإن هذا مستحب وكذلك من هذا الأضحية فإنها مستحبة وكل ما أفضى إلى الأعمال المشروعة المستحبة فإنه من هذا القسم . القسم الثامن:الذبح المباح وهو أن يذبح الذبيحة ليأكل منها في نفسه فإن هذا مباح ولكنه قد يصحبه نية أن يريد بها التقوّي على الطاعة فيكون مستحبة من هذه الجهة وأما إذا أكل ليتنعم أو ليترفه في الأكل من هذه الذبيحة فإن هذا من المباح . فهذه الأقسام كل قسم يفارق القسم الآخر في حكمه ومن هنا يتبين أن الذبائح متفاوتة بحسب حكمها وأود التنبيه إلى مسألة، أذكر أنّه سأل عنها أكثر من شخص وهي الذبح للضيف عندما يقدم على الرجل بعض الناس يقول هذه الذبيحة لفلان فيُخشى أن تكون من الشرك فنقول إن الذبح للضيف ليس هو من الشرك وإنما هو لإكرامه ولهذا فإنه من يكرم الضيف لا يتقرب له بالذبح وإنما يتقرب له بالإطعام والإطعام لا يكون إلا بالذبح على عادة الناس في كثير من المجتمعات كما هو في هذه البلاد أنهم يعدون أنه من إكرام الضيف أن يذبح له ،وأن يطعم الطعام الذي يليق به وهذا الذبح ليس لا شيء فيه بل إنه من إكرام الضيف وإكرام الضيف مطلوب بل إنه واجب عند كثير من أهل العلم فالذبح للضيف لإطعامه لا لتعظيمه بالذبح ومن هنا يتبين أن الذين يذبحون الذبائح عند مرور العظماء ومن يعظمّونهم في أنفسهم فإن هذا من الشرك كالذي إذا مر به الرجل ذبح أمام البيت كما أخبرني بعض من يحدث عن بعض المجتمعات أنه إذا مر أحد الوجهاء من المكان خرجوا أمام البيوت وذبحوا الذبائح عند مروره هذا لا شك أنه شرك لأنه تعظيم للمار بالذبح له لا بقصد الإطعام أما الذي يذبح للضيف يريد إطعامه فإنه لا يقصد أن يعظمه بالذبح وإنما يقصد أن يوقره وأن يقوم بواجبه بإطعامه فإذاً الذبح له عدة صور والذبح الذي هو عبادة هو أن يتقرب لمن يتقرب له بالعبادة التي هي بنية التعظيم وأما إذا صاحب الذبح بعض المقاصد الأخرى كما تقدم فإن الذبيحة بحسبها . ودليل الذَّبْحِ قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ ). هذا دليل على الذبح ،قل إن صلاتي الصلاة واضحة ونسكي النسك هو الذبح ،ومنه قول الله -عزوجل- (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )فالنسك هنا الذبح كما معلوم ومن هنا أطلق النسك على الذبح وإن كان النسك يطلق على ما هو أشمل من الذبح وهو على العبادة وأخص ما يكون في مناسك الحج كما قال تعالى:"فإذا قضيتم مناسككم "أي أعمال الحج ويطلق النسك على ما هو أشمل من أعمال الحج وسائر العبادات ولهذا يقال الناسك أي عابد كما في عنوان كتاب ابن القيم "مدارج السالكين" يعني الذين يتقربون إلى الله -عزوجل- ،وهو قريب من السلوك والناسك والسالك هي بمعنى العابد والنسيكة هي الذبيحة والمقصود بقوله ونسكي هنا هو الذبح ولهذا قال ابن كثير هذه الآية كقوله تعالى فصل لربك وانحر لأنه ذكر الصلاة والذبيحة وقال العلماء الحكمة من هذا أن أكثر من كانوا يعبدون الأصنام كانوا يتقربون لها بالصلاة والسجود وبالذبح فأمر الله -عزوجل- بمخالفتهم بأن يخلص صلاته وذبحه لله -عزوجل-. قال:( وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أي ما أحيا عليه وما أموت لله رب العالمين وهذا يشمل حياة الإنسان أنها كلها لله -عزوجل- ،وأن حياة الإنسان لله -عزوجل- وكل ما يتقرب به لله -عزوجل- ولا يجوز أن يقول الإنسان إن حياتي لفلان كما يقول من يقول بعض من يخاطبون الناس يقال فلان هو حياتي أو كذا فهذا لا يجوز ،لأن الحياة لله -عزوجل- " وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي " وكل ما يفعله الإنسان وما يحيا عليه وما يموت لله -عزوجل-. قال : ومِنَ السُّنَّةِ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ». اللعن هو دليل على تحريم هذا الأمر وأن من ذبح لغير الله بنية التعبد فهو ملعون واللعن هو الطرد من رحمة الله -عزوجل- فإذا كان في حق الكفار فهو الطرد المؤبد وإذا كان في حق فسقة المسلمين كقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" لعن الله السارق يسرق البيضة"،"لعن الله من غيّر منار الأرض "،فهذا لعن مؤكد واللعن كالتكفير يطلق على الأوصاف وينزل على المعينين ولكنه على شروط لا بد تستوفى الشروط في حق المعين . [المتن] قال -رحمه الله تعالى-: ودليلُ النَّذْرِ قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾[الإنسان:7]. [الشرح] ودليلُ النَّذْرِ قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ النذر من العبادات لله -عزوجل- ،ولهذه الآية كما فهم بعض أهل العلم وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ النذر ليس بعبادة وإنما الوفاء به عبادة وإنما قالوا بهذا لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :"إنما يستخرج به من البخيل" فدل على أنه مكروه ولا يمكن أن تكون العبادة مكروهة وبعض أهل العلم يخرّج هذا على النذر المعلّق لأن النذر على قسمين لأن النذر قسمين معلّق ومطلق يعنى لا يعلّق بشيء والنذر المعلق أن يقول لله علي إن حصل كذا أن أفعل كذا فهو يعلقه على شيء ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- :"إنما يستخرج به من البخيل" لأن البخيل لا يفعل إلا إذا علق على شيء قال العلماء والنذر المطلق لا يدخل في هذا مثل أن يقول لله عليّ نذر أن أصوم كذا أو أن أفعل كذا ولا يعلقه على شيء ولكن أيضاً هذا كرهه بعض أهل العلم لأنه إلزام للنفس بما لا يجب ويخشى من التفريط في هذا وأن لا يفِ بذلك ولهذا أصل النذر مختلف فيه بين أهل العلم وأما الوفاء به فقد دلت عليه النصوص كما في هذه الآية في قول الله -عزوجل- :"يوفون بالنذر" أي أنهم يوفون بما نذروا به . النذر باللغة هو: الوجوب وبالشرع هو :إلزام النفس بما لا يجب ،إلزام بما لا يجب على النفس كأن يلزم نفسه بشيء لا يجب عليه والنذر أيضاً قد يكون نذر معصية وهو أن ينذر لله -عزوجل- أن يعصي أو أن يفعل كذا فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به ولكن اختلف العلماء هل يجب به كفارة يمين أم لا لأنهم قالوا النذر كاليمين أما إذا نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يؤديها إذا تمكن منها. [المتن] قال -رحمه الله تعالى- : الأصلُ الثَّاني: معرفةُ دين الإسلامِ بالأدلةِ، وهو الاستسلامُ للهِ بالتوحيدِ، والانقيادِ له بالطاعةِ، والبراءة مِنَ الشِّركِ وأهلِهِ؛ وهو ثلاثُ مراتبَ: الإسلامُ، والإيمانُ، والإحسانُ، وكلُّ مرتبةٍ لها أركانٌ. [الشرح] الأصلُ الثَّاني: معرفةُ دين الإسلامِ بالأدلةِ، وهو الاستسلامُ للهِ بالتوحيدِ، والانقيادِ له بالطاعةِ، والبراءة مِنَ الشِّركِ وأهلِهِ؛بعد أن ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه -عزوجل- ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة هذا هو الأصل الثاني الذي يجب على المسلم أن يحققه ثم عرّفه بعبارات موجزة ومشتملة على أصول عظيمة قال هو الاستسلام لله بالتوحيد ،والاستسلام هو استسلام القلب لله بالتوحيد وتسليم النفس لله -عزوجل- ومنه كما جاء في الحديث في أذكار النوم "وأسلمت نفسي إليك "فالإسلام هو أن يسلّم الرجل نفسه لله -عزوجل- ومنه التسليم للمنايا وللموت والتسليم للقاتل كما يقال فلان أسلم نفسه لفلان ومنه قال الله -عزوجل- "(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) يعني أسلمه نفسه والاستسلام لله -عزوجل- هو أن يسلم العبد نفسه لله وأن يستسلم القلب لله -عزوجل- بالتوحيد والانقياد له بالطاعة الانقياد متعلق بأعمال الجوارح والاستسلام متعلق بأعمال القلوب والبراءة من الشرك وأهله لا بدّ من تحقيق العبادة وهو إخلاص العبادة بالقلب والإنقياد للجوارح ثم بعد ذلك البراءة من الشرك ومن أهله فإنه لا يستقيم التوحيد إلا بهذا والشهادتان مبناهما على إخلاص العبادة لله والبراءة لكل معبود غير الله -عزوجل-. قال -رحمه الله تعالى-: وهو ثلاثُ مراتبَ: الإسلامُ، والإيمانُ، والإحسانُ، وكلُّ مرتبةٍ لها أركانٌ. هذه مراتب الدين ومراتب الإسلام وهي ثلاث مراتب عظيمة كما دل عليه حديث جبريل الإسلام والإيمان والإحسان فالإسلام هو أول المراتب التي يدخل بها المسلم بالدين ولهذا الله -عزوجل- عاب على الأعراب عندما قالوا في قوله تعالى :(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا) فدعوى الإيمان قبل تحققه دعوى غير صحيحة ،فالمسلم أول ما ينطق بالشهادتين ويمتثل الإسلام يكون مسلما فإذا ارتقى بذلك يكون مؤمنا فالإسلام قال العلماء هو اخص من جهة نفس وأعم من جهة أهله فالإسلام بالنسبة إلى الإيمان هو اخص منه لأن شعب الإيمان شاملة للإيمان وما يتعلق بالإيمان وأما من جهة أهله فإن كل مؤمن مسلم ولهذا المؤمنون كلهم مسلمون فالمسلمون كثر وأهل الإيمان منهم قلة ولهذا يقال في الإسلام هو أخص من جهة نفسه يعني باعتبار الأعمال هو أخص من الإيمان وأما من جهة أهله فهو أعم فإن المسلمين أكثر من المؤمنين والإيمان هو أعم من جهة نفسه، لأن شعب الإيمان كثيرة تدخل فيها أركان الإسلام وهو أخص من جهة أهله فإن أهل الإيمان هم خواص المسلمين ولهذا كل مؤمن مسلم وليس العكس ليس كل مسلم مؤمن فالإسلام مرتبة والإيمان مرتبة أقوى من الإسلام ولكنّ أحد هذين الأمرين يطلق على الآخر فقد يذكر الإسلام ويدخل فيه الإيمان ويذكر الإيمان ويدخل فيه الإسلام وأما الإحسان فهو مرتبة متعلقة بالمراقبة وهو أن يؤدي العبد العبادات على وجه المراقبة ولهذا لم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإحسان أركان كما ذكر في الإسلام والإيمان وإنما قال أن تعبد الله كأنك تراه لاحظوا ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان ثم ذكر مرتبة الإحسان وهو أن يُحسن في أركان الإسلام وفي أركان الإيمان وفي سائر شعب الإيمان وهو أن يعبد الله كأنه يراه وقيل أن له مرتبتان : المرتبة الأولى أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يحقق هذه أن يعبد الله ويعلم أن الله يراه فهما مرتبتان وقيل أنه مرتبة واحدة ولكن الثانية تعين على الأولى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم انه يراك وهذا مما يعينك على تحقيق المرتبة الأولى . قال وكل مرتبة لها أركان يعني هذه النواحي الثلاث كل مرتب لها أركان فالإسلام له أركان والإيمان له أركان والإحسان أركانه ليست متعلقة بشعب جديدة وإنما بتأدية العمل على وجه المراقبة لله -عزوجل- . [المتن] قال -رحمه الله تعالى- : فأركانُ الإسلامِ خمسةٌ: شهادةُ أنْ لا إلـه إلاّ اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامُ الصلاةِ، وإيتاءُ الزكاةِ، وصومُ رمضانَ، وحجُّ بيتِ اللهِ الحرامِ. [الشرح] هذه الأركان هي اركان الإسلام الخمس المعلومة وهي الأركان التي يقوم عليها الإسلام وقد سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن هذه الأركان عن شيء يوجب دخول الجنة فقال الرجل لا أزيد عليه قال أفلح إن صدق ،قد ذكر العلماء أن دخول الجنة معلّق على هذه الأركان لأن هذه تجب على عامة الناس وأما بقية الواجبات الأخرى التي ليست هي من الأركان فإنها تختص ببعض الناس دون بعض مثل بر الوالدين فإنما يجب على من له والدان والجهاد على القادرين عليه والأمر بالمعروف على القادرين عليه وهكذا وأما هذه الأركان فعامة الناس يشتركون فيها وهذه الأركان إذا ترك الشهادتين مع اعتقاد صدق الشهادتين فإنه كافر بإجماع الأمة حتى يعتقد ويتلفظ ،وأما بقية الأركان الأربعة بعد الشهادتين فإنه إذا تركها مستحل لتركها فإنه كافر بإجماع الأمة وإذا ترك بعض هذه الأركان مع وجود الاعتقاد وعدم الاستحلال فإن تكفيره محل اختلاف بين أهل العلم كما هو معلوم عند المحققين من أهل العلم . قال -رحمه الله تعالى- فدليلُ الشّهادةِ قولُهُ تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. ذكر المصنّف بعد ذلك الأدلة على هذه الأركان فدليل الشهادة قوله تعالى : ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾،هذا دليل على الشهادة وهذه الشهادة العظيمة أخبر الله -عزوجل- أن الرب شهد بها وهي دليل على أنها حق ثم ذكر أخبر عن الملائكة أنهم يشهدون بها ثم ثلّث بأهل العلم ولهذا قال العلماء أن هذه تزكية لأهل العلم وأن الله استشهد بهم ومعلوم من انه لا يستشهد إلا بالعدل فدل على تعديل أهل الله -عزوجل- والمقصود بأهل العلم هم أهل العلم بدين الله -عزوجل- الذين عرفوا العلم وما من عالم إلا وهو يشهد هذه الشهادة ومن خالف في هذه الشهادة فهو جاهل ،وعلى قدر العلم بهذه الشهادة يقوى الإيمان وتصدق هذه الشهادة ويستقر الإيمان بها في القلب "قائما بالقسط "يعني هذا صفة لله -عزوجل- أنه قائما بالقسط أي بالعدل ثم جاء مؤكداً لهذه الشهادة في قوله "لا إله إلا هو العزيز الحكيم "والعزيز هو من أسماء الله -عزوجل- وهو متضمن صفة العزة وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله -عزوجل- والحكيم والمتضمن لصفة الحكمة وهي من الصفات الذاتية الثابتة لله -عزوجل- وفي اقتران العزيز بالحكيم كمال فوق انفراد احد الاسمين دون الآثخر ولهذا قال العلماء على أن هذا دليل على أن عزة الله -عزوجل- مصحوبة بالحكمة بخلاف من قامت به العزة من المخلوقين فإنه لربما حملته عل الإثم فإن من بعض الأعزاء ما تحمله العزة على الإثم وأما الله -عزوجل- فعزته مقترنة بالحكمة وكذلك قد توجد الحكمة في بعض المخلوقين ولا يصحبها عز فالحكمة موجودة في أهل العلم والفضل وكثيرا ما توجد الحكمة في هؤلاء ولكن لا تقترن بالعز وكذلك العز يوجد في أهل الجاه كثيرا وكثيراً ما تتخلف الحكمة ولهذا كان الله -عزوجل- متصف بالعزة المطلقة وبالحكمة المطلقة وهو بلا شك متفرد بالكمال من كل صفة وما يحصل في المخلوقين من العز والحكمة إنما هو بعز الله للأعزاء وما حصل من الحكمة فهو من الله -عزوجل- كما قال الله -عزوجل- :(يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ). قال -رحمه الله تعالى- : ومعناها لا معبودَ بحقٍّ إلا اللهُ وحده؛ (لا إلـه) نافيًا جميعَ مَا يُعْبدُ مِنْ دونِ اللهِ، (إلا الله) مُثْبِتًا العبادةَ للهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ في عبادتِهِ، كما أنَّه ليس له شريك في مُلْكِهِ،هذا تفسير لمعنى الشهادة قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله لأنه ليس مقصود عندما يقول لا إله إلا الله نفي الألوهية ولكن نفي أن يكون إله معبود بحق إلا الله -عزوجل- وإلا لو قلنا لا إله موجود إلا الله فهذا يعني أنه ليس هناك آلهة من دون الله وقد دلت النصوص على وجود الشرك والآلهة التي تعبد من دون الله كثيرة كما قال كفار قريش :"أجعل الآلهة آلهة واحدة" فهي كثيرة ولكن المعبود بحق هو الله -عزوجل- ولهذا يقدر الخبر هنا لا معبود بحق إلا الله وأما الآلهة المعبودة من دون الله -عزوجل- فهي كثيرة والذي يٌخرج إخلاص العبادة أن يشهد أنه لا معبود بحق ولا يستحق هذا الاسم إلا الله -عزوجل- ولكن من المخلوقين من اتخذ إلها من دون الله فأعطاه الاسم وهو ظالم بهذا وصرف له العبادة وهو ظالم بهذا وأما المعبود بحق وهو المستحق لهذه الصفة ولصفة الألوهية وهو المستحق للاسم العظيم وهو الله ولهذا لا يجوز لأحد أن يتسمّى بهذا الإسم وهو الله ولا يتصف بهذه الصفة وهي صفة الألوهية ولهذا قيل أن هذا الاسم هو الاسم الأعظم ولهذا من فضله أنه يُخبر عن الأسماء بهذا الاسم يقال ولله الأسماء الحسنى ولا يقال للرحيم الأسماء فهذا دليل على عظم هذا الاسم ولهذا كل ما ورد في التسميّة وفي كثير من الأشياء التي يذكر عليها اسم الله -عزوجل- يقدم اسم الله وكثير ما يقترن بالرحمن والرحيم ،ثم قال لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله يعني إذا قال لا إله فالمقصود أنه ينفي جميع ما عُبد من دون الله -عزوجل- ويشهد أنه لا معبود بحق من دون الله -عزوجل- إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده ينفي الألوهية عن غير الله -عزوجل- ويثبتها لله -عزوجل- لأنه هو المستحق لها . لا شريك له في عبادته أي لا شريك لله -عزوجل- في عبادته كما أنه لا شريك له في ربوبيته . قال -رحمه الله تعالى-: وتفسيرُها الذي يوضِّحُها قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾[الزخرف:26-28]. قال -رحمه الله تعالى- وتفسيرُها الذي يوضِّحُها من كتاب الله -عزوجل- قوله تعالى﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي ) إذا هنا هذه الجملة اشتملت على معنى الشهادتين وهي البراءة من كل ما عبد من دون الله إلا الله -عزوجل- إلا الذي فطرني وهو الله -عزوجل- فاطر السموات والأرض هو الذي فطر الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها ما من مولود إلا ويولد على الفطرة يعني يخلقه الله -عزوجل- على الفطرة وهي الإسلام أيضاً فطر الإسلام لأن الله فطر [...]لأن مراتب الهداية داخلة تحت هذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه هذا هو الشاهد من هذه الآية وهذا من دقيق استدلال المصنّف رحمه الله لأن هذه الكلمة هي الشهادتان وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي شهادة أن لا إله إلا الله" لعلهم يرجعون إلى الله -عزوجل- وينيبون إليه . قال رحمه الله وقوله : وقولُه تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾[آل عمران:26] هذه أيضاً معنى الشهادتين :" قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ"الكلمة هنا هي الشهادة والكلمة تطلق في كلام الله -عزوجل- وفي كلام سلف المتقدمين على الجملة وهي غير الكلمة التي تطلق في اصطلاح النحاة أن الكلمة هي الكلمة المفردة خلاف الجملة وأن الجملة مركبة من كلمات فالكلمة تطلق على أكثر من الكلمة اصطلاحاً النحاة وتطلق على الجملة ولهذا يرد في كلام الله -عزوجل- مثل هذا وكذلك في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:"إني أعلمك كلمات "يعني بمعنى جمل ولهذا علّمه عدة جمل وهذه الكلمة إلى كلمة سواء هي معنى الشهادتين بينما إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إي أنها تكون متفق عليها بيننا وبينكم ونصطلح عليها ولا تختصم وهذا دليل على أن الصلح بين الناس إنما يكون على الحق ولا يكون على الباطل ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً هذا معنى الشهادتين "لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله" أي لا يتخذ بعض الناس من هو من جنس ما بني البشر أو من غيرهم من الجنس الآخر من الجن أو من الملائكة أرباباً من دون الله وهذا دليل أن من عبد غير الله فكأنما أثبت له الربوبية لأنه ما قال احد أنه يعبد ما يعبد من دون الله ويعتقد أنه رب إلا ما قال فرعون قال "أنا ربكم الأعلى" على سبيل العناد وإلا ما من عابد يعبد من يعبد من دون الله إلا وهو يعتقد أن الله -عزوجل- هو الرب ولهذا قال شيخ الإسلام :"ما قال أحد من العقلاء أن لله شريكاً في خلق السموات والأرض وإنما كانوا يعبدون غير الله -عزوجل- يتزلفون بعبادتهم لله -عزوجل-" قال فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون إن تولوا عن هذه الكلمة تبرأوا منهم وقل اشهدوا بأنا مسلمون أي نلزم هذه الكلمة ونسلم لله -عزوجل- ونتبرأ من الشرك . [المتن] قال -رحمه الله تعالى- : ودليلُ شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ قولهُ تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾[التوبة:128]. [الشرح] هذا دليل أن محمداً رسول الله" لقد جاءكم رسول من أنفسكم "هذا دليل على أن هذا النبي أنّه مرسل من الله رسول من أنفسكم وهذه منة من الله أن جعل هذا الرسول من جنسنا ومن مما نعرف لغته ونعرف أصله ونعرف ما كان عليه ولهذا كانت هذه منة عظيمة أن امتن على هذه الأمة برسول من أنفسهم ثم هو متصف بصفات عظيمة "عزيز عليه ما عنتم "أي يشق عليه ما فيه عنت وحرج على هذه الأمة ولهذا كان -صلى الله عليه وسلم- من أرحم الرسل بأمته يقول "لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "ولما اجتمعوا يأتمون بصلاته في رمضان لم يخرج إليهم في الليلة الثالثة قال إني أخشى أن تفرض عليكم كان عليه الصلاة والسلام رفيقاً بالأمة ومن شفقته على أمته أنه مازال يسأل الله -عزوجل- عندما افترضها الله خمسينا ويراجع الله -عزوجل- حتى استقرت الفريضة على خمس صلوات وأجرها خمسين وهذا من شفقته على أمته كما كان صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته أنه كان يكثر الوصايا لهم ويكثر لهم من النصح وهذا من رحمته بالأمة وكان همّ قبل وفاته أن يكتب لهم كتاباً وأراد أن يوصي لأبي بكر ثم إنه بعد ذلك تركه وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ،ثم هم أن يوصي في آخر أيامه ثم تركه لهذا المقصد قال شيخ الإسلام "وهذا دليل أن هذا الكتاب أنه لا يجب عليه وإلا لو كان واجباً لكتبه عليه الصلاة والسلام "ولكن من شفقته بأمته أراد أن يكتب لهم كتاباً لمن يكون الخليفة من بعده وهمّ بهذا في حياته ثم تركه كما جاء في الصيحح ثم قال ثم قد يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر أي أنه لا يمكن أن يشك في مثله ثم همّ بذلك أن يكتب في مرضه الذي مات به ثم ترك ذلك إما لهذا المقصد وإما لأنه رأى أن ثم ذكر لهم قبل هذا أنه يكفي عليه الصلاة والسلام وهذا من شفقته على أمته؛ وإلا لو كان الكتاب يجب عليه لكتبه عليه الصلاة والسلام وهذا من شفقته ومن تنفله في حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. "حريص عليكم" أي شديد الحرص على هداية الأمة حتى انه كان يستغفر للمنافقين حتى نهاه الله -عزوجل- عنه وكان يصبر عليهم ولما لاقى من قومه ما لاقى عندما أخرجوه من مكة وأدموا عقبيه وجاءه ملك الجبال قال: إن الله أرسلني إليك فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين قال لا وإني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ، وهذا صبر عظيم في أول البعثة وهو رجل وفرد لا عون له إلا الله -عزوجل- ومع هذا يصبر ويتحمل وكان يعفو عن الظالمين ولما جاءه الأعرابي وأغلظ إليه وأعطاه وقال له: بئس أخو العشيرة وقال له لا أجملت ولا اعطيت ،ثم لازال يرفق به حتى شهد بأنه أحسن له وأجمل وقال لأصحابه لو تركته على ما قال لقتلتموه ولدخل النار ولكني ما زلت أترفق به أو كما قال حتى هداه الله -عزوجل- ثم قال مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل له إبل شردت عنه أو ذهبت فهمّ الناس أن يلحقوا بها فما زادوها إلا نفورا فقال دعوها فأنا أولى بها فما زال يرفق به حتى اجتمعت عليه هذا -صلى الله عليه وسلم- من رفقه وشفقته بالأمه وحرصه على كل فرد من الأمة حتى رؤوس المنافقين كان يحرص عليهم عليه الصلاة والسلام. "بالمؤمنين رؤوف رحيم" أي أنه متصف بالرأفة والرحمة ولهذا جمع الله له بين هاتين الصفتين العظيمتين والرب -عزوجل- متصف بالرأفة والرحمة وما اتصف به النبي -صلى الله عليه وسلم- هو مما يليق بالمخلوق وما اتصف به الرب -عزوجل- هو مما يليق بالخالق -عزوجل- . [المتن] قال -رحمه الله تعالى-: ومعنى شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ: طاعتُهُ فيما أَمَرَ، وتصديقُهُ فيما أَخْبَرَ، واجتنابُ ما عنْهُ نهى وزَجَرَ، وأنْ لا يُعبدَ اللهُ إلاَّ بما شَرَعَ. [الشرح] ثم ذكر معنى الشهادة وهي مشتملة على هذه الأصول الأربعة وهي طاعته فيما أمر لأن الطاعة إما تتعلق بالأوامر أو النواهي أو الأخبار أو أن يتعبد بالدين فأمّا الأوامر فالإيمان به أن يُطاع فيما أمر وأما الأخبار فهو أن يصدّق فيما أخبر به وأما النواهي أن يُجتنب ما نهى عنه وزجر وأما العبادة أن لا يُعبد الله إلا بما شرع فمن حقق هذه الأصول حقق شهادة أن محمداً رسول الله وأما من خالف في شيء فعلى قدر الإخلال بهذه الأصول فيكون هذا نقص في شهادة أن محمداً رسول الله ولهذا جعل الله محبة رسول الله دليل على اتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا بعض الغلاة الذين دخلوا في بعض أنواع من البدع يزعمون أنهم أولى الناس بمحبة النبي صلى الله عليه ولو تأملوا فعلهم لعرفوا أنهم يقصّرون في اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- لخروجهم عن سنته إلى البدع ولهذا خاطب النبي -صلى الله عليه وسلم- خيار الأمّة الذين لا يشك في حسن مقصدهم في النفر الذين جاؤوا لبيوت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهمّوا بترك بعض الأمور المباحة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- مبيناً لهم أن هذا مخالف لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه فإنه على قدر إخلاله بالسنة يكون إخلاله بشهادة أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام أما من كذبه في شيء من الأخبار فهذا كفر بيّن وأما طاعته في الأوامر فإن أطاعه فلا شك أن هذا هو الواجب فإن عصاه فإن كانت المعصية من غير استحلال فإن هذا من جنس المعاصي وأما إذا استحل المحرمات أو أنه اعتقد عدم وجوب الواجبات فهذا كفر، وكذلك النواهي إذا ارتكب شيئاً منها مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر باجتنابها فإن هذا معصية إلا إن استحلها فإنه يكفر بذلك. [المتن] قال -رحمه الله تعالى- ودليلُ الصلاةِ، والزكاةِ، وتفسيرُ التَّوحيدِ قولُه تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾[البينة:5]. دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )الأمر بعبادة الله -عزوجل- مع إخلاص الدين هذا تفسير كلمة التوحيد ،حنفاء أي أنهم حنفاء مائلون عن الشرك إلى التوحيد ،ويقيموا الصلاة وهذا دليل الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا دليل الزكاة وذلك دين القيّمة أي الدين القيّم والشريعة المستقيمة القيّمة التي لا اعوجاج فيها وأن من سلكها سلك الطريق الأقوم إلى الجنة وأن هداية هذه الشريعة هي للأقوم كما قال الله -عزوجل-" إن هذا القرءان يهدي للتي هي أقوم"فما من شيء في كتاب الله -عزوجل- وفي سنة النبي صلى الله عليه إلا وهو أقوم من غيره من المناهج والمسالك فهو أقوم طريق وهو دين القيّم مستقيم على التوحيد وعلى كل ما فيه الخير إذا ما استقام عليه المسلم . [المتن] قال -رحمه الله تعالى- ودليلُ الصيامِ قولُه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[البقرة:183]. هذا دليل الصيام وهو قول الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾أي أن الله كتبه والكتابة هنا شرعية لأن الكتابة تكون قدرية كونية كقول الله -عزوجل-:" لأغلبن انا ورسلي" والكتابة تكون شرعية مثل كتب الله عليكم الصيام أي شرعه لكم والصيام أخبر الله -عزوجل- هنا أنه كتبه على من مضى ولم يقل الله -عزوجل- كتب صيام رمضان لأن الشرائع تختلف وأما الصيام فهو مكتوب على من قبلنا لكن كيف يصومون ومتى يصومون وفي أي وقت يصومون فالله أعلم بذلك ولكن الصيام مشروع وهو مكتوب عليهم كما كتب علينا وهذا دليل على أنه من العبادات التي كانت موجودة قبلنا. "لعلكم تتقون" أي تتقون الله -عزوجل- وبالاستقامة على طاعته وبترك المحرمات والتقوى إذا ذكرت منفردة عن البر دخل البر دخل فيها البر فالتقوى هنا تشمل البر وهو فعل الطاعات ،وتشمل التقوى إذا ما ذكرت مع البر وهي ترك المحرمات. [المتن] قال -رحمه الله تعالى- ودليلُ الحجِّ قولُه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[آل عمران:97]. [الشرح] هذا دليل الحج وهو قوله تعالى :" وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ"أي أن الله -عزوجل- فرض على الناس حج البيت والحج في اللغة هو القصد وفي الشرع هو القصد البيت هو المشاعر المقدسة التي شرع الله -عزوجل- للحاج أن يؤدي العبادات المشروعة فيها . "لمن استطاع إليه سبيلاً " استطاع هنا فسرها النبي -صلى الله عليه وسلم- هي ملك الزاد والراحلة وما يُبَلغ الرجل إلى المشاعر وأن يرجع إلى أهله . ومن كفر فإن الله غني عن العالمين استدل بعض العلماء بهذه الجملة على أن ترك الحج أنه كفر لأن الله -عزوجل- قال :"ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" والكفر يطلق على الأكبر وعلى الأصغر ولهذا وينبغي أن يُرجع في تفسير هذه النصوص ولهذا اختلف أهل العلم في ترك الحج لمن كان قادراً عليه هل يكون تركه إذا ما اعتقد وجوبه أنه كفر أو انه كبيرة من كبائر الذنوب . هذا والله أعلم . *[...] الصوت مقطوع.-----------------------------------------------------
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#8
|
|||
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله الوالدة أم عبد الله
أعانك الله وبارك الله فيك ونفعنا بك وجعلها الله في ميزان حسناتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون |
|
#9
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ابنتي الحبيبـــــــة " أم أُنَيْسة الأثرية " وحيــّــــاك الله وبيــّـــاك وسدّد على طريق الخير والهدى خطـــــاك. اللهم آمين ولك ولكل من ساهم بهذا الجهد بمثل وزيادة : رؤية وجه الله الكريم في جنة عرضها كعرض السموات والأرض. شكر الله لك المرور والدعاء، وجزاك عني خير الجزاء.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
|
#10
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم تفريغ الدرس السادس شرح الأصول الثلاثة -لفضيلة الشيخ د.إبراهيم بن عامر الرحيلي-حفظه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد ، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب : المرتبة الثانية : الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان . الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المرتبة الثانية من مراتب الدين بعد أن ذكر المصنِّف -رحمه الله - المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام وقد تقدم أنّ الإسلام هو أعم من جهة أهله وأخص من جهة نفسه، وأن الإيمان بالنظر إلى الإٍسلام هو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله ،ومرتبة الإيمان هي مرتبة فوق مرتبة الإسلام وذلك أن المسلم إذا دخل في الإسلام بالنطق بالشهادتين وحقق أركان الإسلام فإنه لا يزال يرتقي في شعب الإيمان حتى يحقق الإيمان الكامل الواجب. والإيمان له شعب كما جاء في هذا الحديث الإيمان في اللغة كما هو معلوم هو الإقرار والإيمان في الشرع عند أهل السنّة والجماعة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان أي الجوارح أي أنه مكون من هذه الأجزاء الثلاثة وهذه الأجزاء كما هو معلوم هي أجزاء البدن القلب واللسان والجوارح وإنما كان الإيمان مركب منها باعتبار ما يقوم بهذه الأجزاء من الشعب ولهذا نقول إن هذه هي أجزاء الإيمان وأما القول بأنها أركان الإيمان فهذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أركان الإيمان كما في حديث جبريل كما سيأتي ولم يذكر هذه الأجزاء وإنما ذكر أركان الإيمان فهذه هي أركان الإيمان باعتبار ما يقوم بالبدن من الشعب ومعلوم أن هذه هي أجزاء البدن فكل ما قام بالقلب هو من الشعب القلبية وما قام باللسان هو من الشعب القولية وما قام بالجوارح هو من الشعب المتعلقة بالجوارح . وطبعاً خالف أهل السنّة في هذا طوائف منهم من حصر الإيمان جعله في القلب كما هو قول المرجئة على اختلاف فيما بينهم هل هو المعرفة أو التصديق ومنهم من أضاف إلى هذا القول ومنهم من جعله القول فقط ،وكل طوائف المرجئة متفقون على تأخير الإيمان عن مسمى الإيمان ولهذا سموا مرجئة لإرجائهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وهذا خطأ فإن النصوص دلت على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كما في جاء في كثير من نصوص إطلاق الإيمان على الأعمال من أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح ولا شك أن قول المرجئة قول باطل باتفاق أهل السنة وأن من زعم أن شيئاً من شعب الإيمان التي دلت عليها النصوص من أعمال الجوارح أو أعمال اللسان أنها ليست من الإيمان وأنها خارجة عن ماهيته فلا شك أن هذا قول المرجئة وقول المرجئة قول مبتدع باطل متفق على رده بين أهل السنة والجماعة.ويقابل قول المرجئة قول الخوارج الذين غلوا في الإيمان وزعموا ان كل ما قيل أنه من الإيمان إذا تركه العبد فإنه يكفر به، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن عامة الطوائف المخالفة لقول أهل السنة في الإيمان يجعلون الإيمان حقيقة واحدة يجعلونه شيئاً واحداً ثم يختلفون بعد ذلك في التفصيل فمتفقون على أن الإيمان شيء واحد ثم بعد ذلك يختلفون في التفصيل؛ فقال المرجئة إذا ثبت بعض الإيمان ثبت كله ولا تضر المعاصي الإيمان وقال غلاتهم يستوي إيمان الفاسق من هذه الأمة وإيمان جبريل لأن الإيمان في القلب ،والناس يتساوون في إيمان القلب وفي عمل القلب وقالوا إذا ثبت بعضه ثبت كله وإذا ثبت أصل الإيمان فالإيمان كله ثابت ثم حملوا النصوص في وعيد العصاة من هذه الأمة قالوا إنما الوعيد في الكفار الذين ليس لهم إيمان وأما هؤلاء فلهم إيمان كامل فإنهم لا يعذبون ولهذا قال المرجئة أن العصاة أنهم مؤمنون كامل الإيمان وأنهم في الجنة وخالف في هذا طائفة منهم وهم مرجئة الفقهاء الذين وافقوهم في أصل الإيمان وأن العمل خارج عن ماهية الإيمان لكن قال مرجئة الفقهاء إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وقالوا هو متوعَد بالوعيد لتركه الواجب الذي أمر به ،قالوا عرفنا أن هؤلاء معرضون للوعيد لما دلت عليه النصوص من وعيدهم وإلا فالإيمان فإنه لا يتعلق بهذا الأمر ولكن يتعارض عند هؤلاء قولهم أنه تحت المشيئة وأنه مؤمن كامل الإيمان ،فإن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص كيف يكون مؤمن كامل الإيمان وهو تحت المشيئة يقال إنه معرّض للعذاب. قابل هؤلاء الخوارج قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله فمتى نقص شيء من الإيمان بارتكاب الكبائر والذنوب فإنه يذهب الإيمان بالكلية ولا يبقى منه شيء واتفق الوعيدية من الخوارج والمعتزلة على أنّ مرتكب الكبيرة أنه خارج عن الإيمان لكنهم اختلفوا هل هو كافر كما يقول الخوارج أو في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة ويتفق الفريقان على انه خالد مخلّد في النار وإن كان الخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين والمعتزلة يقولون يعذب عذابا دون ذلك ،وأما في الدنيا فإن الخوارج يعاملونهم معاملة الكفار والمعتزلة يعاملونه معاملة المسلم ،وأهل السنّة يقولون أن الإيمان يتجزأ كما دلّت على هذا النصوص ودلّ على هذا الحديث في شعب الإيمان وأنه يذهب بعضه ويبقى بعضه ولكنّهم لا يجعلون الشعب على درجة واحدة فمن الشعب ما إذا ذهبت يقال ذهب الكمال المستحب منه وهي الشعبة المستحبة ومن الشعب ما إذا ذهبت ذهب الكمال الواجب منه وهي الشعب الواجبة بعد الأركان الخمسة ثم يختلفون في ذهاب بعض الأركان بعد الشهادتين في ذهاب الأركان الأربعة بعد الشهادتين هل يكفر المسلم بتركها إذا تركها تهاوناً مع وجود الإعتقاد أم لا ؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل السنّة وأما إذا ترك النطق بالشهادتين فإنه يكفر بهذا وبهذا يتبيّن أن الشعب ليست على درجة واحدة فمنها ما إذا تركها العبد يكفر بتركها بالإجماع كالنطق بالشهادتين ومنها ما يكفر بتركها عند بعض أهل السنة وهي الأركان الأربعة بعد الشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج وأما ما بعد الأركان الخمسة فلم يقل أحد من أهل السنّة أنه إذا ارتكب شيئاً من الذنوب أوترك شيئاً من الواجبات فإنه يكفر بهذا، وإنما يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهذا هو أصل أهل السنة الذي خالفوا فيه الفرق المخالفة لهم في هذا الباب فعندما قالوا هو مؤمن بإيمانه أثبتوا له بعض الإيمان وهذا رد على الخوارج وعندما قالوا فاسق بكبيرته هذا رد على المرجئة وهذا هو الوسط الذي دلت عليه النصوص وهو الحق أن الإيمان ليس على درجة واحدة وأنه متفاوت في شعبه . ثم ذكر المصنّف أنّ الإيمان بضع وسبعون شعبة وهذا كما جاء في الحديث في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي بعض الروايات بضع وستون شعبة ،وهذا دليل على أن الإيمان يصل إلى هذا العدد وأن مجموع هذه الشعب تصل إلى هذا العدد قال:" فأعلاها قول لا إله الا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " وهذا نص الحديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله والحياء شعبة من الإيمان ،فأعلاها قول لا إله إلا الله قوله فأعلاها كما جاء في الحديث فهذا يدل على أن الشعب متفاوتة وأن فيها أدنى وأعلى وهذا على خلاف من يقول أن الإيمان شيء واحد وهذا الحديث يدل على أمرين عظيمين : على أن الإيمان يتجزأ وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون أو بضع وستون ويدل على ان هذه الشعب متفاضلة وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله فهذا يدل على أصلين عظيمين وأن الإيمان ينقسم ويتجزأ ويدل على أن شعبه متفاوتة وهذه من الأدلة الواضحة من الحديث على عقيدة أهل السنة وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وقوله أدناها دليل على أن الشعب أيضاً فيها أعلى وأدنى والدليل أيضاً هذا الدليل لتفاضل المؤمنين في الإيمان وهذا قول أهل السنة وأن الإيمان يزيد وينقص وأن المؤمنين يزيدون وينقصون في إيمانهم والنقص والزيادة يكون في القلب ويكون بحسب أعمال الجوارح وبهذا على قدر تحقيق العبد لهذه الشعب يكون أعلى درجة في الإيمان ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا نص الحديث "والحياء شعبة من الإيمان" وهذه أيضاً شعبة أخرى من شعب الإيمان وهي شعبة قلبية ويلاحظ أن هذا الحديث اشتمل على ثلاث شعب وهذه الشعب الثلاث منقسمة على الاعتقاد ومنقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح وهذا دليل لقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح فشعبة الشهادتين شعبة قولية وشعبة إماطة الأذى عن الطريق شعبة عملية وشعبة الحياء شعبة قلبية ولعل هذه هي الحكمة والله أعلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم لمّا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ثم قال والحياء شعبة من الإيمان فلِما ذكر الحياء مع انّه داخل فيما بين ما هو أعلى وأدنى؟ لعل هذا والله أعلم هو التنبيه إلى هذه الشعبة وأنها من الشعب القلبية لأن الأعلى متعلّق بالشعبة القولية والأدنى متعلق بالشعبة العمليّة فناسب أن يذكر على أن من الشعب ما هو من أعمال القلوب فقال والحياء شعبة من الإيمان فهذا الحديث العظيم فيه دلالة لقول أهل السنة من أكثر من وجه ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا الأدلة لعقيدتهم من الكتاب والسنة حتى تترسخ في نفوسهم ويعلم أنها حق وأن الأدلة قد دلت عليها وكذلك يبيّن للمخالفين أن هذه الأدلة هي التي دلت على قول أهل السنّة هو ليس أنه من الأقوال المبتدعة. [المتن] قال رحمه الله تعالى : وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . [الشرح] أركان الإيمان ستة كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث جبريل وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر ، هذه الأركان هي أركان الإيمان وأعظم هذه الأركان هو الإيمان بالله -عزوجل- وهو متضمن لأنواع التوحيد الثلاثة وما بعده من الأركان هو متعلق به ولهذا عطفت عليه وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لان هذه الأركان الثلاثة متعلقة بالإيمان بالله -عزوجل- لأن منها بالله الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بوجود الملائكة والإيمان بوجود الكتب متعلق بأنواع التوحيد أما الإيمان بالملائكة فهو متعلق بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنه هو الذي أوجدهم وكذلك الإيمان بالكتب متعلق بتوحيد الأسماء والصفات وأن الله هو المتكلم بها والإيمان بالرسل متعلق أيضاً بالخلق وأن الله هو الذي خلقهم وانه هو الذي أرسلهم وخاطبهم ولهذا تعطف هذه الأركان على الركن الأول ويأتي أحياناً في النصوص ولهذا يأتي أحيانا في النصوص ذكر الإيمان بالله مع ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر كما في قول -الله عزوجل- :"لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" يؤمنون بالله واليوم الآخر فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر ولما لم يذكر الأركان بعد الإيمان بالله -عزوجل- لأن داخلة في الإيمان بالله -عزوجل- واليوم الآخر خُص هنا لأنه مما يتعلق بالجزاء والحساب يوم القيامة وكذلك القدر هو داخل في الإيمان بالله -عزوجل- لأنه متعلق بالأسماء والصفات فإن مراتب القدر الثلاثة :العلم والكتابة والمشيئة ،هي من باب الأسماء والصفات وكذلك الخلق هو متعلق بالأسماء والصفات من جهة وهو متعلق بتوحيد الربوبية من جهة أخرى فالإيمان بهذه الأركان العظيمة هو من أركان الإيمان الستة التي لا بدّ للمسلم أن يحققها . وقد تقدّم التفصيل في شروح الحديث عن هذه الأركان وما يتعلق بها من مسائل وهي مسائل عظيمة والإيمان بها إيماناً مجملاً على ما دلت عليه النصوص والإيمان المفصّل هو بكل ما ورد بهذه الأركان وما يتعلق بها وأود التنبيه هنا إلى الفرق بين الأركان والشعب فالأركان داخلة في الشعب ،فأركان الإيمان هي أعظم شعب الإيمان فالأركان داخلة في الشعب ،فكل ركن هو شعبة وليس كل شعبة ركن، ولهذا تلاحظون أن أهل العلم الذين اجتهدوا في التأليف في شعب الإيمان أول ما يقدمون من شعب الإيمان عند ذكره يقدمون أركان الإيمان وأركان الإسلام. وأما قول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل فهذه أجزاء الإيمان إذن عندنا أجزاء وأركان وشعب فالأركان داخلة في الشعب والأجزاء هي أجزاء البدن التي تقوم بها الشعب قوام الشعب إلى هذه الأجزاء الثلاثة من البدن . [المتن] قال رحمه الله تعالى والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى :" (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ). [الشرح] هذا في الدلالة على أركان الإيمان في قول -الله عزوجل- :"لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ" البر إذا ذُكر منفرداً عن التقوى دخلت فيه سائر الأعمال المشروعة من الطاعات وترك المحرمات وإذا ذكرت التقوى معه فالبر هو فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات ،فالبر هنا يشمل كل ما شرعه -الله عزوجل- لعباده من الأعمال وكذلك ترك المحرمات يقول -الله عزوجل- :"ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب " قيل إن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى فإن كل طائفة من الطائفتين ادّعت أنها على الحق وكان اليهود يستقبلون المغرب والنصارى يستقبلون المشرق فنزلت هذه الآية مبيّنة أن ليس البر في استقبال المشرق والمغرب وإنما هو في الإيمان بالله وقيل نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يصلون إلى القبلة الأولى إلى المسجد الأقصى ثم نسخت هذه القبلة فشق ّ هذا على بعض أهل الكتاب وبعض المؤمنين فنزلت هذه الآية مبيّنة أن ليست العبرة بتولي جهة من هذه الجهات وإنما العبرة بطاعة -الله عزوجل- ولهذا لما كانت هذه القبلة الأولى مشروعة حفظ -الله عزوجل- على أهلها إيمانهم كما قال -الله عزوجل- :"وما كان الله ليضيع إيمانكم" لما خشي بعض الصحابة من الذين كانوا يستقبلون القبلة الأولى ومات بعضهم على ذلك قال بعض أصحاب النبي صلى فكيف بإخواننا ؟يعني الذين كانوا يستقبلون المسجد الأقصى فنزلت هذه الآية مبيّنة أن -الله عزوجل- لا يضيع إيمانهم لأنه هذا شرع لهم في وقتهم وأما بعد نسخ القبلة فلا يجوز استقبال المسجد الأقصى وهذا دليل على أن المؤمنين إنما استقبالهم على هذه الجهات أو تأدية العبادات في أماكن معينة إنما هو طاعة لله ، وهذا يبيّن ويدل على أنه ليس المقصود من استقبال الجهات أو تأدية بعض المناسك في بعض المشاعر أن المقصود هو تعظيم الأمكنة لذاتها وإنما المقصود هو تحقيق عبادة -الله عزوجل- وإلا فالأمكنة فإنّها لا تقدس ،ولهذا قال عمر لما قبّل الحجر الأسود قال :والله إني لأعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنّي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ؛فهذا دليل على أن العبرة ليست بالأماكن والبقاع وإنما العبرة بطاعة الله لكن إذا جاءت النصوص بالترغيب بالعمل في مكان فإنا نمتثل هذا كما فضلت هذه المساجد الثلاثة على غيرها فتقصّد هذه الأماكن الفاضلة وتأدية العبادة فيها يكون هذا من الاتباع لدين -الله عزوجل-. قال :"ولكنّ البر من ءامن بالله واليوم الآخر" يعني أن البر هو في هذا ،يعني الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فدلّ على أن هذه الشعب أنها من البر وأن هذه الأركان العظيمة هي من البر وبيّن -الله عزوجل- أن البر وفسّره بهذه الأركان كما فسّر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بهذه الأركان ومعلوم أن الإيمان يدخل في البر فإن الإيمان هو امتثال الطاعة وترك المحرم فالبر يطلق ويراد به الإيمان وكذلك التقوى تطلق ويراد بها الإيمان" إن أكرمكم عند الله أتقاكم "يعني في الإيمان أتقى لله عزوجل بامتثال الطاعة وترك المحرم . [المتن] قال رحمه الله تعالى : ودليل القدر قوله تعالى (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر:49) . [الشرح] هذا دليل القدر لأنه لم يذكر في الآية وأحياناً تذكر أركان الإيمان في بعض المواطن ولا يذكر القدر معها والحكمة من هذا والله أعلم أن القدر كما تقدم هو متعلق بالإيمان بالله لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بتقدير -الله عزوجل- للمقادير ومعلوم مراتب القدر وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق متعلقة بباب الأسماء والصفات ومرتبة الخلق متعلقة بالربوبية وهي متعلقة بالأسماء والصفات من جهة أن -الله عزوجل- متصف بصفة الخلق ولهذا يدخل الإيمان بالقدر في الإيمان ب-الله عزوجل- وقد دلت هذه الآية أيضاً على الإيمان بالقدر في قول -الله عزوجل- إنا كل شيء خلقناه بقدر فدل هذا على أن كل شيء مخلوق فإن -الله عزوجل- خلقه بقدر وأن الأمر لم يكن صدفة كما يقول من ينكر القدر وإنما الأمور مقدّرة من الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات الأرض بخمسين ألف سنة وعلم ما ستفضي إليه وما سيكون في المخلوقات بناءً على علمه السابق . [المتن] قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة : الإحسان ركن واحد وهو " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " [الشرح] قبل أن ننتقل إلى هذه المرتبة أود التنبيه حقيقة على مسألتين كثر فيهما الكلام وقد سبق التنبيه في بعض الدروس عليها وأذكر من سبق أن سمع هذا الكلام وأنبّه على من لم يسمع لحقيقة أهمية هذه المسائل ولكثرة ما يحصل فيهما من النزاع ،وهما مسألتان محدثتان تكلم فيهما بعض المتأخرين وحصل فيهما خلط في بعض الأمور وإنما أقول ما أقول نصحاً أهل السنّة ولأخواني لما أحب لنفسي من الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال الأئمة المحققين : المسألة الأولى مسألة قول القائل إن العمل هل هو شرط صحة أو شرط كمال ؟ وهذا السؤال محدَث فإن العمل لا يوصف بهذه الأوصاف فالقول بأنه شرط صحة أو شرط كمال هذه من الألفاظ المجملة ولهذا لا ينبغ لطالب العلم ان يلتزم إحدى الإجابتين فيقول العمل شرط صحة أو شرط كمال وإنما نلتزم ما دلت عليه النصوص ونقول نحن لا نعرف شرط صحة ولا شرط كمال وإنما نعرف أن العمل من الإيمان هذا الذي دلّت عليه النصوص وهذا هو منهج السلف عندما يسألون عن شيء فإنهم يقولون لا نعرف هذا سئل الإمام أحمد عن قول من يقول إن الله -عزوجل- جبر العباد قال نحن لا نعرف هذا نعرف قول -الله عزوجل- وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فعدل عن القول المجمل إلى الحق ونحن نعدل عن هذه الأقوال المجملة إلى الحق نقو ل إن العمل من الإيمان كما دلت على هذا النصوص . وأمّا وجه الإجمال في السؤال فإن القول بأن العلم شرط صحة أو شرط كمال هذا في خطأ لأن العمل ليس على درجة واحدة والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله ويخبر أن فيها أعلى وأدنى ثم نجعل لها حكما واحدا نقول العمل شرط صحة فهذا لا يجوز لأن فيه مساواة بين المتفاضلات وهذا من الظلم كما ذكره شيخ الإسلام فكيف تُجعل شعبة شهادة أن لا إله إلا الله كشعبة إماطة الأذى عن الطريق ولهذا من قال إن العمل شرط صحة دخل في هذا بعض الشعب المستحبة أليست إماطة الأذى عن الطريق من العمل فهل الآن من لم يمط الأذى عن الطريق لم يصح إيمانه ولكن الذي يطلق اللفظ لا يتأمل ما يتضمنه هذا الإطلاق من أخطاء وكذلك الذي يقول إن العمل شرط كمال فإنه يدخل في العمل شهادة أن لا إله إلا الله والأركان الخمسة فهل يقال أن هذه الأعمال أنها شرط كمال وأنها ليست من الإيمان هذا غير صحيح ولهذا نقول أن العمل من الإيمان فإذا قيل ما حكم ترك العمل ؟قلنا سم لنا العمل ونبيّن لك حكمه فإن سمى شعبة مستحبة قلنا هذه شعب مستحبة لا تنقص من الكمال الواجب ،وإن سمّى لنا شعبة من الشعب التي هي بعد الأركان الخمسة قلنا هذه إذا كان معتقداً لوجوب الواجبات وتحريم المحرمات ولم يمتثل فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وإذا سمى لنا الأركان الأربعة بعد الشهادتين قلنا أن هذه المسائل مختَلف فيها بين أهل السنة بعد اعتقاد وجوبها وليس لنا أن نتهم من لم يكفّر بهذه المباني الأربعة بأنه مرجئ أو من كفر بها بأنه من الخوارج ،بل هذه أقوال أهل السنّة . وأما إذا ترك الشهادتين فنقول هذا كافر بإجماع الأمة هذا هو العدل والإنصاف وتنزيل الأحكام على منازلها التي دلت عليها النصوص لا نترك الحكم العمل يتفاوت والشعب متفاوتة فلا نقول أنه شرط صحة ولا نقو ل أنه شرط كمال وإنما نقول العمل من الإيمان هذه هي الإجابة التي دلت عليها النصوص والتي من سمعها من أهل العلم فإنه لا يخالف فيها وهذه الإجابة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة لا نزاع فيها ومن نازع فيه فإنما ينازع لعدم فهمه لموقف أهل السنة ولعقيدتهم من هذه المسألة. وأما المسألة الثانية وهي قول من يقول ما حكم ترك جنس العمل فهل ترك جنس العمل يذهب بأصل الإيمان أم أنه يبقى معه الأصل ؟ نقول هذا أيضا من الألفاظ المجملة لأنه ما المقصود بجنس العمل هل المقصود عمل القلوب أو عمل اللسان أو عمل الجوارح ؟فإذا قيل إنه عمل القلوب فالاتفاق أن من ترك شيء من الاعتقاد فإنه يكفر ومن ترك شعبة الشهادتين من أعمال اللسان فإنه يكفر وأما من ترك الشعب العملية والتي تبدأ بالصلاة إلى إماطة الأذى عن الطريق فهذه كما تقدم عل قسمين الأركان الأربعة مختلف بين أهل السنة بأنه إذا تركها فهل يكفر أو لا يكفر؟هناك خمسة أقوال في هذه المسألة منهم من يكفر بترك احد هذه المباني الأربعة ومنهم من لا يكفر بترك هذه المباني الأربعة ومنهم من يكفر بترك الصلاة فقط ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتلا الإمام عليها فهذه أقوال أهل السنة وهي خمس روايات عن الإمام احمد وقد نقل الخلاف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن رجب رحمهما الله وذكر أن هذه أقوال أهل السنة . فنقول الآن لمن قال بترك جنس العمل نقول :أن تارك جنس العمل إذا تلفظ بالشهادتين فإنا لا نحتاج أن نبحث في جنس العمل وإنما نبحث في أركان الإسلام الأركان الأربعة بعد الشهادتين فإذا كان الرجل من أهل السنة يعتقد تكفيره بأحد هذه المباني الأربعة فإنه لا يحتاج بعد ذلك أن يبحث في الذنوب الأخرى التي بعد الأركان الأربعة وأما إذا كان الرجل يعتقد أنه لا يكفر بترك هذه المباني الأربعة كما هو القول لبعض أهل السنة فإنه لا يمكن أن يكفره لما بعده فإذاً نلاحظ أن هذه المسألة مسألة تكلّف ويقال جنس العمل فأول ما يبحث عن الأركان أركان الإسلام فإذا ترك الشهادتين فهو كافر بالإجماع إذا ترك المباني الأربعة هو محل اختلاف بين أهل السنة لكن محصل هذه الأقوال أن منهم من يكفره بهذه المباني الأربعة أو ببعضها ومنهم من لا يكفره فإذاً نحن لا نحتاج بعد ذلك في أن نبحث في مسألة جنس العمل وهو تَرَكَ العمل بالكلية وإنما نقول للرجل ما الذي تعتقد فيمن ترك الصلاة أو الزكاة؟فإذا قال هو كافر قلنا لا يحتاج بعد ذلك هل هو بار بوالديه أو عاق هل هو آمر بالمعروف أو منكر لأنه عمله حابط إذا حكمنا له بالكفر وإذا حكمنا له بالإسلام فإنه لا يمكن أن نكفره فيما بعد المباني الأربعة،بل إني أن أقول كلمة وينبغي لطلاب العلم أن يبحثوا عنها ويتأكدوا من حقيقتها انه ما قال احد من أهل السنة أن رجلاً قال بترك الصلاة وكفره بغيرها من الأعمال،يعني ما قال احد من أهل السنة أن الرجل إذا ترك الصلاة لا يكفر ثم يكفّره مثلا بترك الزكاة أو الصوم أو الحج أو سائر الأعمال،فإذاً رجعنا أيضاً إلى مسألة الصلاة فإذا كنا نكفره بترك الصلاة فلا حاجة للبحث بعد ذلك في عمله وإذا كنا لا نكفره بترك الصلاة فما الحاجة أن نبحث فيما بعد الصلاة . ثم إن مسألة ترك العمل مسألة متصورة في الذهن ولا حقيقة لها في الواقع فإنه لا يتصور أن رجلاً يعني يعيش الدهر ولا يعمل بشيء ،بل إن الإنسان لو تكلّف هذا ما استطاع لو لم يكن له إلا أنه يعمل وينفق على أسرته وعلى أهله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم:" وفي بضع أحدكم صدقة "إذا أتى أهله له صدقة إذا مشى في الطريق ويريد كسباً أو يريد أن يحقق مصلحة لأهله فإنه يؤجر على ذلك فكيف يقال أن مسألة ترك جنس العمل أنه متصور؟! فينبغي لطلاب العلم أن يعيدوا المسائل إلى أصولها وأن يرفعوا النزاع الذي يحصل بسبب هذه الألفاظ المجلة والتي تفرِّق أهل السنة وهم على عقيدة واحدة لا يختلفون فيها فكلهم مجمعون بحمد الله على رد قول المرجئة وقول من يقول إن العمل ليس من الإيمان وكلهم متفقون على در قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ،وأما ما بعد ذلك من الألفاظ المجملة فينبغي أن تعاد إلى أصولها وإلى مصادرها وأن يُعدَل في الأقوال وأن يتجنب المتكلم الألفاظ المجملة التي يحصل بسببها التنازع ،وكم حصل من التنازع قديماً وحديثاً بسبب هذه الألفاظ المجملة التي تطلق وتكون محتملة للحق والصواب فعند ذلك يتنازع الناس فيها . ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان وهي مرتبة عظيمة فوق مرتبة الإيمان وهي أعلى المراتب وهي كما قال المصنِّف هنا ركن واحد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما فسره قال "أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ويلاحظ هنا أن هذا الركن وهو ركن الإحسان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عملاً كما ذكر في أركان الإسلام وأركان الإيمان وإنما ذكر صفة لتأدية العمل ويكون معنى الإحسان هو أن يحقق الرجل أركان الإسلام وأركان الإيمان وسائر الطاعات على هذا الوجه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه ،أن يراقب الله عزوجل في عبادته كأنه يرى الله عزوجل ولا شك أن من عبد الله بهذه المرتبة فلا بدّ أن يحسّن العمل فإن مشاهدة العبد لهذا الباب العظيم ولهذا المقام مما يقو ي الإخلاص في قلبه ومما يعينه على تحقيق العبادة على الوجه الأكمل،قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك ولهذا قيل أن الإحسان هو ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه ومما يعين على تحقيق هذه المرتبة أن تعلم انه يراك وقيل إن الإحسان يشتمل على ركنين الركن الأول :أن تعبد الله كأنك تراه. والركن الثاني: أن تعبد الله وتعلم أنه يراك . فتكون هذه مرتبة ثانية أو ركن ثاني للإحسان والذي ذكره هنا المصنف رحمه الله أن الإحسان ركن واحد وهذا قول لبعض أهل السنة ،والآخر أيضاً قول كما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله . والإحسان في العمل هو تحسينه مأخوذ من الحسن وأن الأشياء فيها حسن وأحسن والإحسان هو أن يؤدي العبادة على الوجه الأحسن والإحسان قد يكون في نوع من أنواع العبادة وقد يكون في سائر الشعب فهذا هو المحسن المطلق الذي هو أعلى المؤمنين درجة وهو المحسن الذي بلغ درجة الإحسان في كل المراتب ومنهم من يحسن في شيء دون شيء فإحسانه على قدر ما أحسن في من العمل . [المتن] قال رحمه الله تعالى:والدليل قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) (النحل:128) [الشرح] هذا دليل الإحسان وهو قول الله عزوجل:" (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ)وهذا دليل على فضل هذه المرتبة حيث أن الله عزوجل أخبر انه مع هؤلاء ومعية الله عزوجل المذكورة هنا هي المعية الخاصة وهي المعية التي تقتضي النصر والتأييد فإن المعية المضافة لله عزوجل على نوعين وهي معية عامة وهي التي تستلزم العلم وهي معية الله عزوجل لكل خلقه كما قال الله عزوجل:"وهو معكم أينما كنتم "وهذه تقتضي المجازاة والإحاطة والقدرة على العباد والإطلاع عليهم والمعية الخاصة التي تلتزم النصر والتأييد وهي المذكورة هنا في أن الله عزوجل مع هؤلاء الذين اتقوا والذين هم محسنون الذين اتقوا الله عزوجل وحققوا الأعمال المشروعة وتجنبوا الأعمال المحرمة على وجه الإحسان ولهذا ذكر التقوى هنا مع الإحسان مبيناً أن الإحسان يكون بتقوى الله عزوجل على هذه المرتبة وهي أن يكون متقياً محسنا أن يتقي على وجه الإحسان وأن يحسّن عمله . [المتن] قال رحمه الله تعالى : وقوله تعالى (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (الشعراء:217-220) [الشرح] قوله (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ) هذا أمر بالتوكل على الله عزوجل، والعزيز من أسماء الله وهو متضمن لصفة العزة وهي صفة ذاتية والرحيم متعلق وهو اسم من أسماء الله عزوجل وهو متضمن لصفة الرحمة، وهي من صفات الله عزوجل الثابتة له وقيل إن الرحيم مشتق من الرحمة التي هي مختصة بالمؤمنين والرحمن مشتق من الرحمة التي هي عامة لعموم الخلق. والرحمة من الله عزوجل تكون متعلقة بمشيئته إذا كانت متعلقة بالعبد أنه يرحم من يشاء ويعذب من يشاء فمتى ما قام مقتضى الرحمة فإن الله يرحم ومتى ما اقتضى مقام العقوبة فإن الله يعاقب ،ولكن الله عزوجل أخبر أن رحمته تغلب غضبه ، وهذا من رحمته عزوجل ومن لطفه بعباده ورحمته متعلقة بمشيئته وغضبه متعلق بمشيئته ،قال الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ قيل يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم حين قيامه وجلوسه وقيل حين قيامه في الصلاة عندما يقوم في الصلاة وقيل حين تقوم يعني تقوم منفرداً في الصلاة . "وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ" قيل عندما تصلي مع الجماعة أي أنك تكون مع الساجدين وقيل تقلبك في الساجدين يعني تقلّب بصرك بالنظر إليهم قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه ويكون تقلّبه في الساجدين بالنظر إليهم وقيل معنى تقلبك في الساجدين أي تقلبك في أصلاب آباءك من صلب رجل إلى آخر من هذا النسب الشريف الذي جعل الله عزوجل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهم بأنهم ساجدين لأنهم من الذين اصطفاهم الله عزوجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسماعيل ولا يزال يتقلّب في أصلاب الرجال الذين شرفهم الله عزوجل بغير مراتب ولكن هذا لا يلزم أن يكون كل من كان من آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم أنه يكون مؤمناً ولكن هذا بحكم الغالب أنه من ذرية صالحة مباركة وأن الله عزوجل اصطفاه منهم ولكن هذا لا يلزم أن كل ما يكون بينه وبين إبراهيم عليه السلام أنه يكون على التوحيد وقد يكون في بعض فترات لم تبلغ بعضها وأمرهم إلى الله عزوجل . ثم قال:" إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" هو من أسماء الله عزوجل وهو متضمن صفة السمع والعليم من أسماء الله عزوجل وهو متضمن لصفة العلم لله عزوجل وكل اسم متضمن لصفة . [المتن] قال رحمه الله تعالى : وقوله تعالى (وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ )(يونس: من الآية61). [الشرح] وهذا أيضا الدليل على الإحسان لأنه في الآيات السابقة فيها مراقبة الله عزوجل وأنه يراه وهذا مما يعين على تحقيق مرتبة الإحسان وكذلك هنا في قوله:{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا}أي أنه مطلع عليهم وهذا مما يعين على المراقبة وعلى تحقيق مرتبة الإحسان إذ تفيضون فيه تتكلمون فيه وتدخلون فيه أي في كل ما تتكلمون به أو ما تدخلون فيه من الأعمال فإن الله عزوجل مطلع عليكم . [المتن] قال رحمه الله تعالى : والدليل من السنة حديث جبرئيل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلي ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره " قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال " أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " قال فأخبرني عن الساعة قال " ما المسؤول عنها بأعلم من السائل " قال فأخبرني عن أمارتها قال " أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان " قال فمضى فلبثنا مليا فقال " يا عمر أتدري من السائل " قلت الله ورسوله أعلم قال " هذا جبرئيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم " . [الشرح] هذا الحديث العظيم وهو حديث جبريل من أقوى الأدلة وتقدم شرحه في الأربعين النووية وهو حديث عظيم قد اشتمل على فوائد عظيمة وعلى هذه المراتب ؛مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان واشتمل على فوائد عظيمة حتى إنه لو جمعت في هذه الفوائد يعني رسالة متوسطة لاستوعبها من كثرة فوائدها لما اشتمل عليه من الفوائد العظيمة وكذلك هذا السياق العظيم الذي ذكره عمر رضي الله عنه ووصف به مجيء جبريل وذكر الوصف الذي أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فوائد سبق أن نبهنا عليه ولا نريد الإطالة ولكن ننبه على بعضها منها قول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وأنه لم يكن له حجّاب وأنهم كانوا يجلسون عنده جلوس الناس مع من يتواضع لهم والصاحب مع أصحابه ،إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وهذا صفة لجبريل عليه السلام ولكنه لم يقل إنه جبريل ويلاحظ هنا من فقه عمر رضي الله عنه أنه تدّرج في رواية هذا الحديث وفي إخباره عن خبر جبريل كما حصل لهم ،فلم يقل جاءنا جبريل في صورة كذا وإنما قال جاءنا رجل وهذا ليكون التدّرج الذي يحصل للمتعلمين كما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وهذا من فقهه رضي الله عنه، قال شديد بياض الثياب هذا يؤخذ منها أدب طلب العلم لأن جبريل جاء هنا بصفة السائل وأن يكون على هيئة حسنة خصوصاً إذا ما كان المكان مكان مجتمع ناس فإن أخذ المظهر الحسن مما يعني يستحسن به الجلوس مع الإنسان ولا تحصل منه نفرة، ولا شك أن أخذ الهيئة الحسنة التي هي متوسطة بين الغلو في ذلك والمبالغة وبين عدم العناية في ذلك أنه من السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة حسنة، ما كان مغالياً وما كان أيضاً متكلفاً في عدم لبس الملابس التي تليق به ، شديد سواد الشعر أيضاً فيه فائدة لطيفة وأن طلب العلم يكون في مرحلة الشباب لأنه جاء في صورة شاب شديد سواد الشعر وأنه ليس بشيخ، وأيضاً فيه الهيئة الحسنة وأن مثل أن تكون له عناية بشعره وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرجّل شعره ويعتني به ،لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذه فيها غرابة من جهتين من جهة هذا المظهر الذي لا يرى عليه أثر السفر فلا بد أن يكون من أهل الإقامة بالمدينة ثم جاء الأمر الآخر الذي يمنع من هذا وهو أنه لا يعرفه منا أحد فليس هو من أهل المدينة فيعرف وليس هو من المسافرين فيرى عليه أثر السفر فأمره غريب وهذا من التشويق لمعرفة ما جاء في هذا الحديث حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الدنو من العالم والسؤال ليكون هذا أوعى وابلغ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه اختلف في هذا هل المقصود أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا واضح ثم قال وضع كفيه على فخذيه واختُلف في هذا هل المقصود أنه وضع يديه على فخذي نفسه أو فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات وقال بعض الشرّاح إنما فعل ذلك للتعمية،لأن هذا ليس مما يكون من أهل الهيئة الذي يحسنون الخطاب وإنما جاء ليكون في هذا تعمية للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على السائلين وعلى المتعلمين وإنما يكون من جبريل عليه السلام إنما جاء للتعليم ولبيان ما يكون عليه المتعلم من شدة الحرص أو انه كما قال بعض الشرّاح أنه يكون للتعمية حتى لا يُعرَف ثم سأله هذه الأسئلة قال يا محمد وخاطبه باسمه عليه الصلاة والسلام لأن هذا كان شأن الأعراب الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد ويسألونه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يجيبهم وإلا فالمقام أن يخاطب بمقام الرسالة ولكن جبريل هنا أتى بصورة رجل أعرابي ليس من أهل المدينة ثم سأله عن الإسلام فأخبره بهذه الأركان فقال له:صدقت قال:فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن الأصل في السائل أنه لا يعلم وإنما يعلم بعد الإجابة ،فهنا أمره عجيب أنه يسأل ويصدّق ثم قال فأخبرني عن الإيمان فذكر أركان الإيمان المتقدمة ثم قال له صدقت ، فلم يعلّق عمر لأنه سبق أن نبّه على هذا قال فأخبرني عن الإحسان قا ل:أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ولم يقل صدقت لانه سبق ان تقرر هذا عند من يسمعه قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه عند السؤال وقيل انه عرفه وقال له كما أنك لا تعلمها فأنا لا أعلمها وهذا من حسن الجواب في جواب من يُقطَع له بشيء أنه لا يعلمه يقال ما المسؤول عنه بأعلم من السائل حتى يَقنَع بذلك وأنه إن كان عندك علم فهو عندي. قال فأخبرني عن إماراتها -أي علاماتها -قال أن تلد الأمة ربتها ،أن تلد الأمة المملوكة ربتها وهذا قيل أن الأمة تكون عند السيّد فيدخل بها فينجب منها فيكون ولدها هو ابن لسيدها وهو سيد لها وتكون بهذا المعنى أن الأمة ولدت ربتها أي سيدتها ابنتها ،وهي سواءً كانت بنت أو كان ذكر فإن إذا ولدت يكون الولد للسيد كما هو معلوم من أن السيد دخل بأمته فأبناؤها هم أبناء له وتسمى أم ولده،وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني أن ترى هؤلاء الحفاة الذين لا ينتعلون العراة الذين ليس لهم ما يكتسون به ،العالة الفقراء،رعاء الشاء الذين ليسوا من أهل الأمصار يتطاولون في البنيان أي أنهم يقطنون الأمصار ويتطاولون في البنيان وهذا فيه بيان تغيّر الزمان وبالمناسبة فإن الملاحظ في عامة أشراط الساعة أن فيها تغيّر وفيها تغيّر للسنن للسنن الكونية أو الشرعية، ومنها أن تلد الأمة ربتها وأن تطلب الدنيا بأعمال الآخرة وأن تزخرف المساجد والمصاحف وأن يعقّ الرجل أباه وأمه ويبر صديقه ، وأنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع وإلى غيرها من الأمور العظيمة التي تدل على انه تغيّر في السنن الكونية والشرعية وهذا دليل على قرب فساد العالم وأنه إذا كثر الخبث والفساد فهذا دليل إيذان خراب الكون وهذا من حكمة الله عزوجل أنه متى ما وصل الخلل إلى حد معين فإن هذا دليل على نهاية الأمر وهذا في كل شيء يعني الظلم الآن إذا حصل من الشخص لا يزال يحصل حتى يصل إلى حد معين فيكون هذا دليل على أن الله عزوجل سيقسم هذا الظالم وكذلك في كل ما يحصل حتى في البدن العلماء يقولون أن الأمراض التي تحصل في البدن فإنه لا تزال الروح في البدن حتى إذا كثرت العلل والأمراض لم يبقى للروح مكان في هذا البدن فتخرج ويكون هذا الموت كذلك العالم إذا كثر الفساد وتغير السنن وتغير الأحوال فإن هذا يكون دليل على فساد العالم وإيذان له عزوجل في قيام الساعة. قال: فمضى فلبثنا ملياً يعني فترة من الزمن، والملي هو الوقت الطويل قيل ثلاثة أيام قال فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يقال في الأمور الله اعلم إلا ما كان يتعلق بالشرع فيقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم به وأما ما يتعلق الآن بالأمور الغيبية أو عندما يأتينا شخص ويقال هل تعرفون هذا لا نقول الله ورسوله أعلم وإنما نقول الله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يحصل بل حياته الذي بما اطلعه الله عزوجل عليه. قال هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وهذا فيه بيان لأن هذا السائل هو جبريل وأنه جاء يعلّم هذه الأمة أمر دينها ولهذا قال العلماء :من أراد أن يتعلم الدين فليتعلم حديث جبريل ومن أراد أن يُعلّم فليبني تعليمه على هذا الحديث العظيم "لأن جبريل وهو خير معلّم جاء في صورة المتعلم سأل عن هذه المسائل وهذا الحديث له منزلة أنه بلغ الأمة برواية الرسولين الملكي والإنس وهما جبريل ونبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا له منزلة عظيمة وهو من حديث الأفراد في هذا الباب ليس له نظير فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ،ثم جبريل يصدِّق النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا الحديث المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا السياق العظيم ، وتدّرج فيمن يروي لهم الحديث كما حصل لهم التدرج في العلم وهذا من فقهه رضي الله عنه حتى أن آخر الحديث أخبرنا بما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وهذا دليل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ليسوا نقلة فقط وإنما هم فقهاء سادة يعرفون ما يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اعتنوا بنقل السنة ونبهوا على معانيها رضي الله عنهم . فنسأل الله التوفيق للجميع
هذا والله أعلم.
__________________
يقول الله - تعالى - : {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون} [سورة الأعراف :96]. قال العلامة السعدي - رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية الكريمة : [... {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا} بقلوبهم إيمانًاً صادقاً صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله - تعالى - ظاهرًا وباطنًا بترك جميع ما حرَّم الله؛ لفتح عليهم بركات من السماء والارض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيشٍ وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب، ولا كدٍّ ولا نصب ... ] اهـ. |
 |
|
|
 |
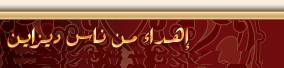 |