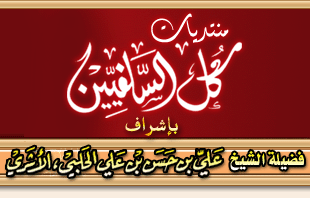

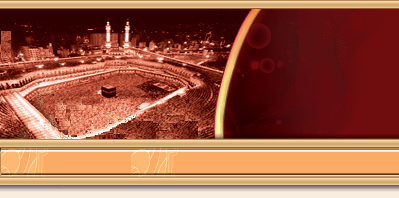
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
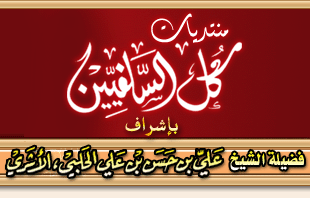 |
 |
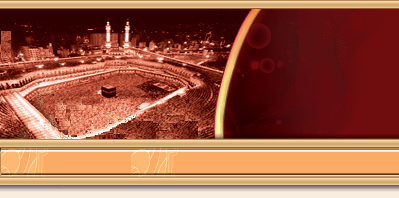 |
|||||
|
|||||||
| 57788 | 74378 |
|
|||||||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
الأصول العلمية لمذهب أهل المدينة ومنزلة الإمام مالك عند ابن تيمية الحلقة الثانية ((والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق، وإما منازع، فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم، لهم مبجل، لهم عارف بمقدارهم.وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم، وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة.)) (( قول أهل المدينة إمّا حجة قاطعة،أو حجة قوية،أو مرجح للدليل)) سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: عن صحة أصول مذهب أهل المدينة، ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة، وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار، وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار ؟ فأجاب ـ رضي الله عنه ـ: بيان فضل علماء المدينة ومنزلتهم: الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية - دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ فيها سنّ الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم - مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا، في الأصول والفروع. وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه: (خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)[ رواه الإمام مسلم في" فضائل الصحابة"{215/2535}، وابن حبان{6692}].]، فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع، وفي بعض الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه، وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه فتكون أربعة. وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح، أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (خير أمتي القرن الذين يلونني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته)[ رواه البخاري في"فضائل أصحاب النبي"{3651}،ومسلم في "فضائل الصحابة"{160/2533}.]، وفي صحيح مسلم عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: (سأل رجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي بعثت فيهم، ثم الثاني، ثم الثالث)[ مسلم في"فضائل الصحابة"{2536/216}.]. وأما الشك في الرابع، ففي الصحيحين عن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن"[ البخاري في" فضائل أصحاب النبي"{3650}، ومسلم في" فضائل الصحابة"{2535/214}.]. وفي لفظ: "خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" الحديث، وقال فيه: ويحلفون ولا يستحلفون)[ مسلم في"فضائل الصحابة"{2535/213}.]. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: (خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم" - والله أعلم: أذكر الثالث أم لا؟ -" ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا)[ مسلم في" فضائل الصحابة"{2534/213}.]. وقوله في هذه الأحاديث: " يشهدون قبل أن يستشهدوا " قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما، جمعا بين هذا وبين قوله: (ألا أنبئكم بخير الشهداء: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) [ مسلم في" الأقضية"{1819/19}،و أبو داود في" الأقضية"{3596}، و الترمذي في" الشهادات"{2295}،و احمد{115/4}.] وحملوا الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرفه بها. والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ثم يفشو فيهم الكذب، حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة، وبترك الوفاء بالنذر، وهذه الخصال الثلاثة هي آية المنافق، كما ثبت في الحديث المتفق عليه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان"[ البخاري في" الإيمان"{33}، ومسلم في" الإيمان"{108/59}.]، وفي لفظ لمسلم: "وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)[مسلم في"الإيمان"{109/59}.] فذمهم صلى الله تعالى عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق، وبين أنهم يسارعون إلى الكذب، حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك، فإنه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب. وأما ما فيه ذكر القرن الرابع، فمثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس، فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم"، ولفظ البخاري:" ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس)[ البخاري في " فضائل أصحاب النبي"{3649}، ومسلم في" فضائل الصحابة"{2532/208}،و احمد{7/3}.]، ولذلك: قال صلى الله تعالى عليه وسلم في الثانية والثالثة، وقال فيها كلها:" صحب"، ولم يقل رأى. ولمسلم من رواية أخرى: (يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقولون: انظروا هل ترون فيكم من رأى من رأى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به)[مسلم في" فضائل الصحابة"{2532/209}.] . وحديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين: على أن صاحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره. وقال مالك: من صحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال: صحبه شهرا، وساعة. وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا. وفي الطريق الثاني لمسلم ذكر أربعة قرون، ومن أثبت هذه الزيادة قال: هذه من ثقة، وترك ذكرها في بقية الأحاديث لا ينفي وجودها، كما أنه لما شك في حديث أبي هريرة أذكر الثالث؟ لم يقدح في سائر الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها القرن الثالث، ومن أنكرها قال في حديث ابن مسعود الصحيح: أخبر أنه بعد القرون الثلاثة يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته، فيكون ما بعد الثلاثة ذكر بذم، وقد يقال: لا منافاة بين الخبرين، فإنه قد يظهر الكذب في القرن الرابع. ومع هذا فيكون فيه من يفتح به لاتصال الرؤية . وفى القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وأن افتقار العلماء ومقاصد العباد، أكثر من افتقار أهل المدينة، حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله، بما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد. ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة، ولا الشام ،ولا العراق، ولا غير ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكى عن أبي حنيفة، أو أحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعها على كل مسلم، فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه في ذلك، وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك. والكلام، إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لاسيما من حين ظهر فيها الرّفض، فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم، منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المائة السادسة، أو قبل ذلك، أو بعد ذلك، فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان[قاشان: مدينة بإيران قرب أصبهان،{معجم البلدان296/4}.]، وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم، لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالاً كثيرة، فكثرت البدعة فيها من حينئذ. فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة، كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان، والعراقان، والشام، منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة، وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية. فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها. والبصرة خرج منها القدر، والاعتزال، والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها. والشام كان بها النصب والقدر. وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان، وهو شر البدع. وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية، وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية، حيث حرّقهم عليّ بالنار، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم ثمانين، والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره فهرب منه. ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر، وابن عباس؛ وجابر؛ وأمثالهم من الصحابة. وحدثت المرجئة قريباً من ذلك. وأما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين، بعد موت عمر بن عبد العزيز، وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: [يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ،ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً]، ثم نزل فذبحه. وقد روي أن ذلك بلغ الحسن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك، فكان عندهم مهاناً مذموماً؛ إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين، بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة، والاعتزال وبدع النساك بالبصرة، والنصب بالشام؛ فإنه كان ظاهراً. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (إن الدجال لا يدخلها)[ رواه مسلم في" الفتن"{2943/123}.] ،وفي الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد، ـ وهو رأس المعتزلة ـ مر بمن كان يناجي سفيان الثوري، ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا ؟ فقال: هذا سفيان الثوري أو قال: من أهل الكوفة، قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأيي، ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق[يقصد عندهم من العلم بالسنة و آثار الصحابة ما يردون به بدعته،فهم يأتونه بالسند من فوق ،أي:من أعلى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.]. ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك، وهم أهل القرن الرابع؛ حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته، كالثوري؛ والأوزاعي؛ والليث بن سعد؛ وحماد بن زيد؛ وحماد بن سلمة؛ وسفيان بن عيينة؛ وأمثالهم. وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين، وأولئك أخذوا عمن أدركوا من الصحابة. حجية إجماع أهل المدينة النبوية: والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة[ إجماع أهل المدينة]، أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين؛ ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين؛ ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم. وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب. مراتب إجماع أهل المدينة: الأولى : ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد؛ وكترك صدقة الخضراوات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء. أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسف ـ رحمه الله ـ، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة، وأول من لقب قاضي القضاة، لما اجتمع بمالك ،وسأله عن هذه المسائل، وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله، وقال:" لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت". فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة، كما هو حجة عند غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغه هذا النقل، كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه. وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل، كرجوعه إلى أحاديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد[هو محمد بن الحسن الشيباني أحد الأعمدة الثالثة في مذهب أبي حنيفة النعمان ـ رحمهم الله أجمعين ـ ،هو أحد رواة "موطأ" الإمام مالك ، ذهب إلى المدينة فسمعه من الإمام مالك ورجع إلى العراق ، فكان أكثر أئمة الحنفية علما بالسنة و الآثار، يقال أنه خالف مذهب إمامه في ثلثيه ، وذلك لاجتهاده و تتبعه الأدلة ، وعدم تعصبه] ، وتركا قول شيخهما؛ لعلمهما بأن شيخهما كان يقول:" إن هذه الأحاديث أيضاً حجة إن صحت لكن لم تبلغه". ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى، فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس؛ لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما. وقد بينا هذا في رسالة "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"[ قال شيخ الإسلام في هذه الرسالة المباركة ، وهي ضمن " المجموع"{129/20}:"يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن،خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر و البحر،و قد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم؛إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول في أمته، و المحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب و به قاموا، و بهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم،في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل احد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه. و جميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها: عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه و سلم قاله . الثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة: السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، و إذا لم يكن قد بلغه،وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، أو بموجب قياس، أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة و يخالفه أخرى، و هذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم لم تكن لأحد من الأمة. ]، وبينا أن أحداً من أئمة الإسلام لا يخالف حديثاً صحيحاً بغير عذر؛ بل لهم نحو من عشرين عذراً، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث؛ أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم؛ أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عارضه ما هو أقوى منه كالناسخ؛ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيباً، فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئاً بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطؤه مغفور له ;: لقوله تعالى:{ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة ]، وقد ثبت في الصحيح أن الله استجاب هذا الدعاء وقال: ( قد فعلت)[ مسلم في" الإيمان{126/200}.]، ولأن العلماء ورثة الأنبياء. وقد ذكر الله عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما؛ ولم يعب الآخر؛ بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما فقال:{ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} [الأنبياء ]، وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء: مسألة نفش الدواب في الحرث بالليل، وهو مضمون عند جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد. وأبو حنيفة لم يجعله مضموناً. والثاني: ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك يقتضي الضمان بالمثل، إذا أمكن كما قضى به سليمان، وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة، كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. والمقصود هنا: أن عمل أهل المدينة الذي يجري مجرى النقل، حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف - لما سأله عن الصاع والمد، وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم، وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم:" أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون ؟ قال: لا والله ما يكذبون، فأنا حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال وثلث بأرطالكم يا أهل العراق. فقال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت". وسأله عن صدقة الخضراوات، فقال: "هذه مباقيل أهل المدينة، لم يؤخذ منها صدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر، ولا عمر ـ رضي الله عنهما" ـ، يعني: وهي تنبت فيها الخضراوات. وسأله عن الأحباس فقال:" هذا حبس فلان، وهذا حبس فلان"، يذكر لبيان الصحابة، فقال أبو يوسف في كل منهما:" قد رجعت يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت". وأبو يوسف ومحمد وافقا بقية الفقهاء في أنه ليس في الخضراوات صدقة، كمذهب مالك والشافعي وأحمد، وفي أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، كمذهب هؤلاء، وأن الوقف عنده لازم كمذهب هؤلاء. وإنما قال مالك: "أرطالكم يا أهل العراق"؛ لأنه لما انقرضت الدولة الأموية، وجاءت دولة ولد العباس قريباً؛ فقام أخوه أبو جعفر الملقب بالمنصور، فبنى بغداد فجعلها دار ملكه، وكان أبو جعفر يعلم أن أهل الحجاز حينئذ كانوا أعنى بدين الإسلام من أهل العراق، ويروى أنه قال ذلك لمالك أو غيره من علماء المدينة، قال: نظرت في هذا الأمر فوجدت أهل العراق أهل كذب وتدليس؛ أو نحو ذلك، ووجدت أهل الشام إنما هم أهل غزو وجهاد، ووجدت هذا الأمر فيكم. ويقال: أنه قال لمالك: أنت أعلم أهل الحجاز؛ أو كما قال. فطلب أبو جعفر علماء الحجاز أن يذهبوا إلى العراق وينشروا العلم فيه، فقدم عليهم هشام بن عروة؛ ومحمد بن إسحاق؛ ويحيى بن سعيد الأنصاري؛ وربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي؛ وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون؛ وغير هؤلاء. وكان أبو يوسف يختلف في مجالس هؤلاء، ويتعلم منهم الحديث، وأكثر عمن قدم من الحجاز؛ ولهذا يقال في أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف أعلمهم بالحديث؛ وزفر أطردهم للقياس، والحسن بن زياد اللؤلؤي أكثرهم تفريعاً، ومحمد أعلمهم بالعربية والحساب؛ وربما قيل أكثرهم تفريعاً، فلما صارت العراق دار الملك، واحتاج الناس إلى تعريف أهلها بالسّنّة والشريعة، غيّر المكيال الشرعي برطل أهل العراق، وكان رطلهم بالحنطة الثقيلة والعدس إذ ذاك تسعين مثقالاً: مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع الدرهم. فهذا هو المرتبة الأولى لإجماع أهل المدينة وهو حجة باتفاق المسلمين. المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك، وهو المنصوص عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد الأعلى: [إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا تتوقف في قلبك ريبًا أنه الحق]، وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعها، وقال أحمد: كل بيعة كانت في المدينة فهي خلافة نبوة، ومعلوم أن بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كانت بالمدينة، وكذلك بيعة عليّ كانت بالمدينة ثم خرج منها، وبعد ذلك لم يعقد بالمدينة بيعة. وقد ثبت في الحديث الصحيح، حديث العرباض بن سارية، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة)[ أبو داود في" السنة"{46.7}،والترمذي في" العلم"{2676}،وقال:" حسن صحيح".]. وفى السنن من حديث سفينة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:( خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يصير ملكاً عضوضاً)[ أبو داود في" السنة"{46.7}،والترمذي في" العلم"{2676}،وقال:" حسن صحيح".]. فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة، وما يعلم لأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدون مخالف لسنة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. والمرتبة الثالثة : إذا تعارض في مسألة دليلان، كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يرجح بعمل أهل المدينة، ولأصحاب أحمد وجهان: أحدهما: وهو قول القاضي أبي يعلى، وابن عقيل: أنه لا يرجح. والثاني: وهو قول أبي الخطاب، وغيره: أنه يرجح به، قيل: هذا هو المنصوص عن أحمد، ومن كلامه قال: إذا رأى أهل المدينة حديثاً وعملوا به فهو الغاية، وكان يفتي على مذهب أهل المدينة، ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريراً كثيراً، وكان يدل المستفتي على مذاهب أهل الحديث، ومذهب أهل المدينة، ويدل المستفتي على إسحق؛ وأبي عبيد؛ وأبي ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث، ويدله على حلقة المدنيين: حلقه أبي مصعب الزهري ونحوه، وأبو مصعب هو آخر من مات من رواة الموطأ عن مالك، مات بعد أحمد بسنة، سنة اثنين وأربعين ومائتين، وكان أحمد يكره أن يرد على أهل المدينة، كما يرد على أهل الرأي، ويقول إنهم اتبعوا الآثار. فهذه مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة. وأما المرتبة الرابعة : فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا ؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا مذهب الشافعي؛ وأحمد؛ وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك الفاضل عبد الوهاب في كتابه "أصول الفقه" وغيره، ذكر أن هذا ليس إجماعاً ولا حجة عند المحققين من أصحاب مالك، وربما جعله حجة بعض أهل المغرب من أصحابه، وليس معه للأئمة نص ولا دليل، بل هم أهل تقليد. قلت: ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، وهو في الموطأ إنما يذكر الأصل المجمع عليه عندهم، فهو يحكي مذهبهم، وتارة يقول: الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا يصير إلى الإجماع القديم، وتارة لا يذكر. ولو كان مالك يعتقد أن العمل المتأخر حجة يجب على جميع الأمة اتباعها وإن خالفت النصوص، لوجب عليه أن يلزم الناس بذلك حد الإمكان، كما يجب عليه أن يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثابتة التي لا تعارض فيها وبالإجماع، وقد عرض عليه الرشيد أو غيره أن يحمل الناس على موطأه فامتنع من ذلك، وقال: [إن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وإنما جمعت علم أهل بلدي] أو كما قال. قول أهل المدينة إمّا حجة قاطعة،أو حجة قوية،أو مرجح للدليل: وإذا تبين أن إجماع أهل المدينة تفاوت فيه مذاهب جمهور الأئمة، علم بذلك أن قولهم أصح أقوال أهل الأمصار رواية ورأياً، وأنه تارة يكون حجة قاطعة، وتارة حجة قوية، وتارة مرجحاً للدليل؛ إذ ليست هذه الخاصية لشيء من أمصار المسلمين. ومعلوم أن من كان بالمدينة من الصحابة هم خيار الصحابة، إذ لم يخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام بها من هو أفضل منه، فإنه لما فتح الشام والعراق وغيرهما أرسل عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إلى الأمصار من يعلمهم الكتاب والسنة، فذهب إلى العراق: عبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر، وعمران بن حصين، وسلمان الفارسي، وغيرهم. وذهب إلى الشام: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وبلال بن رباح، وأمثالهم. وبقي عنده مثل: عثمان، وعليّ، وعبد الرحمن بن عوف، ومثل: أبي بن كعب، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وغيرهم. وكان ابن مسعود، وهو أعلم من كان بالعراق من الصحابة إذ ذاك، يفتي بالفتيا، ثم يأتي المدينة، فيسأل علماء أهل المدينة، فيردونه عن قوله فيرجع إليهم، كما جرى في مسألة "أمهات النساء" لما ظن ابن مسعود أن الشرط فيها وفي الربيبة، وأنه إذا طلق امرأته قبل الدخول حلت أمها كما تحل ابنتها، فلما جاء إلى المدينة وسأل عن ذلك، أخبره علماء الصحابة أن الشرط في الربيبة دون الأمهات، فرجع إلى قولهم، وأمر الرجل بفراق امرأته بعد ما حملت. عمل أهل المدينة إمّا سنة أو فتوى كبار الصحابة: وكان أهل المدينة فيما يعملون: إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن الخطاب ويقال: إن مالكاً أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب؛ وسعيد بن المسيب عن عمر؛ وعمر محدّث. وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر)[ الترمذي في " المناقب"{3686}،وقال:" حديث حسن غريب".]، وفي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر ) [ البخاري في " فضائل أصحاب النبي"{3689}،ومسلم في" فضائل الصحابة"{2398/23}.] ،وفي السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )[ الترمذي في" المناقب"{3662}،وقال:"حسن"، وابن ماجة في"المقدمة"{97}.]. وكان عمر يشاور أكابر الصحابة، كعثمان، وعليّ، وطلحة، والزبير؛ وسعد، وعبد الرحمن؛ وهم أهل الشورى؛ ولهذا قال الشعبي: انظروا ما قضى به عمر؛ فإنه كان يشاور". ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء، أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه؛ رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشاور علياً وغيره من أهل الشورى، كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض إذا مات زوجها: هل ترث ؟ وأمثال ذلك. فلما قتل عثمان وحصلت الفتنة والفرقة، وانتقل عليّ إلى العراق، هو وطلحة والزبير، لم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء، ولكن كان بها من الصحابة مثل: سعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب؛ ومحمد بن مسلمة؛ وأمثالهم من هو أجل ممن مع عليّ من الصحابة. فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة عليّ وابن مسعود، وعليّ كان بالمدينة، إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود، وهو نائب عمر وعثمان، ومعلوم أن علياً مع هؤلاء أعظم علماً وفضلًا من جميع من معه من أهل العراق، ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه، محتجاً على المناظر بقول عليّ وابن مسعود، فصنف الشافعي كتاب "اختلاف عليّ وعبد الله" يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما. وجاء بعده محمد بن نصر المروزي، فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي، قال: إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. علماء السنة في سائر الأمصار تبع لعلماء المدينة: ومما يوضح الأمر في ذلك: أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدّون أنفسهم أكفاءهم في العلم، كأهل الشام ومصر، مثل: الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين ،ومثل :الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من المصريين، وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين. وكذلك علماء أهل البصرة، كأيوب، وحماد بن زيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأمثالهم. ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار، فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة، وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين، كابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وعبد الله بن الحكم. والشاميون مثل: الوليد بن مسلم، ومروان بن محمد، وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق، كعبد الرحمن بن مهدي، وحماد بن زيد، ومثل: إسماعيل بن إسحاق القاضي، وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك، وكانوا قضاة القضاة، وإسماعيل ونحوه كانوا من أجلّ علماء الإسلام. وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة، وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم، لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدًا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة، فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعًا، ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة. حل شبهة نزاع علماء الكوفة لعلماء المدينة: ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها، وقوي أمر أهل العراق لحصول علىّ فيها، لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم بعد الفرقة، قال عبيدة السلماني قاضي علىّ - رضي الله عنه -:" رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة". ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، الفتنة من هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان)[ البخاري في"الفتن"{7092}،ومسلمفي"الفتن"{2905/45}.]. وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه. بيان فضل علماء المدينة في علم الرواية وعلم الرأي: ومما يوضح الأمر في ذلك أن العلم: إما رواية وإما رأي، وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيًا. 1 ـ علم الرواية: صحة أسانيد أهل المدينة: وأما حديثهم فأصح الأحاديث وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة. وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإنه لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء ولم يكن فيهم - يعني أهل المدينة، ومكة والبصرة، والشام - من يعرف بالكذب لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب، لا سيما الشيعة، فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم؛ ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين، ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب، فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به، كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي، فقيل له [في] ذلك، فقال:" ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه" أو نحو هذا. وهذا القول هو القول القديم للشافعي؛ حتى روي أنه قيل له: إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به فقال: "إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا". ثم إن الشافعي رجع عن ذلك ،وقال لأحمد بن حنبل:" أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه، شاميًا كان أو بصريًا أو كوفيًا"، ولم يقل مكيًا أو مدنيًا؛ لأنه كان يحتج بهذا قبل. وأما علماء أهل الحديث كشعبة، ويحيى بن سعيد، وأصحاب الصحيح والسنن، فكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم، فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهم، وأن فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز، ولا يستريب عالم في مثل أصحاب عبد الله بن مسعود، كعلقمة، والأسود، وعبيدة السلماني، والحارث التيمي، وشريح القاضي، ثم مثل: إبراهيم النخعي، والحكم بن عتيبة، وأمثالهم من أوثق الناس وأحفظهم، فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل العلم بالحديث من أي مصر كان، وصنف أبو داود السجستاني" مفاريد أهل الأمصار" يذكر فيه ما انفرد أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. 2 ـ الفقه و الرأي: ما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين، ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية، وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعًا، كما فرع عثمان البستي وأمثاله بالبصرة، وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة، وصار في الناس من يقبل ذلك، وفيهم من يرد، وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة وأبي الزناد، والزهري، وابن عيينة وأمثالهم، فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردًا، فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد، وهم فوقهم فيما يحمدونه وبهذا يظهر الرجحان. وأما ما قال هشام بن عروة:" لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً حتى فشا فيهم المولدون: أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا". قال ابن عيينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من الرأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم، وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة، والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة. ولما قال مالك - رضي الله عنه - عن إحدى الدولتين: إنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان؛ لأن أولئك أولى بالخلافة نسبًا وقرنًا. وقد كان المنصور والمهدي والرشيد - وهم سادات خلفاء بني العباس - يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق، كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام، ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية كثرت الأحداث فيهم وضعفت الخلافة. ثم إن بغداد إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار، وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز، وسكنها من أفشى السّّنّة بها وأظهر حقائق الإسلام، مثل أحمد بن حنبل ،وأبي عبيد، وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث، ومن ذلك الزمان ظهرت بها السّنّة في الأصول والفروع،وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار، وانتشر أيضًا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب، فصار في المشرق مثل إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وأصحابه، وأصحاب عبد الله بن المبارك،وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليهم من علماء الحديث، فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. أما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب. وهذا باب يطول تتبعه، ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام. منزلة الإمام مالك عند العلماء: إذا تبين ذلك، فلا ريب عند أحد أن مالكًا - رضي الله عنه - أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم بذلك منه، كان له من المكانة عند أهل الإسلام - الخاص منهم والعام - ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام، وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا ألفا وسبعمائة أو نحوها، وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من ثلاثمائة سنة، فكيف بمن انقطعت أخبارهم، أو لم يتصل إليه خبرهم، فإن الخطيب توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة، وعصره وعصر ابن عبد البر، والبيهقي، والقاضي أبي يعلى، وأمثال هؤلاء واحد، ومالك توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وتوفي أبو حنيفة سنة خمسين ومائة، وتوفي الشافعي سنة أربع ومائتين، وتوفي أحمد بن حنبل سنة إحدى وأربعين ومائتين؛ ولهذا قال الشافعي - رحمه الله -:" ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابًا بعد كتاب الله من موطأ مالك". وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه، وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلمًا فإنه رجحه بجمعه ألفاظ أحاديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم، أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري، ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة، وإن كان قد يتفق لبعض ما انفرد به مسلم أن يرجع على بعض ما انفرد به البخاري، فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك، فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم. وإنما كان هذان الكتابان كذلك، لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين، ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك، ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أصح الكتب؛ لأنه أصح منقولاً عن المعصوم من الكتب المصنفة. وأما الموطأ ونحوه، فإنه صنّف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن وقال: (من كتب عني شيئًا غير القرآن فليمحه)[ مسلم في" الزهد"{3004/72}،والدارمي في"المقدمة"{119/1}، و احمد {12/3}.]، ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء، حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو وقال: "اكتبوا لأبي شاه"[ البخاري في" العلم"{112}،ومسلم في"الحج"{1355/447}،و أبو داود في" الحج"{2017}،والترمذي في"العلم"{2667}،وقال:" حديث حسن صحيح"،و أحمد{238/2}.]. وكتب لعمرو بن حزم كتابًا قالوا: وكان النهي أولًا خوفًا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضًا غيره. ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين، فصنف العلم، فأول من صنف ابن جريج شيئًا في التفسير، وشيئًا في الأموات. وصنف سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، ومعمر، وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن، فصنف مالك "الموطأ" على هذه الطريقة، وصنف بعد عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وغير هؤلاء، فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي - رحمه الله - فقال:" ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابًا من موطأ مالك"، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه، وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم؟ رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم. وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة)[ الترمذي في"العلم"{2680}،وقال:" هذا حديث حسن،وهو حديث ابن عيينة"،والنسائي في"الكبرى" في "الحج"{4291/1}.]. فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا:" هو مالك". والذين نازعوا في هذا لهم مأخذان: أحدهما: الطعن في الحديث، فزعم بعضهم أن فيه انقطاعًا. والثاني: أنه أراد غير مالك ،كالعمري الزاهد ونحوه. فيقال: ما دل عليه الحديث وأنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا، وبالتواتر لمن كان غائبا، فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك. وهذا يقرر بوجهين: أحدهما: بطلب تقديمه على مثل الثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي حنيفة، وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني: أن يقال: إن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم، فإنه توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك؛ فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر، وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين، ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك، لا قبله ولا بعده، رحل إليه من المشرق والمغرب، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء ،والزهاد، والملوك، والعامة، وانتشر موطؤه في الأرض، حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارًا من الموطأ، وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق، ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي، ومحمد بن الحسن، وأمثالهما، وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره، وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس، لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت. وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان: مالك، وابن عيينة. ومعلوم عند كل أحد أن مالكًا أجل من ابن عيينة، حتى إنه كان يقول:" إني ومالك كما قال القائل: وابن اللبون إذا ما لزّ في قرن ** لم يستطع صولة البزل القناعيس ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد، مع كونه كان رجلًا صالحًا زاهدًا، آمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه، ولا رحلوا إليه فيه؛ وكان إذا أراد أمرًا يستشير مالكًا ويستفتيه، كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة، فقال:" حتى أشاور مالكًا"، فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك، وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة، وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز - لما قيل له: ولِ القاسم بن محمد - أن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم، لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر، فكيف يقرن هذا بمالك في العلم ورحلة الناس إليه؟! ثم هذه كتب الصحيح التي أجلّ ما فيها كتاب البخاري، أول ما يستفتح الباب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من حديث مالك لا يقدم على حديثه غيره، ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم، فلم يجدوا عالمًا أعلم من مالك في وقته. والناس كلهم مع مالك وأهل المدينة: إما موافق، وإما منازع، فالموافق لهم عضد ونصير، والمنازع لهم معظم، لهم مبجل، لهم عارف بمقدارهم. وما تجد من يستخف بأقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودًا من أئمة العلم، وذلك لعلمهم أن مالكًا هو القائم بمذهب أهل المدينة. وهو أظهر عند الخاصة والعامة من رجحان مذهب أهل المدينة على سائر الأمصار، فإن موطأه مشحون: إما بحديث أهل المدينة، وإما بما اجتمع عليه أهل المدينة: إما قديمًا، وإما حديثًا، وإما مسألة تنازع فيها أهل المدينة وغيرهم فيختار فيها قولا، ويقول:" هذا أحسن ما سمعت". فأما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في الأزمان المتقدمة من هو أتبع لمذهب أهل المدينة من مالك فقد انقطع ذلك. أصول المدونة و اختلاف رواتها: ولسنا ننكر أن من الناس من أنكر على مالك مخالفته أولا لأحاديثهم في بعض المسائل، كما يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة:" تعرقت يا أبا عبد الله "أي: صرت فيها إلى قول أهل العراق الذين يقدرون أقل المهر بنصاب السرقة، لكن النصاب عند أبي حنيفة وأصحابه عشرة دراهم. وأما مالك والشافعي وأحمد فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحاح. فيقال: أولا: أن مثل هذه الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة، وإنهم كانوا يكرهون للرجل أن يوافقهم ،وهذا مشهور عندهم يعيبون الرجل بذلك كما قال ابن عمر لما استفتاه عن دم البعوض، وكما قال ابن المسيب لربيعة لما سأله عن عقل أصابع المرأة. وأما ثانيًا: فمثل هذا في قول مالك قليل جدا، وما من عالم إلا وله ما يرد عليه، وما أحسن ما قال ابن خويز منداد في مسألة "بيع كتب الرأي والإجارة عليها": لا فرق عندنا بين رأي صاحبنا مالك وغيره في هذا الحكم، لكنه أقل خطأ من غيره". وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين، وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. أهل المدينة و كبار أئمة المالكية يرجحون الموطأ على المدونة: وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقًا للحديث الصحيح الذي رواه، لكن ابن القاسم ونحوه من البصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى، ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق، ثم سأل عنها أسد ابن القاسم، فأجابه بالنقل عن مالك، وتارة بالقياس على قوله، ثم أصلها في رواية سحنون، فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق، وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. سبب انتشار مذهب مالك بالمغرب: ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس، وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس، والولاة يستشيرونه، فكانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا بروايته عن مالك، ثم رواية غيره، فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها، وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة، حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك، وما زال يحدث به إلى أن مات لرواية ابن القاسم، وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك، فمثل هذا أن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك، ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها، بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة، فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. بيان صحة أصول الإمام مالك: بيان أنه أعلم أهل عصره بالكتاب و السنة و آثار الصحابة و القياس الصحيح: ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد، وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، حتى إن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي، فقال له الشافعي:" بالإنصاف أو بالمكابرة؟ قال له: بالإنصاف، فقال: ناشدتك الله صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم، فقال: صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم، فقال: صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحبكم؟ فقال: بل صاحبكم، فقال: ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، ونحن نقول بالقياس، ولكن من كان بالأصول أعلم كان قياسه أصح". تفضيل الإمام أحمد لمالك على علماء عصره: وقالوا للإمام أحمد:" من أعلم بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. فقيل له: أيما أعلم بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك أم سفيان؟ فقال: بل مالك. فقيل له: أيما أزهد مالك أم سفيان؟ فقال: هذه لكم". ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم أهل العراق ذلك الوقت بالفقه والحديث، فإن أبا حنيفة، والثوري، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن بن صالح بن جني، وشريك بن عبد الله النّخعي القاضي: كانوا متقاربين في العصر، وهم أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر، وكان أبو يوسف يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ثم إنه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه، وصنف كتاب "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى". وأخذه عنه محمد بن الحسن ونقله الشافعي عن محمد بن الحسن وذكر فيه اختياره وهو المسمى بكتاب "اختلاف العراقيين". ومعلوم أن سفيان الثوري أعلم هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد، والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري، بل سفيان عندهم أمام العراق، فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق. وقد قال الإمام أحمد في علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ما تقدم، مع أن أحمد يقدم سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها، وهو يعظم سفيان غاية التعظيم، ولكنه كان يعلم أن مذهب أهل المدينة وعلمائها أقرب إلى الكتاب والسنة من مذهب أهل الكوفة وعلمائها. وأحمد كان معتدلاً عالمًا بالأمور يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه، ويدعو له، ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي، أو من ينسبه إلى بدعة، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها، ومعرفته بأصول الفقه، كالناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، ويثبت خبر الواحد، ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره. وكان الشافعي يقول:" سموني ببغداد ناصر الحديث". هذا بحث عظيم عن مذهب مالك رحمه ، كتبه إمام عظيم عارف بحقائق المذاهب العلمية ، سأتمه غدا إن شاء الله ثم أشرع بعد ذلك في شرح أصول مالك في الاستنباط و الاثبات ومقارنتها بأصول أحمد . ورغم أن الشيخ الإسلام لا مذهب له في الحقيقة وإن نشأ على مذهب أحمد ابن حنبل فإنه كان يتحرى الدليل جهده، فقد قدم هذه الخدمة الرائعة عن مذهب أهل المدينة ومنزلة الامام مالك ،ونحن أحق بتعرية مختلف حقائق هذا المذهب للناس و كشف مزاياه لشبابنا خاصة وان بعض الظواهر السلبية انتشرت من مدة بسبب فهم خاطئ لمنهج المحدثين ، منزلة الشافعي وفضله في العلم[المناسبة هنا في ذكر منزلة الشافعي ،هو أنه من أجل و أكبر و أعلم تلامذة الإمام مالك ـ رحمه الله ـ فأبرز من أخذ الشافعي عنهم العلم مالك و سفيان بن عينة ،فكان هذا من مزايا الإمام مالك في العلم ،وحسناته على المسلمين . ومن جهة أخرى لا يمكن ذكر علماء الحجاز دون ذكر الإمام المطلبي ، وبيان مكانته هو الآخر.] : ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة، واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهب أهل الحجاز، وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن جريج، كمسلم بن خالد الزّنجي، وسعيد بن سالم القدّاح، ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ، وكمل أصول أهل المدينة وهم أجلّ علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك، ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق، فاجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره، وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه، وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق، ثم ذهب إلى الحجاز. ثم قدم إلى العراق مرة ثانية، وفيها صنف كتابه القديم المعروف بـ "الحجة". واجتمع به أحمد بن حنبل في هذه القدمة بالعراق، واجتمع به بمكة، وجمع بينه وبين إسحاق بن راهويه، وتناظرا بحضور أحمد ـ رضي الله عنهم أجمعين. ولم يجتمع بأبي يوسف ولا بالأوزاعي وغيرهما، فمن ذكر ذلك في الرحلة المضافة إليه فهو كاذب، فإن تلك الرحلة فيها من الأكاذيب عليه وعلى مالك وأبي يوسف ومحمد وغيرهم من أهل العلم ما لا يخفى على عالم، وهي من جنس كذب القصاص، ولم يكن أبو يوسف ومحمد سعيًا في أذى الشافعي قط، ولا كان حال مالك معه ما ذكر في تلك الرحلة الكاذبة. ثم رجع الشافعي إلى مصر وصنف كتابه الجديد، وهو في خطابه وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجاز، فيقول: قال:" بعض أصحابنا"، وهو يعني: أهل المدينة، أو بعض علماء أهل المدينة، كمالك، ويقول في أثناء كلامه:" وخالفنا بعض المشرقيين"، وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدًا منهم ينسب إلى أصحابهم، واختار سكنى مصر إذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر، كالليث بن سعد وأمثاله، وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء، وبعضهم على مذهب الأوزاعي وأهل الشام، ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب، لكن أهل المدينة أجل عند الجميع. مخالفة الشافعي لمالك واجب أملاه عليه العلم و الإخلاص: ثم إن الشافعي - رضي الله عنه - لما كان مجتهدًا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه، وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قام بما رآه واجبًا عليه، وصنف "الإملاء" على مسائل ابن القاسم ،وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه، وقد أحسن الشافعي فيما فعل، وقام بما يجب عليه، وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه، وجرت محنة مصرية معروفة، والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأبو يوسف ومحمد هما صاحبا أبي حنيفة، وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك، ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك، وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب. والشافعي - رضي الله عنه ـ قرر أصول أصحابه والكتاب والسنة، وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث، ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد:" يا بني الزم هذا الرجل فإنه صاحب حجج، فما بينك وبين أن تقول: قال ابن القاسم فيضحك منك إلا أن تخرج من مصر". قال محمد:" فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود، فقلت: قال ابن القاسم فقال: ومن ابن القاسم؟ فقلت: رجل مفت يقول من مصر إلى أقصى الغرب" وأظنه قال:" قلت: رحم الله أبي". وكان مقصود أبيه: اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع، فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم المقلد، بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان، فإن الله أوجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من العلم، والله يخص هذا من العلم والفهم ما لا يخص به هذا، وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة، وهذا هو مخصوص بذلك في نوع آخر. القواعد العلمية الجامعة التي تبين رجحان علم أهل المدينة على غيرهم: لكن جملة مذاهب أهل المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق، وذلك يظهر بقواعد جامعة: منها: قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات في المياه: فإنه من المعلوم أن الله قال في كتابه:{ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف ]. فالله تعالى أحل لنا الطيبات، وحرم علينا الخبائث والخبائث نوعان: 1 ـ ما خبثه لعينه لمعنى قام به، كالدم والميتة ولحم الخنزير. 2 ـ وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما؛ أو بعقد محرم كالربا والميسر. فأما الأول: فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته، كالسموم، والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرم أشياء من الملابس. مذهب أهل المدينة في الأشربة: ومعلوم أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد من مذهب الكوفيين؛ فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر، وأن كل مسكر خمر وحرام، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولم يتنازع في ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم، سواء كان من الثمار أو الحبوب؛ أو العسل أو لبن الخيل، أو غير ذلك. والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب، فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل، ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرًا نيئًا، فإن طبخ أدنى طبخ حل وإن أسكر!. وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت، لكن يحرمون المسكر منها. مذهب أهل المدينة في الأطعمة: وأما الأطعمة: فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة؛ فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير؛ وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع، والخيل تحرم عندهم في أحد القولين، ومالك يحرم تحريمًا جازمًا ما جاء في القرآن، فذوات الأنياب إما أن يحرمها تحريمًا دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور، وروي عنه كراهة ذوات المخالب، والطير لا يحرم منها شيئًا ولا يكرهه، وإن كان التحريم على مراتب، والخيل يكرهها، ورويت الإباحة والتحريم أيضًا. مذهب أهل المدينة في الأطعمة و الأشربة يوافق الأحاديث الصحيحة: ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسّنّة، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسّنّة، وأما الأطعمة، فإنه وإن قيل: إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ففي ذلك خلاف. والأحاديث الصحيحة التي خالفها؛ من حرم الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه، ثم إن هذه الأحاديث قليلة جدًا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. ما خالف فيه مالك الأحاديث الصحيحة له فيه مستند: وأيضًا فمالك معه في ذلك آثار عن السلف كابن عباس؛ وعائشة؛ وعبد الله بن عمر وغيرهم، مع ما تأوله من ظاهر القرآن. ومبيح الأشربة ليس معه، لا نص، ولا قياس، بل قوله مخالف للنص والقياس. وأيضًا فتحريم جنس الخمر، أشد من تحريم اللحوم الخبيثة، فإنها يجب اجتنابها مطلقا، ويجب على من شربها الحد، ولا يجوز اقتناؤها. وأيضًا فمالك جوز إتلاف عينها، اتباعًا لما جاء من السنة في ذلك، ومنع من تخليلها، وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة، فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه للأطعمة؛ كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح. شبهات فقهية على أهل المدينة وحلها: ومما يوضح هذا؛ أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء، حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة، وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع: "سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء ؟ فقال: "إنما يفعله عندنا الفساق". ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة، فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما في تحريم الأشربة المسكرة، فعلم أن أهل المدينة أتبع للسنة. ثم إن من أعظم المسائل: مسألة "اختلاط الحلال بالحرام لعينه"، كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات، فأهل الكوفة يحرمون كل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة، قليلًا كان أو كثيرًا، ثم يقدرون مالا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة، ويقدرونه بعشرة أذرع في عشرة أذرع، ثم منهم من يقول: إن البئر إذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم. والفقهاء منهم من يقول: تنزح، إما دلاء مقدرة منها، وإما جميعها على ما قد عرف، لأجل قولهم: ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه. وأهل المدينة بعكس ذلك فلا ينجس الماء عندهم إلا إذا تغير، لكن لهم في قليل الماء: هل يتنجس بقليل النجاسة ؟ قولان، ومذهب أحمد قريب من ذلك، وكذلك الشافعي، لكن هذان يقدران القليل بما دون القلتين، دون مالك، وعن مالك في الأطعمة خلاف. وكذلك في مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات، ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة، فإن اسم الماء باق، والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة وغيره على أنه لا يتنجس، ولم يعارض ذلك إلا حديث ليس بصريح في محل النزاع فيه، وهو حديث: "النهي عن البول في الماء الدائم"[ البخاري في" الوضوء"{239}، ومسلم في" الطهارة"{282/95}.]، فإنه قد يخص البول بالحكم. وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجري إليه البول، وقد يخص ذلك بالماء القليل. وقد يقال: النهي عن البول لا يستلزم التنجيس، بل قد ينهى عنه، لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كثر؛ يقرر ذلك أنه لاتنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نزحها، ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر، لا ينجسه البول بالاتفاق. والحديث الصحيح لا يعارضه حديث في هذا الإجمال والاحتمال. وكذلك تنجس الماء المستعمل ونحوه، مذهب أهل المدينة ومن وافقهم في طهارته ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم، كحديث:" صب وضوئه على جابر"[ البخاري في" الوضوء"{194}،ومسلم في " الفرائض"{1616/8}،والدارمي في"الوضوء"{187/1}،وأحمد{3/298}.]، وقوله: "المؤمن لا ينجس"[ البخاري في" الغسل"{283}، ومسلم في "الحيض"{371/115}،و أبو داود في الطهارة{231}، والترمذي في" الطهارة{121}،وقال:" حديث حسن صحيح"، و النسائي في" الطهارة"{269}، وابن ماجة في"الطهارة"{524}،و احمد{235/2}.] ، وأمثال ذلك. وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم، مذهب بعض أهل المدينة ومن وافقهم لهم فيه أحاديث صحيحة، عن النبى صلى الله عليه وسلم لا يعارضها شيء. وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة وسيرة الصحابة، ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه، وعلى ذلك بضع عشرة حجة من النص والإجماع القديم والاعتبار، ذكرناها في غير هذا الموضع[ذكرها في " المجموع" كتاب "الطهارة"]، وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه وليس بعام، أو قياس يظن مساواة الفرع فيه للأصل، وليس كذلك. ولما كانت النجاسات من الخبائث المحرمة لأعيانها، ومذهبهم في ذلك أخف من مذهب الكوفيين، كما في الأطعمة، كان ما ينجسونه أولئك أعظم، وإذا قيل: إنه خالف حديث الولوغ ونحوه، في النجاسات فهو كما يقال: إنه خالف حديث سباع الطير ونحوه، ولا ريب أن هذا أقل مخالفة للنصوص ممن ينجس روث ما يؤكل لحمه وبوله، أو بعض ذلك، أو يكره سؤر الهرة. وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع الأرواث والأبوال طاهرة إلا بول الإنسي وعذرته، وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس الذي يذهب إليه أهل المدينة، من أهل الكوفة، ومن وافقهم. ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عالمًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين له قطعًا أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بال الأعرابي في المسجد وأمرهم بالصب على بوله قال: "إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"[ البخاري في" الوضوء"{220}.] ، وهذا مذهب أهل المدينة وأهل الحديث، ومن خالفهم يقول: أنه يغسل ولا يجزئ الصب ،وروي في ذلك حديثًا مرسلًا لا يصح. النوع الثاني من المحرمات: المحرم لكسبه: كالمأخوذ ظلمًا بأنواع الغصب من السرقة والخيانة والقهر؛ وكالمأخوذ بالربا والميسر؛ وكالمأخوذ عوضًا عن عين أو نفع محرم؛ كثمن الخمر والدم; والخنزير والأصنام، ومهر البغي وحلوان الكاهن؛ وأمثال ذلك، فمذهب أهل المدينة في ذلك من أعدل المذاهب، فإن تحريم الظلم، وما يستلزم الظلم أشد من تحريم النوع الأول[أي المحرم لذاته من الأطعمة و الأشربة، لأن هذا الأول لا ظلم فيه للناس و أما الثاني فيتعدى ظلمه لغيرك.] ؛ فإن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هي تغذى تغذية خبيثة، توجب للإنسان الظلم، كما إذا اغتذى من الخنزير والدم والسباع؛ فإن المغذى شبيه بالمغتذى به، فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اغتذى منه. وإباحتها للمضطر، لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة، مع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثرًا يضر. وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره، وحرمه تعالى على نفسه، وجعله محرمًا على عباده. وحرم الربا، لأنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بلا مقابل له، وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار؛ لأن المرابي قد أخذ فضلًا محققًا من محتاج، وأما المقامر فقد يحصل له فضل، وقد لا يحصل له، وقد يقمر هذا هذا، وقد يكون بالعكس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر[مسلم في" البيوع"{1513/4}.] ؛ وعن بيع الملامسة والمنابذة[البخاري في" البيوع"{2146}،ومسلم في" البيوع"{1511/1}.]، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها[البخاري في" البيوع"{198}، ومسلم في " البيوع"{1534/51}.] ، وبيع حبل الحبلة[البخاري في" البيوع"{2143}، ومسلم في " البيوع"{1514/5}.] . ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة، وأرخص في ذلك فيما تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعًا لغيره، كما أرخص في ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح، وإن كان بعض أجزائها لم يخلق، وكما أرخص في ابتياع النخل المؤبّر مع جديده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبد صلاحه، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر، وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبّر إذا لم يشترطها المشتري، فتكون الشجرة للمشتري، والبائع ينتفع بها بإبقاء ثمره عليها إلى حين الجذاذ. وقد ثبت في الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح وقال: (إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا، بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟)[ مسلم في" المساقاة"{1554/14}.] . ومذهب مالك وأهل المدينة في هذا الباب أشبه بالسّنة، والعدل من مذهب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم، وذلك أن مخالفهم جعل البيع إذا وقع على موجود جاز، سواء كان قد بدا صلاحه أو لم يكن قد بدا صلاحه، وجعل موجب كل عقد قبض المبيع عقبه، ولم يجز تأخير القبض، فقال: إنه إذا اشترى الثمر باديًا صلاحه أو غير باد صلاحه جاز، وموجب العقد القطع في الحال، لا يسوغ له تأخير الثمر إلى تكمل صلاحه، ولا يجوز له أن يشترطه. وجعلوا ذلك القبض قبضًا ناقلًا للضمان إلى المشتري دون البائع وطردوا ذلك ،فقالوا: إذا باع عينًا مؤجرة لم يصح لتأخير التسليم، وقالوا: إذا استثنى منفعة المبيع: كظهر البعير وسكنى الدار لم يجز، وذلك كله فرع على ذلك القياس. وأهل المدينة وأهل الحديث خالفوهم في ذلك كله، واتبعوا النصوص الصحيحة، وهو موافقة القياس الصحيح العادل، فإن قول القائل: العقد موجب القبض عقبه؛ يقال له: موجب العقد إما أن يتلقى من الشارع؛ أو من قصد العاقد، والشارع ليس في كلامه ما يقتضي أن هذا يوجب موجب العقد مطلقًا، وأما المتعاقدان فهما تحت ما تراضيا به ويعقدان العقد عليه، فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقبه، وتارة على أن يتأخر القبض كما في الثمر؛ فإن العقد المطلق يقتضي الحلول؛ ولهما تأجيله إذا كان لهما في التأجيل مصلحة، فكذلك الأعيان؛ فإذا كانت العين المبيعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي ثمره ظاهر، وكالعين المؤجرة ،وكالعين التي استثنى البائع نفعها مدة، لم يكن موجب هذا العقد أن يقتضي المشتري ما ليس له؛ وما لم يملكه إذا كان له أن يبيع بعض العين دون بعض، كان له أن يبيعها دون منفعتها. ثم سواء قيل: إن المشتري يقبض العين، أو قيل: لا يقبضها بحال، لا يضر ذلك؛ فإن القبض في البيع ليس هو من تمام العقد، كما هو في الرّهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعًا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع وإن كان في يد البائع، ولكن أثر القبض، إما في الضمان وإما في جواز التصرف، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال:" مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من ضمان المشتري". ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث؛ فإن تعليق الضمان بالتمكين من القبض، أحسن من تعليقه بنفس القبض، وبهذا جاءت السّنة، ففي الثمار التي أصابتها جائحة لم يتمكن المشتري من الجذاذ وكان معذورًا، فإذا تلفت كانت من ضمان البائع؛ ولهذا التي تلفت بعد تفريطه في القبض كانت من ضمانه، والعبد والدابة التي تمكن من قبضها تكون من ضمانه، على حديث عليّ وابن عمر. ومن جعل التصرف تابعًا للضمان فقد غلط؛ فإنهم متفقون على أن منافع الإجارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت من ضمان المؤجر، ومع هذا للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة لئلا يكون ذلك ربحًا فيما لا يضمن، والصحيح جواز ذلك؛ لأنها مضمونة على المستأجر، فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه، ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم يكن من ضمانه. وهذا هو الأصل أيضًا؛ فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه قال:" كنا نبتاع الطعام جزافًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا". وابن عمر هو القائل:" مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيًا مجموعًا فهو من ضمان المشتري". فتبين أن مثل هذا الطعام مضمون على المشتري، ولا يبيعه حتى ينقله، وغلة الثمار والمنافع له أن يتصرف فيها، ولو تَلفَت قبل التمكن من قبضها، كانت من ضمان المؤجر والبائع، والمنافع لا يمكن التصرف فيها إلا بعد استيفائها، وكذلك الثمار لا تباع على الأشجار بعد الجذاذ، بخلاف الطعام المنقول. والسنة في هذا الباب فرقت بين القادر على القبض وغير القادر في الضمان والتصرف، فأهل المدينة أتبع للسنة في هذا الحكم كله، وقولهم أعدل من قول من يخالف السنة. بيع الأعيان الغائبة: ونظائر هذا كثير، مثل بيع الأعيان الغائبة: من الفقهاء من جوَّز بيعها مطلقًا، وإن لم توصف، ومنهم من منع بيعها مع الوصف؛ ومالك جوز بيعها مع الصفة دون غيرها، وهذا أعدل. والعقود، من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الإيجاب والقبول ونحو ذلك، وأهل المدينة جعلوا المرجع في العقود إلى عُرف الناس وعادتهم، فما عده الناس بيعًا فهو بيع، وما عدوه إجارة فهو إجارة، وما عدوه هبة فهو هبة، وهذا أشبه بالكتاب والسنة وأعدل، فإن الأسماء منها ما له حد في اللغة، كالشمس والقمر، ومنها ما له حد في الشرع، كالصلاة والحج، ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل يرجع إلى العرف كالقبض. ومعلوم أن اسم البيع والإجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع، ولا لها حد في اللغة؛ بل يتنوع ذلك بحسب عادات الناس وعرفهم، فما عدوه بيعًا فهو بيع، وما عدوه هبة فهو هبة، وما عدوه إجارة فهو إجارة. ومن هذا الباب أن مالكاَ يجوز بيع المغيب في الأرض كالجزر واللفت، وبيع المقاثي جملة، كما يُجَوِز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره؛ ولا ريب أن هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا التاريخ، ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا، وما يظن أن هذا نوع غرر، فمثله جائز في غيره من البيوع، لأنه يسير والحاجة داعية إليه، وكل واحد من هذين يبيح ذلك، فكيف إذا اجتمعا ؟! وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعًا للأرض، مثل أن يكري أرضًا أو دارًا فيها شجرة أو شجرتان، هو أشبه بالأصول من قول من منع ذلك. وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن حنبل مطلقًا، وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها أرض وشجر، كما فعل عمر بن الخطاب لما قبل الحديقة من أسيد بن الحضير ثلثًا، وقضى بما تسلفه دينًا كان عليه، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع الربا: وهذا يتبين بذكر الربا؛ فإن تحريم الربا أشد من تحريم القمار , لأنه ظلم محقق ,والله سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين: غنيًا وفقيرًا أوجب على الأغنياء الزكاة حقًا للفقراء، ومنع الأغنياء عن الربا الذي يضر الفقراء، وقال تعالى:{ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة 276]. وقال تعالى: { وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ }[الروم 39]، فالظالمون يمنعون الزكاة ويأكلون الربا، وأما القمار فكل من المتقامرين قد يُقمر الآخر، وقد يكون المقمور هو الغني، أو يكونان متساويين في الغنى والفقر، فهو أكل مال بالباطل فحرمه الله، لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج. ومعلوم أن أهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيُّل على استحلاله، وسدوا الذريعة المفضية إليه، فأين هذا ممن يسوغ الاحتيال على أخذه ؟ بل يدل الناس على ذلك. وهذا يظهر بذكر مثل ربا الفضل وربا النساء. أما ربا الفضل، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة[مسلم في "المساقاة"{1588/83}،و الترمذي في" البيوع"{1240}،وقال:" حديث حسن صحيح"،والنسائي في" البيوع"{4559}، وابن ماجة في" التجارات"{2255}،و أحمد{233/2}.]، واتفق جمهور الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب بجنسه إلا مثلًا بمثل؛ إذ الزيادة على المثل أكل مال بالباطل وظلم، فإذا أراد المدين أن يبيع مائة دينار مكسور وزنه مائة وعشرون دينارًا؛ يسوغ له مبيح الحيل أن يضيف إلى ذلك رغيف خبز أو منديل يوضع فيه مائة دينار؛ ونحو ذلك مما يسهل على كل مربٍ فعله، لم يكن لتحريم الربا فائدة، ولا فيه حكمة، ولا يشاء مربٍ أن يبيع نوعًا من هذا بأكثر منه من جنسه إلا أمكنه أن يضم إلى القليل ما لا قدر له من هذه الأمور. وكذلك إذا سوغ لهما أن يتواطآ على أن يبيعه إياه بعرض لا قصد للمشتري فيه , ثم يبتاعه منه بالثمن الكثير؛ أمكن طالب الربا أن يفعل ذلك. ومعلوم أن من هو دون الرسول، إذا حرَّم شيئًا لما فيه من الفساد، وأذن أن يفعل بطريق لا فائدة فيه، لكان هذا عيبًا وسفهًا؛ فإن الفساد باق، ولكن زادهم غشًا، وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه، فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟! بل معلوم أن الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واحتال المنهي على ما نهي عنه بمثل هذه الطريق لعدوه لاعبًا مستهزئًا بأوامرهم، وقد عذب الله أهل الجنة الذين احتالوا على ألا يتصدقوا[يشير شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ إلى قوله تعالى:{ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ (21) أَنْ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}] ، وعذب الله القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم بالحيلة، بأن مسخهم قردة وخنازير[يشير شيخ الإسلام إلى قوله تعالى:{ وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ}]، وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تركبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل»[ الدر المنثور{139/3} وعزاه لابن بطة.] . وقد بسطنا الكلام على قاعدة "إبطال الحيل وسد الذرائع" في كتاب كبير مفرد، وقررنا فيه مذهب أهل المدينة بالكتاب والسنة، وإجماع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وكذلك ربا النسأ، فإن أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن: أن الرجل كان يأتي إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول: أتقضي أم تربي ؟ فإن لم يقضه وإلا زاده المدين في المال، وزاده الطالب في الأجل، فيضاعف المال في المدة لأجل التأخير، وهذا هو الربا الذي لا يشك فيه باتفاق سلف الأمة، وفيه نزل القرآن، والظلم والضرر فيه ظاهر. والله سبحانه وتعالى أحل البيع وأحل التجارة وحرم الربا، فالمبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس، ومسكن ومركب وغير ذلك، والتاجر يشتري ما يريد أن يبيعه ليربح فيه، وأما آخذ الربا فإنما مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى أجل، فيلزم الآخر أكثر مما أخذ بلا فائدة حصلت له، لم يبع ولم يتجر، والمربي آكل مال بالباطل بظلمه، ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها؛ بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس. فإذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم، مثل أن تواطآ على أن يبيعه ثم يبتاعه، فهذه بيعتان في بيعة، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»[ أبو داود في" البيوع"{3461}.] مثل أن يدخل بينهما محللًا يبتاع منه أحدهما ما لا غرض له فيه، ليبيعه آكل الربا لموكله في الربا، ثم الموكل يرده إلى المحلل بما نقص من الثمن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه :«لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه »[ مسلم في" المساقاة"{1597/106}،و أبو داود في" البيوع"{3333}، و الترمذي في"البيوع"{1206}،وقال:"حسن صحيح" وابن ماجة في" التجارات"{2277}، و احمد{87/1}.] « ولعن المحلل والمحلل له»[ أبو داود في" النكاح"{2076}، و الترمذي في" النكاح"{1120}،وقال:"حسن صحيح".]. ومثل أن يضما إلى الربا نوع قرض، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم :«لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك»[ أبو داود في" البيوع"{3504}، و الترمذي في" البيوع"{1234}،وقال:" هذا حديث حسن صحيح"، والنسائي في" البيوع"{4611}.]. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم:« نهى عن المزابنة والمحاقلة»[ البخاري في" البيوع"{1530/42}، ومسلم في" البيوع"{1539/59}، و الترمذي في" البيوع"{1224}، و النسائي في" البيوع"{5423}، و ابن ماجة في" التجارات"{2267}، و الدارمي {83/1} و احمد{224/1}.]. وهو: اشتراء الثمر والحب بخرص، وكما:« نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى»[ مسلم في" البيوع"{1530/42}، و النسائي في" البيوع"{4540}.]؛ لأن الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل، والخرص لا يعرف مقدار المكال، إنما هو حزر وحدس، وهذا متفق عليه بين الأئمة. ثم إنه قد ثبت عنه أنه:« أرخص في العرايا يبتاعها أهلها بخرصها تمرًا»[ البخاري في" المساقاة"{2380}، ومسلم في" البيوع"{1539/60}، و أبو داود في" البيوع"{3362}، و النسائي في" البيوع"{4539}، و ابن ماجة في" التجارات"{2269}، و أحمد{3/1}.]، فيجوز ابتياع الربوي هنا بخرصه، وأقام الخرص عند الحاجة مقام الكيل، وهذا من تمام محاسن الشريعة، كما أنه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة أقام الخرص مقام الكيل، فكان يخرص الثمار على أهلها يحصي الزكاة، وكان عبد الله بن رواحة يقاسم أهل خيبر خرصًا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل فعل، فإذا لم يمكن كان الخرص قائمًا مقامه للحاجة كسائر الأبدال في المعلوم والعلامة؛ فإن القياس يقوم مقام النص عند عدمه والتقويم يقوم مقام المثل، وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى. ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب، إذا تعذر الاستدلال بالقرائن؛ إذ الولد يشبه والده في الخرص، والقافة والتقويم أبدال في العلم كالقياس مع النص، وكذلك العدل في العمل؛ فإن الشريعة مبناها على العدل، كما قال تعالى:{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ }[الحديد 25]، { لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }[البقرة 286]. والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والأعراض بحسب الإمكان، فقال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى }[البقرة 178]. الآية وقال تعالى:{ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ }[المائدة 45]. الآية وقال تعالى:{ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } [الشورى 40] الآية وقال تعالى: { فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ }[البقرة 194] الآية وقال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ }[النحل 126]. الآية فإذا قتل الرجل من يكافئه عمدًا عدوانًا، كان عليه القود، ثم يجوز أن يفعل به مثل ما فعل؛ كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد في إحدى الروايتين بحسب الإمكان؛ إذا لم يكن تحريمه بحق الله كما إذا رضخ رأسه كما (رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية) كان ذلك أتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه، وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية، وكانت الدية بدلًا لتعذر المثل. وإذا أتلف له مالًا؛ كما لو تلفت تحت يده العارية: فعليه مثله، إن كان له مثل، وإن تعذر المثل كانت القيمة، وهي الدراهم والدنانير، بدلًا عند تعذر المثل، ولهذا كان من أوجب المثل في كل شيء، بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل، وفي هذا كانت قصة داود وسليمان. وقد بسطنا الكلام على هذه الأبواب كلها في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا: التنبيه. وحينئذ فتجويز العرايا أن تباع بخرصها لأجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيل، موافق لأصول الشريعة مع ثبوت السنة الصحيحة فيه، وهو مذهب أهل المدينة، وأهل الحديث، ومالك جوز الخرص في نظير ذلك للحاجة، وهذا عين الفقه الصحيح. ومذهب أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي، وأحمد في جزاء الصيد: أنه يضمن بالمثل في الصورة، كما مضت بذلك السنة وأقضية الصحابة، فإن في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع بكبش، وقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وفي الظبي بشاة، وأمثال ذلك. ومن خالفهم من أهل الكوفة، إنما يوجب القيمة في جزاء الصيد، وأنه يشتري بالقيمة الأنعام والقيمة مختلفة باختلاف الأوقات. وإن شاء الله تعالى نتم نقل بقية شرح مزايا مذهب الامام مالك عند شيخ الاسلام ابن تيمية تعريفا للمغاربة أولا و السلفييين منهم ثانيا بمذهب آبائهم و اجدادهم و سنعرج على أصوله وعلى دوره البارز في محاربة العبيديين و الموحدين و الخوارج الصفرية بكفية يتفوق فيها تفوقا كبيرا تحت عنوان جهاد الفقهاء المالكية ضد البدع . http://www.taibaoui.com/index.php?ty...enu=0&limite=0 |
 |
|
|
 |
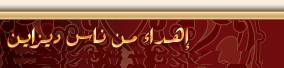 |