


 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
 |
 |
 |
|||||
|
|||||||
| 45917 | 151323 |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله (الدرس الأول) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ بِرَحْمَتِكَ [الحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمًّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.] افتتح المصنف هذه الرسالة ، بهذه الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة ، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها كلامه وخطبه عند مخاطبة الناس ، وهذه الخطبة ، خطبة عظيمة ، مشتملة على فوائد كبيرة منها: الثناء على الله عز وجل ، وحمد الله عز وجل بما هو أهل ، ثم الاستعانة بالله عز وجل ، والاستغفار من الذنب ، فإن هذه من أعظم أسباب التوفيق: الثناء على الله عز وجل ، والاستعانة به في فهم العلم ، وفي غيره من الأمور التي تشرع لها هذه الخطبة ، وكذلك الاستغفار من الذنوب ، فإن من أعظم ما يحول بين العبد وبين تحقيق المصالح والمطالب هو الذنب ، فإذا ما استغفر العبد من ذنوبه ، وفقه الله عز وجل لخير كثير ، ثم الاستعاذة من شرور النفس ، وشر النفس: هو ما توسوس به النفس ، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من هداه الله عز وجل ووفقه ، (وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) : أي من الذنوب والسيئات ، والأعمال: منها ما هو صالح حسن ، ومنها ما هو سيء قبيح ، والاستعاذة من شر الذنوب ، ومن شر السيئات التي هي سبب لحرمان العبد في الدنيا والآخرة ، ثم قال: (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ): هذا فيه تقرير أن الهداية بيد الله عز وجل ، وهذه هداية التوفيق (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ) من هدى الله قلبه ووفقه ، فلا مضل له ، (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ): إن كتب عليه الضلال فإنه لا هادي له ، وأما هداية الإرشاد فإن الأمة خوطبت بها ، وأما هداية التوفيق فهي التي امتن الله عز وجل بها على من شاء ، فمن هداه الله فلا مضل له ، ومن أضله الله فلا هادي له ، ثم قال: (وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ): هذه شهادة توحيد ، وهذه الكلمة العظيمة التي عليها مدار الدين وهو تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولهذا فهذ الخطبة مشتملة على فوائد عظيمة من استحضرها عند قولها ، وحققها لفظا ومعنى، واستحضارا لما يقول فإنه يوفق لخير كثير. قال رحمه الله: [لقد سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ «مُقَدِّمَةً» تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ، وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَالتَّمْيِيزِ -فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ- بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ] ثم ذكر المصنف سبب تأليف هذه الرسالة ، فقال: (لقد سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ «مُقَدِّمَةً» تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً) هذا مما على أن هذه الرسالة هي في إجابة سؤال ورد من بعض طلبة العلم أو من بعض أهل العلم. (بَعْضُ الإِخْوَانِ) أي في الدين ، وهذا مما يدل على حسن استجابة شيخ الإسلام لمن سأله عن ذلك ، ومراعاته لحقوق الأخوة والصحبة ، (لقد سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ) ولم يسمه ؛ لأن المقصود هو معرفة المناسبة وليس السائل ، (أَنْ أَكْتُبَ لَهُ «مُقَدِّمَةً») المقدمة للشيء هو ما يتقدم الشيء وتضبط بـ "مقدِمة" و "مقدَمة" فمقدِمة هي ما يتقدم الشيء ، ومقدَمة ما يُقدم بها للشيء ، فيصح هذا وهذا. والمقصود أن هذه الرسالة هي متضمنة لمقدمة تتضمن القواعد الكلية في التفسير ، وإنما سماها مقدمة ؛ لأنها مقدمة لعلم واسع ؛ وهو علم التفسير ، ولهذا فهذه الرسالة تصلح لأن تكون مقدمة لكل كتاب من كتب التفسير ، ولهذا ذكر بعض أهل العلم ، أن الإمام ابن كثير استفاد من هذه الرسالة في مقدمة كتابه في التفسير ، (تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً) القواعد جمع قاعدة وهو حكم كلي يندرج تحته جزيئات ، فإذا عُرف الحكم الكلي عرف حكم الجزيئات ، ولهذا فالقواعد هي من أعظم ما يعين على معرفة جزئيات العلم ، والقواعد منها ما هو منصوص عليه يعرف بالنص ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة" فإن هذه قاعدة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" فإن هذه قواعد ؛ لأنها يندرج تحتها الكثير من الجزيئات ، وهذه القواعد المنصوص عليها ، هي أقوى ما يكون في معرفة العلم ؛ لأنها معصومة من الخطأ ، ولأن هذه القاعدة منصوص عليها ، فكل ما يندرج تحتها من جزيئات هي صحيحة ، تبعا لصحة القاعدة. ومن القواعد ما هو مستنبط من النصوص ، أي لم يرد به النص ولكنه يعرف من خلال التتبع والسبر للنصوص ، مثل قول العلماء: "الأمر يدل على الوجوب" و" النهي يدل على التحريم" فهذه القواعد أخذها العلماء من تتبع النصوص والاستقراء التام للنصوص بحيث المستقرِء يقرر قاعدة ، يعلم أن الجزئيات كلها مندرجة تحت هذا الأصل ، وتحت هذه القاعدة. وعلى هذا فإن القواعد منها ما هو منصوص عليه ، وهذه القواعد هي التي جاءت بها الأدلة من الكتاب والسنة ، وهذه حق لا باطل فيها ، والاستدلال بها من جهتين ، من جهة أنها دليل شرعي ، ومن جهة أنها قاعدة. وأما كلام العلماء في تحرير القواعد فهو كاجتهاد العلماء في سائر المسائل ، فيؤخذ منه ويرد ، ولهذا قد تكون القاعدة صواب ، وقد تكون خاطئة. وقد نبه شيخ الإسلام على أن كثيرا ممن ألف في أصول الفقه ، ادخلوا في هذا العلم بعض القواعد التي لم تدل عليها الأدلة ، بل إنها أصبحت من أكثر أسباب خطأ الكثير في فهم هذا الباب ؛ بسبب سوء فهم هؤلاء في بعض الأصول والقواعد الشرعية. ولهذا سبق التنبيه على كثير مما قرره وقعد له بعض أهل الكلام ، مثل قولهم: "إن الله عز وجل منزه عن الحوادث" فهذه قاعدة نفوا بها الصفات ، قالوا: إن الصفات حوادث ، والله منزه عن الحوادث ، فالله منزه عن الصفات ، فيأتون ويقررون قواعد ومقدمات باطلة ، ثم يندرج تحتها أخطاء عظيمة ، ولهذا الخطأ في القواعد ليس كالخطأ في غيره ؛ لأن القاعدة كما يقال: (سلاح ذو حدين) ، إما أن تكون صحيحة فتدل على كثير من العلم ، وإما أن تكون خاطئة فتكون سبب لضلال كثير من الناس في أبواب شتى من أنواع العلوم. قال: (تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً ) والقاعدة الكلية هي القاعدة الكاملة التامة التي تندرج تحتها الجزئيات. قال: (تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ، وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَالتَّمْيِيزِ -فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ-) هذه القواعد تعين على فهم القرآن ، والفهم: هو حسن التصور والإدراك للشيء وهو فوق العلم ، فقد يحصل العلم ولا يحصل الفهم ، قد يقف العالم على العلم وعلى النص ولكنه لا يرزق الفهم ، ولذلك فرق الله عز وجل بينهما في قوله: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} فأخبر الله عز وجل أن داوود وسليمان أوتيا علما ، ورزقهما الله علما ، ولكن الفهم في تلك المسألة خص الله عز وجل به سليمان ، فالفهم هو حسن التصور والإدراك للشيء ، والعلم هو إدراك الشيء وهو أن يدرك النص ويقف عليه ، ولكن الفهم للنص هو شيء زائد عن العلم. (وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ) هنا يلاحظ دقة شيخ الإسلام في العبارات ، وما يتضمن كلامه من تقسيمات ، فإنه فرق بين التفسير والمعاني ، فالتفسير: أن يعرف المفسر تفسير كل مفردة وردت في الآية ، والمعنى: هو معرف المعنى الإجمالي لهذه الآية أو لهذا النص. والتفسير قد يكون بمعرفة معنى هذه الكلمة في لغة العرب ، والمعنى هو أوسع من ذلك ، بأن يعرف المراد منها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، مثال ذلك {الصراط المستقيم} فيفسر في اللغة بأنه الطريق القويم ، ولكن يأتي بيان معناه في الشرع ووروده في القرآن بأنه القرآن أو الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولن تجد في لغة العرب أن الصراط المستقيم هو النبي أو القرآن ، ولكن هذا المعنى يعرف من معرفة دلالات القرآن ، ومعرفة النصوص الأخرى . (وَالتَّمْيِيزِ فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ) التمييز هو التفريق بين الأشياء ، وهو أول مراتب العلم ؛ لأن أول مراتب العلم: أن يعرف المعاني والمقاصد ، وأن يفرق بين الألفاظ والمعاني ، ثم بعد ذلك يأتي دور تنزيل الأحكام بحسب التفريق ، ولهذا يلاحظ أن أكثر أخطاء العلماء ليس مرجعها إلى الجهل ن وإنما مرجعها إلى الاشتباه: أن يشتبه لفظ بلفظ ، أو معنى بمعنى ، أو حكم بحكم ، فإذا ما رزق العالم التفريق بين المسائل فإنه يتنبه إلى أنه لا يمكن أن تفترق المسألة ويكون حكمها واحدا ، فافتراق المسائل إذا ما افترقت إلى شيئين أو إلى أكثر ، فإنه مما يدل وينبه المتأمل إلى أنه هناك فرق في الحكم ، ولهذا نجد في كثير من الألفاظ في القرآن الأمر بالشيء والنهي عنه ، مثل: المجادلة ، ومثل: الهجر ، فالذي لا يتنبه إلى هذه الأقسام يظن أن ما يؤمر به هو ما ينهى عنه ، وإذا ما رزق التمييز بين الأشياء ، وأدرك أن الهجر يتنوع ، وأن المجادلة تتنوع ، وكذلك سائر المسائل التي تتنوع أحكامها ، يتنبه إلى أن الحكم إنما تنوع بحسب تنوع المسائل ، ومن هذا مما ذكره العلماء في قواعد التفسير ما جاء من الإخبار عن يوم القيامة ، فقد يأتي في بعض المواطن الإخبار عن شيء ، ثم يخبر في موطن آخر بشيء قد يظن الظان أن هذا معارض لذاك ، ويكون هذا من باب التنوع في الزمن ، ففي بعض المواطن يخبر عن شيء لكن هذا الشيء قد يخبر بوقوعه في موطن آخر أي في زمن آخر ، فإن يوم القيامة يوم طويل ، ولهذا التنبيه على التمييز بين الأشياء مما يعين على فهم الحكم الشرعي. (وَالتَّمْيِيزِ فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ) التمييز بين المنقول في التفسير والمنقول مرجعه إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى فهم الصحابة وهو ما يعرف بالتفسير بالرواية ، فإذا فسر لنا الطاغوت بأنه الشيطان كما نقل عن عمر رضي الله عنه فإن هذا من التفسير بالرواية ، وإذا ما فسر الطاغوت بأنه مجاوزة الحد ؛ لأن الطغيان هو مجاوزة الحد ، هذا التفسير مما يؤخذ من اللغة بالدراية وبالعقل والتأمل لمدلول اللغة ، (فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ) أي ما يعرف في التفسير بالمنقول والمعقول ، وليس المقصود بالمعقول هو أن يعمل المفسر عقله في النص دون أن يرجع إلى أصول ، بل لابد أن يرجع إلى أصول: إما إلى لغة العرب ، وإما إلى دليل آخر يستنبط منه الفهم ، لكنه عرفه بالنظر والتتبع. قال: (بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ): لاحظوا هنا لم يجمع الحق ؛ لأن الحق واحد ، وجمع الأباطيل ؛ لأنها متنوعة ، ولهذا قرر شيخ الإسلام في قول من قال: "إن كل مجتهد مصيب" قال إن هذا خطأ ، فليس كل مجتهد مصيب ، إنما الصواب أن لكل مجتهد نصيب ، فالمجتهدون إذا ما كان اجتهادهم يفضي إلى اختلاف تضاد فإن الحق مع أحد المجتهدَين ، وإن كان الآخر قد سلك الطريق الصحيح فهو معذور بل مأجور على اجتهاده. (بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِلأن الأباطيل متنوعة أيضا ، كما أن البدع متنوعة ، كذلك أهلها الذين حرفوا النصوص عن مدلولاتها الصحيحة ، فإن أباطيلهم متنوعة ، وأهواءهم متفرقة. (وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ) التنبيه على الدليل الفاصل – الذي فيه الفصل- بين الأقاويل – أي بين أقوال الناس- ، ؛ لأن الفصل في الخصومات في الدين والدنيا إلى كتاب الله ، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فالدليل محكم في أقوال الناس ، وأقوال الناس ليست محكمة في الدليل ، والحق يعرف بالدليل ، ولهذا فالأقوال يؤخذ منها ويرد ، لا يؤخذ ما يؤخذ منها بهوى ، ويرد ما يرد منها بهوى ، وإنما يؤخذ منها ما وافق النص ، ففي كتاب الله عز وجل الفصل بين الخصومات ، والفصل بين أهل الخصومات ، ولهذا هو محكم في أقوال الناس. قال رحمه الله:[ فَإِنَّ الكُتُبَ المُصَنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بَالْغَثِّ وَالسَّمِينِ، وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ وَالْحَقِّ المُبِينِ. وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ، وَمَا سِوَى هذا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ.] ثم بعد أن ذكر أن مقصد هذه الرسالة وهو أنها تعين على فهم القرآن ، ومعرفة تفسيره ، والتمييز بين الحق والباطل ، نبه على مسألة مهمة ، وذلك أن في كتب التفسير الكثير من الأقوال الباطلة التي تزيد الفتنة ، ويحصل الاشتباه للناس بسبب وجود هذه الأقوال ، وهذا مما يؤكد معرفة هذه القواعد ؛ لأن الإنسان محتاج إليها ابتداء في فهم كتاب الله عز وجل ، فكيف إذا جاءت الشبه والأقوال الباطلة التي صرفت الكثير من الناس عن معرفة الحق. قال: (فَإِنَّ الكُتُبَ المُصَنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بَالْغَثِّ وَالسَّمِينِ): أي التي كتبت وصنفت في علم التفسير وهي كتب كثيرة ، وشيخ الإسلام متأخر عن عصر التدوين الذي بدأ في عصر مبكر ، فهو يُبين ما اشتملت عليه هذه الكتب ، فكتب التفسير مشحونة -أي مليئة- بالغث والسمين ، والغث: هو الهزيل ، والسمين: هو المعروف بالقوة والسِمن ممدوح في الأشياء ، والهزل مذموم -ولهذا مما يشرع في الأضحية أن تكون سمينة ، وأنه يحرص على أن تكون سليمة من الهزل ، وأن تكون مما يرغب فيه - فكذلك في الأقوال ما هو غث وسمين ، كذلك في كتب التفسير وما اشتملت عليه ، وهذه الكتب أيضا متنوعة منها ما يغلب عليه السِمن والغث فيه قليل ، ومنها ما يغلب عليه الغث والسمن فيه قليل ، بحسب مناهج ومراتب مصنفيها في العلم. (وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ وَالْحَقِّ المُبِينِ) أي أنها مشتملة على الباطل الواضح الذي لا يشتبه على أهل العلم ، وعلى الحق المبين ، وإنما ذكر شيخ الإسلام هذا ؛ لأن الباطل الواضح ينبغي أن يحذر ويترك ، والحق المبين ينبغي أن يؤخذ به ولا يسع المسلم تركه ، وأما ما بين ذلك من الأمور المشتبهة ، فإنه ما زال العلماء يجتهدون في معرفة ذلك ، فالمقصود: ليس قصده بهذا هو أن يضع قواعد يعرف بها طالب العلم الأمور المشتبهة بين العلماء ، فإن الاشتباه الذي وقع بين أهل العلم في هذا الباب لا يمكن رفعه بمعرفة القواعد الكلية ، ولكن بالتتبع لأقوال العلماء ، ولمعرفة مآخذهم في الاستدلال ، وعلى قدرة الناظر في كلامهم على الاستنباط والفهم. قال: (وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ): هنا أشار إلى نوعين من أنواع العلم: النوع الأول: النص ، قال: (وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ) وهذا هو النص ، ومداره على ركنين: على صدق المبلِغ ، وتصديق المبلغَ. ولهذا لا يكون هناك علم إلا بهذين الأمرين ، بأن يكون المبلغ صادق ، وأن أن يكون المبلغ مصدق له ، فيورث العلم ، وإلا فلو كان المبلِغ كاذب أو أن المبلغ لايصدق فإن هذا لا يورث علما ، فالعلم الذي مداره على النقل لابد أن يتوفر فيه هذان الأمران وهو: صدق المبلغ ، وتصديق المبلغ. قال: (وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ) هذا تصديق من المخاطب ، (عَنْ مَعْصُومٍ) لأن المعصوم هو الذي لا يرد عليه الخطأ ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. ثم إن أمة الدعوة انقسموا في تصديقه إلى قسمين: من صدق بما جاء به فهذا أورثه تصديقه العلم ، ومن كذب فإنه لم يحصل له شيء ، ولهذا هذا هو النوع الأول وهو العلم الذي مداره على النقل المصدق من المعصوم ، فلا يمكن أن يتطرق إليه الخلل ؛ لأنه من صادق معصوم في خبره ، والذي يتلقاه مصدق له ، ولهذا الله عز وجل أثنى على النوعين {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون} فأثنى على الصادق في خبره والمصدق له ، وقيل في تفسير هذه الآية {والذي جاء بالصدق} هو النبي صلى الله عليه وسلم {وصدق به} أبوبكر ، وهذا من تفسير هذه الألفاظ ببعض أجزائها ، وإلا فهذه الآية شاملة في كل من قال الصدق ، وكل من صدقه فيما قال. (وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ) وهذا مرجعه إلى الفهم ، يعني ليس هو مما نص عليه ، ولكنه دل الدليل عليه ، وهذا هو الفهم الصحيح الذي دل عليه دليل ، ويقابل هذا القول الذي لم يدل عليه دليل معلوم وهو الباطل ، فإذن هنا العلم مرجعه إلى أحد أمرين: إما نقل ، وإما فهم صحيح دل عليه دليل. (وَمَا سِوَى هذا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ) المزيف هو: المغشوش ، والمردود هو: المتروك ، (و وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ) وإما متوقف فيه ، ما سوى ذلك إما أن يكون معلوم وهو الباطل الذي لا مرية فيه ، يعلم أنه مزيف مردود فيُترك ، وإما موقوف يتوقف فيه. وكأن شيخ الإسلام في قوله هنا: (وَمَا سِوَى هذا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ) يشير إلى ما جاء في كتب التفسير من الباطل الذي لا يشتبه على المسلم أنه باطل ، وقال (وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ) وهذا ما جاء من الأخبار عن أهل الكتاب الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم ، قال: موقوف أي يتوقف فيه ، لا يعرف أنه بهرج ، والبهرج هو: المغشوش ، (وَلَا مَنْقُودٌ) والمنقود هو: السالم من الغش ، أي أنه ما خضع للنقد فيعرف أن سليم وأيضا لا يعرف أنه سلم من الغش فهو لا يعلم هل هو مغشوش أو منقود وإنما متوقف فيه ، وهذه مرتبة الشك ، والشك لا يفيد العلم ، فإذا حصل تردد بين أمرين هل هو مغشوش أم أنه منقود ، فإن هذا لا يفيد علما. قال رحمه الله: [وَحَاجَةُ الأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ القُرْآنِ الَّذِي هُوَ: حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الترديد، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله ] ثم ذكر شدة الحاجة لفهم القرآن قال: (وَحَاجَةُ الأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ القُرْآنِ) لماذا ؟ لأنه حبل الله المتين وهذا كما جاء في بعض الأحاديث: " أن القرآن حبل الله المتين" وجاء في بعضها: "أنه حبل الله وأنه مدود بين الله وبين خلقه" والعرب تطلق على النور أنه حبل إذا كان موصلا إلى شيء كما قال الله عز وجل {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} وقصد بهذا نور النهار وظلمة الليل ، والقرآن نور ، وكأنه حبل ممدود من النور بين الله وبين خلقه ، فمن تمسك به أوصله إلى الله عز وجل ، ومن حاد عنه ضل ، (وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ) كما وصفه الله عز وجل {ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم} فهو ذكر فيه تذكير وفيه موعظة ، وهو حكيم كما أنه موصوف بالحكمة ، فالله عز وجل هو الحكيم ، وكتابه مبناه على الحكمة ، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها ، فليس فيه خلل ، وليس فيه اضطراب ، (وَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ) وهو أحد التفاسير في تفسير الصراط المستقيم أنه القرآن ، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل هو الدين ، ولا تعارض بين هذه التفاسير ؛ لأنه باعتبار المبلِغ عن هذا الصراط فهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصراط ، وباعتبار المنهج الذي خوطبت به الأمة والشريعة فهو الدين ، وباعتبار الدال على هذا من كلام الله عز وجل فهو القرآن. (الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ) أي من تمسك به لم يزغ به الهوى ويضل ؛ لأنه متمسك بهذا الحبل المتين (وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ) قيل الألسن هنا اللغات ، أي أنه لا تلتبس ، ولا يختلط في هذا القرآن اللغات الأخرى ، وإنما هو بلسان عربي مبين كما وصفه به الله عز وجل. (وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الترديد) أي لا يكون باليا قديما على كثرة الترديد ، كما أن كلام الناس إذا قرأته مرة مرتين يمله الإنسان ، ويقال هذا كلام قديم ، عرف من قديم ، فكتاب الله عز وجل كلما قرأه الناس وتدبروه ، كلما ظهر لهم من الفقه والفهم مالم يكن معروفا لديهم ، ولهذا على كثرة قراءته وسماع الناس له فإنهم لا يملون هذا الكلام ، وهذا مما يدل على إعجاز القرآن ، وأنه من كلام الله عز وجل. (وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ) أي لا ينقضي ما فيه العجائب والأمور التي تنبهر لها النفوس ؛ لأن مبناه على القوة والمكانة ، والناس فهمهم فيه ضعف وتقصير ، فكلما تأملوا كلما ظهر لهم من العجائب مالم يكن معلوما لديهم. (وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ) أي لا يكتفي بقراءة شيء منه العلماء ؛ لأن الشبع هو الاكتفاء من الشيء ، فالقرآن لا يشبع منه العلماء الذين يتدبرون كلام الله عز وجل. (مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ) أي من قال بالقرآن بأن أخبر عن كلام الله عز وجل أو ذكر معناه أو استدل به على قوله صدق ، ولهذا إنما يعرف صدق الرجل بموافقه للحق ، والحق إنما يعرف بالدليل. (وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ) من عمل بالقرآن كتب الله عز وجل له المثوبة والأجر على عمله به ، فالقائل به صادق ، والعامل به مأجور. (وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ) من حكم به في الناس عدل في حكمه. (وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) من دعا إلى القرآن ، هدى إلى صراط مستقيم ؛ لأنه هو الصراط المستقيم ، فالذي يدعو إلى القرآن يهدي الناس إلى صراط مستقيم (وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبارٍ قَصَمَهُ اللهُ) من تركه من جبار متكبر قصمه الله ، أي: أهلكه (وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله) من ابتغى الهدى والسلامة من غير القرآن ؛ أضله الله. وهذه الجملة في وصف القرآن ثبت بعضها في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وقد أخرجه الإمام الدارمي في أول كتاب فضائل القرآن من سننه ، وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: [ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ ] ثم ذكر المصنف بعض الآيات الدالة على ما تقدم من أن هذا القرآن فيه هداية النفوس إلى الحق ، كما قال الله عز وجل : ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى﴾ والهدى الذي جاء من الله عز وجل هو القرآن ، قال: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ أي القرآن ﴿فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فلا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة". لأن الناس يوصفون في الدنيا في دينهم بالهدى والضلال ، ويوم القيامة بالسعادة أو الشقاء ، فمن تمسك بالقرآن واهتدى بهديه لم يضل في الدنيا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا" أي في الدنيا ، ويوم القيامة من تمسك به كان من السعداء ، لا يضل في الدنيا ، ولن يشقى في الآخرة. قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ عن القرآن وعن تذكير الله عز وجل لعباده في القرآن ، ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ فالضنك هو الشدة والضيق ، وقيل هذا هو عذاب القبر: أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا في القبر ، وقد روي في هذا بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أن المعيشة الضنكى هي عذاب القبر" وقيل الضنك في الدنيا ، في أنه لا طمأنينة له ولا انشراح وهذا كله صحيح ، فإن من أعرض عن كتاب الله عز وجل ، فإنه لا طمأنينة له ولا انشراح في الدنيا وله الضنك والشدة في القبر ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ قيل أنه يحشر أعمى البصيرة ، وقيل يحشر أعمى البصيرة والبصر ، أما أعمى البصيرة فهذا مما لا شك فيه ﴿قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ هذا من باب الجزاء من جنس العمل ، أي أنه لما نسي آيات الله عز وجل ، والنسيان هنا بمعنى الترك ن وليس النسيان عن ذهوب ، فإن النسيان يرفع به الخطأ ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عفا الله لأمتي الخطأ والنسيان" وقال الله عز وجل : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} لكن المقصود هنا بالنسيان: هو الترك ، فمن أعرض من القرآن يقال: ترك القرآن ، نسي القرآن ، قال: ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ أي تترك ، من هنا يتبين النسيان المضاف إلى الله عز وجل في أنه ليس المقصود به الذهول ، وإنما المقصود به الترك. قال رحمه الله: [ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾] أيضا هذا في معنى الآية السابقة ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾هو كتاب الله عز وجل ، فهو نور للقلوب وهو مبين بين واضح ، ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه ﴾أي من اتبع ما فيه مرضات الله عز وجل ﴿سبل السلام﴾أي طرق السلام ، وإنما جمعت السبل مع أن الطريق واحد كما قال الله عز وجل { وأن هذا صراطي مستقيما} قيل المقصود بالسبل هنا: شعب الإيمان التي تدل على الدين ، وتهدي إلى الإيمان ، فالسبيل قد يقال بأنه واحد ، وقد يقال أنها سبل ، وقد سئل شيخ الإسلام عن قول من قال: "إن السبل إلى الله كعدد الأنفاس" ، فقال : إذا كان المقصود بهذا أبواب الخير فهذا حق ، وإذا كان المقصود اختلاف الناس في الدين ، وافتراقهم في البدع والضلالات فهذا باطل ، لأن بعض الناس يقول: "الكل يعمل ، وكلنا نصل !" لا ليس الأمر كذلك ، إنما العمل بموافقة الشرع ، فإذا كان هذا يعمل ، ويبتغي الثواب من الله عز وجل ، يغلب عليه عمل من الاعمال الصالحة ، هذا يغلب عليه الصلاة ، وهذا يغلب عليه الصدقة ، وهذا يغلب عليه الجهاد ، وهذا يغلب عليه الأمر بالمعروف ، فقد دلت النصوص على أن أهل الجنة يدخلون ببعض هذه الأعمال ، ولكل عمل من هذه الأعمال له باب من الجنة ، فدل هذا على أن هذه الأعمال موصلة إلى الله عز وجل ، فالمقصود بالسبل هنا: سبل الخير ، وطرق الخير ، ﴿ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ﴾لأن الأصل في الإنسان أنه ضال ، كما قال الله عز وجل: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته" فيخرجهم من ظلمات الجهل والهوى إلى نور الإيمان واليقين والعلم ، ﴿ ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾وهو الدين والقرآن. قال رحمه الله: [وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾] ثم أيضا ذكر المصنف مستدلا بقول الله عز وجل ﴿الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ فأخبر الله عز وجل بأنه بهذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام: "أن الله يهدي بالأسباب" يهدي بالقرآن ، فالقرآن من أعظم أسباب الهداية ، ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾أي بهذا القرآن ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾أي بإذن الله وبتوفيقه ؛ لأن هذا القرآن ، نزل على الأمة وليس كل الناس اهتدوا به ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ لأن الأمر يحتاج إلى هداية الإرشاد ، وهي التي نزل بها القرآن ، وإلى هداية التوفيق ، وهذه التي يمن الله بها على من شاء من خلقه ، ولهذا قال هنا ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾فهذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل من خوطب باقرآن يهتدي ، وإنما الهداية بتوفيق الله عز وجل ، وهذه الهداية هي التي تسمى هداية التوفيق ، ﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ الصراط مرة يضاف إلى الله ؛ لأنه هو الذي هدى إليه ، ومرة يضاف إلى العاملين الذين عملوا به {صراط الذين أنعمت عليهم} ، ولا تعارض ، فإنه أضيف إليهم ؛ لأنهم عملوا به ، وهو مضاف إلى الله عز وجل ؛ لأنه هو الذي هدى إليه ﴿ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ والعزيز من أسماء الله عز وجل المتضمن صفة العزة ، والحميد من أسماء الله المتضمن صفة الحمد ، والجمع بين العزة والحمد ، مما يدل على كمال فوق كمال ، فإن عزة الله مقترنة بالحمد ، وذلك لأنه ليس كل عزيز يحمد من المخلوقين ، وليس كل من يحمد فهو عزيز ، ولهذا يكثر العز في أهل الشرف والجاه ، وتقل فيهم صفات الحمد ، وتكثر صفات الحمد في العلماء وتقل فيهم صفات العزة ، والله عز وجل هو العزيز الحميد ، ﴿اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾أي أنه مع عزه وأنه محمود من كل وجه فله ملك السماوات والأرض. قال رحمه الله: [ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ ] ثم قال الله عز وجل ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا﴾ الروح هنا هو القرآن ، ولهذا ينبغي التنبه أن الروح مرة يضاف إلى الله عز وجل ويكون صفة من صفات الله عز وجل كما هو الشأن هنا فالروح هنا القرآن ، وأحيانا ترد الروح وتضاف إلى الله عز وجل ويراد بها الروح المخلوقة كما قال الله عز وجل {فنفخنا فيها من روحنا}. فالمقصود بالروح هنا هو القرآن ؛ وإنما سماه الله روحا ؛ لما فيه من حياة الأرواح والقلوب ، ﴿ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا﴾ أي بأمر الله عز وجل ، ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ ﴾ أي قبل نزول هذا القرآن ما كنت تعلم الكتاب ولا الإيمان ، فلما أنزل الله عز وجل عليه ذلك هداه الله عز وجل إلى معرفة الكتاب والإيمان ، ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ﴾ جعلناه بمعنى أنزلناه ، وهذا المعنى يعرف بنظائر هذا السياق في كتاب الله عز وجل ، كما قال عز وجل: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وقال: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} فالذين لا ينتبهون لمثل هذا ، قد يضل بعضهم فيقول بأن جعل هنا بمعنى خلق ، لكنهم لو تنبهوا للسياق الآخر ، يعرفون أن جعل هنا بمعنى أنزل وصيّر {إنا جعلناه قرآنا عربيا} ، فالمقصود بالجعل: هو الإنزال ، فالقرآن كلام الله ليس هو مخلوق كما قالت المعتزلة والجهمية ؛ ولأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تكون بمعنى خلق ، ولكن بمعنى صيّر وأنزل ، ﴿ نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ جعله الله عز وجل نورا ثم بيّن أن هدايته لمن شاء من عباد الله عز وجل {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ لاحظوا هنا الفرق بين هداية التوفيق ، وهداية الإرشاد ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ هي هداية الإرشاد ، والهداية الأولى في وقوله ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ ﴾ هي هداية التوفيق ، ﴿صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ أي مرجع الأمور من أمور الدين والدنيا ، كلها مرجعها إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: [وَقَدْ كَتَبْتُ هَذِهِ «المُقَدِّمَةَ» مُخْتَصَرَةً، بِحَسَبِ تَيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى، مِنْ إِمْلاءِ الفُؤَادِ، وَاللهُ الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ] ثم ذكر المصنف أنه كتب هذه المقدمة ، وهي مختصرة ( َبتيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى) وهذا من إسناد الفضل لصاحبه ، كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام هذا ، أن ما وفق إليه من العلم هو بتوفيق الله ، وبفضل الله ، قال: (تَيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى، مِنْ إِمْلاءِ الفُؤَادِ) هذا مما يدل على أنه كتبها من إملائه ، ولم يرجع فيها إلى الكتب وينقل ، وإنما كان يصنف من إملائه ، ككثير من الرسائل والكتب ، ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي كتبها من إملائه ، وهي مشتملة على نقول ، وعلى نصوص ، مما يدل على سعة علمه وحفظه رحمه الله تعالى. قال: (وَاللهُ الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ) أي أنه الله عز وجل هو الذي بيده الهداية ، وهذا فيه أيضا الإشارة إلى أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل لن تكون هادية ، ولن تكون محققة للمقصود إلا لمن هداه الله عز وجل ، فإذا كان كتاب الله عز وجل لم يهتدي به بعض الناس – إلا بإذن الله- فمن شاء الله هدايته اهتدى ، فكذلك كلام أهل العلم ، مهما كان بينا واضحا ، فإنه لن يكون سببا لهداية الناس إلا من وفقه الله عز وجل لهذا. هذا والله أعلم وصلى الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! " |
|
#2
|
|||
|
|||
|
اللهم بارك!
مِن نقلك أم من جهدك -يا أم عامر-؟! حبذا لو بيَّنتِ -عمر الله أوقاتك بطاعته-! |
|
#3
|
|||
|
|||
|
بحثت عن تفريغ لهذا الشرح في الشبكة ، فلم أظفر بشيء ، فاستعنت بالله وقمت بتفريغها ، إلى الآن لم أكملها ، لكن سأنتهي خلال أيام يإذن الله.
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! " |
|
#4
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم تابع مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله (الدرس الثاني) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :[فَصْلُ: يجب أنَّ يعلم أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بيِّنَ لأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ ، كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا.] هذا الفصل عقده المصنف ؛ ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن للأمة تفسير القرآن ، كما بيّن ألفاظه ، أما ألفاظه فقد تلقتها الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغه جبريل ، فتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ، وجبريل تلقاه من رب العالمين ، ولهذا فهذا الكتاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه ولا لجبريل إلا البلاغ ، وهو كلام رب العالمين في لفظه ومعناه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى لفظه ، كما سمعه من جبريل ، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم تصرف في ألفاظه ، بخلاف السنة النبوية ، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيها عن الله عز وجل بتعبير النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا امتن الله عز وجل عليه بقوة البيان ، وأوتي جوامع الكلم ، فكان يعبر عن المعاني التي أراد بأفضل عبارة تدل على المعنى المراد وهذا في السنة النبوية ، أما في الأحاديث القدسية فهي أيضا من كلام رب العالمين ، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أي تصرف لا في ألفاظها ولا في معانيها ، وإنما قد يفسرها كما يفسر القرآن ، فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا من كلامه ، أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه من الأحاديث القدسية فهي بألفاظها ومعانيها من الله عز وجل ، وأما الأحاديث النبوية وهي التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي وعما أوحى الله عز وجل إليه في بعض المسائل فيعبر بلفظه ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى" هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما المعنى الذي عبر عنه هو وحي من الله ، ولهذا السنة وحي كما أن القرآن وحي ، لكن السنة النبوية عبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بألفاظه ، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في الرد على المخالفين في ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أن هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم ، إما في بلاغه وفي علمه ، وإما في بيانه ، أو في ضعف إرادته عن البيان ، فإذا اكتملت قوة العلم ، وقوة البيان ، وقوة الإرادة ، فإنه لا يمكن أن يرد على ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه شيء من الخلل ، كما يحصل لبعض الناس الذي قد تكون له قوة علمية ولكن ليس له قوة بيان ، فيأتيه خلل من جهة ضعف البيان ، أما النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل من قوة البيان ما يستطيع أن يعبر عما أراد من المعاني التي أوحى الله عز وجل بها إليه. فقال المصنف رحمه الله هنا: (فَصْلُ: يجب أنَّ يعلم أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بيِّنَ لأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ ، كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ) بيّن المعاني بشرحه وتفسيره لها ، وهذا مما يدل على أن جزء من التفسير مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ابن عباس في أن التفسير على مراتب: منه ما يعرف بالقرآن ، ومنه ما يعرف بالسنة ، ومنه ما يعرف من لغة العرب. (كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ) أي بين المعاني كما بين الألفاظ ، لـ (قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ يَتَنَاوَلُ هَذَا وَهَذَا) فإن البيان هنا يتناول اللفظ والمعنى ، وإلا فلا معنى لكتاب ينزل على أمة تضبط ألفاظه ، ولا تضبط معانيه ، فلا يكون حصل البلاغ ، ولا حصل البيان ؛ لأن المقصود بهذا الكتاب ليس هو كما يزعم المفوضة: أنه متعبد بتلاوته دون فهم معانيه ! بل هذا باطل ! ، قال ابن مسعود: ما أنزل الله آية ، إلا وهو يحب أن يُعلم ما أراد منها. فالله عز وجل ما أنزل هذا القرآن ليتلى فقط ، وليتبعد بتلاوته ، مثلما هو حاصل في الأذكار ؛ فالأذكار متعبد بقولها ، وإن كان هناك لمن تأمل ما فيها من المعاني فهو يستنبط الأحكام ، ولكن الأصل فيها التعبد ، ولهذا فهذه الأذكار يرددها الإنسان ؛ لأنه متعبد بترديدها وبقولها ، والقرآن يتلوه الإنسان ويتدبر فيه ، ويتأمل معانيه ، فالمقصود أن البلاغ لا يحصل بمجرد بلاغ اللفظ ، بل لابد من بلاغ المعنى ، وإلا لما حصل هناك فهم ولا فقه ولا عمل لكتاب لا يعرف معناه ، ولهذا قال المصنف هنا: (يجب أنَّ يعلم أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بيِّنَ لأَصْحَابِهِ مَعَانِيَ القُرْآنِ ، كَمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ) وهذه مقدمة مهمة جدا ، يعني تَحفز الهمم على البحث على المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يحصل العجز عن ذلك ، بل الإعراض كما ذهب المفوضة ، يقولون: ما أُمرنا بهذا ، الله أعلم بمراد كلامه!!! أو أيضا أن ينحرف الناظر في هذا الأمر بأن يفسره بغير ما فسره به النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب هو تلقي هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى ، كما اعتنت الأمة بلفظه ، يجب أن تعني بمعانيه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: [وَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ: حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا القُرْآنَ، كَـ: عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمَا: (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ؛ قَالُوا: فَتَعَلَّمْنَا القُرْآنَ وَالعِلْمَ وَالعَمَلَ جَمِيعاً)؛ وَلِهَذَا كَانُوا يَبْقَونَ مُدَّةً فِي حِفْظِ السُّورَةِ.] ثم قال المصنف (وَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ) وهو من التابعين (حَدَّثَنَا الَّذِينَ كَانُوا يُقْرِئُونَنَا القُرْآنَ، كَـ: عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِمَا: (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ) وهذا خبر من هذا التابعي عن القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يقرئونهم القرآن - يعلمونهم القرآن- ، (أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تَعَلَّمُوا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهَا حَتَّى يَتَعَلَّمُوا مَا فِيهَا مِنَ العِلْمِ وَالعَمَلِ) وهذا دليل على أنهم في تعلمهم للقرآن يتعلمون القرآن ويتعلمون معه العلم والعمل ، فما كان همهم معرفة العلم ، بل كانوا يعرفون العلم والعمل ، وهذا دليل على فقههم ، وأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل لبيان العلم والحق وللعمل ، فمن استفرغ جهده في تعلم القرآن دون العمل به فقد يأتي الأجل وهو لم يعمل ، فلا يكون ممن عمل بالقرآن ، ولهذا كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل ؛ لأن القرآن وكل ما ورد في كتاب الله ، إما آية فيها علم وخبر ، وإما فيها أمر أو نهي ، فالأمر والنهي متعلق بالعمل: أن يعمل بأوامره ، وأن ينتهى عن نواهيه ، وإما أن تكون متعلقة بالإخبار كما أخبر الله عز وجل عن الأنبياء الصادقين ، وما أخبر الله عز وجل عما يحصل يوم القيامة ، فالإيمان بالقرآن في هذا المقام هو: أن يُصدَق ما جاء فيه من الأخبار ، ويعتقد أنها حق ، وكذلك أن يعتقد أن ما جاء فيه من الأوامر والنواهي أنه يجب أن تلتزم ، ولهذا مدار الإيمان على هذا: التصديق بالأخبار ، وتحليل الحلال ، وحريم الحرام. وأما التقصير في العمل فله تفضيل بعد ذلك ، لكن لابد من هذا في الإيمان ، ولهذا ذكر العلماء في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم: تصديقه فيما أخبر ، وطاعته فيما نهى عنه وزجر ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ، هذا حقيقة الإيمان. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن ويتعلمون العلم والعمل ، فإذا كانت آية في العلم عرفوا مقصود الآية ومدلولها وعلى أي شيء دلت ، وإذا كانت في الأوامر والنواهي ، عرفوا ما هو الشيء المأمور به ، وما هو الشيء المنهي عنه وامتثلوا العمل ، فتعلموا القرآن ، وتعلموا العلم والعمل ، وهذا بخلاف ما عليه الآن المتأخرون كما تلاحظون ، أنه يبدأ بحفظ القرآن وقد ينتهي المتعلم من حفظ القرآن وهو لا يعرف شيئا من الأحكام ، ولهذا تلاحظون الخلل الموجود في بعض من يحفظ القرآن في أنه قد ينحرف ، بخلاف ما كان في عصر السلف خاصة في عصر الصحابة فإن الذي يكمل القرآن بل يحفظ شيئا من القرآن ، يكون له من الفقه بقدر ما قرأ من القرآن ، بل حصل هذا الانحراف في وقت مبكر، كما حصل من الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: "يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم" فهم يقرؤؤن القرآن ، ويقيمون ألفاظه ، لكنه لا يبلغ صدورهم ، وليس لهم تدبر ولا فهم ؛ ولهذا ضلوا ، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم به ، مع حفظهم للقرآن ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه يأتي في آخر الزمان ، أقوام يقيمون القرآن كما يقام السهم" ومع هذا لا يعملون به ، أي: يضبطون ألفاظه ولا يعرفون معانيه بل يخالفونها ، والمقصود هو: ضبط القرآن لفظا ومعنى ، فاللفظ متعلق بحفظه ، والمعنى متعلق بالفقه والفهم ، ثم بعد ذلك امتثال العمل بالقرآن ، (قَالُوا: فَتَعَلَّمْنَا القُرْآنَ وَالعِلْمَ وَالعَمَلَ جَمِيعاً) أي: أنهم تعلموا القرآن ، وتعلموا ما فيه من العلم والعمل ، والقرآن إما مشتمل على العلم والخبر ، وإما على الأمر والنهي ، ولهذا يقال: إن هذا من باب الخبر ، وهذا من باب الإنشاء ، والقرآن مشتمل على هذا وهذا ، والإيمان الصحيح بالقرآن لابد أن يتضمن الأمرين: وهو أن يُعتنى بما جاء فيه من العلم والعمل. قال: (وَلِهَذَا كَانُوا يَبْقَونَ مُدَّةً فِي حِفْظِ السُّورَةِ) ؛ لأن ضبط القرآة ، وما في الآيات من العلم والعمل والامتثال يأخذ وقتا طويلا من هؤلاء ، فكان أحدهم يبقى في السورة الوقت الطويل حتى يضبط هذه السورة. وقالَ رحمه الله: [وَلِهَذَا كَانُوا يَبْقَونَ مُدَّةً فِي حِفْظِ السُّورَةِ. وقَالَ أَنَسٌ: (كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «البَقَرَةَ» وَ«آلَ عِمْرَانَ» جَلَّ فِي أَعْيُنِنَا). وَأَقَامَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ «البَقَرَةِ» عِدَّةَ سِنِينَ، قِيلَ ثَمَانِيَ سِنِينَ، ذَكَرَهُ مَالِكٌ.] هذه نماذج من فعل السلف ، (وقَالَ أَنَسٌ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ «البَقَرَةَ» وَ«آلَ عِمْرَانَ» جَلَّ فِي أَعْيُنِنَا) قرأها ليس مجرد قراءة ، وليس مجرد حفظ ، ولكن على الطريقة التي ذكروها ، أنهم ما كانوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا ما فيه من العلم والعمل ، ولهذا كان أحدهم إذا ختم البقرة وآل عمران حفظا وفهما وامتثالا للعمل ، قال: (جَلَّ فِي أَعْيُنِنَا)) يعني أصبحت له مكانة وجلالة في أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من فقههم. قال: (وَأَقَامَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حِفْظِ «البَقَرَةِ» عِدَّةَ سِنِينَ، قِيلَ ثَمَانِيَ سِنِينَ، ذَكَرَهُ مَالِكٌ.) هذا أيضا مثال لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وهو معروف بجلده وشدة حرصه على الخير ؛ أنه حفظ البقرة عدة سنين ، قيل ثماني سنين وهو يحفظ البقرة ، لكن على الطريقة التي ذكر التابعي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: [وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾] هذا في بيان أن القرآن أنزله الله عز وجل للتدبر ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ أي ليتفهموا آياته ، والتدبر قيل: هو النظر إلى دوابر الأمور ، أي الذي ينظر في عواقب الأمور ودوابرها يقال إنه متدبر ، وهذا يتضمن أن ينظر في أول الآية ، وفي آخرها ، وما قبلها ، وما بعدها ، فهذا هو حقيقة التدبر ، وحَسَنُ التدبير هو الذي ينظر إلى العواقب ، بعض الناس إذا نظر إلى شيء نظر إلى عواقب الأمر ، فيقدر حالا له بعد هذا ، إذا فعلت كذا ما هي النتيجة؟ فينظر إلى عواقب الأمور ، والذي لا ينظر إلا إلى الشيء أمامه لا يكون متدبرا ، فكذلك التدبر للقرآن هو أن ينظر إلى معاني هذه الآيات وما قبلها وما بعدها فيكون متدبرا ، ولهذا كان بعض السلف يقرأ الآية ويرددها كثيرا ؛ ليتدبر ؛ لأنه كلما مر عليها تلاوة تدبر فيها معنى ، فمرة يقرأ الآية وينظر إلى معنى في أول الآية ، ثم يقرؤها المرة الثانية فينظر في معنى في آخرها ، ثم يقرأ يعيد ويجمع بين الأمرين ، ثم ينظر إلى ما قبلها وما بعدها ، ولهذا من تأمل تفسير السلف خصوصا تفسير ابن عباس ومن بعده ومن أخذ عنه من التابعين يدرك أن كثيرا من التفاسير - لو تأمل متأمل- يقول: كيف قيل بهذا التفسير ؟ وقد لا يظهر لنا الآن أن في هذه الآية دليل على هذا التفسير ، ولكن لو تأملت فيما قبل هذه الآية تدرك المعنى الذي أخذه واستنبطه المفسر عندما فسر هذه الآية بهذا ، هذا عن طريق التدبر لمعاني القرآن ، سبق أن نبهنا على نماذج من هذا في السنة ، فإن الأمور المتقابلة يدل بعضها على بعض ، فانظر بين المتقابلات ، تتنبه للقسمة ، وإلى بعض الأحوال التي لا ينظر إليها من فسر اللفظ فقط. قال رحمه الله: [ وَقَالَ: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ وَقَالَ: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ ؛ وَتَدَبُّرُ الكَلَامِ بِدُونِ فَهْمِ مَعَانِيهِ لَا يُمْكِنُ!] هذا أيضا فيما جاء من الحث على تدبر كتاب الله تعالى ، قال: (وَتَدَبُّرُ الكَلَامِ بِدُونِ فَهْمِ مَعَانِيهِ لَا يُمْكِنُ) إذ أن التدبر له مرتبتان ، المرتبة الأولى: فهم المعنى ، والمرتبة الثانية: هو أن يجمع بين هذه المعاني ، وبيم هذه الألفاظ ، وأن ينظر في مفهوم هذا اللفظ. ولهذا من رزق هذا الأمر يرزق علما غزيرا عن طريق تدبره ، ولهذا كان العلماء ينظرون إلى مفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة ، ولهذا استنبط العلماء الكثير من الأحكام بالنظر إلى مفهوم المخالفة ، وهل مفهوم المخالفة يعمل به أم لا ؟ وللعلماء كلام يطول في هذا ، وكذلك دلالة السياق ؛ فإن السياق قد يدل على معنى لا يتنبه إليه من نظر إلى اللفظ ، ولهذا انحرف كثير من الناس في هذا الباب ؛ لنظرهم إلى دلالة اللفظ فقط ، مثل من ينظر إلى (الخير) في كتاب الله عز وجل ، يظن أنه كلما ورد هذا اللفظ ، أنه يراد به معنى واحد ، مع أن الخير يتنوع معناه في كتاب الله عز وجل ، فقد يراد به: الدنيا ، وقد يراد به الحسنة ، وقد يراد به الثواب ، وقد يراد به معنى آخر ، فهذا يعرف من دلالة السياق ، هذه لفظة واحدة لا يمكن لمن نظر إلى تفسير هذا اللفظ أن يدرك هذا المعنى إلا أن ينظر إلى دلالة السياق ، وكذلك دلالة السباق: وهو ما يسبق هذا السياق من دلالات ومن معاني ، وكذلك دلالة النص: النصوص الأخرى فإن كتاب الله منزه عن التعارض ، فلا يمكن ما توهم بعض الناس هنا أنه مثبت يأتي في موطن آخر ويكون منفي. فلابد أن يكون هناك فرق بين ما يقال أنه هنا مثبت ، وأنه منفي في مكان آخر. وكذلك دلالة الأصول وقواعد الشرع: مثل دلالة النصوص على أن ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئة الله ، فإذا ما جاء في بعض النصوص ما يدل على أن بعض الذنوب لا يغفره الله فهذا لابد أن يكون له معنى ، والمقصود أن هذا الأصل يرد هذا المعنى الذي يفسره أو يقول به المفسر إذا ما تأمل الأصل فإنه يجد أن هذا يعارض هذا الأصل ، وقد سبق التنبيه في شرح الأحاديث –خصوصا في الأربعين النووية- أن العلماء فسروا بعض الأحاديث بتفسيرات قد يظن الظان أنهم خرجوا عن المعنى القريب إلى التأويل ، وهم في الحقيقة إنما يطلبون موافقة الأصول ، فإنه لا يمكن لنص أن يخالف الأصول وقواعد الشريعة ، فلابد أن يكون له دلالة مثل: "الطهور شطر الإيمان" هذا أشكل على العلماء ، كيف يكون الوضوء هو شطر الإيمان ؟ وإنما هو شرط لصحة الصلاة ، وهل الصلاة شطر الإيمان بالنظر إلى القسمة ؟ تكلم العلماء في هذا ، وخرجوا تخريجات متنوعة طلبا لموافقة الأصول. قال رحمه الله: [وَكَذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ؛ وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَضَمِّنٌ لِفَهْمِهِ.] كذلك قول الله عز وجل ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً﴾ أي أنه نزل بلسان العرب ، بلغة العرب ، ثم قال: ﴿ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (ولعل) إذا وردت في كتاب الله عز وجل ، المقصود بها تحقق الشيء: أي أنه قرآنٌ نزل بلغتكم ، فأنتم تعقلونه ، إذا ما تدبرتم القرآن. قال المصنف رحمه الله: (وَعَقْلُ الْكَلَامِ مُتَضَمِّنٌ لِفَهْمِهِ): لأن العقل هو الإدراك ، ولا يمكن أن يكون هناك تعقل للقرآن دون فهم ، ولهذا إذا لم يحصل للإنسان الفهم فهو معذور ، كالذي لا يعقل ، فلاحظوا الجمع بين ما ورد في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: -قال- والمجنون حتى يعقل" لم رفع القلم عن المجنون؟ لأنه لا يعقل ولا يفهم ، فهنا مدار الحكم على الفهم والعقل ، ولهذا ذكر العلماء في مسألة العذر بالجهل: أن كل من يجهل أو من يقف على النص ولا يفهم ، فإنه معذور إذا استفرغ جهده ووسعه في الاجتهاد ؛ لأن مناط الحكم ومدار الحكم على الفهم. وقد ذكر هذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره من العلماء ومنهم من نقل الإجماع على أن مناط التكليف على الفهم والعقل ، ولهذا عذر الصبي ؛ لأنه لا يميز ، ولا يعقل ، وعذر المجنون كذلك ، وكذلك الأعجمي الذي لا يفهم الخطاب وهو من الذين يدلون على الله بحجة يوم القيامة ، وكذلك المعتوه ، فهؤلاء إنما عذروا ؛ لأنهم لم يفهموا ، إذن فلابد من الفهم ، ولايتصور أن يكون هناك تعقل وتدبر بلا فهم ، ولهذا لما فقد بعض أهل العلم بل الأئمة الكبار الفهم لبعض ألفاظ الكتاب والسنة حصلت لهم أخطاء كبيرة –مع مكانتهم في العلم- ؛ لأن أول مراتب العلم هو الفهم للفظ ، فإذا عرف اللفظ استطاع أن يتدبر وأن يفهم ، ثم على ضوء ذلك يحصل له التصور الصحيح للنص ، وإلا إذا فقد الفهم فإنه فلا يمكن أن يكون هناك تدبر وتعقل لمن لا يفهم ألفاظ الكتاب والسنة. قال رحمه الله: [ ومن المَعْلُومِ أَنَّ كُلَّ كَلَامٍ فَالمَقْصُودُ مِنْهُ فَهْمُ مَعَانِيهِ دُونَ مُجَرَّدِ أَلْفَاظِهِ، فَـ «القُرْآنُ» أَوْلَى بِذَلِكَ.] نعم المقصود من كل كلام هو معرفة الألفاظ ومعرفة المعاني ، مع الوقوف على اللفظ ، فكل متكلم يحب أن يعرف مراد كلامه ، وأولى الكلام بمعرفة المعاني ومعرفة ما تضمنه الأحكام هو كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل وهو تشريع للأمة ، فيه بيان الأحكام ، والحلال والحرام ، فلا يمكن أن يكون هذا القرآن الذي تضمن هذه الأحكام العظيمة أن يكون الله خاطبنا به لنعرف ألفاظه ولنتلوه دون أن نتدبر معانيه. قال رحمه الله: [وَأَيْضاً فَالعَادَةُ تَمْنَعُ أَنْ يَقْرَأَ قَوْمٌ كِتَاباً فِي فَنٍّ مِنَ العِلْمِ، كَـ «الطِّبُّ»، وَ«الحِسَابِ». وَلَا يَسْتَشْرِحُوهُ؛ فَكَيْفَ «بِكَلَامِ اللهِ» تَعَالَى الَّذِي هُوَ عِصْمَتُهُمْ، وَبِهِ نَجَاتُهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ، وَقِيَامُ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ.] هذا أيضا من التمثيل الذي يدركه عامة الناس في أن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه أي لا يطلبوا شرحه ، وإنما يقولون اكتفينا بما فيه وبما جاء فيه ، ولهذا درج العلماء على شرح الكتب ، وكذلك أهل العلم يسألون عما أشكل من الكتب والكلام وهذا من قديم كما عرض مجاهد القرآن على ابن عباس يسأله عن كل آية وعن معناها ، وهذا طلب للشرح والتفسير ، كذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى العلماء بضبط ألفاظها ، وشرح معانيها ، ولهذا لمّا لاحظ بعض أهل العلم وبعض الأئمة أن بعض الناس همتهم في الحديث معرفة الأسانيد دون التفقه في المعاني ذموا هؤلاء حتى قال بعضهم: إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله. هم لا يقصدون بهذا معرفة الأسانيد التي يعرف بها الصحيح من الضعيف ، لكن أصبح للناس مبالغة في طلب الأسانيد وفي تتبعها دون التأمل لما ورد في الأسانيد من المتون ، والتفقه في ذلك. ولهذا تلاحظون أن من اكتفى بذلك في رواية الحديث لم يحصل له الفقه والفهم الذي حصل للفقهاء ، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المصنفين في السنة ليسوا على درجة واحدة ، فذكر منهم من صنف عن فقه ، وذكر منهم: الإمام البخاري والإمام أبوداود والإمام أحمد والنسائي ، فجمعوا بين التصنيف في الحديث مع الفقه. وبعضهم جمع الأحاديث واعتنى بها ولكن لم يكن لهم من الفقه ما لهؤلاء ، وهذا لا يعني أن هؤلاء الذين صنفوا وكانوا دون ذلك أنهم فقدوا الفقه بالكلية ، لكن من العلماء من له فقه وفهم مع رواية الأحاديث فهو إمام في هذا مثل الإمام البخاري ولهذا لقب بأنه أمير المؤمنين في الحديث ؛ لجمعه بين العناية بالأحاديث ، وضبطها لفظا ومعنى ، ولهذا كان ترتيبه للصحيح وفقهه في ترتيبه كان محل دراسة مطولة للعلماء ، وما زال العلماء يستنبطون الأحكام من تراجم الإمام البخاري ، فالمقصود هو العناية بالألفاظ والمعاني ، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه من الممتنع أن يكون هناك كتاب في الطب أو الهندسة أو علم من العلوم يأخذه الناس ولا يهتمون بشرحه ، ولا يطلبون شرحه وبيان ما فيه ، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم ، فعصمتهم ليست بتلاوة القرآن فقط ، وإلا لعصم الخوارج ، وإنما بفهم القرآن ، وبمعرفة ما جاء في القرآن ، ولهذا القرآن يدل على العلم ، ويدل على الفقه ، فإذا كان الذي يأخذ القرآن هو يأخذه بمجرد ألفاظه ولا يعرف معانيه لم يكن هذا من الفقهاء ، وإنما هو من القراء الذين يقرؤون القرآن وليس لهم هذا الفهم ، كما وجد الآن في هذه العصور من يكون له تخصص في القراءة لا يكاد يعرف شيئا من الأحكام ، حتى الأحكام المتعلقة بالتلاوة مثل أحكام سجود التلاوة لا يعرفها ، فوصل الأمر إلى حد أن أبسط الأحكام مما يتعلق بأحكام الشرع حتى أحكام التلاوة ، وهل عند تلاوة القرآن يشترط الطهارة أم لا ؟ كثير من القراء قد لا يكون له معرفة ووقوف على وجه التفصيل ، كما له ذلك التفصيل الذي يقف عليه في أحكام القراءات ، وهذا مما يدل على وجود الخلل ، وإلا فأولى الناس بالفقه هم أهل القرآن. قال رحمه الله: [وَلِهَذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي «تَفْسِيرِ القُرْآنِ» قَلِيلاً جِدّاً، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ فَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ. وَكُلَّمَا كَانَ العَصْرُ أَشْرَفَ كَانَ الاجْتِمَاعُ وَالائْتِلَافُ وَالعِلْمُ وَالبَيَانُ فِيهِ أَكْثَرَ.] قال: (وَلِهَذَا كَانَ النِّزَاعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي «تَفْسِيرِ القُرْآنِ» قَلِيلاً جِدّاً) ؛ لأنهم جمعوا بين العلم بلفظه ومعناه ، وكلما قوي العلم كلما قل الخلاف ، وكلما قل العلم كثر الخلاف – مثل ما هو حاصل الآن- فالخلاف كثير لقة العلم ، ولهذا نلاحظ أنه كلما علت درجة الرجل في العلم ، قلت مخالفته للعلماء ، وكلما جهل كان أكثر مخالفة ، فعصر الصحابة إذا وجد الخلاف فهو قليل بالنسبة لمن بعدهم. قال: (وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي التَّابِعِينَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي الصَّحَابَةِ فَهُوَ قَلِيلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ) يعني ولو وجد أيضا في عصر التابعين من الاختلاف إلا أنه دون من جاء من بعدهم من العصور من الاختلاف. قال: (وَكُلَّمَا كَانَ العَصْرُ أَشْرَفَ كَانَ الاجْتِمَاعُ وَالائْتِلَافُ وَالعِلْمُ وَالبَيَانُ فِيهِ أَكْثَرَ) ولهذا ما وجد نزاع بين الصحابة ، كما وجد بين التابعين ، وكذلك ما وجد بين التابعين فهو أقل بكثير مما وجد بعدهم ، ولهذا انقضت العصور الثلاثة المفضلة ، وليس بين الأمة وعلمائها نزاع في مسائل أصول الدين ، وإنما يحصل بينهم نزاع في بعض المسائل العملية والفرعية ، وأما بعد ذلك العصر فوجد النزاع بين الأمة في أصول الدين وفي الأصول العظيمة ، حتى ظهرت البدع وعمت الناس حتى أصبح في بعض العصور التي جاءت بعد العصور الثلاث المفضلة اشتبه الأمر على الناس ، إلى أن وصل الأمر في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اشتباه عظيم حتى لا يكاد يعرف السنة إلا قلة قليلة من الناس. قال رحمه الله: [وَمِنَ التَّابِعِينَ مَنْ تَلَقَّى جَمِيعَ «التَّفْسِيرِ» عَنْ الصَّحَابَةِ. كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ: (عَرَضْتُ «المُصْحَفَ» عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ، أُوقِفُهُ عِنْدَ كُلِّ آيَةِ مِنْهُ وَأَسْأَلُهُ عَنْهَا) ، وَلِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: (إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ) ، وَلِهَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ: الشَّافِعِيُّ، وَالبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْل العِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي «التَّفْسِيرِ»، يُكَرِّرُ الطُّرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ.] هنا ذكر شيخ الإسلام عناية التابعين بتلقي هذا الباب من أبواب العلم عن الصحابة ، كما حصل مع مجاهد رحمه الله في أنه عرض القرآن على ابن عباس يقفه عند كل آية ويسأله عن معناها ، وهذا دليل على أنهم كانوا قد تلقوا هذا التفسير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، كما تلقاه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال: (وَلِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ: (إِذَا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدٍ فَحَسْبُكَ بِهِ)) يعني أنه يكفي الناظر في هذا الباب ما جاء عن مجاهد ؛ لأن هذا التفسير أخذ عن ابن عباس ، والصحابة أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقدم على غيره ، قال: (وَلِهَذَا يَعْتَمِدُ عَلَى تَفْسِيرِهِ: الشَّافِعِيُّ، وَالبُخَارِيُّ) وهذا من دقة شيخ الإسلام ذكر الإمام الشافعي والبخاري وهما من أجلة الفقهاء وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْل العِلْمِ ، وَكَذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ مِمَّنْ صَنَّفَ فِي «التَّفْسِيرِ») أي يعتنون بتفسير مجاهد (يُكَرِّرُ الطُّرُقَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ) لأن له تميزا عن غيره ؛ لأنه تلقى عن ابن عباس ، ولهذا يكرر الطرق عن مجاهد في أوجه التفسير أكثر من غيره. قال رحمه الله: [وَالمَقْصُودُ أَنَّ التَّابِعِينَ تَلَقَّوُا التَّفْسِيرَ عَنْ الصَّحَابَةِ. كَمَا تَلَقَّوا عَنْهُمْ «عِلْمَ السُّنَةِ»؛ وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالاسْتِنْبَاطِ وَالاسْتِدْلَالِ، كَمَا يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ السُّنَنِ بِالاسْتِنْبَاِط وَالاسْتِدْلَالِ.] المقصود من هذا: (أَنَّ التَّابِعِينَ تَلَقَّوُا التَّفْسِيرَ عَنْ الصَّحَابَةِ) أي أخذوا التفسير من الصحابة ، قال: (كَمَا تَلَقَّوا عَنْهُمْ «عِلْمَ السُّنَةِ) ، فأخذوا التفسير وتلقوه كما تلقوا علم السنة ، قال: (وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالاسْتِنْبَاطِ وَالاسْتِدْلَالِ) هذا من دقة شيخ الإسلام ؛ أن تفسير التابعين لم يكن كله مأخوذ ومتلقى عن الصحابة ، وإنما كانوا يتكلمون في بعض ذلك بالاستباط والاستدلال ، كما أيضا أن الصحابة كانوا كذلك ، ولهذا لم يكن تفسير ابن عباس الذي ينقل عنه يقال أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو تفسير ابن عباس ، ولهذا قد يُخالَف في التفسير ، فيكون الراجح مع غيره ، لكن الصواب فيه أكثر. والاختلاف في هذا التفسير من باب التنوع لا من باب التضاد كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ، كذلك التابعون قد يفسرون بالاستنباط مالم يتلقوه عن الصحابة ، ولكن هذا من استنباط العلماء ، وما زال العلماء ينظرون في القرآن ، ويستبطون منه الأحكام ويظهر بعد ذلك صواب المفسر لهذا الحكم بدلالة النصوص الأخرى. قال: (َمَا يَتَكَلَّمُونَ فِي بَعْضِ السُّنَنِ بِالاسْتِنْبَاِط وَالاسْتِدْلَالِ) أيضا يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال ، لاحظوا قول شيخ الإسلام ابن تيمية (الاستنباط والاستدلال) استنباط الحكم من النص وليس هذا الاجتهاد بمعزل عن النص ، والاستدلال به بالنص على هذا الاستنباط وعلى هذا الفهم ، والاستباط هو استخراج الحكم من النص. قال رحمه الله: [ فَصْلٌ: الخِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ قَلِيلٌ، وَخِلَافُهُمْ فِي الأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلَافِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ. وَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِنَ الخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى «اخْتِلَافِ تَنَوُّعٍ» لَا«اخْتِلَافِ تَضَادٍّ»؛ وَذَلِكَ صِنْفَانِ] ثم ذكر المصنف أن (الخِلَافُ بَيْنَ السَّلَفِ فِي التَّفْسِيرِ قَلِيلٌ، وَخِلَافُهُمْ فِي الأَحْكَامِ أَكْثَرُ مِنْ خِلَافِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ) خلافهم في الأحكام أي اختلافهم في تقرير الأحكام ، أكثر من اختلافهم في التفسير ، وذلك أن جهود السلف في العلم متنوعة ، فمنها ما هو من قبيل التفسير ، ومنها ما هو من قبيل استنباط الأحكام ، فاستنباطهم للأحكام قد يوجد هناك خلاف في بعض الأحكام ، وأما في التفسير فهو قليل ؛ لأنه تفسير لكلام الله عز وجل ، وعامة ما ينقل عنهم هو من التفسير بالمأثور المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة ، ولهذا قل الخلاف ، بخلاف الأحكام فلهم فيها اجتهاد واستنباط ، فخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير ، قال: (وَغَالِبُ مَا يَصِحُّ عَنْهُمْ مِنَ الخِلَافِ يَرْجِعُ إِلَى «اخْتِلَافِ تَنَوُّعٍ» لَا«اخْتِلَافِ تَضَادٍّ») ثم بيّن أن ما ينقل عنهم من الاختلاف أنه يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد ، فاختلاف التنوع: هو تنوع العبارات مع دلالتها على معنى واحد ، واختلاف التضاد: هو تباين العبارات في اللفظ والمعنى ، ولهذا كثيرا ما يظن أن هناك اختلاف [تضاد] بين أقوال السلف في التفسير فيتبين أنها ليست مختلفة ، وإنما اختلافها من باب اختلاف التنوع أي تنوع الألفاظ مع دلالتها على معنى واحد ، ثم ذكر أن ذلك يرجع إلى صنفين: قال رحمه الله: [ أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ المُرَادِ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ ، تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي المُسَمَّى غَيْرِ المَعْنَى الآخَرِ ، مَعَ اتِّحَادِ المُسَمَّى ، بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ المُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ وَالمُتَبَايِنَةِ ، كَمَا قِيلَ فِي اسْمِ السَّيْفِ: «الصَّارِمُ» وَ«المُهَنَّدُ».] قال إن هذا الاختلاف يرجع إلى نوعين: (أَحَدُهُمَا: أَنْ يُعَبِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ المُرَادِ بِعِبَارَةٍ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ ، تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي المُسَمَّى غَيْرِ المَعْنَى الآخَرِ مَعَ اتِّحَادِ المُسَمَّى) أي أن كل واحد منهم يعبر عن المسمى بعبارة تدل عليه ، فهناك اختلاف في التعبير ، وفي الألفاظ مع دلالة هذه العبارات على مسمى واحد ، مع اتحاد المسمى. قال: (، بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ المُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ وَالمُتَبَايِنَةِ ، كَمَا قِيلَ فِي اسْمِ السَّيْفِ: «الصَّارِمُ» وَ«المُهَنَّدُ».) في أن هذه أسماء للسيف ، تنوعت الأسماء لكنها تدل على مسمى واحد وهو السيف ، فذكر أن الاختلاف الذي حصل في تعبيرهم هو من باب الأسماء المتكافئة التبي بين المترادفة والمتباينة ، ولنا وقفة حقيقة عند هذه المسألة ، وذلك أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استشكل من كلام المصنف في هذا الموطن ، قول شيخ الإسلام أنها (متَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ وَالمُتَبَايِنَةِ) وأنا أقف عند هذا الاستشكال وأبين ما يظهر والله أعلم ، وأيضا نستفيد بعض الفوائد المنهجية من بعض العلماء في تقرير العلم ، وقد سبق أن نبهنا على بعض المسائل المتعلقة به. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه الرسالة ، قال: إن هذا مشكل – أو عبارة قريبة منها- ثم قال: إن هذه الأسماء التي يقال إنها متكافئة ، هي في الحقيقة مترادفة من وجه ، ومتباينة من وجه ، كما يقال في أسماء الله عز وجل أنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات ، وهنا وقفة في بيان معنى المترادفة ، والمتباينة ، لبيان وجه ذلك الاستشكال وما يظهر منه: أولا: الألفاظ والمعاني هي على أربعة أقسام ، فإذا اتحد اللفظ والمعنى يقال إنها: متواطئة ، مثل: لفظ الإنسان في دلالته على أفراده ، يقال هذا لفظ متواطئ كما يقال في زيد أنه انسان وفي عمرو ، فهذا لفظ متواطئ في اتحاده في اللفظ والمعنى. ويقابل المتواطئ: المتباين: وهو الاختلاف في اللفظ والمعنى ، مثل الشجر والحجر: فهما لفظان متباينان من حيث اللفظ ومن حيث المعنى ، ولهذا دائما الألفاظ المتباينة يقابلها المتواطئة. ثم هنالك الألفاظ المشتركة: وهو أن يتحد اللفظ مع تباين المعنى ، مثل: العين ، العين لفظ مشترك بين العين الجارية وهي الماء ، وبين العين الباصرة في المخلوقات ، فهذا لفظ مشترك بين هذا وهذا ، ومثل النسيان يطلق على الذهول وعلى الترك فهو لفظ مشترك. وهناك أيضا الأسماء المترادفة وهي التي تتنوع ألفاظها وتتحد في مسماها ، مثل ما ذكر المصنف هنا من الصارم والمهند فهي مترادفة في دلالتها على مسمى واحد ، ومثل الليث والأسد ، تنوع في الألفاظ والمعنى ، إذن فالألفاظ المترادفة هي المتنوعة في ألفاظها مع دلالتها على معنى واحد ، والمتباينة هي المختلفة في ألفاظها ومعانيها. فشيخ الإسلام يقول إن هذه الأسماء التي يكون لها دلالة من وجه ودلالة من وجه آخر مثل: أسماء الله عز وجل ، فهذه من قبيل الأسماء المتكافئة ، ولهذا قال شيخ الإسلام (بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ المُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ وَالمُتَبَايِنَةِ) فهي ليست مترادفة من كل وجه ، وليست متباينة من كل وجه ، ولهذا مثل الآن الصراط عندما يطلق ، يقال: إن الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو القرآن فهذه ألفاظ تدل على معنى ، وهي وإن تنوعت فإنها تدل على حقيقة واحدة وهو هذا الدين ، لكن قد يعبر بالصراط المستقيم عن القرآن باعتبار هو المبين لهذا الدين ، وقد يقال: إنه النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه هو المبلغ. فهذه الأسماء التي قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها متكافئة ليست مترادفة من كل وجه ، وليست هي متباينة من كل وجه ، ولهذا يقول العلماء إنها مترادفة باعتبار ، ومتباينة باعتبار. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما نظر إلى هذه الأسماء أنها تكون مترادفة باعتبار و[متباينة] باعتبار استشكل قول شيخ الإسلام أن هذه أسماء متكافئة ، قال: (بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ وَالمُتَبَايِنَةِ) فهو رحمه الله استشكل أن تكون هذه الأسماء يقال إنها بين المترادفة والمتباينة ، وهي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه ، وسبب هذا الإشكال: أن شيخ الإسلام أراد هنا الإسم المطلق الذي يطلق على هذه الأسماء ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله نظر إلى الاسم المقيد ، وهو في الحقيقة ليس هناك خلاف عند من يقول هذه أسماء مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار ، ليس هناك اختلاف مع من يقول إنها متكافئة ؛ لأن الذي يقول متكافئة ينظر إلى الاسم المطلق لها ، والذي يقول مترادفة باعتبار ومترادفة باعتبار ينظر إلى معنى خاص ، ويضرب لهذا مثال، ومثال ذلك: لو أن ثلاثة رجال أحدهم عالم بمسائل كثيرة ، والآخر جاهل ، وبينهما رجل ثالث يعلم ويجهل ، فلو قال رجل: إن هذا الذي بين الرجلين هو متوسط في حاله بين العلم والجهل ، فهذا اسم مطلق يقال: عالم وجاهل ومتوسط ، هذه أسماء مطلقة ، فلو قال قائل: إن قولنا متوسط مشكل ، فإن هذا عالم من وجه ، جاهل من وجه ، فمثل هذه المسألة هنا ، فالذي ينظر إلى المعنى المطلق يقول إن هذه متكافئة ، والذي ينظر إلى المعاني المقيدة يقول هي مترادفة باعتبار ، متباينة باعتبار ، ولهذا يتبين أن قول شيخ الإسلام (بِمَنْزِلَةِ الأَسْمَاءِ المُتَكَافِئَةِ الَّتِي بَيْنَ المُتَرَادِفَةِ وَالمُتَبَايِنَةِ) فلا يمكن أن تقول أن أسماء الله مترادفة وتسكت ، ولا يمكن أن تقول هي متباينة وتسكت ، لكن تقول هي مترادفة باعتبار ، ومتباينة باعتبار ، وعلى هذا فقول شيخ الإسلام أن هذه الأسماء متكافئة صحيح ، وهي بين المترادفة والمتباينة ، ولا يمكن أن تطلق عليها أنها مترادفة على الإطلاق ، أو أنها متباينة على الإطلاق ، ولكن إذا نظرنا إلى المعاني المقيدة فيكون الأمر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن هذه مترادفة باعتبار ، ومتباينة باعتبار ، لكن هذا لا يشكل على قول شيخ الإسلام أنها متكافئة ، وهذا مرجعه إلى التفريق بين الأسماء المطلقة والمقيدة ، وهذا حصل فيه إشكال لكثير من أهل العلم ، حتى في بعض الإطلاقات ، مثل قول من يقول في بعض الفرق: أنهم من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه ، فيقال: الأشاعرة من أهل السنة فيما وافقوا أهل السنة فيه ، ونسأل عن هذه المسألة ، فنقول: هذا مرجعه إلى التفريق بين الأسماء المطلقة والمقيدة ، فهل تستطيع أن تقول هم من أهل السنة؟ ما تستطيع أن تقول هذا تسكت وإنما تقيد هذا الإطلاق بقيد ، ولهذا يُفرق بين الأسماء المطلقة والمقيدة ، ولهذا حصل الإشكال لبعض الناس في الكلام ، الكلام له حقيقة مطلقة وهو أن الكلام هو: ما اجتمع فيه اللفظ والمعنى ، فمن نظر إلى بعض الإطلاقات وهو أن الكلام يطلق على اللفظ على سبيل التقييد ، أو على المعنى على سبيل التقييد ظن أنه هذا هو حقيقة الكلام. قد بيّن شيخ الإسلام في رده على الأشاعرة والمعتزلة أن الكلام يشمل اللفظ المعنى ، فالمعتزلة نظروا إلى النصوص في إطلاق الكلام على اللفظ فقالوا هو حقيقة في اللفظ ، والأشاعرة نظروا إطلاق النصوص في كلام العرب على المعنى فقالوا هو حقيقة في المعنى ، وهذا كلها معاني مقيدة. ففرق بين الكلام المطلق وبين الكلام المقيد ، ومن تنبه إلى هذا يتنبه إلى كثير من المسائل التي يحصل فيها خلاف بين العلماء ، مثل ما حصل هنا الاستشكال ، فكلام شيخ الإسلام غير مشكل ، ولهذا شيخ الإسلام الذي يقول أن هذه الأسماء متكافئة هو الذي قرر في مواطن أخرى أن هذه الأسماء مترادفة باعتبار ، ومتباينة باعتبار ، لكن باعتبار المعاني المقيدة ، أما باعتبار المعاني المطلقة فيقال هي متكافئة. أيضا هنا ملحظ مهم جدا: وهو تجرد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح كلام شيخ الإسلام لمّا استشكل هذا بيّن أن هذا مشكل. وأيضا مسلك آخر في كلامه رحمه الله: أنه كان في غاية الأدب مع شيخ الإسلام فإنه قال (كلامه مشكل أو أشكل هنا) ، ثم قال (إلا أنه يكون له معنى آخر) وهذا في غاية الأدب مع العلماء ، وهذا مما يدل على ما سبق التنبيه إليه وهو أن هؤلاء العلماء جمعوا بين أمرين: التجرد للحق وحسن الأدب مع العلماء ، فإنه من وفق لهذا فإنه يوفق لخير كثير ، وكذلك نحن هنا قد نستشكل ما استشكله الشيخ ابن عثيمين ، وقد يأتي من يستدرك على المتكلم في كلامه ، فيصوب الشيخ ابن عثيمين فيما قاله ، مع هذا يبقى الاحترام بين أهل العلم ، وأيضا ينبه على مسألة سبق التنبيه عليها وهو أن بعض المستشكلين قد يكون دون بعض من يستشكل كلامه من أهل العلم ، فهذا مما يدل على أن العلم لا يكون من كل وجه للفاضل ، ولهذا ذكر العلماء أيضا في مسألة الترجيح كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في رسالته في اختلاف العلماء وقول من قال إن المقلد يأخذ بقول أعلم العلماء وهذا قال به بعض أهل العلم كما ذكر هذا الشاطبي ، ذكر الإمام الشاطبي أن من سأل رجلا يعلم أن غيره أعلم منه ، فيكون هذا من اتباع الهوى ، فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا ليس بلازم دائما في أن يكون الصواب دائما مع الأعلم ، فقد يكون الصواب مع من دونه ، فالمقصود أن هذه الوقفات ينبغي أن يتنبه وأن يقف معها طلاب العلم ؛ ليدركوا هذا الأصل العظيم الذي عليه العلماء من التجرد للحق مع احترام أهل العلم ، وأنه لا يحجر على مجتهد وعلى ناظر كما يدعي بعض المتعصبة أنه لا يستدرك على فلان ، وكذلك لا يسلك المسلك الآخر السيء: وهو الجرأة على العلماء ، وإنما يحترم أهل العلم ، ويعلم لهم قدرهم ، مع النظر والتدبر لكلامهم ، كما أنّا إذا تدبرنا النصوص بقصد التفقه ، فكذلك على أهل العلم ينبغي الوقوف عنده ؛ لمعرفة الصواب من الخطأ ، وتصويب المصيب ، وكذلك التأدب مع المخطي بأن يكون الوقوف عند كلامه على وجه التصويب لا على وجه التشهير والتنقص من العلماء. فالمقصود أن شيخ الإسلام عندما ذكر هنا أن هذه الأسماء متكافئة هي بين المترادفة والمتباينة فلا يصح أن نسميها مترادفة على الإطلاق ، ولا متباينة على الإطلاق ، وإنما يقال هي مترادفة باعتبار متباينة باعتبار ، فكما أنّا قلنا في الرجل الذي توسط بين رجلين إذا أخذنا بالاسم المطلق نقول هو متوسط ، وإذا أردنا أن نفصل في حاله نقول هو جاهل من وجه ، عالم من وجه ، لكن هذا لا يعني أنه لا يقال إنه متوسط ، فهذا حق ، وهذا حق. قال رحمه الله: [ وَذَلِكَ مِثْلُ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى، وَأَسْمَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وَأَسْمَاءِ القُرْآنِ؛ فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُسَمى وَاحِدٍ، فَلَيْسَ دُعَاؤُهُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ الحُسْنَى مُضَادّاً لِدُعَائِهِ بِاسْمٍ آخَرَ؛ بَلْ الأَمْرُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوْ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ، وَكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ المُسَمَّاةِ وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمّنَهَا الاسْمُ؛ كَـ: «الْعَلِيمِ»، يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وَالْعِلْمِ، وَ«الْقَدِيرِ»، يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وَالقُدْرَةِ، وَ«الرَّحِيمِ» يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ وَالرَّحْمَةِ.] ذكر شيخ الإسلام أن هذا التنوع لا يضر في التعبير عن المسمى ، قال : (وَذَلِكَ مِثْلُ أَسْمَاءِ اللهِ الحُسْنَى، وَأَسْمَاءِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وَأَسْمَاءِ القُرْآنِ) قد ذكر شيخ الإسلام في موطن ، أن الأصل في أسماء المخلوقين أنها أعلام وليست بأوصاف إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها أسماء وأوصاف ، وأسماء القرآن ، والقرآن هو كلام الله ليس بمخلوق ، فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف ، وكذلك أسماء كتابه فهي أعلام وأوصاف ، وأما أسماء المخلوقين فالأصل فيها أنها أعلام وليست أوصاف ، فقد يتسمى بمحمد أو أحمد من لا تقوم فيه هذه الصفة ، وكذلك بعبدالرحمن أو عبدالله من لا تقوم فيه هذه الصفة ، وأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعلام وأوصاف ، قال: (فَإِنَّ أَسْمَاءَ اللهِ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى مُسَمى وَاحِدٍ) أي على ذات واحدة (فَلَيْسَ دُعَاؤُهُ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ الحُسْنَى مُضَادّاً لِدُعَائِهِ بِاسْمٍ آخَرَ) ليس هذا مضادا أن تدعو الله أو الرحمن كما قال الله ﴿قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوْ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ولهذا يلاحظ أن من دعا الله باسم من أسمائه لم يكن مشركا ؛ لأنه يدعو الله ، فلو دعاه في كل موطن باسم من أسمائه لا يقال إنه مشرك ، ولكن قد يقال أنه مقصر في أدب الدعاء ، في أنه يدعو الله عز وجل باسم من أسمائه ، مقتضى الفقه أن يدعو بما يتناسب مع الحال ، مثل أن يقول: يا رحيم انصرنا على الأعداء ، فهنا يقال: إنه خالف أدبا من آداب الدعاء ، فإن الله يُتوسل له بصفاته المتضمنة الأسماء لها في كل مقام بما يناسبه ، فيقال: يا عزيز انصرنا على أعدائنا ، ويا قوي انصرنا على أعدائنا ، ويستغفر بأسمائه التي هي مقتضى الرحمة والمغفرة ، فالمقصود أن من دعا الله عز وجل باسم من أسمائه لم يكن مشركا ولا يقال أنه دعا غير الله. قال: (وَكُلُّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ المُسَمَّاةِ وَعَلَى الصِّفَةِ الَّتِي تَضَمّنَهَا الاسْمُ) أسماء الله عز وجل تدل على الذات وتدل على الصفات ، ولهذا فليست هي أسماء مجرده ، وإنما هي أعلام وأوصاف ، كل اسم يتضمن صفة ، ولهذا تنوعت الأسماء ، وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل ، وهو مستحق لها كلها ، ولما تضمنته من [صفات] ، وإلا لو كان كلها لها معنى واحد كان من العبث أن يدعا بأسماء متنوعة في ألفاظها وهي تدل على معنى واحد ، بل هي متنوعة في معانيها ، ولهذا هي تدل على الذات وتدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم ، كالعليم يدل على ذات الله عز وجل ، وعلى صفة العلم. والقدير يدل على الذات وعلى صفة القدرة ، ولهذا كل اسم يصح أن يستدل به على الذات وعلى الصفة ، والرحيم يدل على ذات الله عز وجل وعلى الرحمة ، ولذلك قال أهل العلم هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ، فباعتبار دلالة الرحمن والرحيم والغفور والعزيز والقوي باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة ﴿قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوْ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ﴾ } لكن باعتبار دلالتها على الصفات هي متنوعة. قال رحمه الله: [وَمَنْ أَنْكَرَ دِلَالَةَ أَسْمَائِهِ عَلَى صِفَاتِهِ مِمَّنْ يَدَّعِي الظَّاهِرَ، فَقَوْلُهُ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ غُلَاةِ البَاطِنِيَّةِ «الْقَرَامِطَةِ» الَّذِينَ يَقُولُونَ: (لَا يُقَالُ هُوَ حَيٌّ وَلَا لَيْسَ بِحَيٍّ)؛ بَلْ يَنْفُونَ عَنْهُ النَّقِيضَيْنِ؛ فَإِنَّ أُولَئِكَ «القَرَامِطَةَ البَاطِنِيَّةَ» لَا يُنْكِرُونَ اسْماً هُوَ عَلَمٌ مَحْضٌ كَالمُضْمَرَاتِ، وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا فِي أَسْمَائِهِ الحُسْنَى مِنْ صِفَاتِ الإِثْبَاتِ، فَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى مَقْصُودِهِمْ كَانَ مَعَ دَعْوَاهُ الغُلُوَّ فِي الظَّاهِرِ مُوَافِقاً لِغُلَاةِ البَاطِنِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلِكَ.] ثم قال رحمه الله : (وَمَنْ أَنْكَرَ دِلَالَةَ أَسْمَائِهِ عَلَى صِفَاتِهِ مِمَّنْ يَدَّعِي الظَّاهِرَ) ممن يدعون العمل بظواهر النصوص وإجرائها على ظاهرها. قوله: (مِنْ جِنْسِ قَوْلِ غُلَاةِ البَاطِنِيَّةِ «الْقَرَامِطَةِ») يعني هؤلاء الذين ينكرون دلالة الاسم مع قولهم بالظاهر ، قولهم من جنس قول غلاة الظاهرية القرامطة الذين يعطلون الأسماء والصفات بل ينفون عن الله النقيضين يقولون : (َلا يُقَالُ هُوَ حَيٌّ وَلَا لَيْسَ بِحَيٍّ) ؛ لأنهم يقولون لو قلنا هي حي لشبهناه بالموجودات ، ولو قلنا ليس بحي لشبهناه المعدومات ، فينفون عنه النقيضين ، فيكون لازم قولهم ؛ أنهم شبههوه بالممتنعات ؛ لأن الذي هو ليس بحي و لا ليس بحي هو الممتنع . قال: (بَلْ يَنْفُونَ عَنْهُ النَّقِيضَيْنِ) والنقيضان هو ما يمتنع اجتماعهما. قال: (فَإِنَّ أُولَئِكَ «القَرَامِطَةَ البَاطِنِيَّةَ» لَا يُنْكِرُونَ اسْماً هُوَ عَلَمٌ مَحْضٌ) لم ينكروا الأسماء ؛ لأنها أعلام محضة ، (كَالمُضْمَرَاتِ) ؛ لأن المضمرات تدل على الأسماء المحضة ، وليس فيها معاني ، ولهذا الضمائر ليس فيها معاني ، بخلاف الأسماء فإنها تدل على الذات وتدل على وصف ، (وَإِنَّمَا يُنْكِرُونَ مَا فِي أَسْمَائِهِ الحُسْنَى مِنْ صِفَاتِ الإِثْبَاتِ) هذا الذي أراده هؤلاء القرامطة والباطنية ، لهذا لما نظروا في معنى الحي ، وأن فيه مشابهة –كما ادعوا- بين لفظ الحي والحي ، نفوا هذا الاسم ملا تضمن من معنى ، فهم لم يقصدون نفي الاسم لدلالته على الذات ، وإنما لما تضمن من معنى ، توهموا المشابهة بين لفظ الحي والحي ، فأرادوا تنزيه الله عز وجل بحسب دعواهم – إن صدقوا – في تنزيه الله عز وجل عن المشابهة ، مع أن المقرر في هذا أن الاشتراك في الأسماء لا يدل على الاشتراك في الحقائق كما هو مقرر. قال: (فَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى مَقْصُودِهِمْ كَانَ مَعَ دَعْوَاهُ الغُلُوَّ فِي الظَّاهِرِ مُوَافِقاً لِغُلَاةِ البَاطِنِيَّةِ فِي ذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِ ذَلِكَ) هذا كما تقدم أن هؤلاء الذين نفوا النقيضين إنما أرادوا نفي المعنى فهؤلاء إذا قالوا نثبت الاسم دون المعنى يكون هؤلاء قد وافقوا أولئك ، مع دعوى غلوهم في إثبات الظاهر ، فإنهم وافقوا هؤلاء في تعطيل المعنى.
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! " |
|
#5
|
|||
|
|||
|
لا شلّت يمينك-يا أم عامر- اللهم بـــــــارك؛جهـــــــــــدٌ طيب أسأل الله -العلي القدير- أنْ يعينك على إتمامه على الوجه الذي يرضى
__________________
"ليس بين المخلوق والخالق نسب إلا محض العبودية والافتقار من العبد ، ومحض الجود والإحسان من الرب عز وجل". (ج الرسائل 15/ 56 ) |
|
#6
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم تابع مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله (الدرس الثالث) قال رحمه الله: [وَإِنَّمَا المَقْصُودُ: أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتِهِ وَعَلَى مَا فِي الاسْمِ من صفاته، وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي في الاسْمِ الآخَرِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ] بعد أن ذكر المصنف التنبيه على إنكار دلالات الأسماء من قِبل القرامطة والباطنية وكذلك من يدعي الظاهر وهو ينكر دلالة الأسماء ، نبّه على هذه المسألة فقال: (وَإِنَّمَا المَقْصُودُ: أَنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَاتِهِ وَعَلَى مَا فِي الاسْمِ من صفاته، وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي في الاسْمِ الآخَرِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ) هنا ينبه المصنف إلى أن أسماء الله عز وجل تدل على الذات ، وعلى الصفات بأنواع الدلالات الثلاث: دلالة المطابقة ، ودلالة التضمن ، ودلالة اللزوم ، فكل اسم يدل على الذات ، ويدل على الصفة التي اشتقت منه دلالةَ مطابقة ، مثل: دلالة الخالق على الذات وعلى صفة الخلق ، ودلالة التضمن هي دلالة اسم الخالق على صفة الخلق منفردة عن المعنى الآخر ، وكذلك يدل على الذات منفردة عن الصفة ؛ لأن كلا من الصفة والذات يتضمنها الاسم ، فإذا دل على أحد أجزاء المعنى تسمى هذه الدلالة دلالة تضمن. ودلالة اللزوم هي دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه بدلالة اللزوم ، ولعلنا نعرف تعريفا موجزا بأنواع هذه الدلالات. أولا: هذه الدلالات تسمى دلالات اللفظ ، وهي ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة ، دلالة التضمن ، ودلالة اللزوم ، والأصل في هذا أن الألفاظ في اللغة وكذلك الألفاظ الاصطلاحية وضعت لمعاني ، فهذه المعاني إن دل اللفظ على كامل المعنى تسمى دلالة مطابقة ، فدلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على كامل المعنى مثل دلالة البيت على سائر أجزائه ، مثل: دلالة البيت على الجدار ، والسقف ، والحُجر ، وكل ما يشمله البيت ، فإنه إذا أطلق البيت دل على كامل أجزائه دلالة مطابقة ؛ لأن البيت وضع لهذا المعنى الكامل ، ولهذا الآن في المبايعات وفي أنواع العقود إذا ذكر البيت فأنه يشمل سائر أجزاء البيت ، فلا يقول الرجل بعت البيت على فلان ثم يقول إنما أردت حجرة من حجر البيت أو أردت الجدار ؛ لأن الأصل في البيت أنه يشمل سائر هذه الأجزاء ، ولهذا إذا أراد أن يستثني شيئا فإنه يستثنيه ، يقول: بعت البيت إلا كذا وكذا منه ، فدلالة البيت على سائر أجزائه هذه دلالة مطابقة ، وإنما سميت دلالة مطابقة ؛ لمطابقة اللفظ لكامل المعنى الذي وضع له. الدلالة الثانية: دلالة التضمن وهو دلالة اللفظ على جزء من المعنى الذي وضع له ، مثل دلالة البيت على السقف ، أو دلالة البيت على الجدار ، أو دلالة البيت على حجرة من حجراته ، فهذه دلالة تضمن ؛ لأن البيت يتضمن هذا الذي ذُكر وغيره ، فسميت دلالة تضمن ؛ لأن اللفظ يتضمن هذا الجزء وزيادة ، وإنما أريد به هنا جزء من المعنى مثل ما قلنا في اسم الخالق فإنه يدل دلالة مطابقة على الذات وعلى الصفة ؛ لأنه وضع لهذا ، فإذا دل على الصفة منفردة عن الذات ، أو الصفة منفردة عن الذات فإن هذه تسمى صفة تضمن ، وسميت دلالة تضمن لأن اللفظ يتضمن هذا الجزء من المعنى. الدلالة الثالثة: هي دلالة اللزوم وهو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى الذي وضع له اللفظ ولكنه يستلزمه إما عقليا أو عرفيا ، مثال ذلك دلالة السقف على الجدار ، فإن هذه الدلالة دلالة لزوم ، فإنه ليس من معاني السقف: الجدار ، فإذا قلت السقف لا يعرف في معناه الجدار ؛ لكنه يستلزمه عقلا ، فلا يتصور أن يوجد سقف بلا جدار ، وأما استلزامه له عرفا مثل: دلالة مجيء الملك والأمير على مجيء الحاشية ، فإن مجيء الملك لا يدل على مجيء الحاشية ، لكنه يستلزمه عرفا ، لأنه في عرف الملوك إذا جاء الملك جاءت الحاشية والأعوان والوزراء ، فاستلزمه عرفا كما أن الاستلزام الأول هو استلزام عقلي ، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الذات وعلى الصفات إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم ، مثال ذلك: اسم الخالق يدل دلالة مطابقة على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق ، وإذا دل على جزء من المعنى مثل دلالة الخالق على الذات منفردة أو دلالته على صفة الخلق منفردة فإن هذه دلالة تضمن ، وأما دلالة هذا الاسم على بعض المعاني بدلالة اللزوم مثل دلالة اسم الخالق على القدرة وعلى العلم فإنه لا يتصور عقلا أنه يكون هناك خالق لا يعلم ، أو أن يكون هناك خالق وصانع وهو لا يقدر ، وبهذا يتبين أن هذا الاسم يدل على هذه المعاني بدلالة اللزوم أي أنه يستلزمها ، ولهذا ذكر المصنف أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الإسم من صفاته هذه دلالة مطابقة ، فإذا دل على الذات منفردة أو على الصفة منفردة فإن هذه دلالة تضمن ، قال: (وَيَدُلُّ أَيْضاً عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي في الاسْمِ الآخَرِ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ) مثل الصفة التي في العليم وهي صفة العلم دل عليها اسم الخالق دلالة لزوم. قال رحمه الله تعالى: [وَكَذِلِكَ أَسْمَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مِثْلُ: «مُحَمَّدٍ»، وَ«المَاحِي»، وَ«الحَاشِرِ»، وَ«العَاقِبِ».] وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على معاني ، وكل اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على معنى من المعاني ، مثل محمد يدل على صفة الحمد ، كذلك أحمد ، وكذلك الماحي يدل على المحو أي أن الله محا به الشرك ، وكذلك الحاشر أي أن الناس يُحشرون على قدميه يوم القيامة ، وأنه حامل لواء الحمد ، وأن الناس يوم القيامة يلجؤون إليه بطلب الشفاعة عند الله ؛ ليفصل بينهم ، وكذلك العاقب وهو الذي يعقب غيره من الأنبياء فهو خاتم الأنبياء ، فكل اسم من هذه الأسماء يدل على صفة ولكنه يدل على الصفة الأخرى بطريق اللزوم ، مثل: الماحي فإنه يدل على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الصفة وأنه يدل على الحمد أيضا ؛ لأن محو الشرك محمود ، فدل على صفة الحمد بدلالة اللزوم. قال رحمه الله: [وَكَذَلِكَ أَسْمَاءُ القُرْآنِ؛ مِثْلُ: «القُرْآنِ»، وَ«الفُرْقَانِ»، وَ«الهُدَى»، وَ«الشِّفَاءِ»، وَ«البَيَانِ»، وَ«الكِتَابِ»، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ.] أيضا أسماء القرآن كلها أسماء لها معاني ، وهي أعلام وأوصاف ، القرآن أي أنه مقروء ، وكذلك الفرقان فرق الله به بين الحق والباطل ، وكذلك الهدى والشفاء لأنه فيه شفاء ، البيان لأن فيه بيان ، والكتاب لأن فيه المكتوب ، فكل هذه الأسماء قرآن فهو يدل على كتاب الله عز وجل ، وكل اسم من هذه الأسماء يدل على هذا الكتاب ، وقد يدل على صفة في اسم آخر بدلالة اللزوم. قال رحمه الله: [فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيينَ المُسَمَّى، عَبَّرْنَا عَنْهُ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ إِذَا عُرِفَ مُسَمَّى هَذَا الاسْمِ. وَقَدْ يَكُونُ الاسْمُ عَلَماً، وَقَدْ يَكُونُ صِفَةً] (فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيينَ المُسَمَّى) مثل أن يسأل السائل عن الله عز وجل فيقال من الذي أوجد هذا؟ فيقال العليم السميع البصير ، لأنه المقصود هنا الإخبار عن المسمى ، لكنه إذا سأل عن الصفة فإنه يخبر عن الاسم الذي يتضمن الصفة ، ولهذا لما سألت أمهات المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي أخبره بخبرهم قال: {نبأني العليم الخبير} لأن هذا متضمن علم الله عز وجل بما يتكلم به وبما يسر ، فإذا كان المقصود هو السؤال عن المسمى يخبر عن الله عز وجل بأي اسم من اسمائه ؛ لأن المقصود تعيين المسمى ، قال: (فَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ تَعْيينَ المُسَمَّى، عَبَّرْنَا عَنْهُ بِأَيِّ اسْمٍ كَانَ إِذَا عُرِفَ مُسَمَّى هَذَا الاسْمِ.) وكل اسم هو يدل على المسمى ، وقد يكون هذا الاسم يتضمن صفة لم يسأل عنها . ثم قال: (وَقَدْ يَكُونُ الاسْمُ عَلَماً، وَقَدْ يَكُونُ صِفَةً): لأنه الاسماء تتنوع فقد تكون أسماء أعلام أو أوصاف فإذا كان السؤال عن المسمى فيخبر عنه بأي اسم من أسمائه الدالة على هذه الذات. قال رحمه الله: [ كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾. مَا ذِكْرُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ: هُوَ «القُرْآنُ»، مَثَلاً، أَوْ: مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الكُتُبِ؛ فَإِنَّ «الذِّكْرَ» مَصْدَرٌ، وَالمَصْدَرُ تَارَةً يُضَافُ إِلَى الفَاعِلِ. وَتَارَةً إِلَى المَفْعُولِ. فَإِذَا قِيلَ: ذِكْرُ اللهِ، بِالمَعْنَى الثَّانِي، كَانَ مَا يُذْكَرُ بِهِ؛ مِثْلُ قَوْلِ العَبْدِ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ». وَإِذَا قِيلَ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ، كَانَ مَا يَذْكُرُهُ هُوَ، وَهُوَ كَلَامُهُ. وَهَذَا هُوَ المُرَادُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ ؛ لأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾. وَهُدَاهُ: هُوَ مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الذِّكْرِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (125)قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا﴾.] قال: (كَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾. مَا ذِكْرُهُ؟ فَيُقَالُ لَهُ: هُوَ «القُرْآنُ»، مَثَلاً، أَوْ: مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الكُتُبِ؛ فَإِنَّ «الذِّكْرَ» مَصْدَرٌ، وَالمَصْدَرُ تَارَةً يُضَافُ إِلَى الفَاعِلِ. وَتَارَةً إِلَى المَفْعُولِ. فَإِذَا قِيلَ: ذِكْرُ اللهِ، بِالمَعْنَى الثَّانِي، كَانَ مَا يُذْكَرُ بِهِ؛ مِثْلُ قَوْلِ العَبْدِ: «سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ») إذا كان الذكر هنا من باب إضافته إلى المفعول كان المعنى هو ذكر العبد له مثل قول العبد سبحان الله والحمدلله ، فيكون الفعل هنا مضاف إلى العبد وما يصدر منه فيكون معناه عندما يذكر الله عز وجل فيكن من باب إضافة المصدر إلى المفعول ؛ لأن الله عز وجل يُذكر والعبد ذاكر فأضيفه هنا بالضمير الراجع إلى الله عز وجل وهو الذي ذكره العبد ، فالله ذاكر والعبد يذكره: يسبحه ويكبره ويحمده ويهلله فيكون هذا من باب إضافة المصدر للمفعول ، (وَإِذَا قِيلَ بِالمَعْنَى الأَوَّلِ، كَانَ مَا يَذْكُرُهُ هُوَ، وَهُوَ كَلَامُهُ) إذا أضيف المصدر للفاعل كان المقصود بالذكر كلامه الذي يذكره كما يقول :﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ أي عن كلامي الذي قام به والذي هو فاعل له (وَهَذَا هُوَ المُرَادُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ ؛ لأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى﴾) هنا لاحظوا استدلال شيخ الإسلام بدلالة السباق ؛ لأنه ذكر أن هذا الذكر في قوله تعالى (﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ ؛ لأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ﴾) فدل على أن الذكر هنا هو الهدى الذي ذكره الله عز وجل في قوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ﴾ لأن فعل العبد ليس هو الهدى الذي جاء من الله عز وجل وإنما دل عليه الكتاب الذي جاء به الله عز وجل ، أما الهدى الذي جاء من الله عز وجل هو الكتاب ، أما الهدى الذي قام بالعبد هو فعله ، والفعل إنما جاء من قبل العبد لم يأتي من قبل الرب ، فالرب عز وجل خالق له بلا شك لكنه فعل العبد ، قال: (وَهُدَاهُ: هُوَ مَا أَنْزَلَهُ مِنَ الذِّكْرِ) لأنه قال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى ﴾ ، وقال بعد قوله {فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتيتك آياتنا فنسيتها} فالآيات هنا دل على أن الذكر السابق هو الآيات التي جاءت من عند الله عز وجل ، وهذه أيضا من دلالة السياق ، لكن السياق قد يكون سابقا وقد يكون لاحقا ، فهذا مما يدل على أن تدبر والقرآن والنظر إلى السباق وما يلحق النص: دلالة السياق ، يهتدي بها المفسر إلى معرفة اللفظ المذكور في الآية. قال رحمه الله: [وَالمَقْصُودُ: أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ الذِّكْرَ هُوَ كَلَامُهُ المُنَزَّلُ، أَوْ هُوَ ذِكْرُ العَبْدِ لَهُ؛ فَسَوَاءٌ قِيلَ: ذِكْرِي: كِتَابِي، أَوْ كَلَامِي، أَوْ هُدَايَ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ المُسَمَّى وَاحِدٌ.] هنا يشير المصنف إلى أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له ، إذن فالنص هنا دل على هذا ، ودل على هذا ، قال : (فَسَوَاءٌ قِيلَ: ذِكْرِي: كِتَابِي) من باب إضافة المصدر للفاعل ، (أَوْ كَلَامِي، أَوْ هُدَايَ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ المُسَمَّى وَاحِدٌ) أي أن الكتاب والكلام والهدى هذه أسماء تدل على مسمى واحد وهو القرآن فهو ذكر وهو كتاب وهو كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: [وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ مَا فِي الاسْمِ مِنَ الصِّفَةِ المُخْتَصَّةِ بِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى تَعْيِينِ المُسَمَّى؛ مِثْلُ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ: ﴿الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ﴾. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اللهُ، لَكِنْ مُرَادَهُ: مَا مَعْنَى كَوْنِهِ قُدُّوساً سَلَاماً، مُؤْمِناً؟ وَنَحْوَ ذَلِكَ.] ذكر أن هذا من مقاصد السائل ، ذكر في المقصد الأول: إذا كان مقصود السائل تعين المسمى فهذا يخبر بأي اسم من الأسماء التي تدل على هذا المسمى ، ثم ذكر هنا فقال : (وَإِنْ كَانَ مَقْصُودُ السَّائِلِ مَعْرِفَةَ مَا فِي الاسْمِ مِنَ الصِّفَةِ المُخْتَصَّةِ بِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى تَعْيِينِ المُسَمَّى) يعني لا يُكتفى هنا بالإخبار عن المسمى ، لأنه يريد معنى زائد عن الذات وهو معنى قائم في الذات ، ولهذا الصفة هي معنى قائم في الذات ، ودلالة الأسماء على الذات والصفات هي دلالة زائدة عن الذات وهي متضمة لصفة خلافا لمن زعم من المعتزلة أنها أسماء مجردة ، لا تتضمن الصفات ، فهي تدل على الذات وتدل على معنى زائد عن الذات ، فإذا كان مقصود السائل هو السؤال عن صفة فلابد أن يكون هناك قدر زائد عن الذات وعن المسمى ، (أَنْ يَسْأَلَ عَنِ: ﴿الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ﴾. وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اللهُ) أن هذه أسماء الله (لَكِنْ مُرَادَهُ: مَا مَعْنَى كَوْنِهِ قُدُّوساً سَلَاماً، مُؤْمِناً؟) فهنا سؤال عن الصفة فيبين له معنى الصفة ، والصفة أمر زائد عن الذات ولهذا أسماء المخلوقين هي أعلام مجردة ليست أوصافا ، ولا ينقدح في الذهن إذا ما سمعت أن فلان اسمه محمد أو حامد أو شاكر أنه متصف بهذه الصفة التي اشتق منها هذا الاسم ، لأنها أسماء مجردة ، وأما أسماء الله وجل ، فإذا سمعت الاسم المشتق من صفة فأنت تعلم أنه متصف بهذه الصفة ، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف ، فإذا سأل سائل عن الصفة ، فلابد أن يبين له المعنى الدال على هذه الصفة ، فلا تكتفي بدلالته على الاسم المجرد وإنما تبين له معنى الصفة. قال رحمه الله: [ إِذَا عُرِفَ هَذا، فَالسَّلَفُ كَثِيراً مَا يُعَبِّرُونَ عَنْ المُسَمى بِعِبَارَةٍ تَدُلُ عَلَى عَيْنِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الاسْمِ الآخِرِ؛ كَمَنْ يَقُولُ: أَحْمَدُ هُوَ: الحَاشِرُ، وَالمَاحِي، وَالعَاقِبُ. وَالقُدُّوسُ: هُوَ الغَفُورُ الرحِيمُ، أَيْ أَنَّ المُسَمَى وَاحِدٌ، لَا أَنَّ هَذِهِ الصِّفَةَ هِيَ هَذِهِ!] ثم ذكر أن (السَّلَفُ كَثِيراً مَا يُعَبِّرُونَ عَنْ المُسَمَّى بِعِبَارَةٍ تَدُلُّ عَلَى عَيْنِهِ) تدل على الذات؛ لأن المقصود هو الإخبار عن الذات ، (وَإِنْ كَانَ فِيهَا) أي في هذه الذات ، (مِنَ الصِّفَةِ مَا لَيْسَ فِي الاسْمِ الآخِرِ) فالمقصود من العبارة: وإن كان في العبارة من الصفة ما ليس في الاسم الآخر (كَمَنْ يَقُولُ: أَحْمَدُ هُوَ: الحَاشِرُ) فهنا المقصود لما سأل السائل عن أحمد قيل هو الحاشر ، ولكن السائل لما سأل عن صفة ، ولكن أُخبر باسم آخر يتضمن صفة أخرى ؛ لأن المقصود هو الإخبار عن عين المسمى لا عن صفته ، لكنه لو قال من أحمد وهو يريد أن يعرف الذات والصفة فيقال هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحمد ؛ لأنه محمود ، ولأنه قامت به هذه الصفة ، ولكن لما يخبر عن المسمى ويراد به عين المسمى فيخبر بهذا الاسم أو بغيره فيقال: (أَحْمَدُ هُوَ: الحَاشِرُ، وَالمَاحِي، وَالعَاقِبُ) وإن كان في كل اسم من هذه الأسماء صفة ليست في الاسم الأول. وكذلك لو قال من القدوس فيقال (هُوَ الغَفُورُ الرحِيمُ) أي أن المسمى واحد ، لا أن هذه الصفة هي هذه ليس المقصود أن معنى القدوس هو معنى الغفور ، لكن المقصود أن المسمى بالقدوس هو المسمى بالغفور الرحيم ، وإلا فكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة. قال رحمه الله: [وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اخْتِلَافَ تَضَاٍّد كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ النَّاسِ؛ مِثَالُ ذَلِكَ: تَفْسِيرُهُمْ لِلصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ: «القُرْآنُ»، أَي اتِّبَاعُهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، -فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، ورَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ- «هُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَالذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الإِسْلَامُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ النواسِ بْنِ سَمْعَانَ - الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ-: «ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً: صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، وَعَلَى جَنْبَتَي الصِّرَاطِ سُورَانِ، وَفِي السُّوَريْنِ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ. قَالَ: فَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ هُوَ الإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللهِ، وَالأَبْوَابُ المُفَتّحَةُ مَحَارِمُ اللهِ، وَالداعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ: كِتَابُ اللهِ، وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ: وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ» فَهَذَانِ القَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ؛ لأَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ هُوَ اتِّبَاعُ «القُرْآنِ»، وَلَكِنْ كُلاً مِنْهُمَا نَبَّهَ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ الوَصْفِ الآخَرِ، كَمَا أَنَّ لَفْظَ: «صِرَاطٌ» يُشْعِرُ بِوَصْفٍ ثَالِثٍ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ: «السُّنَّةُ وَالجَمَاعَةُ»، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ: «طَرِيقُ العُبُودِيَّةِ»، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ: «طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم »، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ . فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَشَارُوا إِلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ وَصَفَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا.] ثم ذكر المصنف أن هذا ليس كما يظن البعض أنه اختلاف تضاد ، وإنما هو من اختلاف التنوع ، فإن كل واحد من هؤلاء يعبر عن هذه الذات باسم من أسمائها يدل عليها ، وذكر مثالا لهذا: الصراط المستقيم ، فسره بعضهم بقوله : هو القرآن ، والمقصود هو اتباعه ، ثم استدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو«هُوَ حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَالذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ» فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه الصراط المستقيم ، فهذا الاسم شرعي دلّ عليه النص ، فمن قال الصراط المستقيم هو القرآن لدلالة هذا النص ، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى القرآن الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام كما جاء في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً: صِرَاطاً مُسْتَقِيماً، وَعَلَى جَنْبَتَي الصِّرَاطِ سُورَانِ ) ثم بعد ذلك فسر الصراط فقال: ( فَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ هُوَ الإِسْلَامُ ) فهنا جاء تفسير الصراط المستقيم أنه الإسلام فمن سماه الإسلام فهو أيضا يستدل بدليل جاء فيه إطلاق الصراط المستقيم على الإسلام قال : (فَهَذَانِ القَوْلَانِ مُتَّفِقَانِ؛ لأَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ هُوَ اتِّبَاعُ «القُرْآنِ» ) فلا يفرق بينهما ، لكن هذا يخبر عن معنى ، وهذا يخبر عن معنى ، فالإسلام هو الدين وهو الذي دل عليه القرآن ، فباعتبار ما اشتمل عليه القرآن من الدين فهو دين الإسلام ، وباعتبار الدال على هذا الدين هو القرآن ، فباعتبار المبلغ عن هذا الدين فالصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: (وَلَكِنْ كُلاً مِنْهُمَا نَبَّهَ عَلَى وَصْفٍ غَيْرِ الوَصْفِ الآخَرِ ) يعني كل واحد منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر مع أن المعنى يدل على شيء واحد ، فلا يعقل أن تحصل فرقة بين الأمة على شيء واحد ، فيقال نحن لا ندري من نتبع الدين أم القرآن أم النبي صلى الله عليه وسلم ؟! لأن من اتبع أحد هذه المسميات فقد اتبع الدين ، فإذا اتبع القرآن اتبع الإسلام ، وإذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن ، فليس هناك اختلاف تضاد إنما اختلاف تنوع. قال: (كَمَا أَنَّ لَفْظَ: «صِرَاط» يُشْعِرُ بِوَصْفٍ ثَالِثٍ) لعله يقصد الوصف اللغوي وهو أن الصراط هو الطريق.( وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ: «السُّنّةُ وَالجَمَاعَةُ» ) ؛ لأن [أهل] السنة والجماعة هم الذين امتثلوا القرآن وهم الذي كانوا على الهدي الذين كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.( وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ: «طَرِيقُ العُبُودِيَّةِ» وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: هُوَ: «طَاعَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم »، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ) كل هذه أشياء تدل على حقيقة واحدة ، لا يفرق بينها. قال:(فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ أَشَارُوا إِلَى ذَاتٍ وَاحِدَةٍ، لَكِنْ وَصَفَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا) وهو هذا الدين ، لكن منهم يعبر بالدين ومنهم من يعبر بالكتاب الذي دل عليه ، ومنهم من يعبر بالنبي الذي دعى إليه ، ومنهم من يعبر بالحقيقة الكاملة لهذا الدين وهو العبودية ، قال: ( لَكِنْ وَصَفَهَا كُلٌّ مِنْهُمْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهَا) كل يصف هذه الحقيقة بصفة من صفاتها ، فالنهاية فالجميع يلتقي في حقيقة واحدة ، وهو أن المراد بالصراط المستقيم هو هذا الدين. قال رحمه الله: [ الصِّنْفُ الثَّانِي: أَنْ يَذْكَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنَ الاسْمِ العَامِّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ، عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَتَنْبِيهِ المُسْتَمِعِ عَلَى النَّوْعِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الحَدِّ المُطَابِقِ للمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِ. مِثْلُ سَائِلٍ أَعْجَمِيٍّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى لَفْظِ «الخُبْزِ» فَأُرِيَ رَغِيفاً، وَقِيلَ لَهُ: هَذَا؛ فَالإِشَارَةُ إِلَى نَوْعِ هَذَا، لَا إِلَى هَذَا الرَّغِيفِ وَحْدَهُ] هنا رجع المصنف إلى التقسيم الذي ذكره ، وهو أنّ الاختلاف يرجع إليه وهو اختلاف تنوع ، فذكر في النوع الأول هو أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى كما ذكر. فكل واحد يعبر عن المسمى بعبارة غير عبارة صاحبة ، والجميع يشير إلى ذات واحد ، ثم ذكر النوع الثاني وهو (أَنْ يَذْكَرَ كُلٌّ مِنْهُمْ مِنَ الاسْمِ العَامِّ بَعْضَ أَنْوَاعِهِ ) يذكر بعض الأفراد الداخلة ضمن هذا الاسم العام ، (عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَتَنْبِيهِ المُسْتَمِعِ عَلَى النَّوْعِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الحَدِّ المُطَابِقِ للمَحْدُودِ) فيكون هنا الخبر على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع إلى النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود وهي التعاريف ، وإنما سميت التعاريف حدودا ؛ لأنها تحد المعنى ، كما أن حدود الأرض تحد الأرض المحدودة ، فالمقصود هنا ليس هو الحد وإنما هو التمثيل الذي يبين هذه الحقيقة. قال: ( وَتَنْبِيهِ المُسْتَمِعِ عَلَى النَّوْعِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الحَدِّ المُطَابِقِ للمَحْدُودِ فِي عُمُومِهِ وَخُصُوصِهِمِثْلُ سَائِلٍ أَعْجَمِيٍّ سَأَلَ عَنْ مُسَمَّى لَفْظِ «الخُبْزِ» فَأُرِيَ رَغِيفاً، وَقِيلَ لَهُ: هَذَا؛ فَالإِشَارَةُ إِلَى نَوْعِ هَذَا) سأل عن الخبز فقال: ما الخبر؟ فأري رغيفا ، قيل له: هذا ، فليس المقصود أن هذا الخبر هو هذا الرغيف فقط ، وإنما المقصود هو أن هذا الخبر هذا نوعه ، وإن كان ما يدخل في هذه الحقيقة يتنوع من حيث الطريقة ، ومن حيث الحجم ، قال: (فَالإِشَارَةُ إِلَى نَوْعِ هَذَا، لَا إِلَى هَذَا الرَّغِيفِ وَحْدَهُ) فليس المقصود أن هذا هو الخبر وحده ، بحيث لو كان هناك رغيف آخر فهو خارج عن ماهية الخبر ، وإنما المقصود هو التمثيل. قال رحمه الله: [ مثَالُ ذَلِكَ: مَا نُقِلَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الظَّالِمَ لِنَفْسِهِ يَتَنَاوَلُ المُضِيعَ لِلوَاجِبَاتِ، وَالمُنْتَهِكَ لِلحُرُمَاتِ. وَالمُقْتَصِدُ يَتَنَاوَلُ فَاعِلَ الوَاجِبَاتِ، وَتَارِكَ المُحَرَّمَاتِ. وَالسَّابِقُ يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ سَبَقَ فَتَقَرَّبَ بِالحَسَنَاتِ مَعَ الوَاجِبَاتِ. فَالمُقْتَصِدُونَ هُمْ أَصْحَابُ اليَمِينِ، ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ثُم إِنَّ كُلّاً مِنْهُمْ يَذْكُرُ هَذَا فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ؛ كَقَوْلِ القَائِلِ: «السَّابِقُ»: الَّذِي يُصَلِّي فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وَ«المُقْتَصِدُ»: الَّذِي يُصَلِّي فِي أَثْنَائِهِ، وَ«الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ»: الَّذِي يُؤَخِّرُ العَصْرَ إِلَى الاصْفِرَارِ. أَوْ يَقُولُ: السَّابِقُ وَالمُقْتَصِدُ وَالظَّالِمُ قَدْ ذَكَرَهُمْ فِي آخِرِ «سُورَةِ البَقَرَةِ»؛ فَإِنَّهُ ذَكَرَ المُحْسِنَ بِالصدَقَةِ، وَالظَّالِمَ بِأَكْلِ الرِّبَا، وَالعَادِلَ بِالبَيْعِ. وَالنَّاسُ فِي الأَمْوَالِ، إِمَّا مُحْسِنٌ، وَإِمَّا عَادِلٌ، وَإِمَّا ظَالِمٌ؛ «فَالسَّابِقُ»: المُحْسِنُ بِأَدَاءِ المُسْتَحَبَّاتِ مَعَ الوَاجِبَاتِ، وَ«الظَّالِمُ»: آكِلُ الرِّبَا،َ ْأو مَانِعُ الزَّكَاةِ، وَ«المُقْتَصِدُ»: الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ وَلَا يَأْكُلُ الرِّبَا. وَأَمْثَالَ هَذِهِ الأَقَاوِيلِ] ثم ذكر شيخ الإسلام مثالا لهذا مما جاء في القرآن وتفسير السلف لبعض هذه الحقائق ببعض أجزائها ، كتفسير السلف لفظ العام بذكر بعض أجزائه لا على سبيل الحد ، وإنما على سبيل التمثيل كما قيل لمن سأل الخبر فأُشير إلى الرغيف فقيل له هذا ، قال مثال ذلك ما ذكر في قوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ فذكر الله عز وجل الذين اصطفاهم الله عز وجل بهذا الدين أنهم على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه ، ومقتصد ، وسابق بالخيرات. ثم قال شيخ الإسلام: (فَمَعْلُومٌ أَنَّ الظَّالِمَ لِنَفْسِهِ يَتَنَاوَلُ المُضِيعَ لِلوَاجِبَاتِ، وَالمُنْتَهِكَ لِلحُرُمَاتِ) لاحظوا الحد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا هو الحد العام الذي يحد به الظالم لنفسه ، بخلاف ما سيأتي فإنه يعرف ببعض أفراده ، فهنا عرفه شيخ الإسلام التعريف المطلق وهو الحد الجامع المانع قال: (الظَّالِمَ لِنَفْسِهِ يَتَنَاوَلُ المُضِيعَ لِلوَاجِبَاتِ، وَالمُنْتَهِكَ لِلحُرُمَاتِ) لأن ظلم العبد لنفسه يكون بالمعصية ، والمعصية يتصور أن تكون بترك واجب ، أو بفعل محرم ، فلا يتصور أن يكون هناك معصية بغير هذين الطريقين ، ويدخل في هذا من تضييع الواجبات: تضييع التوحيد وقد يصل إلى الشرك ، وقد يدخل في فعل المحرمات: أن يفعل الشرك ، لكن المقصود هنا أن يقصر فيما أوجب الله عليه من أصل الدين ، أو من الواجبات التي إذا تركها فإنها لا تذهب بالأصل وكذلك المحرمات ، فالظالم هو المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات. والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات ، فهو لم يقصر فيما أوجب الله عليه ولم يتنفل ، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات ، فهذه هي الحدود الجامعة المانعة لهذه المراتب ، في بيان أن السابق هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وتقرب إلى الله بالنوافل والمستحبات ، والمقتصد: هو من اقتصد في أداء الواجب وترك المحرم ، والظالم: هو من قصر بترك الواجب أو بفعل المحرم. قال:( فَالمُقْتَصِدُونَ هُمْ أَصْحَابُ اليَمِينِ، ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10)أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾.) فالسابقون هم المقربون ، ولكل واحد من هذين الصنفين مرتبة في الجنة بحسب منزلته عند الله عز وجل ، وهذا من عدل الله وحكمته. قال شيخ الإسلام: (ثُمَّ إِنَّ كُلّاً مِنْهُمْ يَذْكُرُ هَذَا فِي نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطَّاعَاتِ) يذكر هذه المراتب في نوع من أنواع الطاعات: (كَقَوْلِ القَائِلِ: «السَّابِقُ»: الَّذِي يُصَلِّي فِي أَوَّلِ الوَقْتِ) لماذا أطلق السابق على الذي يصلي في أول الوقت؟ لأن الصلاة في أول الوقت مستحبة ، فهو أدى الواجب بالصلاة في أول الوقت ، وأداها على وجه مستحب بفعل هذه الصلاة في وقتها المستحب ، ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فقال: "الصلاة على وقتها" قال العلماء المقصود الصلاة على أول وقتها ؛ لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخره ، وإن كان الذي أداها في آخر الوقت ليس بعاصي ولكنه فوّقت المستحب ، فهنا عبر بعض المفسرين عن السابق بأنه (الَّذِي يُصَلِّي فِي أَوَّلِ الوَقْتِ) ؛ لأنه أدى الصلاة على الوقت الصحيح في وقت مستحب. (وَ«المُقْتَصِدُ»: الَّذِي يُصَلِّي فِي أَثْنَائِهِ) في أثناء الوقت قبل خروجه ، فهذا مقتصد لكنه قطعا لم يصلي في أول الوقت ، وإنما صلى في أثناء الوقت قبل خروجه ، لأنه لو صلى في أول الوقت فهو سابق. (وَ«الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ»: الَّذِي يُؤَخِّرُ العَصْرَ إِلَى الاصْفِرَارِ.) لأن تأخيرها إلى هذا الوقت محرم ، ولأن وقتها يخرج قبل ذلك ، ولأن الاصفرار هو دليل على خروج الوقت ، وقرب دخول وقت المغرب ، وقرب غروب الشمس ، ولاحظوا أن هذا التفاوت مرجعه إلى التفاوت في تأدية الصلاة بحسب الوقت ، وقد يأتي آخر ويقول السابق هو الذي أدى الصلاة على الوجه الكامل ، يؤدي الواجبات والمستحبات ، فهذا سابق بالنظر إلى الكيفية ، والمقتصد هو الذي أدى الصلاة ولم يتنفل فيها ، والظالم لنفسه هو الذي قصّر في صلاته فهذا أيضا باعتبار الكيفية. قال: (أَوْ يَقُولُ: السَّابِقُ وَالمُقْتَصِدُ وَالظَّالِمُ قَدْ ذَكَرَهُمْ فِي آخِرِ «سُورَةِ البَقَرَةِ») قد يأتي مفسر آخر يقول: (السَّابِقُ وَالمُقْتَصِدُ وَالظَّالِمُ قَدْ ذَكَرَهُمْ فِي آخِرِ «سُورَةِ البَقَرَةِ» فَإِنَّهُ ذَكَرَ المُحْسِنَ بِالصَّدَقَةِ) فهذا سابق ( وَالظَّالِمَ بِأَكْلِ الرِّبَا) فهذا ظالم (وَالعَادِلَ بِالبَيْعِ) فهذا مقتصد (وَالنَّاسُ فِي الأَمْوَالِ، إِمَّا مُحْسِنٌ، وَإِمَّا عَادِلٌ، وَإِمَّا ظَالِمٌ) فإذن هنا يشير: لمّا ذكر الله عز وجل في آخر سورة البقرة لمّا ذكر الصدقة والحث عليها ، وذكر الربا ، وذكر البيع ، فقال مفسر: هذه المراتب ذكرها الله في آخر سورة البقرة ، فالسابق هو المحسن بالصدقة ، والظالم هو آكل الربا ، والمقتصد هو الذي قام بالبيع فهو مقتصد لم يظلم بأكل الحرام ، ولم يتنفل بالصدقة ، والناس كذلك في المال. ولذلك ذكر العلماء أن هذه المراتب قد تكون عامة ، فقد يكون الرجل محسن وسابق في كل شعب الإيمان ، وقد يكون سابقا في بعضها ، فقد يكون بعض الناس له سبق في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم وليس له ذلك في بعض الأعمال الأخرى ، ولذلك قيل السابق في كل هذه المراتب هو الصّدّيق الذي سبق إلى كل شعبة ، فذكر أن هذه المراتب يُعبر عنها بهذه الحقائق الشرعية ، وهذا له أمثلة كثيرة كما سيأتي في بعض النصوص ، كقول من قال في قول الله عز وجل: {والذي جاء بالصدق وصدق به} قال بعض المفسرين: الذي جاء بالصدق هو جبريل ، وصدق به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبوبكر. وقيل: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به المؤمنون. وقيل: الذي جاء بالصدق هم الأنبياء والذي صدق به هم المؤمنون ، فيلاحظ أن هذه التفسيرات إنما جاءت على سبيل التمثيل لما يدخل تحت هذا المعنى ، وإلا فكل هذه الأفراد التي ذكرت داخلة تحت هذا المعنى ، وقد يأتي آخر فيعبر عن هذه الحقيقة بلفظ عام فيقول: الذي جاء بالصدق هو كل من أخبر بالصدق فهذا لفظ عام يدخل فيه كل هذه الأفراد ، وصدق به هو كل من صدق الصادق. في خبره فهذا هو تعبير عن هذه الحقائق ببعض أفرادها ، وعليه فلا يتصور عند من قال: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وأن الذي صدق به هو أبوبكر ، أنه لا يدخل في هذا الوصف غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بالصدق ، ولا يدخل في المصدق له غير أبي بكر ، وإنما المقصود التمثيل. قال رحمه الله تعالى: [فَكُلُّ قَوْلٍ: فِيهِ ذِكْرُ نَوْعٍ دَاخِلٌ فِي الآيَةِ، إِنَّمَا ذُكِرَ لِتَعْرِيفِ المُسْتَمِعِ بِتَنَاوُلِ الآيَةِ لَهُ، وَتَنْبِيهِهِ به عَلَى نَظِيرِهِ؛ فَإِنَّ التَعْرِيفَ بِالمِثَالِ قَدْ يُسَهِّلُ أَكْثَرَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِالحَدِّ المُطَابِقِ. وَالعَقْلُ السَّلِيمُ يَتَفَطَّنُ لِلنَّوْعِ كَمَا يَتَفَطَّنُ إِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَغِيفٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا هُوَ الخُبْزُ.] ثم ذكر أن كل ما يُذكر مما هو داخل في معنى الآية على سبيل التعريف يتناول هذا ، قال: (وَتَنْبِيهِهِ عَلَى نَظِيرِهِ) التعريف بالمثال هو تنبيه على نظيره لا على القول أن هذا الذي عُرف به أنه يحد هذا المعنى ولا يدخل فيه غيره ، بل المقصود هو التنبيه على نظيره ، قال: (فَإِنَّ التَعْرِيفَ بِالمِثَالِ قَدْ يُسَهِّلُ أَكْثَرَ مِنَ التَّعْرِيفِ بِالحَدِّ المُطَابِقِ) ؛ لأن المثال المحسوس يعرفه كل الناس فقول من قال: {إن الذي جاء بالصدق وصدق به} هو النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه بالمثال إلى الأنبياء ، والذي قال {الذي صدق به} تنبيه بالمثال إلى كل من صدق به إلى كل الأمة الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو تنبيه إلى النوع وليس المقصود الحصر ، ثم ذكر أن هذا قد يكون أسهل عند بعض الناس من التعريف بالحد المطابق ؛ لأن الحد المطابق قد لا يتصوره كثير من الناس ، أما هذا المثال المحسوس فيعرفه أكثر الناس ، ولهذا كثيرا ما تُعرّف الأشياء بالأمثلة ، وأحيانا يجمع التعريف بالحد المطابق وبين المثال ، مثل: من يعرف السابق يقول: هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات وسابق إلى المستحبات كأبي بكر ، فهذا جمع بين التعريف بالحد المطابق والتمثيل. قال: (وَالعَقْلُ السَّلِيمُ يَتَفَطَّنُ لِلنَّوْعِ كَمَا يَتَفَطَّنُ إِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَغِيفٍ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا هُوَ الخُبْز) أنه يتنبه إلى النوع ، ولا يتصور أن المقصود أن الخبز محصور في هذا الرغيف ، لكنه تنبه لهذا ، ولهذا لو رأى رغيفا آخر يعرف أن هذا يدخل في ذلك الاسم. قال رحمه الله: [يَجِيءُ كَثِيراً مِنْ هَذَا البَابِ قَوْلُهُمْ: هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا؛ لَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ المَذْكُورُ شَخْصاً، كَأَسْبَابِ النُّزُولِ المَذْكُورَةِ فِي التَّفْسِيرِ؛ كَقَوْلِهِمْ: إِنَّ «آيَةَ الظِّهَارِ» نَزَلَتْ فِي امْرَأَةِ أَوْسِ بنِ الصَّامِتِ، وَإِنَّ «آيَةَ اللِّعَانِ» نَزَلَتْ فِي عُوَيْمِرٍ الْعَجْلَانِيِّ، أَوْ هِلَالِ بنِ أُمَيَّةَ. وَإِنَّ «آيَةَ الكَلَالَةِ» نَزَلَتْ فِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. وَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ﴾ نَزَلَتْ فِي: «بَنِي قُرَيْظَةَ» وَ«النَّضِيرِ». وَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ نَزَلَتْ فِي «بَدْرٍ». وَإِنَّ قَوْلُهُ: ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ نَزَلَتْ فِي قَضِيَّةِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ. وَقَوْلِ أَبِي أَيُّوبَ: (إِنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ نَزَلَتْ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ الحَدِيثُ). وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ مِمَّا يَذْكُرُونَ أَنّهُ نَزَلَ فِي قَوْمِ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْل الكِتَابِ؛ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، أَوْ فِي قَوْمٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ. فَالَّذِينَ قَالُوا لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ مُخْتَصٌّ بِأُولَئِكَ الأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ، وَلَا عَاقِلٌ على الإِطْلَاقِ.] ثم أشار شيخ الإسلام في مقابل التفسير أيضا ما يذكر في سبب النزول ، كقول من يقول (هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي كَذَا) فيكون المقصود أن هذه الآية نزلت في هذا النوع ، وسيأتي في كلامه نزاع بين العلماء في أنّ هذا اللفظ عندما يقول المفسر هذه الآية نزلت في كذا ، هل هذا اللفظ صريح في أن ما ذكره هو سبب النزول ، أم المقصود التفسير؟ فإن الألفاظ ثلاثة –كما نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه- ذكر أن هذا من توسع شيخ الإسلام في العلم كما هي طريقته - ، فإن الخبر عن أسباب النزول : إما أن يكون صريحا ، وإما أن يكون واضح الدلالة ، وإما أن يكون محتملا. فإذا قال المفسر سبب نزول هذه الآية هو كذا: فهذا اللفظ صريح في أن سبب النزول هو ما ذكره. وإذا ما قيل حصل كذا ، فأنزل الله كذا ، فهذا ظاهر على أن هذا الذي ذكره هو سبب النزول ؛ لأن التعقيب بالفاء هنا : إما أن تكون ظرفية أو سببية ، فيكون هذا ظاهر أن هذه الآية نزلت بسبب هذه المناسبة ، أي حصل كذا فأنزل الله كذا أي سببا لنزوله. أما إذا قال المفسر هذه الآية نزلت في كذا فهذا محتمل ، هل يريد أن يُخبِر أن سبب النزول هو ما ذكره ، أم أن الإشارة هنا إلى النوع ، وأن هذه الآية نزلت في حكم كذا ، وليس المقصود أنّ هذا خاص به. فذكر شيخ الإسلام جملة من الآيات ، يقال هذه الآية نزلت في كذا و هذه الآية نزلت في كذا ، قال: (وَنَظَائِرُ هَذَا كَثِيرٌ مِمَّا يَذْكُرُونَ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَوْمِ مِنَ المُشْرِكِينَ بِمَكَّةَ) يقال هذه الآية نزلت في أبي جهل ، [أو] نزلت في أمية بن خلف ، أو نزلت في كذا ، أو نزلت (فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْل الكِتَابِ؛ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى) كأن يقال هذه نزلت في كعب ، [أو] نزلت في اليهود أو نزلت في بني قريظة (أَوْ فِي قَوْمٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ.) كأن يقال هذه في كذا (فَالَّذِينَ قَالُوا لَمْ يَقْصِدُوا أَنَّ حُكْمَ الآيَةِ مُخْتَصٌّ بِأُولَئِكَ الأَعْيَانِ دُونَ غَيْرِهِمْ) ليس المقصود بأن حكم هذه الآية مختص بهؤلاء ( فَإِنَّ هَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ، وَلَا عَاقِلٌ على الإِطْلَاقِ.) أي لا يقول هذه الآية إنما جاءت لبيان حكم فلان فقط دون غيره ، بل ذكر العلماء أن هذا عام ، والقاعدة المعروفة عن المفسير وكذلك عند الأصوليين : (أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) بل لو ثبت أن سبب نزول هذه الآية هو ما حصل من فلان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولهذا ضعّف كثير من المحققين إجابة من قال في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن أفضل العمل : فإن السائلين الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل ، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات متنوعة ، فقال بعض الشراح: إنما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كل سائل بحسب حاله ، فضعف بعض العلماء –وهذا هو الحق- هذه الإجابة ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وإلا لو كان الأمر كذلك ، لقيل ما يستفاد من هذه الإجابة إلا أنها إجابة في حق فلان ، ولا يستنبط منها حكم شرعي بعد ذلك في المفاضلة بين الأعمال ، وهذا ضعيف! فإن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، لكن قد يقال: إن هذه الإجابة خاصة بهذا النوع ، كما قال من قال: من سأل وله والدان عن أفضل العمل ، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: "بر الوالدين" ، فتكون هذه الإجابة شاملة لكل من له والدان أنّ هذا أفضل العمل في حقه ، وليس المقصود أن هذه الإجابة هي في حق السائل بمفرده. قال رحمه الله: [وَالنَّاسُ وَإِنْ تَنَازَعُوا فِي اللَفْظِ العَامِّ الوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ، هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ أم لا؟ فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ إِنَّ عُمُومَاتِ «الكِتَابِ» وَ«السُّنَّةِ» تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ المُعَيَّنِ، وَإِنَّمَا غَايَةُ مَا يُقَالُ: إِنَّهَا تَخْتَصُّ بِنَوْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ، فَتَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ وَلَا يَكُونُ العُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ. وَالآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إِنْ كَانَتْ «أَمْراً» أَوْ «نَهْياً» فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ «خَبَراً» بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وِلمن كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيْضاً.] ثم ذكر المصنف رحمه الله: أن الناس (تَنَازَعُوا فِي اللَفْظِ العَامِّ الوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ، هَلْ يَخْتَصُّ بِسَبَبِهِ أم لا؟) لكن ما نوع هذا الإختصاص؟ كثيرا ما يظن بعض الناس في الخلاف الناشيء بين العلماء ما لم يقصدوه ، فقد يظن مثل من يسمع هذه العبارة أن العلماء تنازعوا في النص الوارد على سبب خاص أنه خاص بذلك المعين ، فيقول شيخ الإسلام: (فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ إِنَّ عُمُومَاتِ «الكِتَابِ» وَ«السُّنَّةِ» تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ المُعَيَّنِ) يعني مثل ذلك السائل ، فلم يقل أنها خاصة به ، لكن غاية ما يقال في حق من قال إنها خاصة إنها تختص بنوع ذلك الشخص ، مثل ما قلنا في الذي سأل عن أفضل العمل ، فأُجيب ببر الوالدين ، لم يقل أحد من علماء المسلمين أن هذا خاص بهذا السائل ، و إلا لكان هذا النص معطل عن كل معنى يستدل به لهذه المسألة ، فيكون هذا خاص بفلان ، فالنزاع الذي نشأ بين العلماء: هل اللفظ عام أو أنه مختص؟ ما نوع الاختصاص هنا ؟ هو اختصاص بالنوع لا اختصاص بالمعين السائل أو الذي نزل به النص ، فذكر شيخ الإسلام أنه (لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ إِنَّ عُمُومَاتِ «الكِتَابِ» وَ«السُّنَّةِ» تَخْتَصُّ بِالشَّخْصِ المُعَيَّنِ) الذي نزل بسببه النص ، وإنما الذي قال بالاختصاص قال إنه خاص بهذا النوع. قال: (فَتَعُمُّ مَا يُشْبِهُهُ وَلَا يَكُونُ العُمُومُ فِيهَا بِحَسَبِ اللَّفْظِ) هذا على قول ؛ لأن العلماء على قولين: منهم ن قال: هذا نص عام في هذا النوع وفي غيره ، فيقال لكل من سأل عن أفضل العمل فيقال بر الوالدين هو أفضل العمل ، في حق من له والد ومن ليس له والد ، والذي ليس له والد ، يكون قد فاته من هذه الفضيلة بقدر ما فاته من ذهاب بر الوالدين ، ويبقى بر الوالدين بعد موتهما ، والذي يقول أن هذا خاص بهذا النوع يقول: هذا خاص بهذا النوع ؛ لمن له والد ، فالنزاع هنا ، هل هو عام عموم مطلق ، أم عام عموم مقيد بهذا النوع ؟ وأما القول بأنه خاص بفلان بعينه أو بمعين فذكر شيخ الإسلام أن هذا لم يقل به أحد من علماء المسلمين. قال: (وَالآيَةُ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ مُعَيَّنٌ إِنْ كَانَتْ «أَمْراً» أَوْ «نَهْياً» فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وِلمن كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيْضاً) ليست هي خاصة به وإنما هي عامة لكل من كان بمنزلته ( وَإِنْ كَانَتْ «خَبَراً» بِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ فَهِيَ مُتَنَاوِلَةٌ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وِلمن كَانَ بِمَنْزِلَتِهِ أَيْضاً) أي من كان في حكمه ، أما القول بأنها خاصة في المعين وأنه يفهم من قول من قال من أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ أو النزاع بين أهل العلم هل اللفظ هو عام أم مقيد بسببه ، المقصود بالنوع لا الشخص المعين ، أما الشخص المعين ، فلم يقل بهذا أحد ، وإلا لبقيت النصوص معطلة ، فلا تكون أحكاما إلا في حق من نزلت فيهم ، وأما بعد ذلك فلا حاجة للأمة فيها ؛ لأن هذا حكم خاص بفلان بعينه ، فالصحيح أنها عامة في هؤلاء ومن كان في منزلتهم هذا على قول ، وعلى قول أنها عامة العموم المطلق ؛ لأن الأمة مخاطبة بهذا .
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! " |
|
#7
|
|||
|
|||
|
اللهم آمين وإياكِ أيا سلفية.
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! " |
 |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أصول، التفسير |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
 |
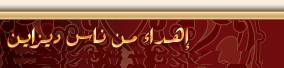 |