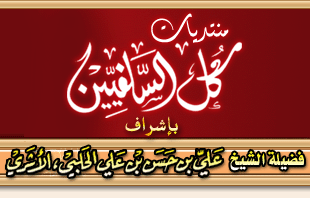

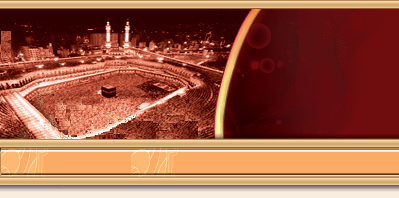
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
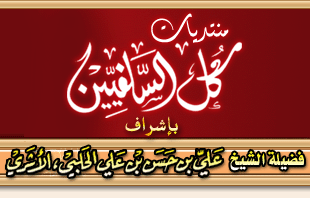 |
 |
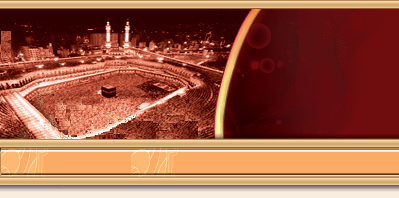 |
|||||
|
|||||||
| 77287 | 98094 |
|
#41
|
|||
|
|||
|
الألوسى
تمتعت الأسرة الآلوسية بمنزلة رفيعة وتقدير عظيم لمكانة أبنائها واشتغالهم بالعلم وتصدرهم للدرس والإفتاء والقضاء في بغداد. وأصل هذه الأسرة من جزيرة آلوس في نهر الفرات، ومن هنا جاءت التسمية، وقد ارتحل عميد هذه الأسرة الكريمة السيد محمود الخطيب الآلوسي إلى بغداد واتخذها وطنًا في الثلث الأخير من القرن القرن الثاني عشر الهجري، وكان عالمًا صالحًا، أحسن تربية أبنائه وتعليمهم، فساروا في طريقه، وجلسوا للتدريس والقضاء، وتعاقب أحفاده يحملون راية آبائهم في تواصل جاد وعمل مثمر حتى يومنا هذا، غير أن الذي طير شهرة العائلة، وجعلها محط الأنظار هو الإمام أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله صلاح الدين بن محمود الخطيب الآلوسي. المولد والنشأة ولد أبو الثناء محمود الآلوسي في بغداد في (15 شعبان 1217 هـ = 11 من ديسمبر 1803م). ونشأ في بيت علم وفضل، فأبوه واحد من كبار علماء بغداد، وكان بيته كعبة للعلماء والطلاب، حيث تعقد جلسات العلم وتطرح سائله وقضاياه المختلفة في الفقه والحديث والتفسير والنحو والبلاغة والبيان وغيرها من العلوم. وفي هذا الجو العلمي نشأ الصبي الصغير، وتعلقت عيناه بأبيه وهو يراه يتصدر تلك الحلقات مناقشًا ومحاورًا ومعلمًا، ويلقى من الحاضرين أسمى آيات التقدير والإعجاب، وسمت نفس الصبي إلى طلب العلم وتحصيله، وكان في نفسه استعداد عظيم للعلم، وحافظة قوية تلتهم ما تقرأه، وهمة عالية في المثابرة على المذاكرة، ولم تمض عليه سنوات قليلة حتى كان قد أتم حفظ المتون في الفقه والنحو والعقيدة والفرائض قبل أن يتم الرابعة عشرة من عمره. ولم يقتصر الآلوسي في طلب العلم على والده، بل اتجه إلى حلقات غيره من أفذاذ العلماء في عصره، فاتصل بالشيخ علي السويدي، وأمين الحلي، وخالد النقشبندي، وعبد العزيز الشواف، ثم تطلعت همته إلى السفر إلى بيروت ودمشق، ليتتلمذ على علمائها. علاقته بداود باشا وفي تلك الفترة كانت العراق قد شهدت بواكير نهضة مباركة قام عليها داود باشا والي بغداد النابه، فاستقدم عددًا من الخبراء الأوروبيين وعهد إليهم بإنشاء المصانع وبناء المدارس، وأقام مطبعة حديدة، وأصدر صحيفة سماها جرنال العراق، وأعاد تعمير المساجد القديمة، وعين بها جماعة من العلماء للتدريس، وكان لهذه الجهود أثر لا ينكر في تحريك الحياة الراكدة، وكان من الطبيعي أن يجد الفتى النابه في داود باشا رمزًا للنهوض واليقظة، فوقف معه وعاونه. ولما اشتد الخلاف بين داود باشا والدولة العثمانية، وكان هو واليا من قبلها وقف الآلوسي في صف الوالي وآزره، وحشد الرأي العام في تأييده ومعاونته ضد الجيش العثماني الذي أحكم الحصار على بغداد، وشاءت الأقدار أن ينتشر الطاعون في بغداد فيعصف بالأهالي في غير رحمة، وزاد الأمر سوءا فيضان دجلة بمياه كاسحة أغرقت المدينة، ولم يجد داود باشا فائدة من المقاومة فاستسلم للجيش العثماني. وجاء قائد الحملة ليبحث عن رجال داود باشا ومعاونيه ويزج بهم في السجون، وكان الآلوسي واحدا ممن طالتهم المحنة، وحلت بهم المصيبة، وزجوا في السجون. في كنف الوالي الجديد غير أن نباهة الآلوسي وسعة علمه بلغت مسامع الوالي الجديد رضا باشا، فطلب بعض مؤلفاته ليقرأها وكان على حظ من المعرفة، فنالت إعجابه، وأصدر أمرًا بالإفراج عن الآلوسي وعينه خطيبًا لجامع الشيخ عبد القادر الجيلي، وكان يحضر دروسه، فأعجب بحسن بيانه وغزارة علمه، واتفق أن أنجز كتابه "كتاب البرهان في إطاعة السلطان" فقدمه إليه، فأجازه عليه بتولية أوقاف مدرسة مرجان التاريخية، وكانت لا تُعطي إلا للجهابذة من العلماء، ثم ولاه منصب الإفتاء في بغداد وهو في الثلاثين من عمره، تقديرًا لعلمه وكفايته ونبوغه وذكائه، كان يشترط فيمن يتولى هذا المنصب الجليل في الدولة العثمانية أن يكون حنفي المذهب؛ لأنه المذهب الرسمي للدولة، وعلى الرغم من كون الآلوسي شافعي المذهب فإنه استطاع في فترة قصيرة أن يدرس المذهب في أوسع كتبه ومدوناته الكبيرة، وأن يلم بقضاياه ومسائله. ولما ظهرت نعمة الله على الآلوسي واتسع رزقه، اشترى دارًا واسعة، وجعل قسمًا منها مسكنًا لطلابه الذين يغدون إليه من أطراف العراق وكردستان لتلقي العلم عليه، ولم يكتف الآلوسي باستقبالهم في مسكنه، وإنما امتدت إليه مظلة كرمه، فكان يطعمهم ويتكفل بهم. محنته لم يمكث رضا باشا في ولايته على العراق طويلا، فحل مكانه محمد نجيب، ولم يجد الآلوسي في ظل ولايته ما كان يجده عند الوالي السابق من التقدير والإجلال، بل ضاق من مكانته ونفوذه العلمي في بغداد، فانتهز فرصة اشتعال مظاهرة ضده واتهم الآلوسي بأنه الذي يقف خلفها، وسارع بغزله عن الإفتاء، وحاربه في رزقه، وحال بينه وبين السفر إلى الأستانة لمقابلة الخليفة العثماني. واضطرته هذه الظروف الصعبة إلى بيع أثاث بيته حتى يتمكن من الإنفاق على بيته وعلى العشرات من طلابه الذين يسكنون بيته، وكانت في الشيخ عزة نفس وإباء، فلم يشأ أن يعلن عن ضيق ذات يده، وفي الوقت نفسه انشغل بإكمال تفسيره للقرآن حيث كان يجد فيه السلوى عما به من ضيق، حتى إذا انقضت سنوات المحنة انطلق إلى الأستانة ومعه تفسيره (1267 هـ = 1851م). الرحلة إلى الأستانة وفي دار الخلافة العثمانية استقبله محمد عارف حكمت شيخ الإسلام استقبالا حسنًا، وأشار عليه أن يكتب إلى الصدر الأعظم مذكرة عن حاله وما يرجوه، فكتب إليه، فأعجب الصدر الأعظم بما كتب، ونعم برضا الخليفة عبد المجيد، الذي رتب له مالا جزيلا كل عام، وعاد إلى بغداد بعد أن مكث في دار الخلافة واحدًا وعشرين شهرًا، وخرجت بغداد كلها في استقباله. مؤلفاته ترك الآلوسي مؤلفات كثيرة، إذ كان ذا قلم سيال، وفكر متدفق، ومنطق منظم، وبدأ التأليف منذ فترة باكرة وهو في الثالثة عشرة، ثم تتابعت مؤلفاته تترى في حياته المديدة، ومن هذه المؤلفات: - الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية، وهو إجابة لأسئلة بعث بها إليه أهالي الهند يستفتونه في بعض المسائل، وقد أجازه السلطان العثماني محمود الثاني على هذا الكتاب جائزة سنية (قيمة). - الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية، ويحتوي على ثلاثين مسألة مهمة في الفقه والتفسير واللغة والمنطق. - نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول، ودون فيه رحلته إلى عاصمة دار الخلافة واصفًا ما نزل به المدن، ومن قابله من الناس، وهي تعد وثيقة تاريخية تسجل فترة زمنية من التاريخ الاجتماعي والثقافي لأمتنا. - سُفْرة الزاد لسَفْرة الجهاد، دعا فيها المسلمين إلى اليقظة علميًا واقتصاديًا وعسكريًا، وأعلن أن الجهاد فريضة محتومة أمام اعتداءات الاستعمار. روح المعاني غير أن أجل إنتاج الآلوسي وأعظم آثاره التي جعلت له اسمًا مدويًا، وجلبت له الذيوع والشهرة، وأنزلته منزلة رفيعة بين كبار العلماء هو تفسيره المعروف بـ"روح المعاني" في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، وهو تفسير جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسير مثل تفسير ابن عطية وتفسير أبي حيان، والكشاف للزمخشري وتفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي وتفسير الفخر الرازي، وصاغ من ذلك كله تفسيره بعد أن أطال النظر فيما قرأ، ووازن وقارن ورجح ما اختاره، معتمدًا على زاد كبير من الثقافة الواسعة في علوم الشرع واللغة. وتوسع الآلوسي في تفسيره في المسائل البلاغية، وعني بمسائل النحو ولزم حدود الاعتدال في مناقشة الآراء الفقهية المخالفة للمذهب الحنفي. وفاة الآلوسي كان الآلوسي إمامًا لمدرسة كبيرة امتدت به، وتأثرت بطريقته ومنهجه في التأليف، ولولاه لربما تاخرت النهضة العلمية في العراق؛ لأن تلاميذه حملوا رايته ونهجوا طريقته، فاتصل تأثيره في الأجيال اللاحقة ولم ينقطع، وقد مدح في حياته ورثي بعد مماته بأشعار كثيرة لم تتح نظائرها إلا للملوك والأمراء، وقد جمع تلميذه الأديب عبد الفتاح الشواف، وابنه أبو البركات نعمان خير الدين هذه الأشعار في كتاب كبير من مجلدين سمياه: حديقة الورود في مدائح أبي الثناء محمود. ولم تطل الحياة بعد عودة الآلوسي من عاصمة دار الخلافة، حيث لقي ربه في (25 من ذي القعدة سنة 1270 هـ = 19 أغسطس 1854م). من مصادر الدراسة: • محمد حسين الذهبي – التفسير والمفسرون – مكتبة وهبة – القاهرة. • محمد رجب البيومي – النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين – دار القلم – دمشق – 1415 هـ = 1995م. عباس العزاوي – ذكرى أبي الثناء الآلوسي – بغداد – 1958م. • محمد بهجة الأثري – الألسيون – موسوعة الحضارة الإسلامية (فصلة تجريبية – عماده 1989م.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#42
|
|||
|
|||
|
ابن الصلاح
حمل الأئمة المحققون من السلف الصالح تكاليف الجهاد العلمي منذ أن نشطت حلقات العلم، وازدهرت حركة التأليف في القرون الأولى، وكان كل جيل يسلم ما لديه من أمانة العلم إلى من خلفه، فيحمل المشعل المتّقد، ويصونه ويسدّ ثغراته، ويكمل ما يحتاج إلى إكمال وتنظيم. وفي الوقت الذي نشطت فيه حركة جمع الحديث، ووضع المؤلفات الجامعة، كانت توضع الضوابط الدقيقة للأسانيد والرواة، والآليات التي تمكّن من البصر بعلل المرويات ومظان الوهم أو التدليس والخطأ. وكان جهابذة المحدثين يجمعون بين الاشتغال بالرواية والجمع وتصنيف السنن والصحاح من جانب، والبصر بالأسانيد ومعرفة الرجال: كأحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم من جانب آخر، وقد يغلب جانب على آخر، فتغلب مشاركة صاحبه في التأليف فيه. وكانت دواوين السنة أسبق في الظهور من الكتب التي تتعلق بعلم الحديث الذي يتناول الرواية وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف الكتب التي تجمع الحديث من الجوامع، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، وغيرها. ويعد القاضي "أبو محمد الرامَهُرمزي" المتوفى سنة (360 هـ = 970م) أول من صنف في هذا الفن الذي يُعرف بعلم الحديث، وقعّد قواعده، وأرسى أصوله، في كتابه "المحدث الفاصل بين الراوي والواعي"، وإن لم يستوعب جميع أبحاث هذا الفن، ثم جاء الحاكم النيسابوري، صاحب "المستدرك على الصحيحين" المتوفَّى سنة (405هـ = 1014م)، فخطا بهذا الفن خطوات واسعة، في كتابه "معرفة علوم الحديث"، وهو الكتاب الذي سار على نهجه من صنفوا بعده الكتب الجامعة في علوم الحديث. ثم جاء الحافظ أبو بكر البغدادي المتوفى سنة (463هـ=1070م)، فعكف على تحرير مناهج المحدثين من شوائب الخلل التي طرأت عليها، فصنف عدة كتب لمعالجة هذا الأمر، فوضع في أصول الحديث كتابه "الكفاية في علم الرواية"، وألف في آداب الرواية كتابه "الجامع لآداب الشيخ والسامع". وأسهم علماء المغرب في هذا الفن، وكان قد صار دار حديث ورواية، وأنجب أفذاذًا من المحدثين، فيضع حافظ المغرب "القاضي عياض" المتوفى سنة (544هـ = 11449م) كتابه المعروف "الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع". وفي القرن السابع الهجري يتقدم "ابن الصلاح" المتوفى (643هـ=1245م) فيحيي تراث السلف الصالح في هذا الفن، ويعيد إليه حيويته ونضارته بكتابه المعروف بـ"مقدمة ابن الصلاح"، الذي يعد عمدة في المنهج النقلي لتوثيق المصادر وتحقيق النصوص في مجال الدراسات الإسلامية. المولد والنشأة في سنة (577 هـ = 1181م) وُلد "تقي الدين عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن عثمان" في بلدة "شرخان" قرب "شهرزور" التابعة لإربل بالعراق، وغلب عليه لقب أبيه الصلاح عبد الرحمن، فصار لا يعرف إلا به. وكان والده من مشايخ بلدته، فأولاه عنايته؛ حيث عهد به إلى من حفّظه القرآن وعلمه التجويد، ثم تلقى على يديه علومه الأولى في الفقه، وقد أرسله إلى "الموصل" فسمع الحديث من "أبي جعفر عبيد الله بن أحمد" المعروف بابن السمين، فكان أول شيوخه بعد أبيه، ثم تردد على عدد من علماء الموصل يسمع منهم الحديث، ولزم أستاذه "عماد الدين أبا أحمد بن يونس" الذي اصطفاه معيدًا له، فأقام لديه فترة، ثم بدأ الرحلة في طلب الحديث، فرحل إلى همذان ونيسابور ومرو وبغداد ودمشق يسمع من أعلامها ويروي عنهم. الاشتغال بالتدريس وبعد هذه السياحة الطويلة في طلب العلم، استقر في مدينة القدس في بادئ الأمر مدرسًا بالمدرسة الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي، وأقبل الناس عليه لِمَا رأوا من علمه وتقواه، ثم انتقل إلى دمشق تسبقه شهرته وفضله، فتولى التدريس في المدرسة الرواحية، ولَمّا بنى الملك الأشرف ابن الملك العادل دار الحديث الأشرفية، تولى ابن الصلاح أمرها والتدريس بها، ثم عهد إليه- إلى جانب ذلك- التدريس في مدرسة "ست الشام"، وهي المدرسة التي أنشأتها "زمرد خاتون" بنت "أيوب" زوجة "ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه" صاحب حمص. ويذكر المؤرخ الكبير ابن خلكان أنه قدم عليه في (شوال 632هـ=مايو 1235م) وأقام عنده، وذكر أنه كان يقوم بوظائفه على خير وجه دون إخلال، وقد تتلمذ عليه كثيرون، منهم: ابن خلكان، وفخر الدين عمر بن يحيى الكرجي، وزين الدين الفارقي، وغيرهم. مقدمة ابن الصلاح لم تشغله أعباء مناصبه عن الفتيا والتأليف، فصنّف في علوم الحديث والرواية، والرجال والفقه، بالإضافة إلى شروحه وأماليه وفتاواه، ومن تلك المؤلفات: "شرح صحيح مسلم"، و"أدب المفتي والمستفتي"، و"طبقات فقهاء الشافعية"، و"مشكل الوسيط في فقه الشافعية"، و"مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث"، وقد جمع في هذا الكتاب ما انتهت إليه جهود العلماء الذين سبقوه من المشارقة والمغاربة، وأحسن تصنيفها وثبوتها. وقد تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول، واستأثر بمنزلة خاصة عند العلماء في عصر ابن الصلاح والعصور التي تلته، وتتابع عليه العلماء شرحًا وتلخيصًا ونظمًا، وعَدُّوه من أحسن ما صنف أهل الحديث في معرفة اصطلاح الحديث. فلخصه الإمام محيي الدين النووي المتوفى سنة (676هـ = 1277م) في كتاب سماه "الإرشاد إلى علم الإسناد"، ثم اختصر التلخيص في كتابه "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير"، وهو الذي شرحه الحافظ السيوطي في كتابه التدريب، كما اختصر المقدمة قاضي القضاة "بدر الدين بن جماعة" المتوفى سنة (733هـ=1332م) في كتابه "مختصر مقدمة ابن الصلاح". وقد نظّم قاضي "القضاة شهاب الدين الخولي" المتوفى سنة (693هـ = 12933م) مقدمة ابن الصلاح شعرًا في أرجوزته "أقصى الأمل والسول في علوم أحاديث الرسول"، وقام بهذا العلم أيضًا الحافظ "زين الدين العراقي" في ألفيته (أي ألف بيت) المعروفة بألفية العراقي، وعمل لها شرحًا سماه "فتح المغيث". وقام جماعة من كبار حفاظ الحديث فوضعوا شروحًا لتلك المقدمة، يأتي في مقدمتها: "محاسن الاصطلاح" لسراج الدين البلقيني المتوفى (805هـ=1402م)، و"التقييد وإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح" لزين الدين العراقي المتوفى (806هـ=1403م)، ويجدر بالذكر أن الدكتورة "عائشة عبد الرحمن" قد نشرت في مصر مقدمة "ابن الصلاح" مع كتاب "محاسن الاصطلاح" نشرة علمية دقيقة، مع مقدمة نفيسة، سنة (1394هـ = 1974م). وفاة ابن الصلاح وبعد حياة حافلة تُوفي ابن الصلاح في دمشق في سحر الأربعاء الموافق (25من ربيع الآخر 643هـ = 19من سبتمبر 1245م)، وقد ازدحم الناس للصلاة عليه، وتم دفنه في مقابر الصوفية. من مصادر الدراسة: • تاج الدين السبكي- طبقات الشافعية الكبرى- تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي- هجر للطباعة والنشر- القاهرة (1413 هـ = 1992). • ابن خلكان- وفيات الأعيان- تحقيق إحسان عباس- دار صادر- بيروت- بدون تاريخ. • الذهبي- سير أعلام النبلاء- تحقيق بشار عواد معروف ومحيي هلال السرحان- المجلد (23)- مؤسسة الرسالة- بيروت (1412 هـ = 1992م). • عائشة عبد الرحمن- مقدمة تحقيقها لكتابي مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح- دار الكتب المصرية- القاهرة (1994م).
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#43
|
|||
|
|||
|
إبن دقيق العيد
لم تكن القاهرة وحدها في العصر المملوكي حاضرة العلم في مصر، ومركز الإشعاع الثقافي وملتقى العلماء والفقهاء، بل نافستها مراكز أخرى في صعيد مصر، امتلأت بالمدارس ودور الحديث، وازدانت بأعلامها من رجال الفقه والحديث واللغة والأدب، وكانت إسنا وقوص وأسيوط وأخميم، وأسوان، ومنفلوط، تموج حركة ونشاطًا، بحلقات العلم التي تحتضنها ساحات المساجد وقاعات المدارس. ويذكر ابن دقماق المؤرخ المصري أنه كان بقوص وحدها ستة عشر مكانًا للتدريس، وبلغ من ازدهار الحركة العلمية بصعيد مصر في تلك الفترة المملوكية أن وضع الأدفوي كتابه المعروف "الطالع السعيد" وخصصه فقط لتراجم نجباء علماء الصعيد. المولد والنشأة في عرض البحر ولد ابن دقيق العيد، وأبواه متوجهان إلى الحجاز لأداء فريضة الحج في (25 من شعبان 625هـ=31 من يونيو 122م)، ولما قدم أبوه مكة حمله، وطاف به البيت، وسأل الله أن يجعله عالمًا عاملاً. ونشأ ابن دقيق العيد في قوص بين أسرة كريمة، تعد من أشرف بيوتات الصعيد وأكرمها حسبًا ونسبًا، وأشهرها علمًا وأدبًا، فأبوه أبو الحسن علي بن وهب عالم جليل، مشهود له بالتقدم في الحديث والفقه والأصول، وعُرف جده لأبيه بالعلم والتقى والورع، وكانت أمه من أصل كريم، وحسبها شرفًا أن أباها هو الإمام تقي الدين بن المفرج الذي شُدّت إليه الرحال، وقصده طلاب العلم. وتعود سبب شهرته باسم ابن دقيق العيد، أن جده "مطيعًا" كان يلبس في يوم عيد طيلسانًا ناصع البياض، فقيل كأنه دقيق العيد، فسمي به، وعُرف مطيع بدقيق العيد، ولما كان "علي بن وهب" حفيده دعاه الناس بابن دقيق العيد، واشتهر به ابنه تقي الدين أيضًا، فأصبح لا يُعرف إلا به. بدأ ابن دقيق العيد طريق العلم بحفظ القرآن الكريم، ثم تردد على حلقات العلماء في قوص، فدرس الفقه المالكي على أبيه، والفقه الشافعي على تلميذ أبيه البهاء القفطي، ودرس علوم العربية على محمد أبي الفضل المرسي، ثم ارتحل إلى القاهرة واتصل بالعز بن عبد السلام، فأخذ عنه الفقه الشافعي والأصول، ولازمه حتى وفاته. ثم تطلعت نفسه إلى الرحلة في طلب العلم، وملاقاة العلماء، فارتحل إلى دمشق في سنة (660هـ=1261م) وسمع من علمائها ثم عاد إلى مصر. قيامه بالتدريس والتأليف استقر ابن دقيق العيد بمدينة قوص بعد رحلته في طلب الحديث، وتولى قضاءها على مذهب المالكية، وكان في السابعة والثلاثين من عمره، ولم يستمر في هذا المنصب كثيرًا، فتركه وولى وجهه شطر القاهرة وهو دون الأربعين، وأقام بها تسبقه شهرته في التمكن من الفقه، والمعرفة الواسعة بالحديث وعلومه. وفي القاهرة درس الحديث النبوي في دار الحديث الكاملية، وهي المدرسة التي بناها السلطان الكامل سنة (621هـ=1224م)، ثم تولى مشيختها بعد ذلك، وكان على تبحره في علوم الحديث يتسدد في روايته، فلا يروي حديثًا إلى عن تحرٍّ واحتراز، ومن ثم كان قليل التحديث لا عن قلة ما يحفظه ولكن مبالغة في التحري والدقة. ويصف ابن سيد الناس مكانة شيخه ابن دقيق العيد في هذا الفن بقوله: "وكان للعلوم جامعًا، وفي فنونها بارعًا مقدمًا في معرفة علل الحديث على أقرانه، منفردًا بهذا الفن النفيس في زمانه". ولابن دقيق العيد كتاب عمدة في علم مصطلح الحديث سماه "الاقتراح في معرفة الاصطلاح" والكتاب مطبوع نشرته وزارة الأوقاف بالعراق. ودرّس الفقه الشافعي في المدرسة الناصرية التي أنشأها صلاح الدين الأيوبي بجوار قبة الإمام الشافعي، ولما كان شيخًا قد تضلّع في الفقه وأحاط بمسائله في المذهبين المالكي والشافعي؛ فقد قام بتدريسهما في المدرسة الفاضلية. ولم يقف الشيخ الجليل على أدلة المذهبين، والاجتهاد في نطاقهما، وإنما تجاوز ذلك إلى مرحلة الاجتهاد المستقل في بعض ما كان يعرض له من قضايا، حيث كان يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة، غير مقلد لأحد في اجتهاده، وقد شهد له معاصروه بالسبق والتقدم في الفقه، وأقروا له بالاجتهاد، فوصفه الإسنوي بأنه "حافظ الوقت خاتمة المجتهد". ويقول الأدفوي: "ولا شك أنه من أهل الاجتهاد ولا ينازع في ذلك إلا من هو من أهل العناد، ومن تأمل كلامه علم أنه أكثر تحقيقًا وأمتن وأعلم من بعض المجتهدين فيما تقدم وأتقن". وله مؤلفات فقهية تنطق بعلو كعبه في هذا الميدان، منها: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني النابلسي. وكتاب العمدة يحتوي على مجموعة من الأحاديث مبوبة على أبواب الفقه، مثل باب الطهارة وباب الوضوء، وباب التيمم، وقد قام ابن دقيق العيد بشرح الكتاب، فتصدى لبيان معاني الحديث، وما به من بيان، واستنبط ما فيه من أحكام، وأقوال الفقهاء فيه واختلافاتهم. وقد أملى ابن دقيق العيد هذا الشرح على تلميذه عماد الدين بن الأثير. وقد طُبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة (1342هـ= 1924م) واعتنى بنشره محمد منير الدمشقي. وإلى جانب هذا له شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه، وشرح مختصر الزبيدي في فقه الشافعية، وشرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية، غير أن هذه الكتب فُقدت ولم يصل إلينا منها شيء. وله جملة من الفتاوى والمباحثات الفقهية والأصولية، لا يجمعها كتاب، وقد أورد السبكي في طبقات الشافعية نماذج منها، وقد صدرها بقوله: "فوائد الشيخ تقي الدين ومباحثه أكثر من أن تُحصى، ولكنها غالبًا متعلقة بالعلم من حيث هو؛ حديثًا وأصولاً وقواعد كلية". الأديب الشاعر كان ابن دقيق العيد على انشغاله بالفقه والحديث أديبًا بارعًا، وخطيبًا مفوهًا، وشاعرًا مجيدًا، ولو انصرف إلى الأدب لكان له منزلة ومكانة، ويجمع معاصروه على براعته في الخطابة وتفوقه فيها، فكان يملك أفئدة الناس بأسلوبه المؤثر ونبراته الصادقة، وعظاته البالغة، وذكر السبكي أن لابن دقيق العيد "ديوان خطب". وله أيضًا "ديوان شعر" جمعه صلاح الدين الصفدي المؤرخ المعروف، ونُشر بالقاهرة. قاضي القضاة تولى ابن دقيق العيد منصب قاضي القضاة في أخريات حياته في (18 من جمادى الأولى 695هـ= من مارس 1296م) بعد وفاة القاضي ابن بنت الأعز، وقبله بعد تردد وإلحاح، وكانت فترة توليه القضاء على قصرها من أكثر سني عمره خطرًا وأعظمها شأنًا، فقد أصبح على اتصال وثيق بالسلطان وكبار رجال الدولة، لكن كان له من ورعه ودينه وعلمه ما يجعله يجهر بالحق ويدافع عنه، فلا يقبل شهادة الأمير؛ لأنه عنده غير عدل، وإن كان الكبراء والعلماء يتملقونه ويقتربون إليه، فرد شهادة "منكوتمر" نائب السلطنة حين بعث إليه يعلمه أن تاجرًا مات وترك أخًا من غير وارث سواه، وأراد منه أن يثبت استحقاق الأخ لجميع الميراث بناء على هذا الإخبار، فرفض ابن دقيق العيد، وترددت الرسل بينهما، لكن القاضي كان يرفض في كل مرة، على الرغم من إلحاح منكوتمر عليه؛ لأن الأدلة لم تكن كافية لإثبات أخوة المذكور إلا شهادة منكوتمر، وأمام إصرار نائب السلطنة، استقال ابن دقيق من منصب القضاء احترامًا لنفسه وإجلالاً لمنصب القضاء، فلما بلغ السلطان "حسام الدين لاجين" ذلك أنكر على نائبه تصرفه في التدخل في عمل القضاء، وأرسل في طلب الشيخ، فلما جاء قام إليه وأجلسه بجواره، وأخذ يسترضيه ويتلطف به حتى قبل أن يعود إلى منصبه. ويذكر له وهو في منصبه أن رفض قيام السلطان "الناصر محمد بن قلاوون" بجمع المال من الرعية لمواجهة التتار، معتمدًا على الفتوى التي أصدرها العز بن عبد السلام بجواز ذلك أيام سيف الدين قطز، وقال للسلطان: إن ابن عبد السلام لم يفت في ذلك إلا بعد أن أحضر جميع الأمراء كل ما لديهم من أموال، ثم قال له في شجاعة: كيف يحل مع ذلك أخذ شيء من أموال الرعية، لا والله لا جاز لأحد أن يتعرض لدرهم من أولاد الناس إلا بوجه شرعي" واضطر السلطان أن يرضخ لكلام القاضي الشجاع. ولا شك أن ابن دقيق العيد قد ارتفع بمنزلة القاضي وحافظ على كرامة منصبه، فتطبيق الأحكام الشرعية هو سبيله إلى العدل دون تفرقة، والالتزام بالحق هو الميزان الذي يستعمله في قضاياه وفتاواه، فحين رأى بعض الناس تستحلّ أموال اليتامى القصّر الذين لا يستطيعون التصرف فيما يرثونه من أموال أنشأ ما يسمى "المودع الحكمي"، وهو شبه في زماننا "الديوان الحسبي" تُحفظ فيه أموال اليتامى الصغار، يقول ابن حجر العسقلاني: "وهو أول من عمل المودع الحكمي، وقرر أن من مات وله وارث إن كان كبيرًا أقبض حصته، وإن كان صغيرًا أحمل المال في المودع، وإن كان للميت وصي خاص ومعه عدول يندبهم القاضي لينضبط أصل المال على كل تقدير". وكان ابن دقيق معنيًا بشئون القضاة الذين يتبعونه في الأقاليم، فيرسل إليهم الرسائل المطولة التي ترسم لهم ما يجب عليهم أن ينتهجوه ويلتزموه في أحكامهم، وكيفية معالجة قضايا الناس، وتضمنت رسائله أيضًا وصاياه لهم بالتزام العدل وتطبيق أحكام الشرع. وفاة الشيخ يذكر عدد كبير من المؤخرين أن ابن دقيق العيد كان على رأس المائة السابعة الذي حدد للأمة أمر دينها بعلمه الغزير واجتهاده الواسع، وشهد له معاصروه بالسبق والتقدم في العلم، فقد كان ضليعًا في جميع العلوم اللغوية والشرعية والعقلية. ويؤكد السبكي ذلك فيقول: "ولم ندرك أحدًا من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة، المشار إليه في الحديث النبوي، وأنه أستاذ زمانه علمًا ودينًا". وقضى الشيخ حياته بين التأليف والتدريس نهارًا، والعبادة والصلاة ليلاً، حتى لقي الله في يوم الجمعة (11 من صفر 702هـ=5 من أكتوبر 1302م). من مصادر الدراسة: • عبد الوهاب السبكي: طبقات الشافعية الكبرى – تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو – دار هجر للطباعة والنشر – القاهرة – 1413هـ=1992م. • الأدفوي: الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد – تحقيق سعد محمد حسن – الدار المصرية للتأليف والترجمة – القاهرة – 1966م. • الإسنوي: طبقات الشافعية – تحقيق عبد الله الجبوري – رئاسة ديوان الأوقاف – بغداد – 1390هـ. • محمود رزق سليم: عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي – مكتبة الآداب – القاهرة – بدون تاريخ. • علي صافي حسين: ابن دقيق العيد حياته وديوانه – دار المعارف – القاهرة – 1960م.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#44
|
|||
|
|||
|
ابن جرير الطبري
هو أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، الإمام الجليل ، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف المشهورة ، وهو من أهل آمل طبرستان، ولد بها سنة 224هـ أربع وعشرين ومائتين من الهجرة ، ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، سنة ست وثلاثين ومائتين ، وطوّف في الأقاليم ، فسمع بمصر والشام والعراق ، ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد ، وبقى بها إلى أن مات سنة عشر وثلاثمائة . مبلغه من العلم والعدالة : كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام ، يُحكم بقوله ، ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظـًا لكتاب الله ، بصيرًا بالقرآن ، عارفـًا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن ، عالمـًا بالسنن وطرقها ، وصحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، عارفـًا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، عارفـًا بأيام الناس وأخبارهم .. هذا هو ابن جرير في نظر الخطيب البغدادي، وهي شهادة عالم خبير بأحوال الرجال ، وذكر أن أبا العباس بن سريج كان يقول : محمد بن جرير فقيه عالم ، وهذه الشهادة جد صادقة ؛ فإن الرجل برع في علوم كثيرة ، منها : علم القراءات ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، والتاريخ ، وقد صنف في علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما صنف . مصنفاته : كتاب التفسير، وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك، وكتاب القراءات، والعدد والتنزيل ، وكتاب اختلاف العلماء ، وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين ، وكتاب أحكام شرائع الإسلام ، وكتاب التبصر في أصول الدين … وغير هذا كثير . ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد ، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا وبالشهرة الواسعة ، سوى كتاب التفسير ، وكتاب التاريخ . وقد اعتبر الطبري أبا للتفسير ، كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامي ، وذلك بالنظر لما في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية ، ويقول ابن خلكان : إنه كان من الأئمة المجتهدين ، لم يقلد أحدًا ، ونقل : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين ، قالوا : وله مذهب معروف ، وأصحاب ينتحلون مذهبه ، يقال لهم الجريرية ، ولكن هذا المذهب الذي أسسه ـ على ما يظهر ـ بعد بحث طويل ، ووجد له أتباعـًا من الناس ، لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب المسلمين ؛ ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهبـًا بمذهب الشافعي ، يدلنا على ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى لابن السبكي ، من أن ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعي ، وأفتيت به ببغداد عشر سنين . علو همتـه : كان رحمه الله عالي الهمة متوقد العزم ـ قال : عند تفسيره للقرآن : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة ، فقالوا هذا ما يفني الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة . اتهامه بالوضع للروافض : وقد اتُهِمَ رحمه الله بأنه كان يضع للروافض، وهذا رجم بالظن الكاذب ، ولعله أشبه على صاحب هذا القول ابن جرير آخر ، وهو محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي . وفاته : مرض أبو جعفر بذات الجنب فجاءه الطبيب فسأل أبا جعفر عن حاله ، فعرّفه حاله وما استعمل وما أخذ لعلته ، وما انتهى إليه في يومه ، فقال له الطبيب : ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء ، فلما كان يوم السبت لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثمائة كانت منيته ودفن يوم الأحد ، ولم يؤذن به أحد ، فاجتمع على جنازته ما لا يحصى عددهم إلا الله ، وصلى على قبره شهورًا ليلاً ونهارًا . هذا هو ابن جرير ؛ وهذه هي نظرات العلماء إليه ، وذلك هو حكمهم عليه ، ومن كل ذلك تبين لنا قيمته ومكانته . التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : يعتبر تفسير بن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها ، كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي ؛ وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعـًا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي ؛ نظرًا لما فيه من الاستنباط ، وتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ، ترجيحـًا يعتمد على النظر العقلي ، والبحث الحر الدقيق . ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءًا من الحجم الكبير ، وقد كان هذا الكتاب من عهد قريب يكاد يعتبر مفقودًا لا وجود له ، ثم قدّر الله له الظهور والتداول ، فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن وجدت في حيازة أمير ( حائل ) الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمر اء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب ، طبع عليها الكتاب من زمن قريب ، فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المأثور . ما قيل في تفسيره : ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير ، لوجدنا أن الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته ، واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه لطالب التفسير ، فقد قال السيوطي رضي الله عنه " وكتابه ـ يعني تفسير محمد بن جرير ـ أجل التفاسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ، والإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوق بذلك على تفسير الأقدمين " . وقال النووي : " أجمعت الامة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري " . وقال ابو حامد الإسفرايني : " لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا " . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما التفاسير التي في أيدي الناس ، فأصحها تفسير ابن جرير الطبري ، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ، وليس فيه بدعة ، ولا ينقل عن المتهمين ، كمقاتل بن بكير والكلبي " . ويذكر صاحب لسان الميزان : أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالوية فرده بعد سنين ، ثم قال : " نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير " . هذا وقد كتب ( نولدكه ) سنة 1860م بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب " لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ، ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تمامـًا ، وكان مثل تاريخه الكبير مرجعـًا لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم " . اختصار الطبري لتفسيره : ويظهر مما بأيدينا من المراجع ، أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم ، ثم اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذي هو عليه الآن ، فابن السبكي يذكر في طبقاته الكبرى " أن أبا جعفر قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ فقال : ثلاثون ألف ورقة ، فقالوا : هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه ، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ثم قال : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ ، قالوا : كم قدره ؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسير ، فأجابوه بمثل ذلك ، فقال : إنا لله ، ماتت الهمم ، فاختصره في نحو ما اختصر التفسير " أ.هـ . أولية تفسيره : هذا ونسطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية بين كتب التفسير ، أولية زمنية ، وأولية من ناحية الفن والصناعة . أما أوليته الزمنية ، فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا ، وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن ، ولم يصل إلينا شيء منها ، اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده . وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة ؛ فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها في مؤلفه ، حتى أخرجه للناس كتابـًا له قيمته ومكانته ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في تفسيره ، بعد أن أخذنا فكرة عامة عن الكتاب، حتى يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه ، سبق به مؤلفه غيره من المفسرين ، فكان عمدة المتأخرين ، ومرجعـًا مهمـًا من مراجع المفسرين ، على اختلاف مذاهبهم ، وتعدد طرائقهم ، فنقول : طريقة ابن جرير في تفسيره : تتجلى طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في القراءة شوطـًا بعيدًا ، فأول ما نشاهده ، أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول " القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ، ثم يفسر الآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية ، وإذا كان في الآية قولان أو أكثر ، فإنه يعرض لكل ما قيل فيها ، ويستشهد على كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين . ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية ، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال ، ويرجح بعضها على بعض ، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك ، كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية من توجيه الأدلة وترجيح ما يختار . إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي : ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكير ، ولا يزال يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين ، والمنقول عنهم نقلاً صحيحـًا مستفيضـًا ، ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح ، فمثلاً عند ما تكلم عن قوله تعالى في الآية (49) من سورة يوسف ( ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناسُ وفيه يعصِرون ) نجده يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية ، ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه ، وبدون اعتماد منه على شيء إلا على مجرد اللغة ، فيفند قوله ، ويبطل رأيه ، فيقول ما نصه " .. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ، ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب ، يوجه معنى قوله ( وفيه يعصرون ) إلى وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث ، ويزعم أنه من العصر ، والعصر التي بمعنى المنجاة، من قول أبي زبيد الطائي : صاديـا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود أي المقهور ـ ومن قول لبيد : فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافـًا بغير معصر وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين . موقفه من الأسانيد : ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها ، إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف ، لأنه كان يرى ـ كما هو مقرر في أصول الحديث ـ أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح ، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانـًا موقف الناقد البصير، فيعدل من يعدل من رجال الإسناد ، ويجرح من يجرح منهم ، ويرد الرواية التي لا يثق بصحتها ، ويصرح برأيه فيها بما يناسبها ، فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 94) من سورة الكهف : ( .. فهل نجعل لك خرجـًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا )يقول ما نصه : " روى عن عكرمة في ذلك ـ يعني في ضم سين سدًا وفتحها ـ ما حدثنا به أحمد بن يوسف ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنا حجاج ، عن هرون ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : ما كان من صنعة بني آدم فهو السَّد يعني بفتح السين ، وما كان من صنع الله فهو السُّد ،ثم يعقب على هذا السند فيقول : وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلك ، فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هرون ، وفي نقله نظر ، ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة أصحابه " أ.هـ . تقديره للإجماع : كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ، ويعطيه سلطانـًا كبيرًا في اختيار ما يذهب إليه من التفسير ، فمثلاً عند قوله تعالى في الآية ( 230) من سورة البقرة ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـًا غيره ) يقول ما نصه : " فإن قال قائل : فأي النكاحين عنى الله بقوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـًا غيره ؟ النكاح الذي هو جماع ؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج ؟ قيل كلاهما ؛ وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجـًا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول ، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول ؛ لإجماع الأمة جميعـًا ، فإذا كان ذلك كذلك " فمعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـًا غيره ، نكاحـًا صحيحـًا ، ثم يجامعها فيه : ثم يطلقها ، فإن قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره ، فما الدلالة على أن معناه ما قلت ؟ قيل : الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعـًا على أن ذلك معناه " . موقفه من القراءات : كذلك نجد أن ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني المختلفة ، وكثيرًا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة ، والتي تقوم على أصول مضطربة مما يكون فيه تغير وتبديل لكتاب الله ، ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب ، فمثلاً عند قوله تعالى في الآية (81) من سورة الأنبياء ( ولسليمان الريح عاصفة ) يذكر أن عامة قراء الأمصار قرءوا ( الريح ) بالنصب على أنها مفعول لـ "سخرنا" المحذوف ، وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ ( الريح ) بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول : والقراءة التي لا استجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه . سبب عناية ابن جرير بالقراءات : ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين ، حتى أنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفـًا خاصـًا في ثمانية عشر مجلدًا ، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه ، واختار منها قراءة لم يخرج بها من المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا ، شأن الكثير من مؤلفاته . موقفه من الإسرائيليات : ثم إننا نجد ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلي ، يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وابن جريج والسدي ، وغيرهم ، ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرًا مما رواه عن مسلمة النصارى ، ومن الأسانيد التي تسترعي النظر ، هذا الإسناد : حدثني ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي عتاب .. رجل من تغلب كان نصرانيـًا عمرًا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين ، وكان فيما ذكر ، أنه كان نصرانيـًا أربعين سنة ثم عمر في الإسلام أربعين سنة . يذكر ابن جرير هذا الإسناد ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل خبرًا عن آخر أنبياء بني إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى : ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ، فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا )(الإسراء/7) . " .. وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات ، ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة . وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقد ، فتفسيره لا يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل ، احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلي ، على أن ابن جرير ـ كما قدمنا ـ قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويها ، وبذلك يكون قد خرج من العهدة ، وعلينا نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات . احتكامه إلى المعروف من كلام العرب : وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه ، ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعـًا موثوقـًا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها ، وترجيح بعض الأقوال على بعض . فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كلٍ زوجين اثنين .. )(هود/40) نراه يعرض لذكر الروايات عن السلف في معنى لفظ التنور ، فيروى لنا قول من قال : إن التنور عبارة عن وجه الأرض ، وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير الصبح ، وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفها ، وقول من قال : إنه عبارة عما يختبز فيه .. ثم قال بعد أن يفرغ من هذا كله : " وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله ( التنور ) قول من قال : التنور : الذي يختبز فيه ، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب ، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب . رجوعه إلى الشعر القديم : كذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع ، متبعـًا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أندادًا .. )(البقرة/22) يقول ما نصه : " قال أبو جعفر : والأنداد جمع ند ، والند : العدل والمثل ، كما قال حسان ابن ثابت : أتهجوه ولست له بندٍ فشركما لخيركما الفداء اهتمامه بالمذاهب النحوية : كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرًا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في النحو والصرف ، ويوجه الأقوال ، تارة على المذهب البصري ، وأخرى على المذهب الكوفي ، فمثلاً عند قوله تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف )(إبراهيم/18) يقول ما نصه : " اختلف أهل العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال : ومما نقص عليكم مثل الذين كفروا ، ثم أقبل يفسره كما قال : مثل الجنة .. وهذا كثير . وقال بعض نحويي الكوفيين : إنما المثل للأعمال ، ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ، ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه ، ومعنى الكلام : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد .. إلخ . والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر كنزًا ثمينـًا ومرجعـًا في بابها ، أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب ، معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ ، ونرى أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن أمرًا مقصودًا لذاته ، وإنما كانت وسيلة للتفسير ، على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض ، كما يحاول بذلك ـ أحيانـًا ـ أن يوفق بين ما صح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما . معالجـته للأحكام الفقهية : كذلك نجد في هذا التفسير آثارًا للأحكام الفقهية ، يعالج فيه ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم ، ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه ، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة ، فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) (النحل /8) نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، ويذكر قول كل قائل بسنده .. وأخيرًا يختار قول من قال : إن الآية لا تدل على حرمة شيء من ذلك ، ووجه اختياره هذا فقال : ما نصه : " والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني ـ وهو أن الآية لا تدل على الحرمة ـ وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره ـ ( لتركبوها ) دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب لا للأكل ، لكان في قوله ( فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (النحل/5) دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء وللركوب ، وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( ومنها تأكلون ) جائز حلال غير حرام ، دليل واضح على أن أكل ما قال ( لتركبوها ) جائز حلال غير حرام ، إلا بما نص على تحريمه ، أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء . وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا كتاب الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ؛ إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك ، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم الفرس " أ.هـ . خوضه في مسائل الكلام : ولا يفوتنا أن ننبه على ما نلحظه في هذا التفسير الكبير ، من تعرض صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن ، مما يشهد له بأنه كان عالمـًا ممتازًا في أمور العقيدة ، فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه ، وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في مناقشته ، وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته ، موافق لأهل السنة في آرائهم ، ويظهر ذلك جليـًا في رده على القدرية في مسألة الاختيار . فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )(الفاتحة/7) نراه يقول ما نصه : " وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ( ولا الضالين ) وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه ، وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنه مغضوب عليهم ، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية ، جهلاً منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه ، ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه ،لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره ،وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ، ولوجب أن يكون خطأ قول القائل : تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح ، واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة ،وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب ، وفي قوله جل ثناؤه ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) (يونس/22) وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها ، ما يدل على خطأ التأويل الذي تأوله مَن وصفنا قوله، في قوله ( ولا الضالين ) ، وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى، تصحيحـًا لما ادعى المنكرون أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجله وجدت أفعالهم ، مع إبانة الله عز ذكره نصـًا في آيٍ كثيرة من تنزيله : أنه المضل الهادي ، فمن ذلك قوله جل ثناؤه : ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوةً فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون )(الجاثية/23) فأنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره ، ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه في أول الكتاب ، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مشيئة غير الذي وجد منه الفعل غيره ، فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبـًا ،ويوجده الله جل ثناؤه عينـًا منشأة ، بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبـًا له بالقوة منه عليه ، والاختيار منه له ، وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرًا .أ.هـ . وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال : فثم من كتبه ـ يعني محمد بن جرير ـ كتاب تفسير القرآن ، وجوده ، وبين فيه أحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله وغريبه ، ومعانيه ، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله ، والصحيح لديه من ذلك ، وإعراب حروفه ، والكلام على الملحدين فيه ، والقصص ، وأخبار الأمة والقيامة ، وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة ، وآية آية ، من الاستعاذة ، وإلى أبي جاد ، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل " أ.هـ . هذا وقد جاء في معجم الأدباء ج18 ص64ـ65 وصف مسهب لتفسير ابن جرير ، جاء في آخره ما نصه " وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق ،وعن سعيد بن جبير طريقين ، وعن مجاهد بن جبر ثلاث طرق ، وعن الحسن البصري ثلاث طرق ، وعن عكرمة ثلاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم طريقين ،وعن عبد الله بن مسعود طريقـًا ،وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،وتفسير ابن جريج ، وتفسير مقاتل بن حبان ، سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم ، وفيه من المسند حسب حاجته إليه ، ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به ، فإنه لم يدخل في كتابه شيئـًا عن كتاب محمد بن السائب الكلبي ، ولا مقاتل بن سليمان ، ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء والله أعلم ، وكان إذا رجع إلى التاريخ والسيروأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبي ، وعن ابنه هشام ، وعن محمد بن عمر الواقدي ، وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم . هو أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، الإمام الجليل ، المجتهد المطلق، صاحب التصانيف المشهورة ، وهو من أهل آمل طبرستان، ولد بها سنة 224هـ أربع وعشرين ومائتين من الهجرة ، ورحل من بلده في طلب العلم وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، سنة ست وثلاثين ومائتين ، وطوّف في الأقاليم ، فسمع بمصر والشام والعراق ، ثم ألقى عصاه واستقر ببغداد ، وبقى بها إلى أن مات سنة عشر وثلاثمائة . مبلغه من العلم والعدالة : كان ابن جرير أحد الأئمة الأعلام ، يُحكم بقوله ، ويُرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظـًا لكتاب الله ، بصيرًا بالقرآن ، عارفـًا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن ، عالمـًا بالسنن وطرقها ، وصحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، عارفـًا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المخالفين في الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، عارفـًا بأيام الناس وأخبارهم .. هذا هو ابن جرير في نظر الخطيب البغدادي، وهي شهادة عالم خبير بأحوال الرجال ، وذكر أن أبا العباس بن سريج كان يقول : محمد بن جرير فقيه عالم ، وهذه الشهادة جد صادقة ؛ فإن الرجل برع في علوم كثيرة ، منها : علم القراءات ، والتفسير ، والحديث ، والفقه ، والتاريخ ، وقد صنف في علوم كثيرة وأبدع التأليف وأجاد فيما صنف . مصنفاته : كتاب التفسير، وكتاب التاريخ المعروف بتاريخ الأمم والملوك، وكتاب القراءات، والعدد والتنزيل ، وكتاب اختلاف العلماء ، وتاريخ الرجال من الصحابة والتابعين ، وكتاب أحكام شرائع الإسلام ، وكتاب التبصر في أصول الدين … وغير هذا كثير . ولكن هذه الكتب قد اختفى معظمها من زمن بعيد ، ولم يحظ منها بالبقاء إلى يومنا هذا وبالشهرة الواسعة ، سوى كتاب التفسير ، وكتاب التاريخ . وقد اعتبر الطبري أبا للتفسير ، كما اعتبر أبا للتاريخ الإسلامي ، وذلك بالنظر لما في هذين الكتابين من الناحية العلمية العالية ، ويقول ابن خلكان : إنه كان من الأئمة المجتهدين ، لم يقلد أحدًا ، ونقل : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ذكره في طبقات الفقهاء في جملة المجتهدين ، قالوا : وله مذهب معروف ، وأصحاب ينتحلون مذهبه ، يقال لهم الجريرية ، ولكن هذا المذهب الذي أسسه ـ على ما يظهر ـ بعد بحث طويل ، ووجد له أتباعـًا من الناس ، لم يستطع البقاء إلى يومنا هذا كغيره من مذاهب المسلمين ؛ ويظهر أن ابن جرير كان قبل أن يبلغ هذه الدرجة من الاجتهاد متمذهبـًا بمذهب الشافعي ، يدلنا على ذلك ما جاء في الطبقات الكبرى لابن السبكي ، من أن ابن جرير قال : أظهرت فقه الشافعي ، وأفتيت به ببغداد عشر سنين . علو همتـه : كان رحمه الله عالي الهمة متوقد العزم ـ قال : عند تفسيره للقرآن : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ قال : ثلاثون ألف ورقة ، فقالوا هذا ما يفني الأعمار قبل تمامه فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة . اتهامه بالوضع للروافض : وقد اتُهِمَ رحمه الله بأنه كان يضع للروافض، وهذا رجم بالظن الكاذب ، ولعله أشبه على صاحب هذا القول ابن جرير آخر ، وهو محمد بن جرير بن رستم الطبري الرافضي . وفاته : مرض أبو جعفر بذات الجنب فجاءه الطبيب فسأل أبا جعفر عن حاله ، فعرّفه حاله وما استعمل وما أخذ لعلته ، وما انتهى إليه في يومه ، فقال له الطبيب : ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء ، فلما كان يوم السبت لأربع بقين من شوال سنة عشر وثلاثمائة كانت منيته ودفن يوم الأحد ، ولم يؤذن به أحد ، فاجتمع على جنازته ما لا يحصى عددهم إلا الله ، وصلى على قبره شهورًا ليلاً ونهارًا . هذا هو ابن جرير ؛ وهذه هي نظرات العلماء إليه ، وذلك هو حكمهم عليه ، ومن كل ذلك تبين لنا قيمته ومكانته . التعريف بهذا التفسير وطريقة مؤلفه فيه : يعتبر تفسير بن جرير من أقوم التفاسير وأشهرها ، كما يعتبر المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا بالتفسير النقلي ؛ وإن كان في الوقت نفسه يعتبر مرجعـًا غير قليل الأهمية من مراجع التفسير العقلي ؛ نظرًا لما فيه من الاستنباط ، وتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ، ترجيحـًا يعتمد على النظر العقلي ، والبحث الحر الدقيق . ويقع تفسير ابن جرير في ثلاثين جزءًا من الحجم الكبير ، وقد كان هذا الكتاب من عهد قريب يكاد يعتبر مفقودًا لا وجود له ، ثم قدّر الله له الظهور والتداول ، فكانت مفاجأة سارة للأوساط العلمية في الشرق والغرب أن وجدت في حيازة أمير ( حائل ) الأمير حمود ابن الأمير عبد الرشيد من أمر اء نجد نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكتاب ، طبع عليها الكتاب من زمن قريب ، فأصبحت في يدنا دائرة معارف غنية في التفسير المأثور . ما قيل في تفسيره : ولو أننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسير ابن جرير ، لوجدنا أن الباحثين في الشرق والغرب قد أجمعوا الحكم على عظيم قيمته ، واتفقوا على أنه مرجع لا غنى عنه لطالب التفسير ، فقد قال السيوطي رضي الله عنه " وكتابه ـ يعني تفسير محمد بن جرير ـ أجل التفاسير وأعظمها ، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال ، وترجيح بعضها على بعض ، والإعراب ، والاستنباط ، فهو يفوق بذلك على تفسير الأقدمين " . وقال النووي : " أجمعت الامة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري " . وقال ابو حامد الإسفرايني : " لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيرًا " . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " وأما التفاسير التي في أيدي الناس ، فأصحها تفسير ابن جرير الطبري ، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة ، وليس فيه بدعة ، ولا ينقل عن المتهمين ، كمقاتل بن بكير والكلبي " . ويذكر صاحب لسان الميزان : أن ابن خزيمة استعار تفسير ابن جرير من ابن خالوية فرده بعد سنين ، ثم قال : " نظرت فيه من أوله إلى آخره فما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير " . هذا وقد كتب ( نولدكه ) سنة 1860م بعد اطلاعه على بعض فقرات من هذا الكتاب " لو كان بيدنا هذا الكتاب لاستغنينا به عن كل التفاسير المتأخرة ، ومع الأسف فقد كان يظهر أنه مفقود تمامـًا ، وكان مثل تاريخه الكبير مرجعـًا لا يغيض معينه أخذ عنه المتأخرون معارفهم " . اختصار الطبري لتفسيره : ويظهر مما بأيدينا من المراجع ، أن هذا التفسير كان أوسع مما هو عليه اليوم ، ثم اختصره مؤلفه إلى هذا القدر الذي هو عليه الآن ، فابن السبكي يذكر في طبقاته الكبرى " أن أبا جعفر قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدره ؟ فقال : ثلاثون ألف ورقة ، فقالوا : هذا ربما تفنى الأعمار قبل تمامه ، فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة ، ثم قال : هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ ، قالوا : كم قدره ؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسير ، فأجابوه بمثل ذلك ، فقال : إنا لله ، ماتت الهمم ، فاختصره في نحو ما اختصر التفسير " أ.هـ . أولية تفسيره : هذا ونسطيع أن نقول إن تفسير ابن جرير هو التفسير الذي له الأولية بين كتب التفسير ، أولية زمنية ، وأولية من ناحية الفن والصناعة . أما أوليته الزمنية ، فلأنه أقدم كتاب في التفسير وصل إلينا ، وما سبقه من المحاولات التفسيرية ذهبت بمرور الزمن ، ولم يصل إلينا شيء منها ، اللهم إلا ما وصل إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب الخالد الذي نحن بصدده . وأما أوليته من ناحية الفن والصناعة ؛ فذلك أمر يرجع إلى ما يمتاز به الكتاب من الطريقة البديعة التي سلكها في مؤلفه ، حتى أخرجه للناس كتابـًا له قيمته ومكانته ونريد أن نعرض هنا لطريقة ابن جرير في تفسيره ، بعد أن أخذنا فكرة عامة عن الكتاب، حتى يتبين للقارئ أن الكتاب واحد في بابه ، سبق به مؤلفه غيره من المفسرين ، فكان عمدة المتأخرين ، ومرجعـًا مهمـًا من مراجع المفسرين ، على اختلاف مذاهبهم ، وتعدد طرائقهم ، فنقول : طريقة ابن جرير في تفسيره : تتجلى طريقة ابن جرير في تفسيره بكل وضوح إذا نحن قرأنا فيه وقطعنا في القراءة شوطـًا بعيدًا ، فأول ما نشاهده ، أنه إذا أراد أن يفسر الآية من القرآن يقول " القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا ، ثم يفسر الآية ويستشهد على ما قاله بما يرويه بسنده إلى الصحابة أو التابعين من التفسير المأثور عنهم في هذه الآية ، وإذا كان في الآية قولان أو أكثر ، فإنه يعرض لكل ما قيل فيها ، ويستشهد على كل قول بما يرويه في ذلك عن الصحابة أو التابعين . ثم هو لا يقتصر على مجرد الرواية ، بل نجده يتعرض لتوجيه الأقوال ، ويرجح بعضها على بعض ، كما نجده يتعرض لناحية الإعراب إن دعت الحال إلى ذلك ، كما أنه يستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآية من توجيه الأدلة وترجيح ما يختار . إنكاره على من يفسر بمجرد الرأي : ثم هو يخاصم بقوة أصحاب الرأي المستقلين في التفكير ، ولا يزال يشدد في ضرورة الرجوع إلى العلم الراجع إلى الصحابة أو التابعين ، والمنقول عنهم نقلاً صحيحـًا مستفيضـًا ، ويرى أن ذلك وحده هو علامة التفسير الصحيح ، فمثلاً عند ما تكلم عن قوله تعالى في الآية (49) من سورة يوسف ( ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناسُ وفيه يعصِرون ) نجده يذكر ما ورد في تفسيرها عن السلف مع توجيهه للأقوال وتعرضه للقراءات بقدر ما يحتاج إليه تفسير الآية ، ثم يعرج بعد ذلك على من يفسر القرآن برأيه ، وبدون اعتماد منه على شيء إلا على مجرد اللغة ، فيفند قوله ، ويبطل رأيه ، فيقول ما نصه " .. وكان بعض من لا علم له بأقوال السلف من أهل التأويل ، ممن يفسر القرآن برأيه على مذهب كلام العرب ، يوجه معنى قوله ( وفيه يعصرون ) إلى وفيه ينجون من الجدب والقحط بالغيث ، ويزعم أنه من العصر ، والعصر التي بمعنى المنجاة، من قول أبي زبيد الطائي : صاديـا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود أي المقهور ـ ومن قول لبيد : فبات وأسرى القوم آخر ليلهم وما كان وقافـًا بغير معصر وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين . موقفه من الأسانيد : ثم إن ابن جرير وإن التزم في تفسيره ذكر الروايات بأسانيدها ، إلا أنه في الأعم الأغلب لا يتعقب الأسانيد بتصحيح ولا تضعيف ، لأنه كان يرى ـ كما هو مقرر في أصول الحديث ـ أن من أسند لك فقد حملك البحث عن رجال السند ومعرفة مبلغهم من العدالة أو الجرح ، فهو بعمله هذا قد خرج من العهدة ومع ذلك فابن جرير يقف من السند أحيانـًا موقف الناقد البصير، فيعدل من يعدل من رجال الإسناد ، ويجرح من يجرح منهم ، ويرد الرواية التي لا يثق بصحتها ، ويصرح برأيه فيها بما يناسبها ، فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية ( 94) من سورة الكهف : ( .. فهل نجعل لك خرجـًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدًا )يقول ما نصه : " روى عن عكرمة في ذلك ـ يعني في ضم سين سدًا وفتحها ـ ما حدثنا به أحمد بن يوسف ، قال : حدثنا القاسم ، قال : حدثنا حجاج ، عن هرون ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : ما كان من صنعة بني آدم فهو السَّد يعني بفتح السين ، وما كان من صنع الله فهو السُّد ،ثم يعقب على هذا السند فيقول : وأما ما ذكر عن عكرمة في ذلك ، فإن الذي نقل ذلك عن أيوب هرون ، وفي نقله نظر ، ولا نعرف ذلك عن أيوب من رواية ثقاة أصحابه " أ.هـ . تقديره للإجماع : كذلك نجد ابن جرير في تفسيره يقدر إجماع الأمة ، ويعطيه سلطانـًا كبيرًا في اختيار ما يذهب إليه من التفسير ، فمثلاً عند قوله تعالى في الآية ( 230) من سورة البقرة ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـًا غيره ) يقول ما نصه : " فإن قال قائل : فأي النكاحين عنى الله بقوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـًا غيره ؟ النكاح الذي هو جماع ؟ أم النكاح الذي هو عقد تزويج ؟ قيل كلاهما ؛ وذلك أن المرأة إذا نكحت زوجـًا نكاح تزويج ثم لم يطأها في ذلك النكاح ناكحها ولم يجامعها حتى يطلقها لم تحل للأول ، وكذلك إن وطئها واطئ بغير نكاح لم تحل للأول ؛ لإجماع الأمة جميعـًا ، فإذا كان ذلك كذلك " فمعلوم أن تأويل قوله : فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجـًا غيره ، نكاحـًا صحيحـًا ، ثم يجامعها فيه : ثم يطلقها ، فإن قال : فإن ذكر الجماع غير موجود في كتاب الله تعالى ذكره ، فما الدلالة على أن معناه ما قلت ؟ قيل : الدلالة على ذلك إجماع الأمة جميعـًا على أن ذلك معناه " . موقفه من القراءات : كذلك نجد أن ابن جرير يعنى بذكر القراءات وينزلها على المعاني المختلفة ، وكثيرًا ما يرد القراءات التي لا تعتمد على الأئمة الذين يعتبرون عنده وعند علماء القراءات حجة ، والتي تقوم على أصول مضطربة مما يكون فيه تغير وتبديل لكتاب الله ، ثم يتبع ذلك برأيه في آخر الأمر مع توجيه رأيه بالأسباب ، فمثلاً عند قوله تعالى في الآية (81) من سورة الأنبياء ( ولسليمان الريح عاصفة ) يذكر أن عامة قراء الأمصار قرءوا ( الريح ) بالنصب على أنها مفعول لـ "سخرنا" المحذوف ، وأن عبد الرحمن الأعرج قرأ ( الريح ) بالرفع على أنها مبتدأ ثم يقول : والقراءة التي لا استجيز القراءة بغيرها في ذلك ما عليه قراء الأمصار لإجماع الحجة من القراء عليه . سبب عناية ابن جرير بالقراءات : ولقد يرجع السبب في عناية ابن جرير بالقراءات وتوجيهها إلى أنه كان من علماء القراءات المشهورين ، حتى أنهم ليقولون عنه : إنه ألف فيها مؤلفـًا خاصـًا في ثمانية عشر مجلدًا ، ذكر فيه جميع القراءات من المشهور والشواذ وعلل ذلك وشرحه ، واختار منها قراءة لم يخرج بها من المشهور، وإن كان هذا الكتاب قد ضاع بمرور الزمن ولم يصل إلى أيدينا ، شأن الكثير من مؤلفاته . موقفه من الإسرائيليات : ثم إننا نجد ابن جرير يأتي في تفسيره بأخبار مأخوذة من القصص الإسرائيلي ، يرويها بإسناده إلى كعب الأحبار ، ووهب بن منبه ، وابن جريج والسدي ، وغيرهم ، ونراه ينقل عن محمد بن إسحاق كثيرًا مما رواه عن مسلمة النصارى ، ومن الأسانيد التي تسترعي النظر ، هذا الإسناد : حدثني ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن أبي عتاب .. رجل من تغلب كان نصرانيـًا عمرًا من دهره ثم أسلم بعد فقرأ القرآن وفقه في الدين ، وكان فيما ذكر ، أنه كان نصرانيـًا أربعين سنة ثم عمر في الإسلام أربعين سنة . يذكر ابن جرير هذا الإسناد ويروي لهذا الرجل النصراني الأصل خبرًا عن آخر أنبياء بني إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى : ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ، فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا )(الإسراء/7) . " .. وهكذا يكثر ابن جرير من رواية الإسرائيليات ، ولعل هذا راجع إلى ما تأثر به من الروايات التاريخية التي عالجها في بحوثه التاريخية الواسعة . وإذا كان ابن جرير يتعقب كثيرًا من هذه الروايات بالنقد ، فتفسيره لا يزال يحتاج إلى النقد الفاحص الشامل ، احتياج كثير من كتب التفسير التي اشتملت على الموضوع والقصص الإسرائيلي ، على أن ابن جرير ـ كما قدمنا ـ قد ذكر لنا السند بتمامه في كل رواية يرويها ، وبذلك يكون قد خرج من العهدة ، وعلينا نحن أن ننظر في السند ونتفقد الروايات . احتكامه إلى المعروف من كلام العرب : وثمة أمر آخر سلكه ابن جرير في كتابه ، ذلك أنه اعتبر الاستعمالات اللغوية بجانب النقول المأثورة وجعلها مرجعـًا موثوقـًا به عند تفسيره للعبارات المشكوك فيها ، وترجيح بعض الأقوال على بعض . فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : (حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كلٍ زوجين اثنين .. )(هود/40) نراه يعرض لذكر الروايات عن السلف في معنى لفظ التنور ، فيروى لنا قول من قال : إن التنور عبارة عن وجه الأرض ، وقول من قال : إنه عبارة عن تنوير الصبح ، وقول من قال إنه عبارة عن أعلى الأرض وأشرفها ، وقول من قال : إنه عبارة عما يختبز فيه .. ثم قال بعد أن يفرغ من هذا كله : " وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله ( التنور ) قول من قال : التنور : الذي يختبز فيه ، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب ، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب . رجوعه إلى الشعر القديم : كذلك نجد ابن جرير يرجع إلى شواهد من الشعر القديم بشكل واسع ، متبعـًا في هذا ما أثاره ابن عباس في ذلك ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أندادًا .. )(البقرة/22) يقول ما نصه : " قال أبو جعفر : والأنداد جمع ند ، والند : العدل والمثل ، كما قال حسان ابن ثابت : أتهجوه ولست له بندٍ فشركما لخيركما الفداء اهتمامه بالمذاهب النحوية : كذلك نجد ابن جرير يتعرض كثيرًا لمذاهب النحويين من البصريين والكوفيين في النحو والصرف ، ويوجه الأقوال ، تارة على المذهب البصري ، وأخرى على المذهب الكوفي ، فمثلاً عند قوله تعالى : ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم عاصف )(إبراهيم/18) يقول ما نصه : " اختلف أهل العربية في رافع ( مثل ) فقال بعض نحويي البصرة : إنما هو كأنه قال : ومما نقص عليكم مثل الذين كفروا ، ثم أقبل يفسره كما قال : مثل الجنة .. وهذا كثير . وقال بعض نحويي الكوفيين : إنما المثل للأعمال ، ولكن العرب تقدم الأسماء لأنها أعرف ، ثم تأتي بالخبر الذي تخبر عنه مع صاحبه ، ومعنى الكلام : مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد .. إلخ . والحق أن ما قدمه لنا ابن جرير في تفسيره من البحوث اللغوية المتعددة والتي تعتبر كنزًا ثمينـًا ومرجعـًا في بابها ، أمر يرجع إلى ما كان عليه صاحبنا من المعرفة الواسعة بعلوم اللغة وأشعار العرب ، معرفة لا تقل عن معرفته بالدين والتاريخ ، ونرى أن ننبه هنا إلى أن هذه البحوث اللغوية التي عالجها ابن جرير في تفسيره لم تكن أمرًا مقصودًا لذاته ، وإنما كانت وسيلة للتفسير ، على معنى أنه يتوصل بذلك إلى ترجيح بعض الأقوال على بعض ، كما يحاول بذلك ـ أحيانـًا ـ أن يوفق بين ما صح عن السلف وبين المعارف اللغوية بحيث يزيل ما يتوهم من التناقض بينهما . معالجـته للأحكام الفقهية : كذلك نجد في هذا التفسير آثارًا للأحكام الفقهية ، يعالج فيه ابن جرير أقوال العلماء ومذاهبهم ، ويخلص من ذلك كله برأي يختاره لنفسه ، ويرجحه بالأدلة العلمية القيمة ، فمثلاً نجده عند تفسيره لقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون) (النحل /8) نجده يعرض لأقوال العلماء في حكم أكل لحوم الخيل والبغال والحمير ، ويذكر قول كل قائل بسنده .. وأخيرًا يختار قول من قال : إن الآية لا تدل على حرمة شيء من ذلك ، ووجه اختياره هذا فقال : ما نصه : " والصواب من القول في ذلك عندنا ما قاله أهل القول الثاني ـ وهو أن الآية لا تدل على الحرمة ـ وذلك أنه لو كان في قوله تعالى ذكره ـ ( لتركبوها ) دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للركوب لا للأكل ، لكان في قوله ( فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) (النحل/5) دلالة على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء وللركوب ، وفي إجماع الجميع على أن ركوب ما قال تعالى ذكره ( ومنها تأكلون ) جائز حلال غير حرام ، دليل واضح على أن أكل ما قال ( لتركبوها ) جائز حلال غير حرام ، إلا بما نص على تحريمه ، أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء . وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى البغال بما قد بينا في كتابنا كتاب الأطعمة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ؛ إذ لم يكن هذا الموضع من مواضع البيان عن تحريم ذلك ، وإنما ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أن لا وجه لقول من استدل بهذه الآية على تحريم الفرس " أ.هـ . خوضه في مسائل الكلام : ولا يفوتنا أن ننبه على ما نلحظه في هذا التفسير الكبير ، من تعرض صاحبه لبعض النواحي الكلامية عند كثير من آيات القرآن ، مما يشهد له بأنه كان عالمـًا ممتازًا في أمور العقيدة ، فهو إذا ما طبق أصول العقائد على ما يتفق مع الآية أفاد في تطبيقه ، وإذا ناقش بعض الآراء الكلامية أجاد في مناقشته ، وهو في جدله الكلامي وتطبيقه ومناقشته ، موافق لأهل السنة في آرائهم ، ويظهر ذلك جليـًا في رده على القدرية في مسألة الاختيار . فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين )(الفاتحة/7) نراه يقول ما نصه : " وقد ظن بعض أهل الغباء من القدرية أن في وصف الله جل ثناؤه النصارى بالضلال بقوله ( ولا الضالين ) وإضافة الضلال إليهم دون إضافة إضلالهم إلى نفسه ، وتركه وصفهم بأنهم المضللون كالذي وصف به اليهود أنه مغضوب عليهم ، دلالة على صحة ما قاله إخوانه من جهلة القدرية ، جهلاً منه بسعة كلام العرب وتصاريف وجوهه ، ولو كان الأمر على ما ظنه الغبي الذي وصفنا شأنه ،لوجب أن يكون كل موصوف بصفة أو مضاف إليه فعل لا يجوز أن يكون فيه سبب لغيره ،وأن يكون كل ما كان فيه من ذلك من فعله ، ولوجب أن يكون خطأ قول القائل : تحركت الشجرة إذا حركتها الرياح ، واضطربت الأرض إذا حركتها الزلزلة ،وما أشبه ذلك من الكلام الذي يطول بإحصائه الكتاب ، وفي قوله جل ثناؤه ( حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم ) (يونس/22) وإن كان جريها بإجراء غيرها إياها ، ما يدل على خطأ التأويل الذي تأوله مَن وصفنا قوله، في قوله ( ولا الضالين ) ، وادعائه أن في نسبة الله جل ثناؤه الضلالة إلى من نسبها إليه من النصارى، تصحيحـًا لما ادعى المنكرون أن يكون لله جل ثناؤه في أفعال خلقه سبب من أجله وجدت أفعالهم ، مع إبانة الله عز ذكره نصـًا في آيٍ كثيرة من تنزيله : أنه المضل الهادي ، فمن ذلك قوله جل ثناؤه : ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوةً فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون )(الجاثية/23) فأنبأ جل ذكره أنه المضل الهادي دون غيره ، ولكن القرآن نزل بلسان العرب على ما قدمنا البيان عنه في أول الكتاب ، ومن شأن العرب إضافة الفعل إلى من وجد منه وإن كان مشيئة غير الذي وجد منه الفعل غيره ، فكيف بالفعل الذي يكتسبه العبد كسبـًا ،ويوجده الله جل ثناؤه عينـًا منشأة ، بل ذلك أحرى أن يضاف إلى مكتسبه كسبـًا له بالقوة منه عليه ، والاختيار منه له ، وإلى الله جل ثناؤه بإيجاد عينه وإنشائها تدبيرًا .أ.هـ . وعلى الإجمال فخير ما وصف به هذا الكتاب ما نقله الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد الفرغاني في تاريخه حيث قال : فثم من كتبه ـ يعني محمد بن جرير ـ كتاب تفسير القرآن ، وجوده ، وبين فيه أحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، ومشكله وغريبه ، ومعانيه ، واختلاف أهل التأويل والعلماء في أحكامه وتأويله ، والصحيح لديه من ذلك ، وإعراب حروفه ، والكلام على الملحدين فيه ، والقصص ، وأخبار الأمة والقيامة ، وغير ذلك مما حواه من الحكم والعجائب كلمة كلمة ، وآية آية ، من الاستعاذة ، وإلى أبي جاد ، فلو ادعى عالم أن يصنف منه عشرة كتب كل كتاب منها يحتوي على علم مفرد وعجيب مستفيض لفعل " أ.هـ . هذا وقد جاء في معجم الأدباء ج18 ص64ـ65 وصف مسهب لتفسير ابن جرير ، جاء في آخره ما نصه " وذكر فيه من كتب التفاسير المصنفة عن ابن عباس خمسة طرق ،وعن سعيد بن جبير طريقين ، وعن مجاهد بن جبر ثلاث طرق ، وعن الحسن البصري ثلاث طرق ، وعن عكرمة ثلاثة طرق وعن الضحاك بن مزاحم طريقين ،وعن عبد الله بن مسعود طريقـًا ،وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،وتفسير ابن جريج ، وتفسير مقاتل بن حبان ، سوى ما فيه من مشهور الحديث عن المفسرين وغيرهم ، وفيه من المسند حسب حاجته إليه ، ولم يتعرض لتفسير غير موثوق به ، فإنه لم يدخل في كتابه شيئـًا عن كتاب محمد بن السائب الكلبي ، ولا مقاتل بن سليمان ، ولا محمد بن عمر الواقدي؛ لأنهم عنده أظناء والله أعلم ، وكان إذا رجع إلى التاريخ والسيروأخبار العرب حكى عن محمد بن السائب الكلبي ، وعن ابنه هشام ، وعن محمد بن عمر الواقدي ، وغيرهم فيما يفتقر إليه ولا يؤخذ إلا عنهم .
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#45
|
|||
|
|||
|
شيخ الإسلام ابن تيميّـة
إسمه ونسبه هو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. وتيمية هي والدة جدة الأعلى محمد . وكانت واعظة راوية. ولد رحمه الله يوم الأثنين العاشر من ربيع الأول ، بحران سنة 661هـ ولما بلغ سبع سنوات من عمره إنتقل مع والده إلى دمشق ، هربا من التتار . نشأته نشا في بيت علم وفقه ودين، فأبوه و أجداده وإخوانه وكثير من أعمامه كانوا من العلماء المشاهير، منهم جده الأعلى الرابع محمد بن الخضر، ومنهم عبدالحليم بن محمد بن تيمية، وعبدالغني بن محمد بن تيمية ، و حده الأدنى عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية مجد الدين أبو البركات صاحب التصانيف التي منها : المنتقى من أحاديث الأحكام وقد قام الشوكاني بشرحه في كتابه "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار"، والمجرد في الفقه والمسودة في الأصول وغيرها،وكذلك أبوه و أخوه عبدالرحمن وغيرهم. وفي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة هذا العالم الجليل الذي بدأ بطلب العلم على والده وعلماء بلاده أولا، فحفظ القرآن وهو صغير، ودرس الحديث والفقه و الأصول والتفسير، وعرف بالذكاء والفطنة وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره، ثم توسع في دراسة العلوم وتبحر فيها، وأجتمعت فيه صفات المجتهد وأعترف له بذلك الداني والقاصي والقريب والبعيد وعلماء عصره. خصاله تميز شيخ الإسلام إبن تيمية بالإضافة إلى العلم والفقه في الدين و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بخصال حميده فكان سخيا كريما، كثير العبادة والذكر والقرآن، وكان ورعا زاهدا متواضعا، ومع ذلك فقد كانت له هيبة عند السلطان وقصته مع سلطان التتار معروفه، كما عرف رحمه الله بالصبر وقوة الإحتمال في سبيل الله. جهاده جاهد شيخ الإسلام فارس المعقول والمنقول في الله حق جهاده، فقد حاهد بالسيف وحرضّ المسلمين على القتال بالقول و العمل، فقد كان يصول ويجول بسيفه في ساحات الوغى مع الفرسان والشجعان، والذين شاهدوه في القتال أثناء فتح عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالأعداء . وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتار، وحاربهم عند شقحب جنوبي دمشق وكتب الله هزيمة التتار، وبهذه المعركة سلمت بلاد الشام وفلسطين ومصر والحجاز. وطلب من الحكام متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة الذين كانوا عونا للغزاة، فأجج ذلك عليه حقد الحكام و حسد العلماء و الأقران ودس المنافقين والفجار، فناله الأذى والسجن والنفي والتعذيب فما لان و لاخضع . وكانت كلمته المشهورة: "مايصنع أعدائي بي؟!! أنا جنتي وبستاني في صدري أنّى رحت، فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة" وكان يقول في سجنه: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. أما جهاده بالقلم واللسان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب الملل والنحل والفرق والمذاهب الباطلة والبدع كالطود الشامخ فقد تصدى للفلاسفة، والباطنية، من صوفية، وإسماعيلية ونصيرية وروافض، كما تصدى للملاحدة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة ولا تزال بحمد الله ردود الشيخ سلاحا فعالا ضد أعداء هذا الدين العظيم على مر الدوام وذلك لأنها إنما تستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، مع قوة الإستنباط، وقوة الإستدلال و الإحتجاج الشرعي والعقلي، وسعة العلم التي وهبها الله له ولا تزال ردود الشيخ وكتبه هي أقوى سلاح بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت اليوم وهي إمتداد للماضي، وغيّرت أسمائها فقط مثل البعثية و الإشتراكية و القومية و البهائية و القاديانية وغيرها من الفرق . مؤلفاته و إنتاجه العلمي يعتبر شيخ الإسلام من العلماء الأفذاذ الذين تركوا تراثا ضخما ثمينا، لايزال العلماء والباحثون ينهلون منه وقد ألف ابن قيم الجوزية كتب ورسائل شيخه ابن تيمية التي قام بتأليفها وهي مطبوعة. وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمائة مؤلف في مختلف العلوم، و منها ماهو في المجلدات المتعدده وهذه بعض مؤلفاته رحمه الله: 1 - بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (طبع في 11 مجلدا). 2 - إثبات المعاد . 3 - ثبوت النبوات عقلا ونقلا . 4 - الرد على الحلولية والإتحادية . 5 - الإستقامة (في مجلدين). 6 - مجموع فتاوى ابن تيمية : جمعها عبدالرحمن بن قاسم وتقع في (37) مجلدا. 7 - إصلاح الراعي والرعية. 8 - منهاج السنة . 9 - الإحتجاج بالقدر . 10 - الإيمان. 11 - حقيقة الصيام. 12 - الرسالة التدمرية. 13 - الرسالة الحموية. 14 - شرح حديث النزول. 15 - العبودية. 16 - المظالم المشتركة. 17 - الواسطة بين الحق والخلق. 18 - الفرقان بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان. 19 - الكلم الطيب. 20 - رفع أعلام عن الأئمة الأعلام. 21 - حجاب المرأة ولباسها في الصلاة. 22 - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 23 - الرسالة العشرية. 24 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وفاة شيخ الإسلام توفي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة ليلة الإثنين العشرين من ذي القعده سنة(728) وعمره (67) عاما وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق وحضر جنازته جمهور كبير جدا يفوق العدد. ولمن أراد الإستزاده و الإطلاع عن سيرة هذا الشيخ الكبير والعالم النحرير والحجة القوية فعليه بالعودة إلى الكتب التي أولفت عنه رحمه الله رحمة واسعة وهي كثيرة ومنها: 1 - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أبن تيمية لتلميذه ابن عبدالهادي. 2 - الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي . 3 - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزاز. 4 - حياة ابن تيمية للبيطار. 5 - ابن تيمية للإستنبولي. وغيرها كثير .
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#46
|
|||
|
|||
|
الإمام ابن القيم -رحمه الله-
نسبه ونسبته: هو الفقيه، المفتي، الإمام الربّاني شيخ الإسلام الثاني أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرعي ثم الدِّمشقي الشهير بـ"ابن قيم الجوزية" لا غيره خلافًا للكوثري الذي نبزه بـ"ابن زفيل" . ولادته: ولد -رحمه الله- في السابع من شهر صفر الخير سنة (691هـ). أسرته ونشأته وطلبه للعلم: نشأ ابن قيِّم الجوزية في جوِّ علمي في كنف والده الشيخ الصالح قيم الجوزية، وأخذ عنه الفرائض، وذكرت كتب التراجم بعض أفراد أسرته كابن أخيه أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن الذي اقتنى أكثر مكتبة عمّه، وأبناؤه عبد الله وإبراهيم، وكلهم معروف بالعلم وطلبه. وعُرف عن ابن قيم الجوزية -رحمه الله- الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم، والجَلَد والتَّفاني في البحث منذ نعومة أظفاره؛ فقد سمع من الشِّهاب العابر المتوفى سنة (697هـ) فقال -رحمه الله- : "وسمّعت عليه عدّة أجزاء، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه؛ لصغر السِّنِّ ، واخترام المنية له -رحمه الله- " وبهذا يكون قد بدأ الطلب لسبع سنين مضت من عمره. رحلاته: قَدم ابن قيّم الجوزية -رحمه الله- القاهرة غير مرّة ، وناظر ، وذاكر. وقد أشار إلى ذلك المقريزي فقال : "وقدم القاهرة غير مرّة" . قال: "وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر" . وقال: "وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة" . وزار بيت المقدس، وأعطى فيها دروسًا. قال: "ومثله لي قلته في القدس" . وكان -رحمه الله- كثير الحجِّ والمجاورة كما ذكر في بعض كتبه. قال ابن رجب: وحج مرات كثيرةً، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدّة العبادة وكثرة الطواف أمرًا يُتعجب منه" . مكتبته: كان ابن قيّم الجوزية -رحمه الله- مُغرمًا بجمع الكتب، وهذا دليلُ الرَّغبة الصّادقة للعلم بحثًا وتصنيفًا، وقراءةً وإقراءً يظهر ذلك في غزارة المادة العلمية في مؤلفاته، والقدرة العجيبة على حشد الأدلة. وقد وصف تلاميذه -رحمهم الله- مكتبته فأجادوا: قال ابن رجب: "وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه، واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره" . وقال ابن كثير -رحمه الله-: "واقتنى من الكتب ما لم لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْرِه من كتب السلف والخلف" . قلت: ومع هذا كله يقول بتواضع جم: "بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب" . ورحم اللهُ شيخه شيخَ الإسلام ابن تيمية القائل: "فمن نوّر الله قلبه هداه ما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزدْهُ كثرةُ الكتب إلا حيرة وضلالةً" . مشاهير شيوخه: تلقى ابن قيم الجوزية -رحمه الله- العلم على كثير من المشايخ ، ومنهم: 1- قيم الجوزية والده -رحمه الله-. 2- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- لازمه ، وتفقه به، وقرأ عليه كثيرًا من الكتب ، وبدأت ملازمته له سنة (712هـ) حتى توفي شيخ الإسلام سجينًا في قلعة دمشق (728هـ). 3- المزي -رحمه الله- . تلاميذه : 1- ابن رجب الحنبلي ، صرح بأنه شيخه، ثم قال: "ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة ، وسمّعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السّنة ، وأشياء من تصانيفه وغيرها" . 2- ابن كثير -رحمه الله- قال : "وكنت من أصحب الناس له وأحبّ الناس إليه" . 3- الذهبي -رحمه الله- ترجم لابن القيم الجوزية في "المعجم المختص" بشيوخه . 4- ابن عبد الهادي -رحمه الله- ؛ كما قال ابن رجب: "وكان الفضلاء يعظمونه ويتتلمذون له كابن عبد الهادي وغيره" . 5- الفيروزآبادي صاحب "القاموس المحيط" ، كما قال الشوكاني: "ثم ارتحل إلى دمشق فدخلها سنة (755هـ) فسمع من التقي السبكي وجماعة زيادة عن مائة كابن القيم" . علاقته بشيخه ابن تيمية ومنهجه : بدأت ملازمة ابن قيم الجوزية لشيخ الإسلام ابن تيمية عند قدومه إلى دمشق سنة (712هـ) ، واستمرت إلى وفاة الشيخ سنة (728هـ) ، وبهذا تكون مدة مرافقة ابن قيم الجوزية لشيخه ستة عشر عامًا بقي طيلتها قريبًا منه يتلقى عنه علمًا جمًا ، وقرأ عليه فنونًا كثيرة. قال الصفدي: "قرأ عليه قطعة من "المحرّر" لجدّه المجد، وقرأ عليه من "المحصول" ، ومن كتاب "الأحكام" للسيف الآمدي، وقرأ عليه قطعة من "الأربعين" و"المحصل" وقرأ عليه كثيرًا من تصانيفه" . وبدأت هذه الملازمة بتوبة ابن قيم الجوزية على يدي شيخه ابن تيمية ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله يـا قـوم والله العظيـم نصـيحة مـن مشـفق وأخ لكـم معـوان جربت هـذا كلـه ووقعت فـي تلك الشبــاك وكنت ذا طيـران حتى أتـاح لـي الإلـه بفضلـه مـن ليس تجـزيه يـدي ولسـاني فتـى أتى مـن أرض حـرّان فيا أهلًا بمـن قـد جـاء من حــران وكان لهذه الملازمة أثرٌ بالغٌ في نفس ابن قيم الجوزية ؛ فشارك شيخه في الذَّبِّ عن المنهج السلفي، وحمل رايتَه من بعده ، وتحرر من كل تبعية لغير كتاب الله وسُنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- بفهم السلف الصالح. قال الشوكاني : "وليس له على غير الدليل مُعَوَّل في الغالب، وقد يميل نادرًا إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدَّفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة ؛ كما يفعله غيرُه من المتمذهبين، بل لا بد له من مستند في ذلك ، وغالب أبحاثه الإنصافُ والميلُ مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال، وإذا استوعب الكلام في بحث وطوَّل ذيولَه أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدورُ الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل، وأظنها سرت إليه بركةُ ملازمته لشيخه ابن تيمية في السَّراء والضّراء والقيام معه في محنه، ومواساته بنفسه، وطول تردده إليه. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر السُّنة، وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جُنَّة ، فرحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرًا . ومع هذا كله فلم يكن ابن قيم الجوزية -رحمه الله- نسخةً من شيخه ابن تيمية، بل كان متفننًا في علوم شتى -باتفاق المتقدمين والمتأخرين- تدل على علو كعبه، ورسوخه في العلم. وكيف يكون ابن قيم الجوزية مُرَدِّدًا لصدى صوت شيخه ابن تيمية -رحمه الله- وهو ينكرُ التقليدَ ويحاربُه بكلِّ ما أتي من حَوْل وقوَّة؟! ثناء العلماء عليه: قال ابن كثير -رحمه الله- : "سمع الحديث ، واشتغل بالعلم ، وبرع في علوم متعددة ، ولا سيما علم التفسير والحديث الأصلين ، ولما عاد الشيخُ تقي الدين ابن تيمية من الدّيار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علمًا جمًّا ، مع ما سلف له من الاشتغال؛ فصار فريدًا في بابه في فنون كثيرة، مع كثرة الطَّلَب ليلًا ونهارًا، وكثرة الابتهال ، وكان حسنَ القراءة والخُلُق ، وكثيرَ التَّودُّد لا يحسدُ أحدًا ولا يؤذيه ، ولا يستغيبُه ولا يحقدُ على أحد ، وكنت أصحب الناس له ، وأحب الناس إليه ، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثرَ عبادة منه، وكانت له طريقةٌ في الصلاة يطيلها جدًا ، ويمدُّ ركوعَه وسجودَه ويلومُه كثير من أصحابه في بعض الأحيان ، فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك -رحمه الله- ، وله من التّصانيف الكِبار والصِّغار شيءٌ كثير ، وكتَبَ بخطّه الحسنِ شيئًا كثيرًا ، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عشره من كتب السلف والخلف. وبالجملة كان قليلَ النظير في مجموعه وأموره وأحواله ، والغالب عليه الخيرُ والأخلاقُ الصالحةُ ، سامحه الله ورحمه" . قال ابن رجب -رحمه الله- : "وتفقه في المذهب ، وبرع وأفتى ، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه ، وتفنَّن في علوم الإسلام ، وكان عارفًا بالتفسير لا يجارى فيه ، وبأصول الدين ، وإليه فيهما المنتهى ، والحديث معانيه وفقهه ، ودقائق الاستنباط منه ، لا يُلحق في ذلك ، وبالفقه وأصوله وبالعربية ، وله فيها اليَدُ الطولى ، وتعلم الكلام والنَّحو وغير ذلك ، وكان عالمًا بعلم السّلوك ، وكلام أهل التّصوف وإشاراتهم ودقائقهم ، له في كل فَنّ من هذه الفنون اليد الطولى. وكان -رحمه الله- ذا عبادة وتَهَجد ، وطول صلاة إلى الغاية القصوى ، وَتَألُّه ولهج بالذّكر ، وشغف بالمحبة ، والإنابة والاستغفار ، والافتقار إلى الله والانكسار له ، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته ، لم أشاهد مثله في ذلك ، ولا رأيت أوسع منه علمًا ، ولا أعْرَف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله " . وقال ابن ناصر الدين الدمشقي -رحمه الله- : "وكان ذا فنون في العلوم ، وخاصة التفسير والأصول في المنطوق والمفهوم" . وقال السيوطي -رحمه الله- : "قد صَنَّفَ ، وناظر ، واجتهد ، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث ، والفروع ، والأصلين ، والعربية" . مؤلفاته : ضرب ابن قيم الجوزية بحظ وافر في علوم شتى يظهر هذا الأمر جَليًّا لمن استقصى كتبه التي كانت للمتقين إمامًا، وأفاد منها الموافق والمخالف. قال ابن حجر -رحمه الله- ، "ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته" . وإليك أشهرها مرتَّبة على حروف المعجم: 1- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. 2- أحكام أهل الذمة. 3- إعلام الموقعين عن رب العالمين. 4- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. 5- بدائع الفوائد. 6- تحفة المودود في أحكام المولود. 7- تهذيب مختصر سنن أبي داود. 8- الجواب الكافي، وهو المسمى "الداء والدواء". 9- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد -صلى الله عليه وسلم- خير الأنام. 10- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 11- حكم تارك الصلاة. 12- "الرسالة التبوكية "وهو الذي بين يديك. 13- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. 14- الروح. 15- زاد المعاد في هدي خير العباد. 16- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. 17- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. 18- طريق الهجرتين وباب السعادتين. 19- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 20- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وقد انتهيت من تحقيقه بحمد الله وفضله على نسختين خطيتين. 21- الفروسية. 22- الفوائد. 23- الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ، وهي "القصيدة النونية". 24- الكلام على مسألة السماع. 25- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 26- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. 27- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 28- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى. 29- الوابل الصيب في الكلم الطيب. محنة وثبات : حُبس مع شيخه ابن تيمية في المرة الأخيرة في القلعة منفردًا عنه بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروبًا بالدرة سنة (726هـ) ، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه سنة (728هـ) . وحبس مرة لإنكاره شدّ الرحال إلى قبر الخليل. قال ابن رجب -رحمه الله- : "وقد امتحن وأوذي مرات" . وفاته : توفي -رحمه الله- ليلة الخميس ثالث عشرين من رجب الفرد سنة (751هـ) ، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير -رحمه الله- وأسكنه الفردوس الأعلى ، وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين ، والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن أولئك رفيقًا. مصادر ترجمته: 1- "أبجد العلوم" ، صديق حسن خان ، (3 / 138). 2- "البداية والنهاية" ، ابن كثير ، (14 / 234). 3- "البدر الطالع" ، الشوكاني ، (2 / 143). 4- "بغية الوعاة" ، للسيوطي ، (1 / 62). 5- "التاج المكلل" ، صديق حسن خان ، (ص416). 6- "الدرر الكامنة" ، ابن حجر ، (4 / 21-23). 7- "ذيل طبقات الحنابلة" ، ابن رجب ، (2 / 447). 8- "ذيل العبر في خبر من عبر" ، (5 / 282). 9- "الرد الوافر" ابن ناصر الدين الدمشقي (ص68). 10- "شذرات الذهب" ، ابن العماد ، (6 / 168). 11- "طبقات المفسرين" ، للداوودي ، (2 / 93). 12- "الفتح المبين في طبقات الأصوليين" ، المراغي ، (2 / 76). وقد صنفت كتب مفردة مثل: 1- "ابن قيم الجوزية" ، محمد مسلم الغنيمي. 2- "ابن قيم الجوزية حياته وآثاره" ، بكر بن عبد الله أبو زيد. 3- "ابن قيم الجوزية وموقفه من التفكير الإسلامي" ، عوض الله حجازي. 4- "ابن القيم وآثاره العلمية" ، أحمد ماهر البقري. 5- "ابن القيم اللغوي" ، أحمد ماهر البقري. 6- "ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه" ، عبد العظيم عبد السلام.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#47
|
|||
|
|||
|
الحاكم النيسابوري
هو الحاكم الحافظ الشهير بإمام المحدثين ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد حمدوية بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع الشافعي والطهماني الذي يرجع نسبه الي ابراهيم بن طهمان. { طلب العلم منذ الصغر باعتناء والده وخاله وأول سماعه للعلم كان في سنة ثلاثين وقد استملي علي ابي حاتم بن حيان في سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان اول سماعه وهو ابن تسع ولحق الاسانيد العالية بخراسان. ثم رحل منها الي العراق سنة احدي واربعين وهو ابن عشرين سنة وسافر الي المدينة وحج ثم رحل الي بلاده وله الي العراق والحجاز رحلتان. سمع الحاكم من نحو الفي شيخ من نيسابور وحدها وسمع بغيرها من نحو الف شيخ فشيوخه لا يحصون كثرة ان الحاكم النيسابوري تقلد القضاء بنيسابور وكان الحاكم اماما حافظا عارفا ثقة واسع العلم اتفق الناس علي امامته وعظمة قدره ورحل اليه الناس في البلاد لسعة علمه ودراسته واتفق العلماء علي أنه من أعلم الائمة الذين حفظ الله بهم هذا الدين. تفرد الحاكم ابو عبد الله في عصره من غير ان يقابله احد ممن اشتهر بحفظ الحديث وعلله بالحجاز والشام والعراق والري وطبرستان وخراسان باسرها وما وراء النهر. قال الحافظ ابو القاسم بن عساكر: يعد من الاشعريين وهو قول ضعيف وان كان كثير من مشايخه يفضلون مذهب الاشعري مثل ابي بكر بن اسحاق الضبي وابي بكر بن فورك وابي سهل الصعلوكي فهذا لايدل علي اعتناقه هذا المذهب وحول مصنفاته ذكرت محدثتنا: أنه اتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريبا من ألف جزء من تخريج الصحيحين والعلل والتراجم والابواب والشيوخ ثم المجموعات مثل معرفة علوم الحديث وتاريخ البنيسابوريين وكتاب مزكي الاخبار والمدخل الي علم الصحيح وكتاب الاكليل وفضائل الشافعي والمستدرك علي الصحيحين وغير ذلك كثير حيث بلغت تصانيفه خمس مائة جزء يستقفي في ذلك انه يؤلف الغث والسمين ثم يتكلم عليه فيبين ذلك اقوال في المستدرك تساهل كبير ففي احاديث كثيرة ليست علي شرط الصحة بل فيه احاديث موضوعة مستنكرة. عاش الحاكم النيسابوري رحمه الله حميدا ولم يخلف في وقته مثله وقد تعقبه الذهبي في المستدرك واقر الصحيح منه وبين الضعيف وتوفي في ثالث يوم من صفر سنة خمس واربعمائة.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#48
|
|||
|
|||
|
الهيثمى
علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح نور الدين أبو الحسن الهيثمي. كان أبوه صاحب حانوت بالصحراء فولد له هذا في رجب سنة خمس وثلاثين وسبعمائة. نشأ فقرأ القرآن ثم صحب الزين العراقي وهو بالغ ولم يفارقه سفراً وحضراً حتى مات بحيث حج معه جميع حجاته ورحل معه سائر رحلاته ورفقه في جميع مسموعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس ودمشق وبعلبك وحلب وحماة وطرابلس وغيرها. وربما سمع الزين بقراءته. ولم ينفرد عنه الزين بغير ابن الباب والتقى السبكي وابن شاهد الجيش، كما أن صاحب الترجمة لم ينفرد عنه بغير صحيح مسلم على ابن عبد الهادي. وممن سمع عليه سوى ابن عبد الهادي: الميدومي ومحمد بن إسماعيل بن الملوك ومحمد عبد الله النعماني وأحمد بن الرصدي وابن القطرواني والعرضي ومظفر الدين محمد بن محمد بن يحيى العطار وابن الخباز وابن الحموي وابن قيم الضيائية وأحمد بن عبد الرحمن المرداوي. فمما سمعه على المظفر: صحيح البخاري. وعلى ابن الخباز: صحيح مسلم، وعليه وعلى العرضي مسند أحمد. وعلى العرضي والميدومي: سنن أبي داود. وعلى الميدومي وابن الخباز: جزء ابن عرفة. قال السخاوي: وهو مكثر سماعاً وشيوخاً، ولم يكن الزين يعتمد في شيء من أموره إلا عليه حتى أنه أرسله مع ولده ولي الدين أبو زرعة لما ارتحل بنفسه إلى دمشق. وزوجه ابنته خديجة ورزق منها عدة أولاد. وكتب الكثير من تصانيف الشيخ بل قرأ عليه أكثرها، وتخرج به في الحديث، بل دربه في إفراد زوائد كتب كالمعاجم الثلاثة والمسانيد لأحمد والبزار وأبي على الكتب الستة وابتدأ أولاً بزوائد أحمد فجاء في مجلدين، وكل واحد من الخمسة الباقية في تصنيف مستقل، إلا الطبراني الأوسط والصغير فهما في تصنيف، ثم جمع الجميع في كتاب واحد محذوف الأسانيد سماه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) وكذا أفرد زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين (اسمه: موارد الظمآن لزوائد ابن حبان) ورتب أحاديث الحلية لأبي نعيم على الأبواب ومات عنه مسودة فبيضة وأكمله شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) في مجلدين، وأحاديث الغيلانيات والخلعيات، وفوائد أبي تمام، والأفراد للدارقطني أيضاً على الأبواب، ومات عنه مسودة فبيضه وأكمله شيخنا في مجلدين، ورتب كلاً من ثقات ابن حيان وثقات العجلي على الحروف. وأعانه الزين العراقي بكتبه ثم بالمرور عليها وتحريرها وعمل خطبها ونحو ذلك، وعادت بركة الزين عليه في ذلك وفي غيره. كما أن الزين استروح بعد بما عمله سيما المجمع. وكان عجباً في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيوخ وعدم مخالطة الناس في شيء من الأمور، والمحبة في الحديث وأهله. وحدث بالكثير رفيقاً للزين بل قل أن حدث الزين بشيء إلا وهو معه وكذلك قل أن حدث هو بمفرده. لكنهم بعد وفاة الشيخ العراقي أكثروا عنه، ومع ذلك فلم يغير حاله ولا تصدر ولا تمشيخ، وكان مع كونه شريكاً للشيخ يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه جميعها وربما استملى عليه، ويحدث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه إلا لمن ضايقه. ولم يزل على طريقته حتى مات في ليلة الثلاثاء تاسع عشر رمضان سنة سبع بالقاهرة ودفن من الغد خارج باب البرقية منها رحمه الله وإيانا. قال شيخنا (ابن حجر) في معجمه: وكان خيراً ساكناً ليناً سليم الفطرة شديد الإنكار للمنكر كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده محباً في الحديث وأهله. ثم أشار لما سمعه منه وقرأ عليه وأنه قرأ عليه إلى أثناء الحج من مجمع الزوائد سوى المجلس الأول منه ومواضع يسيرة من أثنائه، ومن أول زوائد مسند أحمد إلى قدر الربع منه، قال: وكان يودني كثيراً ويعينني عند الشيخ، وبلغه أنني تتبعت أوهامه في مجمع الزوائد فعاتبني وتركت ذلك إلى الآن (سيأتي كلام السخاوي في الدفاع عن الهيثمي، مع أن مذهب السخاوي في نشر الأغلاط مشهور) واستمر على المحبة والمودة، قال وكان كثير الاستحضار للمتون يسرع الجواب بحضرة الشيخ فيعجب الشيخ ذلك وقد عاشرتهما مدة فلم أرهما يتركان قيام الليل ورأيت من خدمته لشيخنا وتأدبه معه من غير تكلف لذلك ما لم أره لغيره ولا أظن أحداً يقوى عليه. وقال في إنباء الغمر بأبناء العمر: إنه صار كثير الاستحضار للمتون جداً لكثرة الممارسة، وكان هيناً ديناً خيراً محباً في أهل الخير لا يسأم ولا يضجر من خدمة الشيخ وكتابة الحديث سليم الفطرة كثير الخير والاحتمال للأذى خصوصاً من جماعة الشيخ، وقد شهد لي بالتقدم في الفن جزاه الله عني خيراً وكنت قد تتبعت أوهامه في كتابه المجمع فبلغني أن ذلك شق عليه فتركته رعاية له. قلت (السخاوي): وكأن مشقته لكونه لم يعلمه هو بل أعلم غيره وإلا فصلاح ينبو عن مطلق المشقة، أو لكونها غير ضرورية بحيث ساغ لشيخنا الإعراض عنها، والأعمال بالنيات. وقال البرهان الحلبي: إنه كان من محاسن القاهرة ومن أهل الخير غالب نهاره في اشتغال وكتابة مع ملازمة خدمة الشيخ في أمر وضوئه وثيابه ولا يخاطبه إلا بسيدي حتى كان في أمر خدمته كالعبد، مع محبته للطلبة والغرباء وأهل الخير وكثرة الاستحضار جداً. وقال التقي الفاسي: كان كثير الحفظ للمتون والآثار صالحاً خيراً. وقال الأقفهسي: كان إماماً عالماً حافظاً زاهداً متواضعاً متودداً إلى الناس ذا عبادة وتقشف وورع. قال السخاوي: والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جداً بل هو في ذلك كلمة اتفاق، وأما في الحديث فالحق ما قاله شيخنا (ابن حجر): إنه كان يدري منه فناً واحداً - يعني الذي دربه فيه شيخهما العراقي - قال: وقد كان من لا يدري يظن لسرعة جوابه بحضرة الشيخ أنه أحفظ وليس كذلك بل الحفظ المعرفة.
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#49
|
|||
|
|||
|
الحافظ العراقي
اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، وولادته : هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي(1) الرازياني (2) العراقي الأصل (3) المهراني (4) المصري المولد الشافعي المذهب . كنيته : أبو الفضل ، ويلقّب بـ(زين الدين)(5).وُلِدَ في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادى الأولى سنة ( 725 ه ) (6). أسرته : أقام أسلاف الحافظ العراقي في قرية رازيان – من أعمال إربل (7) – إلى أن انتقل والده وهو صغير مع بعض أقربائه إلى مصر (8)، إذ استقر فيها وتزوج من امرأة مصرية (1) ولدت له الحافظ العراقي . وكانت أسرته ممن عُرفوا بالزهد والصلاح والتقوى، وقد كان لأسلافه مناقب ومفاخر (2) ، وكانت والدته ممن اشتهرن بالاجتهاد في العبادات والقربات مع الصبر والقناعة (3) . أمّا والدُه فقد اختصَّ – منذ قدومه مصر – بخدمة الصالحين (4) ، ولعلَّ من أبرز الذين اختصَّ والده بخدمتهم الشيخ القناوي (5) . ومن ثَمَّ ولد للمتَرجَمِ ابنٌ أسماه : أحمد وكنَّاه : أبا زرعة ، ولقَّبه : بولي الدين (6) ، وكذلك بنت تدعى : خديجة ، صاهره عليها : الحافظ نور الدين الهيثمي ورزق منها بأولاد ، وأشارت بعض المصادر أنَّ له ابنتين أخريين : جويرية (7) وزينب (8) . نشأته : وُلِد الحافظ العراقي – كما سبق – في مصر ، وحمله والده صغيراً إلى الشيخ القناوي ؛ ليباركه ، إذ كان الشيخ هو البشير بولادة الحافظ ، وهو الذي سمَّاه أيضاً (9) ؛ ولكنَّ الوالد لَمْ يقم طويلاً مَعَ ولده ، إذ إنَّ يدَ المنونِ تخطَّفته والطفل لَمْ يزل بَعْد طريَّ العود ، غضَّ البنية لَمْ يُكمل الثالثة من عمره (10) ، وَلَمْ نقف عَلَى ذكر لِمَن كفله بَعْدَ رحيل والده ، والذي يغلب عَلَى ظننا أنّ الشَّيْخ القناوي هُوَ الَّذِي كفله وأسمعه (11) ؛ وذلك لأن أقدم سماع وجد له كان سنة ( 737 ه ) بمعرفة القناوي (1) وكان يُتَوقّعُ أن يكون له حضور أو سماع من الشيخ ، إذ كان كثير التردد إليه سواء في حياة والده أو بعده ، وأصحاب الحديث عند الشيخ يسمعون منه ؛ لعلوِّ إسناده (2). وحفظ الزينُ القرآنَ الكريمَ والتنبيه وأكثر الحاوي مَعَ بلوغه الثامنة من عمره (3) ، واشتغل في بدء طلبه بدرس وتحصيل علم القراءات ، وَلَمْ يثنِ عزمه عَنْهَا إلا نصيحة شيخه العزّ بن جَمَاعَة ، إذ قَالَ لَهُ : (( إنَّهُ علم كَثِيْر التعب قليل الجدوى ، وأنت متوقد الذهن فاصرف همَّتك إِلَى الْحَدِيْث )) (4). وكان قد سبق له أن حضر دروس الفقه على ابن عدلان ولازم العماد محمد بن إسحاق البلبيسي (5) ، وأخذ عن الشمس بن اللبان ، وجمال الدين الإسنوي الأصولَ (6) وكان الأخير كثير الثناء على فهمه ، ويقول : (( إنَّ ذهنه صحيح لا يقبل الخطأ )) (7) ، وكان الشيخ القناوي في سنة سبع وثلاثين – وهي السنة التي مات فيها – قد أسمعه على الأمير سنجر الجاولي ، والقاضي تقي الدين بن الأخنائي المالكي ، وغيرهما ممّن لم يكونوا من أصحاب العلوِّ (8). ثمَّ ابتدأ الطلب بنفسه ، وكان قد سمع على عبد الرحيم بن شاهد الجيش وابن عبد الهادي وقرأ بنفسه على الشيخ شهاب الدين بن البابا (9) ، وصرف همَّته إلى التخريج وكان كثير اللهج بتخريج أحاديث " الإحياء " وله من العمر -آنذاك- عشرون سنة (10) وقد فاته إدراك العوالي مما يمكن لأترابه ومَن هو في مثل سنّه إدراكه ، ففاته يحيى بن المصري – آخر مَن روى حديث السِّلَفي عالياً بالإجازة (11) – والكثير من أصحاب ابن عبد الدائم والنجيب بن العلاّق (1) ، وكان أوّل مَن طلب عليه الحافظ علاء الدين بن التركماني في القاهرة وبه تخرّج وانتفع (2) ، وأدرك بالقاهرة أبا الفتح الميدومي فأكثر عنه وهو من أعلى مشايخه إسناداً (3) ، ولم يلقَ من أصحاب النجيب غيره (4) ، ومن ناصر الدين محمد بن إسماعيل الأيوبي(5)، ومن ثَمَّ شدَّ رحاله – على عادة أهل الحديث (6) – إلى الشام قاصداً دمشق فدخلها سنة ( 754 ه ) (7) ، ثُمَّ عادَ إليها بعد ذلك سنة ( 758 ه ) ، وثالثة في سنة ( 759 ه ) (8) ، ولم تقتصر رحلته الأخيرة على دمشق بل رحل إلى غالب مدن بلاد الشام (9) ، ومنذ أول رحلة له سنة ( 754 ه ) لم تخلُ سنة بعدها من الرحلة إمّا في الحديث وإمّا في الحجّ (10) ، فسمع بمصر (11) ابن عبد الهادي ، ومحمد بن علي القطرواني ، وبمكة أحمد بن قاسم الحرازي ، والفقيه خليل إمام المالكية بها ، وبالمدينة العفيف المطري ، وببيت المقدس العلائي ، وبالخليل خليل بن عيسى القيمري ، وبدمشق ابن الخباز ، وبصالحيتها ابن قيم الضيائية ، والشهاب المرداوي ، وبحلب سليمان بن إبراهيم بن المطوع ، والجمال إبراهيم بن الشهاب محمود في آخرين بهذه البلاد وغيرها كالإسكندرية ، وبعلبك ، وحماة ، وحمص ، وصفد ، وطرابلس ، وغزّة ، ونابلس … تمام ستة وثلاثين مدينة . وهكذا أصبح الحديث ديدنه وأقبل عليه بكليته (12) ، وتضلّع فيه رواية ودراية وصار المعول عليه في إيضاح مشكلاته وحلّ معضلاته ، واستقامت له الرئاسة فيه ، والتفرد بفنونه ، حتّى إنّ كثيراً من أشياخه كانوا يرجعون إليه ، وينقلون عنه – كما سيأتي – حتَّى قال ابن حجر : (( صار المنظور إليه في هذا الفن من زمن الشيخ جمال الدين الأسنائي … وهلمَّ جرّاً ، ولم نرَ في هذا الفنّ أتقن منه ، وعليه تخرج غالب أهل عصره )) (1) . مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه : مما تقدّم تبيّنت المكانة العلمية التي تبوّأها الحافظ العراقي ، والتي كانت من توفيق الله تعالى له ، إذ أعانه بسعة الاطلاع ، وجودة القريحة وصفاء الذهن وقوة الحفظ وسرعة الاستحضار ، فلم يكن أمام مَن عاصره إلاّ أن يخضع له سواء من شيوخه أو تلامذته . ولعلّ ما يزيد هذا الأمر وضوحاً عرض جملة من أقوال العلماء فيه ، من ذلك : 1. قال شيخه العزُّ بن جماعة : (( كلّ مَن يدّعي الحديث في الديار المصرية سواه فهو مدَّعٍ )) (2). 2. قال التقي بن رافع السلامي : (( ما في القاهرة مُحَدِّثٌ إلاّ هذا ، والقاضي عزّ الدين ابن جماعة )) ، فلمَّا بلغته وفاة العزّ قال : (( ما بقي الآن بالقاهرة مُحَدِّثٌ إلاّ الشيخ زين الدين العراقي )) (3) . 3. قال ابن الجزري : (( حافظ الديار المصرية ومُحَدِّثُها وشيخها )) (4) . 4. قال ابن ناصر الدين : (( الشيخ الإمام العلاّمة الأوحد ، شيخ العصر حافظ الوقت … شيخ الْمُحَدِّثِيْن عَلَم الناقدين عُمْدَة المخرِّجِين )) (5) . 5. قال ابن قاضي شهبة : (( الحافظ الكبير المفيد المتقن المحرّر الناقد ، محَدِّث الديار المصرية ، ذو التصانيف المفيدة )) (6) . 6. قال التقي الفاسي : (( الحافظ المعتمد ، … ، وكان حافظاً متقناً عارفاً بفنون الحديث وبالفقه والعربية وغير ذلك ، … ، وكان كثير الفضائل والمحاسن )) (7) . 7. وقال ابن حجر : حافظ العصر (1) ، وقال : (( الحافظ الكبير شيخنا الشهير )) (2) . 8. وقال ابن تغري بردي : (( الحافظ ، … شيخ الحديث بالديار المصرية ، … وانتهت إليه رئاسة علم الحديث في زمانه )) (3) . 9. وقال ابن فهد : (( الإمام الأوحد ، العلاّمة الحجة الحبر الناقد ، عمدة الأنام حافظ الإسلام ، فريد دهره ، ووحيد عصره ، من فاق بالحفظ والإتقان في زمانه ، وشهد له في التفرّد في فنه أئمة عصره وأوانه )) (4) . وأطال النفس في الثناء عليه . 10. وقال السيوطي: (( الحافظ الإمام الكبير الشهير ،… حافظ العصر )) (5) . ويبدو أنّ الأمر الأكثر إيضاحاً لمكانة الحافظ العراقي ، نقولات شيوخه عنه وعودتهم إليه ، والصدور عن رأيه ، وكانوا يكثرون من الثناء عليه ، ويصفونه بالمعرفة ، من أمثال السبكي والعلائي وابن جماعة وابن كثير والإسنوي (6) . ونقل الإسنوي عنه في " المهمات " وغيرها (7) ، وترجم له في طبقاته ولم يترجم لأحد من الأحياء سواه (8) ، وصرّح ابن كثير بالإفادة منه في تخريج بعض الشيء (9) . ومن بين الأمور التي توضّح مكانة الحافظ العراقي العلمية تلك المناصب التي تولاها ، والتي لا يمكن أن تسند إليه لولا اتفاق عصرييه على أولويته لها ، ومن بين ذلك : تدريسه في العديد من مدارس مصر والقاهرة مثل : دار الحديث الكاملية (10) ، والظاهرية القديمة (11) ، والقراسنقرية (12) ، وجامع ابن طولون (1) والفاضلية (2) ، وجاور مدةً بالحرمين (3) . كما أنّه تولّى قضاء المدينة المنورة ، والخطابة والإمامة فيها ، منذ الثاني عشر من جُمَادَى الأولى سنة ( 788 ه ) ، حتى الثالث عشر من شوال سنة ( 791 ه ) ، فكانت المدة ثلاث سنين وخمسة أشهر (4) . وفي سبيل جعل شخصية الحافظ العراقي بينة للعيان من جميع جوانبها ، ننقل ما زَبَّره قلم تلميذه وخِصِّيصه الحافظ ابن حجر في وصفه شيخه ، إذ قال في مجمعه (5) : (( كان الشيخ منور الشيبة ، جميل الصورة ، كثير الوقار ، نزر الكلام ، طارحاً للتكلف ، ضيق العيش ، شديد التوقي في الطهارة ، لطيف المزاج ، سليم الصدر ، كثير الحياء ، قلَّما يواجه أحداً بما يكرهه ولو آذاه ، متواضعاً منجمعاً ، حسن النادرة والفكاهة ، وقد لازمته مدّة فلم أره ترك قيام الليل ، بل صار له كالمألوف ، وإذا صلَّى الصبح استمر غالباً في مجلسه ، مستقبل القبلة ، تالياً ذاكراً إلى أن تطلع الشمس ، ويتطوع بصيام ثلاثة أيام من كلِّ شهر وستة شوال ، كثير التلاوة إذا ركب … )) ، ثُمَّ ختم كلامه قائلاً : (( وليس العيان في ذلك كالخبر )) . شيوخه : عرفنا فيما مضى أنَّ الحافظ العراقي منذ أن أكبَّ على علم الحديث ؛ كان حريصاً على التلقي عن مشايخه ، وقد وفّرت له رحلاته المتواصلة سواء إلى الحج أو إلى بلاد الشام فرصة التنويع في فنون مشايخه والإكثار منهم . والباحث في ترجمته وترجمة شيوخه يجد نفسه أمام حقيقة لا مناص عنها ، وهي أنَّ سمة الحديث كانت الطابع المميز لأولئك المشايخ ، مما أدَّى بالنتيجة إلى تنّوع معارف الحافظ العراقي وتضلّعه في فنون علوم الحديث ، فمنهم من كان ضليعاً بأسماء الرجال ، ومنهم من كان التخريج صناعته ، ومنهم من كان عارفاً بوفيات الرواة ، ومنهم من كانت في لغة الحديث براعته … وهكذا . وهذا شيء نلمسه جلياً في شرحه هذا بجميع مباحثه ، وذلك من خلال استدراكاته وتعقباته وإيضاحاته والفوائد التي كان يطالعنا بها على مرِّ صفحات شرحه الحافل . ومسألة استقصاء جميع مشايخه – هي من نافلة القول – فضلاً عن كونها شبه متعذرة سلفاً ، لاسيّما أنه لم يؤلف معجماً بأسماء مشايخه على غير عادة المحدّثين ، خلافاً لقول البرهان الحلبي من أنه خرّج لنفسه معجماً (1) . لذا نقتصر على أبرزهم ، مع التزامنا بعدم إطالة تراجمهم : 1 – الإمام الحافظ قاضي القضاة علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني ، المشهور بـ (( ابن التركماني )) الحنفي ، مولده سنة ( 683 ه ) ، وتوفي سنة ( 750 ه ) ، له من التآليف : " الجوهر النقي في الرد على البيهقي ، وغيره (2) . 2 – الشيخ المُسْنِد المعمر صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي المصري ، ولد سنة ( 664 ه ) ، وهو آخر من روى عن النجيب الحراني ، وابن العلاق ، وابن عزون ، وتوفي سنة ( 754 ه ) (3) . 3 – الإمام الحافظ العلاّمة علاء الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي ثم المقدسي ، ولد سنة ( 694 ه ) ، وتوفي سنة ( 761 ه ) ، له من التصانيف : " جامع التحصيل "، و " الوشي المعلم "، و " نظم الفرائد " وغيرها (4). 4 – الإمام الحافظ العلاّمة علاء الدين أبو عبد الله مغلطاي بن قُليج بن عبد الله البكجري الحكري الحنفي ، مولده سنة ( 689 ه ) ، وقيل غيرها ، برع في فنون الحديث ، وتوفي سنة ( 762 ه ) ، من تصانيفه : ترتيب كتاب بيان الوهم والإيهام وسمّاه : " منارة الإسلام " ، ورتّب المبهمات على أبواب الفقه ، وله شرح على صحيح البخاري ، وتعقّبات على المزي ، وغيرها (5) . 5 – الإمام العلاّمة جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ، شيخ الشافعية ، ولد سنة ( 704 ه ) ، وتوفي سنة ( 777 ه ) ، له من التصانيف : طبقات الشافعية ، والمهمات ، والتنقيح وغيرها (1) . تلامذته : تبين مما تقدّم أنّ الحافظ العراقي بعد أن تبوأ مكان الصدارة في الحديث وعلومه وأصبح المعوّل عليه في فنونه بدأت أفواج طلاب الحديث تتقاطر نحوه ، ووفود الناهلين من معينه تتجه صوبه ، لاسيّما وقد أقرَّ له الجميع بالتفرد بالمعرفة في هذا الباب ، لذا كانت فرصة التتلمذ له شيئاً يعدّه الناس من المفاخر ، والطلبة من الحسنات التي لا تجود بها الأيام دوماً . والأمر الآخر الذي يستدعي كثرة طلبة الحافظ العراقي كثرة مفرطة ، أنه أحيا سنة إملاء الحديث – على عادة المحدّثين (2) – بعد أن كان درس عهدها منذ عهد ابن الصلاح فأملى مجالس أربت على الأربعمائة مجلس ، أتى فيها بفوائد ومستجدات (( وكان يمليها من حفظه متقنة مهذّبة محرّرة كثيرة الفوائد الحديثية )) على حد تعبير ابن حجر (3) . لذا فليس من المستغرب أن يبلغوا كثرة كاثرة يكاد يستعصي على الباحث سردها ، إن لم نقل أنها استعصت فعلاً ، فضلاً عن ذكر تراجمهم ، ولكن القاعدة تقول : (( ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه )) وانسجاماً معها نعرّف تعريفاً موجزاً بخمسة من تلامذته كانوا بحقّ مفخرة أيامهم وهم : 1 – الإمام برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن أيوب الأبناسي ، مولده سنة ( 725 ه ) ، وهو من أقران العراقي ، برع في الفقه ، وله مشاركة في باقي الفنون، توفي سنة ( 802 ه )، من تصانيفه : الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح،وغيره(4). 2 – الإمام الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي القاهري ، ولد سنة ( 735 ه ) ، وهو في عداد أقرانه أيضاً ، ولكنه اختص به وسمع معه ، وتخرّج به ، وهو الذي كان يعلّمه كيفية التخريج ، ويقترح عليه مواضيعها ، ولازم الهيثمي خدمته ومصاحبته ، وصاهره فتزوج ابنة الحافظ العراقي ، توفي سنة ( 807 ه ) ، من تصانيفه : مجمع الزوائد ، وبغية الباحث ، والمقصد العلي ، وكشف الأستار ، ومجمع البحرين ، وموارد الظمآن ، وغيرها (1) . 3 – ولده : الإمام العلاّمة الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأصل المصري الشافعي المذهب ، ولد سنة ( 762 ه ) ، وبكّر به والده بالسماع فأدرك العوالي ، وانتفع بأبيه غاية الانتفاع ، ودرّس في حياته ، توفي سنة ( 826 ه ) ، من تصانيفه : " الإطراف بأوهام الأطراف " و " تكملة طرح التثريب " و " تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل " ، وغيرها (2) . 4 – الإمام الحافظ برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المشهور بسبط ابن العجمي ، مولده سنة ( 753 ه ) ، رحل وطلب وحصّل ، وله كلام لطيف على الرجال ، توفي سنة ( 841 ه ) ، من تصانيفه : " حاشية على الكاشف " للذهبي و " نثل الهميان " (3) و " التبيين في أسماء المدلّسين " و " الاغتباط فيمن رمي بالاختلاط " وغيرها (4) . 5 – الإمام العلاّمة الحافظ الأوحد شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر ، ولد سنة ( 773 ه ) ، طلب ورحل ، وألقي إليه الحديث والعلم بمقاليده ، والتفرد بفنونه ، توفي سنة ( 852 ه ) ، من تصانيفه: "فتح الباري" و "تهذيب التهذيب" وتقريبه و" نزهة الألباب "، وغيرها(5). آثاره العلمية : لقد عرف الحافظ العراقي أهمية الوقت في حياة المسلم ، لذا فقد عمل جاهداً على توظيف الوقت بما يخدم السنة العزيزة ، بحثاً منه أو مباحثة مع غيره فكانت (( غالب أوقاته في تصنيف أو إسماع )) كما يقول السخاوي (1) ، لذا كثرت تصانيفه وتنوعت ، مما حدا بنا – من أجل جعل البحث أكثر تخصصاً – إلى تقسيمها على قسمين : قسم خاصّ بمؤلفاته التي تتعلق بالحديث وعلومه ، وقسم يتضمن مؤلفاته في العلوم الأخرى ، وسنبحث كلاً منهما في مطلب مستقل . المطلب الأول مؤلفاته فيما عدا الحديث وعلومه : تنوعت طبيعة هذه المؤلفات ما بين الفقه وأصوله وعلوم القرآن ، غير أنَّ أغلبها كان ذا طابع فقهي ، يمتاز الحافظ فيه بالتحقيق ، وبروز شخصيته مدافعاً مرجّحاً موازناً بين الآراء . على أنَّ الأمر الذي نأسف عليه هو أنَّ أكثر مصنفاته فُقدت ، ولسنا نعلم سبب ذلك ، وقد حفظ لنا مَنْ ترجم له بعض أسماء كتبه ، تعين الباحث على امتلاك رؤية أكثر وضوحاً لشخص هذا الحافظ الجليل ، وإلماماً بجوانب ثقافته المتنوعة المواضيع . ومن بين تلك الكتب : 1 – أجوبة ابن العربي (2) . 2 – إحياء القلب الميت بدخول البيت (3) . 3 – الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد (4) . 4 – أسماء الله الحسنى (1) . 5 – ألفية في غريب القرآن (2) . 6 – تتمات المهمات (3) . 7 – تاريخ تحريم الربا (4) . 8 – التحرير في أصول الفقه (5) . 9 – ترجمة الإسنوي (6) . 10 – تفضيل زمزم على كلّ ماء قليل زمزم (7) . 11 – الرد على من انتقد أبياتاً للصرصري في المدح النبوي (8) . 12 – العدد المعتبر في الأوجه التي بين السور (9) . 13 – فضل غار حراء (10) . 14 – القرب في محبة العرب (11) . 15 – قرة العين بوفاء الدين (12) . 16 – الكلام على مسألة السجود لترك الصلاة (13) . 17 – مسألة الشرب قائماً (1) . 18 – مسألة قصّ الشارب (2) . 19 – منظومة في الضوء المستحب (3) . 20 – المورد الهني في المولد السني (4) . 21 – النجم الوهاج في نظم المنهاج (5) . 22 – نظم السيرة النبوية (6) . 23 – النكت على منهاج البيضاوي (7) . 24 – هل يوزن في الميزان أعمال الأولياء والأنبياء أم لا ؟ (8) . المطلب الثاني مؤلفاته في الحديث وعلومه : هذه الناحية من التصنيف كانت المجال الرحب أمام الحافظ العراقي ليظهر إمكاناته وبراعته في علوم الحديث ظهوراً بارزاً ، يَتَجلَّى لنا ذلك من تنوع هذه التصانيف ، التي بلغت ( 42 ) مصنفاً تتراوح حجماً ما بين مجلدات إلى أوراق معدودة ، وهذه التصانيف هي : 1 – الأحاديث المخرّجة في الصحيحين التي تُكُلِّمَ فيها بضعف أو انقطاع (9) . 2 – الأربعون البلدانية (10) . 3 – أطراف صحيح ابن حبان (1) . 4 – الأمالي (2) . 5 – الباعث على الخلاص من حوادث القصاص (3) . 6 – بيان ما ليس بموضوع من الأحاديث (4) . 7 – تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي (5) . 8 – ترتيب من له ذكر أو تجريح أو تعديل في بيان الوهم والإيهام (6) . 9 – تخريج أحاديث منهاج البيضاوي (7) . 10- تساعيات الميدومي (8) . 11- تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد (9) . 12- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح (10) . 13- تكملة شرح الترمذي لابن سيد الناس (11) . 14- جامع التحصيل في معرفة رواة المراسيل (12) . 15- ذيل على ذيل العبر للذهبي (1) . 16- ذيل على كتاب أُسد الغابة (2) . 17- ذيل مشيخة البياني (3) . 18- ذيل مشيخة القلانسي (4) . 19 – ذيل ميزان الاعتدال للذهبي (5) . 20- ذيل على وفيات ابن أيبك (6) . 21- رجال سنن الدارقطني (7) . 22- رجال صحيح ابن حبان (8) . 23- شرح التبصرة والتذكرة (9) . 24- شرح تقريب النووي (10) . 25- طرح التثريب في شرح التقريب (11) . 26- عوالي ابن الشيخة (12) . 27- عشاريات العراقي (13) . 28- فهرست مرويات البياني (14) . 29- الكلام على الأحاديث التي تُكُلِّمَ فيها بالوضع ، وهي في مسند الإمام أحمد (1) . 30 – الكلام على حديث : التوسعة على العيال يوم عاشوراء (2) . 31- الكلام على حديث : صوم ستٍّ من شوال (3) . 32- الكلام على حديث : من كنت مولاه فعليٌّ مولاه (4) . 33- الكلام على حديث : الموت كفّارة لكل مسلم (5) . 34- الكلام على الحديث الوارد في أقل الحيض وأكثره (6) . 35- المستخرج على مستدرك الحاكم (7) . 36- معجم مشتمل على تراجم جماعة من القرن الثامن (8) . 37- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأحاديث والآثار(9). 38- مشيخة عبد الرحمن بن علي المصري المشهور بابن القارئ (10) . 39- مشيخة محمد بن محمد المربعي التونسي وذيلها (11) . 40- من روى عن عمرو بن شعيب من التابعين (12) . 41- من لم يروِ عنهم إلا واحد (13) . 42- نظم الاقتراح (14) . وفاته : تتفق المصادر التي بين أيدينا على أنَّه في يوم الأربعاء الثامن من شعبان سنة (806ه) فاظت روح الحافظ العراقي عقيب خروجه من الحمام عن عمر ناهز الإحدى وثمانين سنة ، وكانت جنازته مشهودة ، صلّى عليه الشيخ شهاب الدين الذهبي ودفن خارج القاهرة (1) رحمه الله . ولما تمتع به الحافظ العراقي في نفوس الناس ، فقد توجع لفقده الجميع ، ومن صور ذلك التوجع أن العديد من محبيه قد رثاه بغرر القصائد ، ومنها قول ابن الجزري (2) : رحمة الله للعراقي تترى حافظ الأرض حبرها باتفاق إنني مقسم أليَّة صدق لم يكن في البلاد مثل العراقي ومنها قصيدة ابن حجر ومطلعها (3): مصاب لم ينفس للخناق أصار الدمع جاراً للمآقي ومن غرر شعر ابن حجر في رثاء شيخه العراقي قوله في رائيته التي رثا بها شيخه البلقيني : نعم ويا طول حزني ما حييت على عبد الرحيم فخري غير مقتصر(4) لَهْفِيْ على حافظ العصر الذي اشتهرت أعلامه كاشتهار الشمس في الظهر علم الحديث انقضى لَمَّا قضى ومضى والدهر يفجع بعد العين بالأثر لَهْفِيْ على فَقْدِ شيخَيَّ اللذان هما أعزّ عنديَ من سمعي ومن بصري لَهْفِيْ على من حديثي عن كمالهما يحيي الرميم ويلهي الحي عن سمر اثنانِ لم يرتقِ النسران ما ارتقيا نسر السما إن يلح والأرض إن يطر ذا شبه فرخ عقاب حجة صدقت وذا جهينة إن يسأل عن الخبر لا ينقضي عجبي من وفق عمرهما العام كالعام حتى الشهر كالشهر عاشا ثمانين عاما بعدها سنة وربع عام سوى نقص لمعتبر الدين تتبعه الدنيا مضت بهما رزية لم تهن يوما على بشر بالشمس وهو سراج الدين يتبعه بدر الدياجي زين الدين في الأثر (1)
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
|
#50
|
|||
|
|||
|
الإمام سهل بن عبد الله التستري
تذخر المكتبة الإسلامية بالكثير من المؤلفات في الفقه والحديث والتفسير علي يد أئمة أعلام كان لهم الفضل في إثراء العلوم الاسلامية بهذه المؤلفات.. وطوال الشهر الكريم سنعرض كل يوم واحد من هؤلاء الأئمة في الفقة والحديث والتفسير.. نقدم شيئا من سيرة حياته ونشأته العلمية ومدرسته الفكرية والمذهبية ثم أهم مؤلفاته وقبسا منها. هو من أعلام العلماء وأئمة التصوف الزاهد الورع والعابد المتقشف أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ولد في تستر بالأهواز سنة ثلاث ومائتين من الهجرة وعاش في القرن الثالث الهجري ذلك القرن الذي حفل بالائمة الكبار في كل فن من الفنون. نشأ سهل فوجد امامه في جنح الليل خاله محمد بن سوار قائما يتبتل إلي الله ويضرع إليه ويناجيه يصلي في خشوع ويدعو في خضوع ويقضي الليل ساهرا في عبادة خاشعة آسرة جذبت سهلا إليه وربطته به وحببته فيه. وأرسلوه إلي الكتاب فاشترط أن يكون ذهابه ساعة من نهار حتي لا ينفرط عقد عبادته ولا يتشتت ذهنه. وذهب إلي الكتاب. وضم إلي العمل العلم وإلي الذكر فيوضات الخير النابعة من داخل القلب لقد حفظ القرآن وتفقه في أمور الشرع. لقد حفظ القرآن وهو ابن سن سنين وشغله الذكر والاستغراق في العبادة عن متطلبات الحياة المادية العادية. لقد تغذي بالذكر فخف احتياجه إلي ما سواه وكان يكتفي بخبز الشعير وكان يأكل أقل القليل منه. كانت تلقي مشكلات المسائل علي العلماء ثم لا يوجد جوابا الا إلي عنده وهو ابن إحدي عشرة سنة وحينئذ ظهرت عليه الكرامات. وبلغ سهل النضوج العلمي والنضوج الروحي ويرسم الطريق إليه علي هدي. ولم تقتصر دعوته إلي الله علي التربية وتعليم السلوك ولم تقتصر دعوته علي القول والموعظة الحسنة لقد ترك مؤلفات قيمة في مجالات متعددة وشارك في أنواع من العلوم ـ ومن أشهر كتبه.. رقائق المحبين مواعظ العارفين. جوابات أهل اليقين. قصص الأنبياء هذا فضلا عن تفسيره المشهور. ولقد امتاز سهل بتعظيمه للسنة وبتعظيمه للشريعة. وقد تكلم علي بعض آيات من القرآن مبينا ما ألهمه بشأنها. وقد فال: أصولنا سبعة.. التمسك بكتاب الله تعالي والاقتداء بسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأكل الحلال وكف الأذي واجتناب الآثام والتوبة وأداء الحقوق. لقد سار سهل في إطار القرآن وعرف ما قاله الأئمة أو كثير من الأئمة في تفسير الآيات ولكن القرآن لا يمكن أن يحيط أحد بأقطاره ولا يمكن أن تكون المعاني اللغوية الضيقة هي كل ما عبر عنه القرآن إنها ـ إن عبرت ـ فإنها تعبر عن ظاهر. ولكن القرآن الكريم ليس هو ما يظهر للناظر منذ الوهلة الأولي. إن وراء ظاهره اسرارا لا تتعارض مع هذا الظاهر ولكنها توضحه وتجعله نافذا إلي القلوب جاذبا للنفوس آسرا للأرواح. إنها ما عبر عنه الرسول صلي الله عليه وسلم بقوله: (لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع). ويري سهل أن ظاهر الآية التلاوة وباطنها الفهم وحدها الحلال والحرام ومطلعها: إشراق القلب علي المراد بها فقها من الله عز وجل فالعلم الظاهر علم عام والفهم لباطنه والمراد به خاص
__________________
زيارة صفحتي محاضرات ودروس قناة الأثر الفضائية https://www.youtube.com/channel/UCjde0TI908CgIdptAC8cJog |
 |
|
|
 |
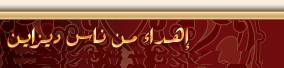 |