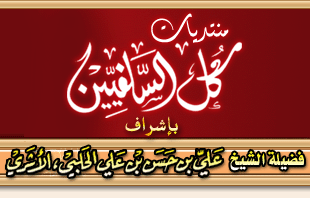

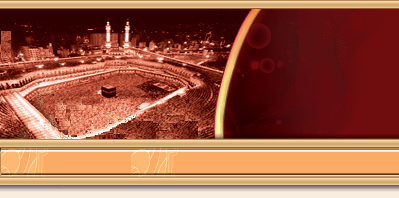
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
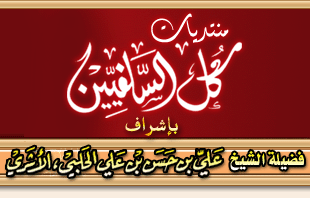 |
 |
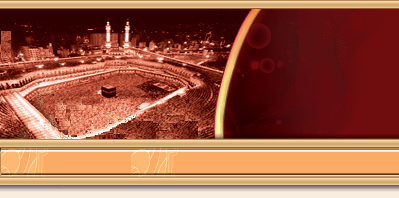 |
|||||
|
|||||||
| 73613 | 98954 |
|
#21
|
|||
|
|||
|
الحديث الثاني عشر الشرح "مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَرْءِ" خبر مقدم و: "تَرْكُ" مبتدأ مؤخّر. وقوله: "مَا لاَيَعْنِيْهِ" أي ما لاتتعلق به عنايته ويهتم به، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَولِيَصْمُت " فإنه يشابهه من بعض الوجوه. من فوائد هذا الحديث: .1أن الإسلام جمع المحاسن، وقد ألّف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع: (محاسن الدين الإسلامي) وكذلك ألّف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلّها تجتمع في كلمتين: قال الله عز وجل: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ)(النحل: الآية90) .2أن ترك الإنسان ما لايهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. .3أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع كثيراً لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لاتعنيه، أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لاتعنيه ويتدخل فيما لايعنيه، وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. .4أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لايعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لاتهمّه ولاتعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يَرِدُ إشكالٌ: وهو هل ترك العبد ما لايعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والجواب: لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عزّ وجل: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)(آل عمران: الآية104) فلو رأيت إنساناً علىمنكر وقلت له: يا أخي هذا منكر لايجوز. فليس له الحق أن يقول: هذا لايعنيك، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها. ومن ذلك أيضاً: ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت أن يدلّهم على الخير ويأمرهم به ويحذرهم من الشر وينهاهم عنه. قال الله عزّ وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ)(التحريم: الآية6) تم بحمدالله.. يتبع إن شاء الله الحديث الثالث عشر (لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)..
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#22
|
|||
|
|||
|
الحديث الثالث عشر
عَنْ أَبِيْ حَمْزَة أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ) رواه البخاري ومسلم الشرح قوله: "لاَيُؤمِنُ أَحَدُكُمْ" أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال والتمام، وليس نفياً لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، ولا يعتبر مرتدّاً، وإنما هو من باب النصيحة، فيكون النفي هنا نفياً لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لاننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لادليل عليه، لأنه إذا لم يكن عليه دليلٌ صار تحريفاً وليس تأويلاً، أما التأويل الذي دلّ عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "اللَّهُمَّ فَقِّههُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأوِيْلَ". فإن قال قائل: في قول الله تعالى: ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّه مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ) (النحل:98) المراد به: إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلاً مذموماً، أو تأويلاً صحيحاً؟ والجواب: هذا تأويل صحيح، لأنه دلّ عليه الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتعوّذ عند القراءة لا في آخر القراءة . وإذا قال قائل: في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)(المائدة: الآية6) إن المراد إذا أردتم القيام إليها، فهل يعتبر هذا تأويلاً مذموماً، أو صحيحاً ؟ والجواب: هذا تأويل صحيح. وعليه فلا ننكر التأويل مطلقاً، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفاً. "لاَ يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ" الإيمان في اللغة هو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان والإيمان وهو مطابق للشرع وقيل: هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه يقال: آمنت بكذا وصدقت فلاناً ولايقال: آمنت فلاناً. وقيل الإيمان في اللغة الإقرار واستدل القائل لذلك أنه يقال: آمن به وأقرّ به، ولا يقال: آمنه بمعنى صدقه، فلمّا لم يتوافق الفعلان في التعدّي واللزوم عُلم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة : إقرار القلب بما يرد عليه، وليس التصديق. وقد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى: (فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ )(العنكبوت: الآية26) على أحد القولين مع أنه يمكن أن يقال: فآمن له لوط أي انقاد له - أي إبراهيم - وصدّق دعوته. أما الإيمان في الشرع فهوكما سبق في تعريفه في اللغة. فمن أقرّ بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن، وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يذعنوا. وأبو طالب كان مقرّاً بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ، ويعلن بذلك، ويقول: لقدْ عَلموا أَنَّ ابننا لا مكذّب لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل ويقول: ولقد علمتُ بأنّ دينَ محمّدٍ من خير أديانِ البريّة ديناً لولا الملامة أو حذار مسبّةٍ لرأيتني سمْحَاً بذاكَ مبيناً وهذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليس بمؤمن، لفقده القبول والانقياد، فلم يقبل الدعوة ولم ينقد لها فمات على الكفر - والعياذ بالله - . ومحل الإيمان: القلب واللسان والجوارح، فالإيمان يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيماناً، وعمل الجوارح يسمى إيماناً، والدليل: قول الله عزّ وجل: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ )(البقرة: الآية143) قال المفسّرون: إيمانكم: أي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً فَأَعْلاهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله، وأدنْاهَا إِمَاطَةُ الأذى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ" أعلاها قول: لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح، والحياء عمل القلب. وأما القول بأن الإيمان محلّه القلب فقط، وأن من أقرّ فقد آمن فهذا غلط ولا يصحّ. وقوله: "حَتَّى يُحَبَّ" (حتى) هذه للغاية، يعني: إلى أن "يُحَبَّ لأَخِيْه" والمحبة: لاتحتاج إلى تفسير، ولايزيد تفسيرها إلا إشكالاً وخفاءً، فالمحبة هي المحبة، ولا تفسَّر بأبين من لفظها. وقوله: "لأَخِيْهِ" أي المؤمن "مَا يُحبُّ لِنَفْسِهِ" من خير ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلك، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ فَلْتَأتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ"الشاهد هنا قوله: وَلْيَأتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤتَى إِلَيْهِ . من فوائد هذا الحديث: .1جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقول: "لايُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ" ومثله قوله: "لا يُؤمنُ مَنْ لا يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ" ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لاصَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام" أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر، والأمثلة على هذا كثيرة. .2وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عن من لايحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لايُنفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. .3التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنّى زوال نعمة الله عن أخيه المسلم. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد: فقال بعضهم "تمنّي زوال النعمة عن الغير" . وقال بعضهم الحسد هو: كراهة ما أنعم الله به على غيره، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: إذا كره العبد ما أنعم الله به على غيره فقد حسده، وإن لم يتمنَّ الزوال . .4أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، لأن من الفصاحة، صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، والشاهد لهذا قوله: "لأَخِيهِ" لأن هذه يقتضي العطف والحنان والرّقة، ونظير هذا قول الله عزّ وجل في آية القصاص: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْء)(البقرة: الآية178) مع أنه قاتل، تحنيناً وتعطيفاً لهذا المخاطب. فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة، أي: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى: أن تحب لأخيك أن يكون عالماً، وأن يكون غنياً، وأن يكون ذا مال وبنين، وأن يكون مستقيماً، فقد يصعب هذا؟ فنقول: هذا لايصعب إذا مرّنت نفسك عليه، مرّن نفسك على هذا يسهل عليك، أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعباً. فإن قال تلميذ من التلاميذ: هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب: لا، لأن هذا غشّ، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحساناً إليه، لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليها، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلاً لها. تم بحمدالله .. يتبع إن شاء الله الحديث الرابع عشر (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ)
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#23
|
|||
|
|||
|
عودا حميدا يا إم عبدالرحمن..لقد افتقدناكِ..
جزاك الله خيرا ونفع بك..ولا تطيلي الغيبة!
__________________
زوجة أبي الحارث باسم خلف |
|
#24
|
|||
|
|||
|
الحديث الرابع عشر رواه البخاري ومسلم. الشرح "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" أي لا يحل قتله،وفسّرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إِنَّ دِمَاءَكَمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاَضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ" . وقوله: "امرِئٍ مُسْلِمٍ" التعبير بذلك لايعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيّون بأنفسهم وبالنساء. وقوله: "مُسْلِمٍ" أي داخل في الإسلام. "إِلاَّ بإِحْدَى ثَلاثٍ" يعني بواحدة من الثلاث. "الثَّيِّبُ الزَّانِي" فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو : الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم الله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، ولكن صفة قتله سنذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد. ومفهوم قوله "الثَّيِّبُ" أن البكر لايحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح. "وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ" المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتِلَ به بالشروط المعروفة. "وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ" يعني بذلك المرتدّ بأي نوع من أنواع الرّدة. وقوله: "المُفَارِقُ للجَمَاعَةِ" هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. من فوائد هذا الحديث: .1احترام دماء المسلمين، لقوله: "لايَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ" وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة والإجماع،قال الله تعالى في القرآن الكريم: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) (النساء: 93) فقتل المسلم المعصوم الدم من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. .2أن غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معَاهَداً، أومستأمِناً، أو ذميّاً، فإن كان كذلك فدمه معصوم. والمعاهد: من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن: الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً. والذّميّ: وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذبّ عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائه في بلادنا. إذاً قوله: "لايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ" يخرج بذلك غير المسلم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. .3حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً. .4أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته: أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لاكبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من الرّجم، والصغيرة يتعذّب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطاً، فالثيب الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة. فإن قال قائل: كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ" ؟ فالجواب : أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال الله عزّ وجل: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً )(المائدة: الآية50) فرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشريعة. بماذا يثبت الزّنا ؟ الجواب: يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابدّ، والشهادة على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قطّ، وهو في وقته. والطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقرّ الزاني بأنه زنا . وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين ما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم: فمن قال لابد من التكرار استدل بقصة ماعز بن مالك رضي الله عنه فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا، فأعرض عنه، ثم عاد فقال: إنه زنا،أربع مرات، فقال له: أَبِكَ جُنُونٌ ؟ فقال: لا، فأرسل إلى قومه . هل عهدتم بماعز جنونا ً ؟ فقالوا: لا، فأمر رجلاً أن يستنكهه، أي يشم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران، فلم يجد فيه شيئاً، ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فَرُجِمَ . والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لابد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار في أول مرة لكونه شاكّاً فيه حتى استثبت. أما الذين قالوا يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنا بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شاباً، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بمائة شاة وجارية، ففعل، فسأل أهل العلم فقالوا: ليس عليك هذا، على ابنك جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجم، فترافعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "الغَنَمُ وَالوَلِيْدَةُ" أي الجارية "رَدٌّ عَلَيْكَ" أي مردودة عليك، لأنها أخذت بغير حق "وَعَلَى ابنِكَ جَلْدُ مَائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ" لأنه لم يتزوج "وَاغْدُ يَا أَنِيْسُ إِلَى امْرَأةِ هَذَا فَإِن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا" فغدا إليها فاعترفت، فرجمها هل يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: "لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ"، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه. وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: "النَّفْسُ بالنَّفسِ" وعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(المائدة: من الآية45) . وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس. وأما التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتِلَ به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى علىنفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه. فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم. "التَّارِكُ لدينِهِ" أي المرتدّ "المُفارقُ للجَمَاعَةِ" المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل . ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتاب، بل بمجرّد أن يثبت كفره فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلوهُ" ولم يذكر استتابة. ومنهم من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبتهم، وبعضهم لاتقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة أيام، أي نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن لم يسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله : "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقتُلُوهُ" ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لاتقبل توبته بأن سب الله، أو سب رسوله، أو سب كتابه، أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لاتقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لاتقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر: هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (الزمر: من الآية53) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "التَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا" وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة. فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب: لا والله لا يكون، بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عافٍ عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟ فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ الجواب: لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت علىحال الحياة،لأننا نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأننا نخشىأن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. والله أعلم. تم بحمدالله ... يتبع إن شاء الله الحديث الخامس عشر (مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرَاً أَو لِيَصْمُتْ،....)
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#25
|
|||
|
|||
|
الحديث الخامس عشر الشرح "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ" هذه جملة شرطية، جوابها: "فَليَقُلْ خَيْرَاً أَو لِيَصْمُتْ "، والمقصود بهذه الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أوالسكوت كأنه قال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو اسكت. والإيمان بالله واليوم الآخر سبق ذكرهما. "فَلَيَقُلْ خَيرَاً" اللام للأمر، والخير نوعان: خير في المقال نفسه، وخير في المراد به. أما الخير في المقال: فأن يذكر الله عزّ وجل ويسبّح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فهذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره: فأن يقول قولاً ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإلفة، لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئاً يكون خيراً بذاته وبقيت صامتاً من حين دخلت إلى أن قمت صار في هذا وحشة وعدم إلفة، لكن تحدث ولو بكلام ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير لغيره. " أو لِيَصْمُتْ" أي يسكت. "وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ" أي جاره في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى جاره في المتجر كجارك في الدكان مثلاً، لكن هو في الأول أظهر أي الجار في البيت، وكلما قرب الجار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإكرام فقال: "فليُكْرِم جَارَهُ" ولم يقل مثلاً بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا، وكل شيء يأتي مطلقاً في الشريعة فإنه يرجع فيه إلى العرف، وفي المنظومة الفقهية: وكلُّ ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد فالإكرام إذاً ليس معيناً بل ما عدّه الناس إكراماً، ويختلف من جار إلى آخر، فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لايكفي هذا في إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر والجار: هل هو الملاصق، أو المشارك في السوق، أو المقابل أو ماذا؟ هذا أيضاً يرجع فيه إلى العرف، لكن قد ورد أن الجار أربعون داراً من كل جانب ،وهذا في الوقت الحاضر صعب جداً. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعون داراً مساحتهم قليلة، لكن في عهدنا أربعون داراً قرية، فإذا قلنا إن الجار أربعون داراً والبيوت قصور صار فيها صعوبة، ولهذا نقول: إن صح الحديث فهو مُنَزَّل على الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف. " وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فَليُكرِمْ ضَيْفَهُ" الضيف هو النازل بك، كرجل مسافر نزل بك، فهذا ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراماً. قال بعض أهل العلم - رحمهم الله -: إنما تجب الضيافة إذا كان في القرى أي المدن الصغيرة، وأما في الأمصار والمدن الكبيرة فلايجب، لأن هذه فيها مطاعم وفنادق يذهب إليها ولكن القرى الصغيرة يحتاج الإنسان إلىمكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث أنه عام: "فَليُكْرِمْ ضَيْفَهُ" . من فوائد هذا الحديث: .1 وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فَليَقُلْ خَيرَاً أو لِيَصمُتْ" هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسام: خير، وشر، ولغو. فالخير: هو المطلوب. والشر: محرم، أي أن يقول الإنسان قولاً شراً سواء كان القول شراً في نفسه أو شراً فيما يترتب عليه. واللغو: ما ليس فيه خير ولاشرّ فلا يحرم أن يقول الإنسان اللغو، ولكن الأفضل أن يسكت عنه. ويقال: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، وكم كلمة ألقت في قلب صاحبها البلاء، والكلمة بيدك ما لم تخرج من لسانك، فإن خرجت من لسانك لم تملكها. وإذا دار الأمر بين أن أسكت أو أتكلم فالمختار السكوت،لأن ذلك أسلم. .2الحث على حفظ اللسان لقوله: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرَاً أَوْ لِيَصْمُتْ" .. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له: أَلا أُخْبِرُكَ بِمِلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟ قَالَ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ، فَأَخذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا ، قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ،وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ - الجملة استفهامية - قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّار عَلَى وُجُوهِهِم، أَو قَالَ: "عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلسِنَتِهِمْ" فاحرص على أن لاتتكلم إلا حيث كان الكلام خيراً، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. .3وجوب إكرام الجار لقوله: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَليُكرِمْ جَارَهُ" وهذا الإكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده. وتارة تكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه. وتارةبأن تهدي إليه الهدايا، فالمسألة راجعة إلى العرف. .4أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره، فإنك ترى أهل الملة الواحدة لايكاد يعرف بعضهم بعضاً، متفرقون، حتى الجار لايدري ماذا يحدث لجاره. .5وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراماً، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور، وتقول: ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لافرق بين الواحد والمائة، لأن كلمة (ضيف) مفرد مضاف فيعم، فإذا نزل بك الضيف فأكرمه بقدر ما تستطيع. لكن إذا كان بيتك ضيقاً ولامكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتاً للضيوف، فهل يكفي أن تقول: يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك، ولكن خذ مثلاً مائة ريال أو مائتين - حسب الحال - تبيت بها في الفندق فهل يكفي هذا أو لايكفي ؟ الجواب: للضرورة يكفي، وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في الإكرام،ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلابأس، فهذا نوع من الإكرام، والله أعلم. تم بحمدالله ... يتبع إن شاء الله الحديث السادس عشر ( أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : أَوصِنِيْ، قَال : لاَ تَغْضَبْ)..
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#26
|
|||
|
|||
|
الحديث السادس عشر الشرح لم يبيَّن هذا الرجل، وهذا يأتي كثيراً في الأحاديث لايبيّن فيها المبهم، وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو وصفه لايُحتاج إليه، فلذلك تجد في الأحاديث: أن رجلاً قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعباً عظيماً في تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لاحاجة للتعب مادام الحكم لايتغير بفلان مع فلان. " قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَوصِنِي" الوصية: هي العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلاً على ثلثه أوعلى ولده الصغير أو ما أشبه ذلك. " قَالَ: لاَتَغْضَبْ" الغضب: بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولذلك يحمرّ وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره. فهل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لاتغضب أي لايقع منك الغضب، أو المعنى: لاتنفذ الغضب ؟ لننظر: أما الأول فإن ضبطه صعب،لأن الناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً، لكن لامانع أن نقول: أراد قوله: "لاَ تَغْضَبْ" أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرّد الأمر على نفسك. وأما المعنى الثاني: وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق، فينهى عنه. إذاً كلمة "لاَ تَغْضَبْ" هل هي نهي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي نهي لما يقتضيه الغضب ؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: "لاَ تَغْضَبْ" أي الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله وجه يمكن أن يحمل عليه بأن يقال: اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لاتغضب. والمعنى الثاني لقوله: لاَ تَغْضَبْ أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلّق امرأته، فنقول له: اصبر وتأنَّ. فَرَدَّدَ الرَّجُلُ مِرَارَاً ، - أَيْ قَالَ: أَوْصِنِي - قَالَ: "لاَ تَغْضَبْ" من فوائد هذا الحديث: .1حرص الصحابة رضي الله عنهم على ماينفع، لقوله: "أَوصِنِيْ" ، والصحابة رضي الله عنهم إذا علموا الحق لايقتصرون على مجرّد العلم، بل يعملون، وكثير من الناس اليوم يسألون عن الحكم فيعلمونه ولكن لايعملون به، أما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم إذا سألوا عن الدواء استعملوا الدواء، فعملوا. .2 أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة، فإذا قررنا هذا لايرد علينا الإشكال الآتي وهو أن يقال: لماذا لم يوصه بتقوى الله عزّ وجل،كما قال الله عزّ وجل: (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ )(النساء: الآية131) فالجواب: أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من هذا الرجل أنه غضوب فأوصاه بذلك. مثال آخر: رجل أتى إليك وقال: أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يصاحب الأشرار، فيصح أن تقول: أوصيك أن لاتصاحب الأشرار، لأن المقام يقتضيه. ورجل آخر جاء يقول: أوصني، وأنت تعرف أن هذا الرجل يسيء العشرة إلى أهله، فتقول له: أحسن العشرة مع أهلك. فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى الله عليه وسلم ، أي أن يوصى الإنسان بما تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا. .3النهي عن الغضب، لقوله: "لاَ تَغْضَبْ" لأن الغضب يحصل فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه، فكم من إنسان غضب فطلّق فجاء يسأل، وكم من إنسان غضب فقال: والله لا أكلم فلاناً فندم وجاء يسأل. فإن قال قائل: إذا وجد سبب الغضب، وغضبَ الإنسان فماذا يصنع؟ نقول: هناك دواء - والحمد لله - لفظي وفعلي . أما الدواء اللفظي: إذا أحس بالغضب فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً قد غضب غضباً شديداً فقال: "إِنِّي أَعلَمُ كَلِمَةً لوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَايَجِد - يعني الغضب - لَوقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ" . وأما الدواء الفعلي: إذا كان قائماً فليجلس، وإذا كان جالساً فليضطّجع،لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير حاله الباطن، فإن لم يفد فليتوضّأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب. وهل يقتصر على هذا؟ الجواب: لايلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، وكثير من الناس يفعل هذا، أي إذا غضب خرج من البيت حتى لايحدث ما يكره فيما بعد . .4أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله: "لاَ تَغضبْ" والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم الأمر بمحاسن الأخلاق، فعوّد نفسك التحمل وعدم الغضب، فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت إليه ويضحك مع أن هذا لو فعله أحد آخر فأقل شيء أن يغضب عليه،فعليك بالحلم ما أمكنك ذلك حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر، والضغط وما أشبهه. والله المستعان تم بحمدالله ... يتبع إن شاء الله الحديث السابع عشر (إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ)
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#27
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#28
|
|||
|
|||
|
عمل طيب أسأل الله أن ينفع به ويتقبل منك واصلي.....
__________________
العلم قال الله قال رسوله §§ قال الصحابة هم أولو العرفان@ |
|
#29
|
|||
|
|||
|
الحديث السابع عشر الشرح " إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانُ عَلَى كُلِّ شَيء" أي في كل شيء، ولم يقل: إلى كل شيء،بل قال: على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصاً بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة. ثم ضرب أمثلة فقال: "فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ" والفرق بينهما: أن المقتول لايحل بالقتل كما لو أراد إنسان أن يقتل كلباً مؤذياً، فنقول: أحسن القتلة. وكذا إذا أراد أن يقتل ثعباناً فنقول: أحسن القتلة، وإذا ذبح فنقول: أحسن الذبحة، وهذا فيما يؤكل، أي يحسن الذبحة بكل ما يكون فيه الإحسان، ولهذا قال: "وَليُحدّ أحدكم شَفْرَته" أي السكين، وحدُّها يعني حكها حتى تكون قوية القطع، أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل بها الذبح بسرعة. " وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ" اللام للأمر، أي وليرح ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة وسرعة . من فوائد هذا الحديث: .1رأفة الله عزّ وجل بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء. ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص تدله الطريق، وكذا إطعام الطعام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من القتل والذبح مجرد أمثلة. .2الحث على الإحسان في كل شيء، لأن الله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعاً مؤكداً. .3أنك إذا قتلت شيئاً يباح قتله فأحسن القتلة، ولنضرب لهذا مثلاً: رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، فله طرق في قتله كأن يقتله بالرصاص، أو برضّ الرأس، أو بإسقائه السم، أو بالصعق بالكهرباء، أنواع كثيرة من القتل، فنقتله بالأسهل، وأسهلها كما قيل: الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لايحس المقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء. يستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يُفعل بالجاني كما فُعِل بالمقتول ، ودليل ذلك قصة اليهودي الذي رضّ رأس الجارية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرَضَّ رأسه بين حجرين . .4أن الله عزّ وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله: "إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ" وكتابة الله تعالى نوعان: كتابة قدرية، وكتابة شرعية. الكتابة القدرية لابد أن تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لاتقع. أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه ا لإحسان لقوله: إِنَّ الله كَتَبَ الإِحسَانَ عَلَى كِلِّ شَيء .6حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرّب المعاني في قوله: إِذَا قَتَلتُمْ.. إِذَا ذَبَحْتُمْ . .7وجوب إحسان القِتلة،لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل. وإحسان القتلة على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل، وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة رجم الزاني الثيّب. .8أن نحسن الذبحة، بأن نذبحها على الوجه المشروع، والذبح لابد فيه من شروط: (1) أهلية الذابح بأن يكون مسلماً أو كتابياً، فإن كان وثنياً لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدّاً لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لاتحل ذبيحته لأنه ليس مسلماً ولا كتابياً. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟ فالجواب: قول الله عزّ وجل: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ)(المائدة: الآية5) قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم: ما ذبحوه، والكتابي: هو اليهودي أو النصراني (2) أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها، وهي: كل ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب، أي شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ومعنى: أَنْهَرَ الدَّمَ أي أساله. فلو أن إنساناً ذبح بحجر له حد وأنهر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان: السن، والظفر، علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظِّفْرُ فَمُدَى الحَبَشَة أي سكاكين الحبشة. قوله: "أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ" أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لاتحلّ الذكاة بها، قالوا: لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول، لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لقال: أما السن فسن، لكن قال: "أَمَّا السِّنُّ فَعَظمٌ" فالعلة أعم، وعلى هذا فجميع العظام لاتحل التذكية بها. (3) إنهار الدم أي إسالته، ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا قطعا انهال الدم بكثرة وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة. والدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فاشترط إنهار الدم". هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء، لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء: الودجان - اثنان - والحلقوم، والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟ فالجواب: قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولاتفرى أوداجها. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعلاها؟ الجواب: لايشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها مما يلي الرأس، أو من أسفلها مما يلي النحر، أو من وسطها. (4) ذكر اسم الله عليها عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَا أَنهرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فإذا كان إنهار الدم شرطاً فكذلك التسمية شرط،بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنه لفِسْقُ)(الأنعام: الآية121) فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمّ فالذبيحة حرام. فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لايسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى محدثاً ناسياً فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال: (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)[الأنعام:121] وأطلق بالنسبة للذابح. فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهواً أو نسياناً أو عمداً فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )(البقرة: الآية286) فقال الله: قد فعلت؟ نقول: نحن لانؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي، ونقول: ليس عليه إثم، لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فيقال له: لم يذكر اسم الله عليها، إذاً لا يأكل، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه. ومن فوائد هذا الحديث: 1. -وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنىإحدادها: أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإن ذبح بشفرةكالّة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة. وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟ الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم ،أي تغطى. ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحياناً إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفاً من الذبح وعجزوا عنها. .2وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، فلا يبقى هكذا يحرحر بل بسرعة لأنه أريح لها. ويبقى النظر: هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة، أو نمسك بها؟ فالجواب: نجعلها مطلقة ونضع الرِّجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغاً للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها. فهذا تعذيب لها. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، وهذا أشد، فنقول: ضع رجلك على صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟ فالجواب: لايجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاماً شديداً لها، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا الإيلام، بل ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء. .3إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله، أو ولده فليؤدب بإحسان؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدَاً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرِّحٍ فنقول:حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولاتؤدّب بعنف. وبعض الناس يؤدّب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، بل اضرب ضرباً لاتسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضرباً أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدّبه تأديباً عادياً بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم. تم بحمدالله ... يتبع فى إن شاء الله الحديث الثامن عشر ((اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)..
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
|
#30
|
|||
|
|||
|
الحديث الثامن عشر الشرح قوله: "اتَّقِ اللهَ" أي اتخذ وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. " حَيْثُمَا كُنْتَ" حيث: ظرف مكان، أي في أي مكان كنت سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس. " وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا" (أتبع) فعل أمر، و (السيئة) مفعول أول، و(الحسنة) مفعول ثان. " تَمْحُهَا" جواب الأمر، ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون مجزوماً، ولو لم تكن مجزومة لقيل: تمحوها. والمعنى: إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة،فهذه الحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء - رحمهم الله - هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة، فكأنه قال: إذا أسأت فتب، أو المراد العموم؟ الصواب: الثاني، أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة، دليل هذا قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات)(هود: الآية114)ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال: إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معهم الفجر، فقال: أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم، فتلا عليه الآية:( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات ) [هود:114] وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هي التوبة. " وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا" فبين النتيجة هي أنها تمحوها. " وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ" أي عامل الناس بخلق حسن. والخُلُق: هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخَلْقُ: هو الصفة الظاهرة،والمعنى: عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم: الخلق الحسن: كف الأذى، وبذل الندى، والصبر على الأذى - أي على أذى الغير - والوجه الطلق. كف الأذى منك للناس. بذل الندى أي العطاء. الصبر على الأذى لأن الإنسان لايخلو من أذية من الناس. الوجه الطلق: طلاقة الوجه. وضابط ذلك ما ذكره الله عزّ وجل في قوله: (خُذِ الْعَفْوَ ) [الأعراف:199] أي خذ ما عفا وسهل من الناس، ولاترد من الناس أن يأتوك علىما تحب لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر(وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) [الأعراف:199] وهل الخلق الحسن جِبْلِيٌّ أو يحصل بالكسب؟ الجواب: بعضه جبلي، وبعضه يحصل بالكسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجّ عبد قيس: "إِنَّ فِيْكَ لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ" قال: يارسول الله أخلقين تخلّقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: "بَلْ جَبَلَكَ اللهُ عَلَيْهِمَا" قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالخلق الحسن يكون طبيعياً بمعنى أن الإنسان يمنّ الله عليه من الأصل بخلق حسن. ويكون بالكسب بمعنى أن الإنسان يمرّن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجيب أن الخلق الحسن يُكسِب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. من فوائد هذا الحديث: .1وجوب تقوى الله عزّ وجل حيثما كان الإنسان، لقوله: "اتَّقِ الله حَيْثُمَا كُنْتَ" وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر. وأيهما أفضل: أن يكون في السر أو في العلانية؟ وفي هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسّي والاتباع لما أنت عليه فهنا إعلانها أحسن وأفضل، ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرّاً وعلانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَومِ القِيَامَةِ" أما إذا كان لايحصل بالإظهار فائدة فالإسرار أفضل،لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يظلّهم الله في ظله: "رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ". وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إسراره؟ يقال فيه ما قيل في الأوامر، فمثلاً إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له:إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهاراً، فذلك أفضل لأنه يُتأسّى به، وأما إذا كان الأمر لايتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإسرار أفضل. فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم : "اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ" هل يشمل فعل الأوامر في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلاً؟ الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوِ بقلبك أنك مطيع لله عزّ وجل ممتثل لأمره مجتنب لنهيه. .2أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله: أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا. .3 فضل الله عزّ وجل على العباد وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لاتمحو السيئة إلا بالموازنة، وظاهر الحديث العموم. وهل يُشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ فالجواب: ظاهر الحديث: لا، وأن مجرد فعل الحسنات يذهب السيئات، وهذا من نعمة الله عزّ وجل على العباد ومن مقتضى كون رحمته سبقت غضبه. .4-الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لقوله: "وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ". فإن قيل: معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحياناً هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب: لا ينافيه، لأنه لكل مقام مقال، فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ" ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق ومن ذلك: مرّ يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك يامحمد - والسام يعني الموت - فقالت عائشة رضي الله عنها : عليك السام واللعنة - جزاءً وفاقاً وزيادة أيضاً - فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ وَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكَتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ" . والله الموفّق تم بحمد الله ... يتبع إن شاء الله الحديث التاسع عشر (يَا غُلاَمُ إِنّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحفَظك،)
__________________
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله :تالله ما عَدَا عليك العدوُّ إلا بعد أن تَوَلَّى عنك الوَلِيُّ، فلا تظنّ أن الشيطان غَلَبَ ولكن الحافظ أَعْرَض .
|
 |
|
|
 |
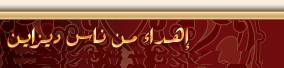 |