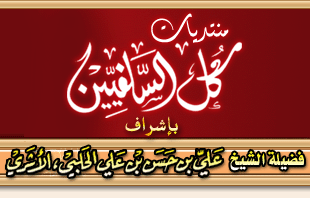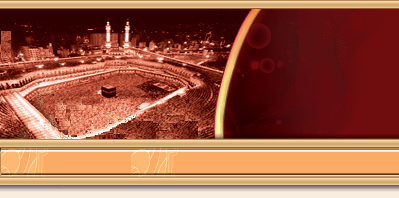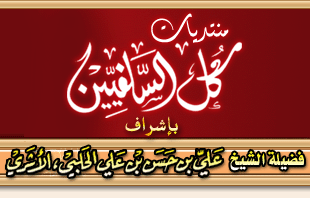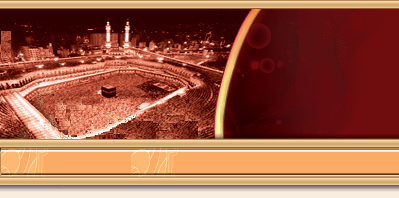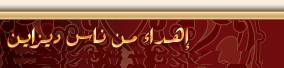بسم الله الرحمن الرحيم
حُكمُ ما يُسمَّى بالأناشيدِ الإسلاميَّة (!!)
[الشَّريط العاشر ضِمن سلسلةِ أشرطةٍ في (حُكم الغِناء)*]
لفَضيلةِ الشَّيخِ عبدِ المالِك رَمضاني
-حَفظهُ اللهُ-
موضوعنا العاشِر: هو موضوع (الأناشيد) التي تُسمَّى بـ(الإسلامية!!).
يعني: هذه القصائد التي يُمدح اللهُ ورسولُه -صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم-؛ هل هي جائزةٌ أم لا؟
أولًا: ينبغي تقسيمُ هذا الموضوعِ إلى قسمَين:
* إما أن تكونَ هذه الأناشيدُ عادةً.
* وإمَّا أن تكونَ عبادة.
فإذا كانت الأناشيدُ عادةً مِن العاداتِ؛ فالأصلُ في العاداتِ الإباحةُ إلا لنصٍّ؛ لقولِ الله -عزَّ وجلَّ-: {وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ}؛ يعني: كلُّ ما يقومُ به الإنسانُ مِن عاداتٍ؛ فهو جائز، فالعاداتُ -شرعًا- جائزة؛ إلا إذا كان لدينا نصٌّ -مِن آيةٍ قرآنية، أو حديثٍ نبويٍّ صحيح يحرِّم هذه العادة-؛ فهي جائزةٌ حينذاك.
إذًا: فالشيءُ الذي لا يُتقرَّب به الإنسانُ إلى ربِّه؛ يُسمَّى (عادةً)، والشَّيءُ الذي يُتقرَّب به الإنسانُ إلى ربِّه -عزَّ وجلَّ- يُسمَّى (عبادةً).
مِن هُنا: ينبغي أن نعرفَ -ها هُنا- أمرَين:
* الأوَّلُ: أنَّ النَّشيدَ غناء؛ لأنَّ الغناء: كل كلامٍ مُطرَّبٍ فيه، ولو لم تَصحبْه آلةٌ موسيقيَّة، كما أشار إليه الأصمعيُّ، وابنُ منظور، وابنُ الأثير، وإليهِ أشارَ القُرطبيُّ، ووافقه على ذلك ابنُ حجرٍ، وكذا ابنُ الجوزي، وأبو موسى ابنُ المديني -عليهم رحمةُ الله جميعًا-.
وذلك في حديث ورد: لقد سمعَ النَّبيُّ -صلَّى الله عليهِ وآلِه وسلَّم- أبا موسَى الأشعريَّ -رضيَ الله-تَعالَى-عنهُ- يقرأُ القرآنَ بصوتٍ رائعٍ مُؤثِّرٍ، فقال له: «لقد أوتيتَ مزمارًا مِن مزاميرِ آلِ داود»، فأبو موسى -رضيَ اللهُ-تَعالَى-عنهُ-لا شك أنَّه لم يستعمل مع القُرآن الكريمِ آلةً موسيقيَّة، مع ذلك: فقد سمَّى النبيُّ -صلَّى الله عليهِ وآلِه وسلَّم- تلاوتَه للقُرآنِ الكريمِ مزمارًا؛ فهذا يدلُّ -من جهةِ الشَّرع- أنَّ الغناءَ إذا كان خاليًا مِن آلةٍ موسيقيَّة يُسمَّى (مِزمارًا).
والآياتُ التي حَرَّمت الغناءَ، والأحاديثُ التي حرَّمتِ الغناء لم تُفصِّل بين غِناءٍ صِحِبتْه آلةٌ موسيقيَّة، وبين غناءٍ خلا مِن آلةٍ موسيقيَّة، و(تركُ الاستفصال في حِكايةِ الحال مع قيامِ الاحتِمال؛ ينزل منزلةَ العُمومِ في المقال)؛ أي أنَّ الغناء -بقسمَيه-سواء كان مصحوبًا بآلةٍ موسيقيَّة، أو بغيرِ آلة- يُعتبر ممنوعًا لوُرودِ الأدلَّة عامَّة، بل وَردت مُجملةً كما وردتْ مفصلة.
* الأمرُ الثَّاني: أنَّ الآياتِ والأحاديثَ التي منعتِ الغناء لم تُفرِّق بين غناءِ عادةٍ وغناءِ عبادةٍ؛ بل حرَّمتهُما جميعًا؛ كما في سورة لقمان؛ حيث جعل الله -عزَّ وجلَّ- مجرد التَّطريبِ بالكلامِ، وتلحين الغناءِ باللِّسان -فقط- غناءً ممنوعًا، وهذا هو السِّرُّ في قولِ الله -عزَّ وجلَّ-: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} فقال: {لَهْوَ الْحَدِيثِ} ولم يُسمِّه بغير هذه التَّسمية؛ إشارةً إلى أنَّ الحديثَ أو الكلامَ إذا كان يلهُو بهِ صاحبُه على طريقةِ أهلِ الغِناءِ والألحان؛ فإنَّما هو المحرَّم شَرعًا، وهذا مِن بلاغةِ القُرآن الكريم؛ حيث ترِدُ فيه لفظةٌ واحدة تحمل مَعنَيَين جميعًا، أو معانٍ كثيرة، كما في هذه الآية الكريمة.
إذًا من خلالِ هذا الكلام: يُستخلصُ أن الغناءَ -بقسمَيه- ممنوعٌ -أصلًا-؛ فالأصل في الغناء: المنع.
يعني: أن القاعدةَ التي تقولُ: (الأصلُ في العاداتِ الإباحة إلا لِنصٍّ)؛ هذه مَنقوضة بالنَّص؛ إذْ عندنا النُّصوص التي تحرِّم الغناء ولم تَنصَّ على عادةٍ أو عبادة؛ أي: لم تُفرِّق بين العادةِ والعبادة.
فنقول:
إذًا: الغِناء بِقسمَيه ممنوع... ومَن قال: (إذا كان الغناءُ عادةً فهو جائز)؛ فعَلَيه بالدَّليل؛ إذ نحنُ باقون على الأصل، وهو خارجٌ عن الأصل، ومَن خرج عن الأصل؛ فعليه أن يأتيَ بالمرجِّحِ الذي جعله يَخرج عنه.
بل إنَّ لدينا أدلةً خاصَّة في الموضوع.
لَدينا أدلةٌ تمنعُ الغناءَ إذا كان عادةً كما تَمنعُه إذا كان عبادةً.
يتبع إن شاء الله
______________
* سلسلة طيِّبة مُباركة، عظيمة النفع، كنتُ قد أنزلتُها على الجهاز -قديمًا-؛ لتفريغِها -بناءً على طلب بعض المشرفين-، لكني استصعبتُ الأمر؛ بسبب اللهجة الجزائريَّة -في بعض الجُمل-! فتوقفتُ!
والآن بدأتُ في تفريغ آخِر حلقةٍ من هذه السِّلسلة النافعة؛ لأهميَّة مادتِها، وعِظم البلاءِ بِما يُسمَّى -زورًا- (أناشيد إسلاميَّة)! وأسأل الله التيسير وأن ينفعَ بها.