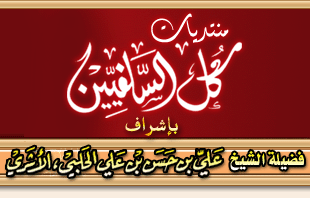

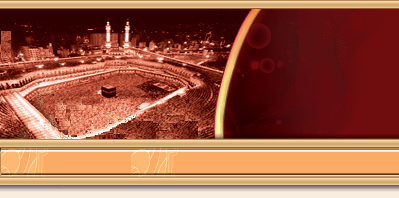
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
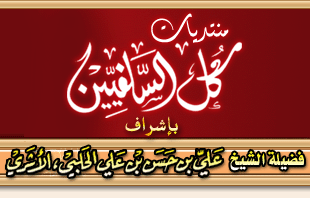 |
 |
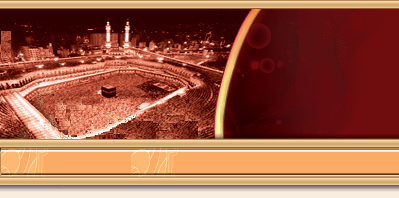 |
|||||
|
|||||||
| 70715 | 73758 |
|
#21
|
|||
|
|||
|
ما حقيقة الخلاف بينكم وبين الشيخ ربيع اهو في المنهج العقدي أم في المنهج الحديثي؟
ج/ الخلاف بيني وبينه خلاف في فهم نصوص النقاد ومنهجهم في التصحيح والتضعيف، ولا أقول إنه خلاف علمي لأن الشيخ لا يتكلم منهجيا، وإنما على أساس تصوره الخاص الذي يختلف باختلاف المخاطب، كان يفهم كلام النقاد فهما سطحيا، ويتهم من يفهم خلاف فهمه باطنيا صوفيا يقدس الأشخاص، وقد نشأ هذا الخلاف وبلغ أشده حين ذكرته بأخطائه الفادحة في فهم نصوص النقاد ومنهجهم في التصحيح والتعليل، والغريب أن الرجل لا يعرفني، ولم يرني ولم يسمع صوتي، وأنا أيضا لم ألتق به ولم أسمع صوته حتى هذا اليوم، فإذا به أعلم الناس بي وأكثرهم اطلاعا على ما في نفسي؟ والشيء الوحيد الذي أدى إلى إشعال غضبه في أعصابه هو تنبيهي بأخطائه الفادحة في رسالته الماجستير المطبوعة. وليس الخلاف بيني وبينه خلاف عقدي أيضا لأني لم أتطرق أثناء ذلك النقاش لشيء من ذلك ، لكن الرجل سعى سعيه لتحقيق غرض في نفسه. (يغفر الله لي وله ) .(منقول) |
|
#22
|
|||
|
|||
|
قد اقتنيت قبل مدّة رسالة علميّة بعنوان : دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج الدال أن التحلل بالجمرات مشروط بطواف الإفاضة يوم النحر .
تقديم : الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي -و- فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد . تأليف : محمد بن سعيد بن عبد الله الكثيري . الطبعة الأولى :1423.هكذا جاء في غلاف الرسالة (بحرفه). و قد جاء في مقدمة عبد الله السعد ما يلي : هذا و قد اطلعت على ما كتبه الأخ الشيخ / محمد بن سعيد الكثيري في مؤلفه الموسوم بــ:( دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحجّ) فألفيته كتابا نفيسا في بابه ، فريدا في معناه ، كثير الفوائد ، و قد أحسن -وفقه الله تعالى-في تطبيق القواعد الحديثية سالكا طريقة الحفاظ المتقدمين ، و الأئمة السابقين ، في الحكم على الأحاديث و نقدها ....صفحة :11. و قال صاحب الرسالة في مقدمته : فهذا جزء لطيف تكلمت فيه على :حديث أم سلمة في الحج ، الذي قال فيه غير واحد من أهل العلم : [ لا أعلم أحدا قال به ] مع حكم بعضهم على إسناده بالصحة أو الجودة ، و تبعهم على ذلك بعض أفاضل علماء العصر-أي من سبقه لم يكن معاصرا و كان متأخرا على كل حال!!-ممن نظر لظاهر الإسناد ، فصححه ، حتى قال :( فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و كان صريح الدلالة كهذا ، و جبت المبادرة إلى العمل به ، و لا يتوقف ذلك على معرفة موقف أهل العلم منه...)مما أثار الخلاف في صحة الحديث و العمل به بين أهل العلم و طلابه ...صفحة :79.(و معلوم لمن هذه الكلمات!) فالشيئ الذي أثار الخلاف هو ما بينه هنا في مقطعه الأخير !!!. فالتفريق بين منهج المتأخرين و المتقدمين في التصحيح و التضعيف ظاهر ، و الشيخ مقبل رحمه قال بأنه قرأ الكتاب كما قال في المقدمة : فقد اطلعت على رسالة ( حديث أم سلمة في الحج ) للأخ الفاضل /محمد بن سعيد الكثيري ، فألفيتها رسالة قيمة ، جمع طرق الحديث ، و بين ضعفه و علته ، و شذوذ متنها ...صفحة :5. إلا أن يكون الشيخ مقبل قد اطلع على الرسالة قبل أن تكون على الحال الذي طُبعت عليه ، فكانت عبارة عن جمع للطرق و نقل كلام الائمة و غيرها مما لم يوضح من خلاله طريقة انتهاجه أو نهجه الحديثي الذي صرّح به الشيخ عبد الله السّعد -حفظه الله و سدده-فالله أعلم بكلّ ذلك . |
|
#23
|
|||
|
|||
|
هل هناك فرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها مع التفصيل إن كان هناك تفصيل؟
نص الإجابة-من موقع الشيخ مقبل رحمه الله -: نعم يوجد فرق، فالمتقدمون أحدهم يعرف المحدث وما روى عن شيخه وما روى عنه طلبته ويحفظون كتاب فلان، فإذا حدث بحديث يقولون: هذا ليس من حديث فلان. وأنا أعجب من شدة انتقادهم ومعرفتهم، ففي ترجمة عبدالله بن دينار في «الضعفاء» للعقيلي، ذكر العقيلي كم روى واحد من الأئمة عن عبدالله بن دينار، مثل شعبة، ومالك، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وكذا الاختلاف بين الإمام أحمد، وعلي بن المديني في شأن أيهما أعلم مالك أم سفيان بن عيينة بالزهري، فالإمام أحمد يقول: روى ابن عيينة كذا وكذا من الأحاديث ووهم في كذا وكذا، ويقول: روى مالك أحاديث أكثر من ابن عيينة، وأوهامه أقل من ابن عيينة. فهم لا يماثهم أحد، والمعاصرون لا يعدو أحدهم أن يكون باحثا أما كتب «العلل» فالمعاصرون لا يتحرون في هذا، وكذلك زيادة الثقة، والشاذ، فربما يغتر أحدهم بظاهر السند ويحكم على الحديث بظاهر السند، وقد سبقه المتقدمون وحكموا عليه بأنه حديث معل. فينبغي أن تعرض كتب المتأخرين على كتب «العلل» حتى تعرف أخطاؤهم فإن لهم أخطاء كثيرة بالنسبة إلى العلماء المتقدمين، ولا يقال: كم ترك الأول للآخر، في علم الحديث. أروني شخصا يحفظ مثل ما يحفظ البخاري، أو أحمد بن حنبل، أو تكون له معرفة بعلم الرجال مثل يحيى بن معين، أو له معرفة بالعلل مثل علي بن المديني، والدارقطني، بل مثل معشار الواحد من هؤلاء، ففرق كبير بين المتقدمين والمتأخرين. ------------- راجع كتاب : " تحفة المجيب ص 97 - 98 " س/ إن كان الأئمـه قد ضَعّفوا حديثاً بعينه ثم جاء المتأخرون فصححوه ، وقد ذكر الأئمة في السابق أن له طريق بعضها ضعيفه وبعضها كذا إلا أن الرجل المتأ خر رد هذه العلة ، مرة يرد هذه العلة ومرة يقول: أنا بحثت عن الحديث فوجدت له سنداً لم يطلع عليه الحفاظ الأولون ، فماذا تقول ؟ ج / سؤال حسن ومهم جداً ـ جزاكم الله خيرا ـ . والعلماء المتقدمون مُقَدَّمون فى هذا ، لأنهم ـ كما قلنا ـ قد عرفوا هذه الطرق . ومن الأمثلة على هذا : ما جاء أن الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ يقول في حديث المسح على الوجه بعد الدعاء أنه بمجموع طرقة حسن ، والأمام أحمد يقول: أنه حديث لا يثبت . وهكذا إذا حصل من الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ هذا نحن نأخذ بقول المتقدمين ، ونتوقف في كلام الشيخ ناصر الدين الألباني ، فهناك كتب ما وضعت للتصحيح والتوضعيف ، وضعت لبيان أحوال الرجال ، مثل : ((الكامل)) لابن عدي ((والضعفاء)) للعقيلي ، هم وإن تعرضوا للتضعيف فى هذا فهى موضوعة لبيان أحوال الرجال وليست بكتب علل ، فنحن الذى تطمئن إليه نفوسنا أننا نأخذ بكلام المتقدمين ، لأن الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ ما بلغ فى الحديث مبلغ الإمام أحمد بن حنبل ، ولا مبلغ البخاري ومن جرى مجراهما . ونحن مانظن أن المتأخرين يعثرون على ما لم يعثر عليه المتقدمون ، اللهم إلافى النادر . القصد أن هذا الحديث إذا ضعفه العلماء المتقدمون الذين هم حفاظ ويعرفون كم لكل حديث طريق ، أحسن واحد فى هذا الزمن هو الشيخ ناصر الدين الألباني ـ حفظه الله تعالى ـ وهو يعتبر باحثا ولا يعتبر حافظا ، وقد أعطاه الله من البصيرة فى هذا الزمن مالم يعط غيره ، حسبه أن يكون الوحيد فى هذا المجال ، لكن ما بلغ مبلغ المتقدمين . س / إذا قال أحد من أئمة الحديث : إن الحديث معلول. فهل لا بد من أن يبين السبب ويظهره لنا كطلبة علم، أو لا يقبل منه هذا القول، أو يقبل منه من غير بيان ؟ الجواب: أنا وأنت في هذا الأمر ننظر إلى القائل ، فإذا قاله أبوحاتم ، أو أبوزرعة ، أو البخاري ، أو أحمد بن حنبل ، أو علي بن المديني ، ومن جرى مجراهم ، نقبل منه هذا القول . وقد قال أبوزرعة كما في ((علوم الحديث للحاكم)) ص (113) عند جاء إليه رجل وقال: ما الحجة في تعليلكم الحديث ؟ قال : الحجة ـ إذا أردت أن تعرف صدقنا من عدمه ، أنحن نقول بتثبت أم نقول بمجرد الظن والتخمين ؟ ـ أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته ، ثم تقصد ابن وارة ـ يعني محمد بن مسلم بن وارة ـ وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله ، ثم تميز كلام كل منا على ذلك الحديث ، فإن وجدت بيننا خلاف فاعلم أن كلاً منا تكلم على مراده ، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم . ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليه فقال أشهد أن هذا العلم إلهام . وقد قال عبدالرحمن بن مهدي كما في ((العلل)) لابن أبي حاتم (ج1 ص10) : إن كلامنا في هذا الفن يعتبر كهانة عند الجهال. وإذا صدر من حافظ من المتأخرين ، حتى من الحافظ ابن حجر ففي النفس شيء ، لكننا لا نستطيع أن نخطّئه ، وقد مرّ بي حديث في ((بلوغ المرام)) قال الحافظ : إنه معلول. ونظرت في كلام المتقدمين ، فما وجدت كلامًا في تصحيح الحديث ولا تضعيفه ، ولا وجدت علةً ، فتوقفت فيه. ففهمنا من هذا ، أنه إذا قاله العلماء المتقدمون ولم يختلفوا، أخذنا به عن طيبة نفس واقتناع ، وإذا قاله حافظ من معاصري الحافظ ابن حجر نتوقف فيه . ما صواب هَذِهِ المقولة: إن تضعيف المتأخرين فضلا عن المعاصرين أحاديث لا يؤخذ به حين يعارض تصحيح أو تحسين المتقدمين، وذلك أن المتقدِّمين اطَّلعوا على شواهد ومتابعات بها حسَّنوا وصحَّحوا، وذلك ما لم يطَّلع عليه المتأخِّرون بسبب ضياعها وفقدانها في كثير من كتب الحديث الضَّائعة؟! وهل هَذِهِ المقولة تعتبر حجَّة في البحث العلمي لردِّ ما يحقِّقه المتأخرون والمعاصرون ؟ جواب: الطَّريقة السليمة هي أن ينظر الشَّخص إلى ما قاله المتقدِّمون في الحديث، ثم ينظر في السَّند، فالعلماء المتقدِّمون ربما يتتابعون على تصحيح حديث، وفيه راو لم يوثقه إلا ابن حِبَّان، ويتتابع المتأخر بعد المتقدِّم؛ وهكذا. وربَّما يغترُّ العصري بظاهر السَّند، والعلماء المتقدِّمون قد اطَّلعوا له على عِلَّة، فربما يكون الحديث من رواية معمر عن الزُّهري عن أنس، فماذا بعد هَذَا الإسناد؟! ثمَّ يكون معلًّا !، والجمع بين هَذَا وهذا هو الأولى. والمتأخرون ليسوا بشيء بالنِّسبة إلى المتقدِّمين المتقدِّمون كالإمام البخاري، والإمام أحمد، ومسلم بن الحجَّاج، وأبي حاتم، وأبي زُرعة، ويحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، والسفيانين، والإمام النَّسائي، وأبي داود والتِّرمذيِّ، هؤلاء كتبهم فيها الخير والبركة، وكتبهم أيضا سهلة وليست بمعقَّدة، فأنا أنصح بقراءتها والاستفادة منها. إنَّ العلماء المتقدِّمين ربما يحفظون ما رواه المحدِّث، وما رواه عن كل شيخ من مشايخه، وما رواه كل تلميذ من تلاميذ الزُّهري، فلو أن شخصا كذب على الزُّهري، أو كذب على تلميذ من تلاميذ الزُّهري استطاعوا أن يعلموا أن هَذَا الحديث مكذوب، وأنَّه ليس من حديث الزُّهري، فهذا مجرَّد مثال، وإلا فغير الزُّهري مثله. ففي زماننا هَذَا: من يحفظ نحو عشرين ألف حديث ؟! لأنه قد وجد مثل أخينا في الله عبد الله الدويش وبعض الإخوان يحفظ خيرا كثيرا والإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح، ولو حفظ العصري فليست له بصيرة في العلل كأولائك، فكأنه إلهام من الله تعالى، وحفظ الله بهم الدين، كما قال سبحانه {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} لكن ليس هناك دليل على أنه لا يجوز للعصري أن يصحِّح أو يضعِّف، بل الدَّليل قائم على جواز ذلك. ففي الصَّحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة، والمعنى متقارب أن النبي صلَّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وَسَلَّم قال (( لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا خَذّلّهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ )) بقي ما لو اختلف عصري وإمام من أئمة الحديث اختلف الشَّيخ الألباني والإمام أحمد، فنحن نأخذ بقول الإمام أحمد بطيبة نفس وهكذا إذا اختلف أي محدِّث غير الشَّيخ الألباني مع الإمام البخاري، فنأخذ قول البخاري يطيبة نفس وهؤلاء المحدِّثون المعاصرون لا يتجاوز أحدهم أن يكون باحثا، أمَّا المحدِّثون المتقدِّمون فعندهم بصيرة بالمتن، وعندهم بصيرة بالإسناد، وعندهم بصيرة بما يخالف الكتاب، وبما يخالف التَّاريخ، فبعض الأوقات يطعنون في الحديث لأنَّه يخالف التَّاريخ. فالفرق بين المتأخرين والمتقدِّمين كما بين السَّماء والأرض أمَّا أن يقال: لا يقبل من المتأخرين تصحيح ولا تضعيف فلا، فإنَّ هَذَا مخالف للسُّنَّة كما تقدَّم وقد أنكر العلماء على ابن الصَّلاح حيث قال: إنه قد انقطع زمن التَّصحيح والتَّضعيف. وذكر الشَّيخ الألباني أنَّه صحَّحَ حديثا. فإذا توفَّرت الشُّروط، ولم يكن الشَّخص صاحب هوى، يصحِّح ما يوافق هواه، ويُضعِّف ما يوافق هواه مثل: محمد عبده المصري، وجما الدين الأفغاني، ومحمد رشيد رضا، وشلتوت، ومحمد الغزالي، ومفتي الأزهر، ومفتي مصر، ومفتي الجمهوريَّة اليمينيَّة، فتنبَّه من أصحاب الأهواء. فلا يأتي شيعي ويقول: حديث (( أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرق وهوى ))، ويقول لك: هو صحيح، أو حديث (( علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر )) أو يأتي صوفي ويقول (( ما وسعتني أرضي ولا سمائي، ووسعني قلب عبدي المؤمن )) وهكذا فكن على حذر من أصحاب الأهواء، سواء كانوا من المتقدِّمين أم من المتأخرين. اهـ غارة الأشرطة (1/175-177) و قال الشيخ مقبل رحمه الله في "غارة الفصل": نصيحتي للمعاصرين أن يكثروا من القراءة في تراجم علماء الحديث مثل الإمام مالك ، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، والبخاري ، وأبي حاتم ، وأبي زرعة ، ومسلم بن الحجاج ، والعقيلي ، وابن عدي ، وابن حبان ، و الدارقطني ، والحاكم ، و الخطيب ، وابن عبد البر رحمهم الله، حتى يعرف العصري قدره ، ويترك الجرأة على أولئك الأئمة . حقًا لقد وجدنا من كثير من العصريين الاستخفاف بأولئك الأئمة ، -فهذا يتعجب منهم كيف ضعفوا الحديث وهو بمجموع طرقه في نظره صالح للحجية ... -وذاك يتعجب منهم كيف أعلوا حديثًا ظاهره الصحة ... -وذاك يوهم الذهبي والعراقي وغيرهما من أئمة الحديث حيث قالوا : إنَّ ( سكتوا عنه ) عند البخاري بمعنى متروك ، ويريد أن يجمع بين أقوال أهل العلم في الراوي وهذا إنما يكون إذا كان الجرح غير مفسر ، مثلاً : قال أحمد بن حنبل : ضعيف وقال يحيى بن معين : ثقة ، فالحافظ في " التقريب " يجمع بين قوليهما ويقول : صدوق يهم ، أو صدوق يخطئ أو نحو ذلك ، أما أن يقول يحيى بن معين : كذاب ،ويقول أحمد ثقة ، فالجرح ها هنا مفسر نأخذ بالجرح ؛ لأن يحيى علم ما لم يعلم أحمدبن حنبل ، وهكذا إذا قال البخاري : سكتوا عنه ، وقال أبو حاتم : ثقة أو صدوق ، فقد علم بالاستقراء وبالمقابلة بين عبارات البخاري في " تواريخه " أنَّ : سكتوا عنه بمعنى متروك ، فنأخذ بقول البخاري ، ونقول : علم من حال الراوي ما لم يعلمه أبوحاتم . وأنا أعجب لمن يتعقب الدارقطني ويقول : قلت : أخطأ الدارقطني . الدارقطني الذي لقب بلقب أمير المؤمنين ، وقال فيه الحافظ الذهبي : وأنت إذا قرأت كتابه "العلل" تندهش ، ويطول تعجبك . وصاحبنا العصري مجرد باحث يتطاول على الدارقطني وغيره من أئمة الحديث . نعم إذا اختلف أئمة الحديث في الراوي أو في صحة الحديث وضعفه ، فلك أن تنظر إلى القواعد الحديثية وترجح ما تراه صوابًا إذا كانت لديك أهلية وإلا توقفت . أنا لا أقول : إن أئمة الحديث رحمهم الله معصومون ، فإنك إذا قرأت في كتب العلل تجد أوهامًا لشعبة وسفيان الثوري وغيرهما من أئمة الحديث ، ولكن هذه الأوهام ينبه عليها من بعدهم ، وليس لدى المحدثين رحمهم الله محاباة ، وأنا لا أدعوك إلى تقليدهم فإن التقليد حرام، وليس اتباعك للمحدثين من باب التقليد ؛ بل من باب قبول خبر الثقةكما قال تعالى : ( يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) [ الحجرات :6] كما في " إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد " للصنعاني رحمه الله . فإن قلت : فأنت قد وقعت فيما تحذّر منه في كتابك " الصحيح المسند من أسباب النزول " ؟ قلت : صدقت ، ولكني بعد أن عرفت قدر نفسي رجعت كما في الطبعة الأخيرة ، وكذا وقعت في تصحيح حديث قتيبة بن سعيد في " الجمع بين الصلاتين في السفر " وإذا أعدنا طبعه إن شاء الله سنتراجع ولا نجرؤ أن نخالف أئمتنا أئمة الحديث في شيء نسأل الله أن يرزقنا حبهم واحترامهم ومعرفة منزلتهم الرفيعة . آمين . هذه النصوص منقولة من أحد المنتديات . |
|
#24
|
|||
|
|||
|
علوم الحديث بين المتقدمين والمتأخرين ورقة مقدمة للمؤتمر التخصصي الأول لقسم التفسير والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة الكويت من الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم، وبعد: المقصود بعلوم الحديث أنواع المصطلحات والقواعد التي تعارف المحدثون عليها في تناول الحديث الشريف ومصنفاته تعلماً وتعليماً ورواية ودراية. والمتقدمون والمتأخرون من حيث المعنى اللغوي العام المتقدم: هو من يسبق غيره حسياً أو معنوياً، والمتأخر من يسبقه غيره حسياً أو معنوياً، وقد جاء الأمران في القرآن الكريم كما في سورة المدثر، قال تعالى: (نذيراً للبشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر)، وفي سورة الحجر قال تعالى: (ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون)، وقال أيضاً في السورة نفسها: (ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين). وبهذين المعنيين للفظي المتقدمين والمتأخرين وقع استعمالهما في مؤلفات علوم الحديث حتى ممن أطلق عليهم اسم المتقدمين أنفسهم في وصف من يكون أقدم منهم، كما سيأتي ذكر مثال لذلك. لكن لما بدأ الأخوة المعاصرون في إطلاق هذين اللفظين مضافين إلى الآراء أو المناهج مثل قولهم: رأيُ المتقدمين أو منهج المتقدمين كذا، أو آراء المتأخرين أو مناهج المتأخرين أو عند المتقدمين أو استعمالهم أو صنيعهم أو اصطلاحهم، أو عند المتأخرين أو صنعيهم أو استعمالهم، لوحظ في استعمالاتهم هذه اختلاف، فبعضهم تولى من نفسه بيان مراده بهذا لكي يرتب عليه ما يريد تقريره من آراء، أو انتقادات أو اقتراحات، وبعضهم طُلب منه بيان مراده بهذين اللفظين مع ما قرنهما به من عبارات أخرى كالآراء أو المناهج أو المصطلحات. والذي وقت عليه مكتوباً كالتالي: 1- الأخ الفاضل الدكتور/ إبراهيم اللاحم - بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم. ذكر ما يفيد أن المتقدمين هم: نقاد السنة في عصور الرواية وأنها عبارة عن القرون الثلاثة الأولى. وأن المتأخرين هم: نقاد السنة ممن بعد أهل القرون الثلاثة الأولى إلى وقتنا الحاضر. 2- الدكتور/ بشار معروف - وهو معروف لدى الجميع، وتحقيقاته ومؤلفاته الحديثية. قال: أنا أقصد بالمتقدمين: علماء القرن الثالث الهجري مثل أصحاب الكتب الستة.. وربما وضعت معهم من العلماء الذين ختم بهم العلم كالدارقطني (385هـ) (ص: 11). ثم قال هل يعقل أن هؤلاء الأئمة يفوتهم ...، ثم يأتي الحكم بعد مائة سنة فيخرجه في مستدركه؟ ما معنى هذا؟ يعني أن الحاكم ذهب يبحث في الأحاديث التي تركوها، وهم إنما تركوها عن علم. ثم يضيف (ص: 13) هذه النظرية لا يقرني عليها كثير من العلماء. ثم يقول: المتأخرون: الحاكم (405هـ) ومن بعده. 3- الشيخ الشريف حاتم بن عون العبدلي: في كتابه المنهج المقترح لفهم المصطلح - فيذكر تحديد الذهبي للحد الفاصل بين المتقدمين برأس القرن 3هـ ويعقب عليه بأن هذا اصطلاح منه خاص بكتابه ميزان الاعتدال الذي ذكر فيه هذا التحديد (ص: 52-53). ثم يقول: إن التقدم والتأخر أمر نسبي يختلف باختلاف الأزمان. لكنه في استعراضه لنشأة وتطور علم مصطلحات الحديث وقواعد الجرح والتعديل وعلل الحديث وغيرها قررها قرر أنها قد بلغت ذروة اكتمالها مع ذروة اكتمال تدوين السنة أيضاً، وأن ذلك على الأرجح عنده بغير منازع كان نهاية القرن الثالث الهجري (:55-58، 61)، ثم ذكر في موضع متأخر عن هذا (ص: 174- 176) أنه كان امتداداً لأهل القرن الثالث بعضَ أعيان أئمة القرن الرابع أيضاً، وأنه بناء على ذلك يعتبِر أن أهل الاصطلاح المعتبرين الذين لا تفهم علوم السنة إلا بفهم اصطلاحهم، ومعرفة قوانين علمهم هم أهل القرن الثالث فمن قبلهم وأعيان أئمة القرن الرابع، وأن هؤلاء هم أهل الاصطلاح الذين منهم بدأ وإليهم يعود، وهم الذين يجب علينا فهم اصطلاحهم، وأنهم لم يتركوا لمن بعدهم ممن يريد معرفة مقبول السنة من مردودها إلا أن يتبع نهجهم ويقتفي أثرهم. ومقتضى هذا أنه يعتبر نهاية القرن الرابع هي آخر المتقدمين، ومن بعدها هم المتأخرون. وتفاصيل مؤلفاتهم فيعوم المصطلح يؤيد هذا، ويلتقي في كثير من التفاصيل مع نقد من ألف في موازنة مناهج المتقدمين والمتأخرين. 4- الدكتور/ حمزة المليباري: قد تناول الدكتور بيان مفهوم المتقدمين والمتأخرين والمقصود بكل منهما في كتابه المنشور عام 1995م سنة 1416هـ والذي عنونه بقوله: نظرات جديدة في علوم الحديث. فقال: شاع استخدام كلمتي المتقدمين والمتأخرين في مواضع كثيرة من علوم الحديث دون بيان شاف عن مدلوليهما(1). إلا ما ذكره الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال (1/4) من أن الحد الفاصل بينهم رأس سنة ثلاثمائة(2). وتعقب هذا بأنه تحديد زمني قائم على أساس الفضل والشرف للقرون الأولى فلا يعتبر في المجالات العلمية والمنهجية كعلوم الحديث، لأن حفاظ القرن الرابع، بل النصف الأول من القرن الخامس أيضاً يشتركون مع سلفهم في الأعراف العلمية والمناهج التعليمية والأساليب النقدية وكيفية استخدام التعابير الفنية، دون اللاحقين بهم. وأن هذا الفاصل أيضاً لم يكن معمولاً به في الصناعات الحديثية عموماً. ثم يقول: إن من يتتبع السياق الذي وردت فيه هاتان الكلمتان ومناسبة إطلاقهما يجد أن المفهوم السائد لهذين المصطلحين هو المعنى النسبي، أي كل من سلف يعتبر متقدماً بالنسبة إلى من لحقه. ويتعقب هذا بقوله: وهذا المفهوم غير صالح أيضاً في المجالات العلمية التي يتوخى فيها المنهج والاصطلاح، نظراً إلى كونه تحديداً لغوياً، دون أدنى اعتبار للفاصل العلمي الحقيقي، وإلا فإنه يؤدي إلى الخلط بين أصحاب الرؤى المتباينة جوهرياً وفنياً. ثم يضيف قائلاً: فحين يقع بين مجموعتين خلاف جوهري وتباين منهجي في كثير من مسائل علوم الحديث فإنه يصبح من الضروري فصلهما بما يميز كلاً منهما عن الأخرى، كي لا يشيع الزلل ويكثر حوله الجدل بسبب عدم التمييز بين ذوي المناهج المختلفة (ص: 9 - 10). ومن يتأمل ما تقدم يجد أن المؤلف قد ردَّ ما تعارف عليه كافة علماء الاصطلاح قديماً وحديثاً حتى عصره هو سواء المدلول الزمني الذي حدده الإمام الذهبي، أو المدلول اللغوي النسبي الذي وصفه بنفسه بأنه هو السائد في كتب علوم الحديث. مع تعليله هذا بأن كلا المدلولين المستعملين عند السابقين غير متوافقين مع ما يراه هو، من وجود مجموعتين من العلماء بنيهما خلاف جوهري وتباين منهجي وأن تمييز كل منهما عن الأخرى ضرورة علمية ملحة. وسيأتي عند مناقشة بعض الأمثلة أن التعليل المذكور ليس في محله. ولكننا نريد هنا أن نقول: إذا كان المؤلف الفاضل قد رأى بحكم اختصاصه وخبرته بعلوم الحديث أنه إذا ظهرت له ضرورة علمية تقتضي مخالفة مدلول اصطلاح معين لمن سبقوه ولو من المتقدمين، وتقريره مدلولاً اصطلاحياً آخر مع تعضيده بدليل معتبر في نظره، فلماذا ينكر مثل هذا على من سبقه من أئمة النقد والحفظ لمن اصطلَحَ هو ومن وافقه على تسميته بالمتأخرين؟ كالإمام ابن الصلاح ومن بعده، بل كابن خزيمة ابن حبان والحاكم، الذين قالوا بإخراجهم من المتقدمين كما سيأتي لكونهم في نظرهم متساهلين مطلقاً في التصحيح. وبعد رد المؤلف للمدلولين السابقين لمصطلحي المتقدمين والمتأخرين قرر المدلول الذي يراه هو من وجهة نظره متعيناً. فقال: إن المسيرة التاريخية للسنة النبوية يتعين تقسيمها إلى مرحلتين زمنيتين كبيرتين لكل منهما معالمها وخصائصها المميزة، وآثارها المختلفة فأما الأولى فيمكن تسميتها بمرحلة الرواية، وهي ممتدة من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري تقريباً. وذكر أن أهم خصائص هذه المرحلة التعويل على الرواية المباشرة والإسناد. ثم قال: وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية، وذكر تميزها بالاعتماد بدلاً من الرواية على كتب السابقين. وتأمل قوله: يمكن تسميتها، وتأمل التسمية التي ذكرها لكل من المرحلتين والمدلول الذي ذكره، فستجد بوضوح - أن كلاً من الاسمين والمدلولين، من ابتكار فضيلة المؤلف، وحسب نظره المستند إلى خاصية مشتركة بين أهل كل مرحلة. وخلال باقي الكتاب صار يحيل عليهما كما لو كانا اصطلاحاً مقرراً، أو كما وصفه في البداية بأنه متعين. ولما كانت خاصية الرواية وعدمها التي ذكرت في تسمية المرحلتين لا تقتضي بمفردها ما يراد إثباته من التباين المنهجي والاختلاف الجوهري بينهما. فإن المؤلف قد أضاف قد أضاف ما رآه مؤيداً لمقصوده. فذكر: أن المواد العلمية التي تشكل المحاور الرئيسية في علوم الحديث بمصطلحاتها وقواعدها إنما انبثقت من جهود المحدثين النقاد في المرحلين الأولى (يعني مرحلة الرواية) وهي التي عَنَى بها المتقدمين. ثم يقر أن أهل المرحلة الثانية - يعين ما بعد الرواية وهي التي عَنَى بها المتأخرين - كان لهم أنواع جديدة من الضوابط لتوثيق النسخ والمؤلفات. ثم يخلص من هذا إلى نتيجة إجمالية بقوله: إنه بناء على ما تقدم أصبح النقاد في المرحلة الأولى يعني المتقدمين هم العمدة والمصدر الرئيس لمباحث علو الحديث ومصطلحاتها. ثم يقول: وأما المتأخرين - يعني أهل المرحلة الثانية - فتبعٌ لهم، يتمثل دورهم في النقل والتهذيب والاستخلاص، والاختصار، دون التأسيس والإبداع كما شهد بذلك الواقع. ثم يرتب على ذلك قائلاً: فمن الطبيعي إذن، بروز تباين منهجي بين حفاظ المرحلة الأولى - يعني المتقدمين، وبين أئمة المرحلة الثانية - يعني المتأخرين - في علوم الحديث. ويضيف لإثبات القول بالتباين ما وجد في نتاج أهل المرحلة الثانية من التأثير القوي لعلم المنطق الذي لم يفلت منه علم من العلوم الشرعية وذلك في صياغة الحدود والتعريفات الاصطلاحية، ومراعاة كون التعريف جامعاً، مانعاً موجزاً. في حين كان أكثر ما يُذكر للتعريف في المرحلة الأولى لا يخلو من غموض، أو تطويل، أو لا يكون جامعاً، أو لا يكون مانعاً، أو يكون بالإشارة والألغاز، مع ترك توضيح كل ذلك لإدراك المخاطب للمناسبات والقرائن التي كانوا يرونها تساعد على ذلك. ثم يقول: إن متقضى ذلك ضرورة الاعتبار بمناسبات كلام النقاد وتعابيرهم الفنية، كي تتضح مقاصدهم. ويعلل ذلك بأن العديد من تعاريف المصطلحات التي استقر عليها المتأخرون لا يصلح التقيد بها في كثير من المواضع، لأنها وقعت مضيقة لمدلولاتها التي كانت متسعة في إطلاق المتقدمين. ثم يقول: وفي ضوء هذه الحقائق العلمية، فإننا نستخلص بأن المعنيين بالمتقدمين هم حفاظ مرحلة الرواية، وبالخصوص نقادهم وبالمتأخرين أهل مرحلة ما بعد الرواية، فإن كلاً من هاتين المجموعتين تنفصل عن الأخرى أصالة وتبعية في مجال الحديث وعلومه. فلا ينبغي الخلط بينهما، لأنه ظهر بينهما خلاف جوهري وتباين منهجي. ثم يحيل بالتفاصيل على باقي فقرات الكتاب (ص: 15). وسيأتي بمشيئة الله ذكر بعض نماذج منها ومناقشتها. ثم عرض في بقية الكتاب نماذج تفصيلية لما يراه من تباين منهجي وخلاف جوهري بين من اصطَلحَ على تقسيمهم وجوبياً إلى متقدمين ومتأخرين. وقبل ذكر بعض ما يتسع له الوقت من نماذج التباين المنهجي والخلاف الجوهري في نظره مع مناقشته. أرى أن نتأمل كلام فضيلته السابق فإن من سماهم اصطلاحاً بالمتأخرين قد حدد بنفسه موقفهم من المتقدمين بأنهم ليسوا إلا تابعين لهم، ومقلِّدين، كما حدد بنفسه أيضاً دور المتأخرين العلمي بأنه: نقلٌ وتهذيب واستخلاص واختصار، دون تأسيس ولا إبداع. فكيف يتأتى للتابع أو المقلد بوصفه تابعاً أو مقلداً أن يحدث مخالفة جوهرية لمتبوعه أو مقلِّده؟ ويكيف يقال: إن مجموعة المتأخرين منفصلة عن مجموعة المتقدمين أصالة وتبعية - حسب نص عبارة المؤلف السابقة، وما دام المتأخرين قد شهد له الواقع حسب نص كلام المؤلف - بأنه لم يؤسس ولم يبدع ولكن فقط نَقَل عن المتقدمين، وهذَّب، واختصار، واستخلص من أصولهم فروعاً، فكيف والحالة هذه يكون منهجه مبايناً لما في أصوله المتقدمة أو بعبارة أخرى كيف يكون منهجه مبايناً لمرجعتيه ومنطلقه الأصلي. إن المباينة تعني أول ما تعني عدم التبعية وعدم المرجعية، وفي الحديث الشريف: (ما أبُين من الحي فهو ميت). نعم يمكن للتابع أن يخالف متبوعه في بعض الأمور الجزئية أو الجوانب الشكلية أو التفريع على أصول المتبوع، ونحو ذلك. أما أن يخالف جوهرياً ويباين منهجياً، ويبقى مع ذلك موصوفاً بالتابع لمن خالفه وباينه فهذا ما لا أظن أحداً يقره. الأمر الثاني الذي يحتاج إلى تأمل أن فضيلة المؤلف حدد هنا منذ البداية - أوصاف المقدمين بأنهم حفاظ المرحلة الأولى، وبالخصوص نقادها (ص: 15) فأصبح المتقدمون معروفون زمنياً واختصاصاً. أما المتأخرون فوصفهم فقط بأئمة المرحلة الثانية (ص: 14) وهذا وصف لا يميزهم مثلما ميز وصفُه للمتقدمين بأنهم حفاظ وبالخصوص نقاد، كما أنه لم يحدد فترة زمنية للمتأخرين. في حين سبق له أن رفض مدلولين مستعملين لكلمتين المتقدمين والمتأخرين لكونهما في نظره لا يحققان التمييز بين أصحاب الرؤى المتباينة، فكان مقتضى هذا أن يحدد المراد بالمتأخرين زمناً واختصاصاً. فلذلك احتاج عند ذكر النماذج التفصيلية لقضايا علوم الحديث أن يذكر الأوصاف العلمية لأئمة مرحلة المتأخرين فقال: إن حركة التأليف في علوم الحديث شارك فيها فئات مختلفة في طليعتهم الأصوليين والفقهاء، وفيهم من اندفع إلى ذلك لا لغرض سوى الاندراج في سلك المؤلفين فيها (ص: 16). كما ذكر من النماذج التفصيلية ما يشير إلى الامتداد الزمني للمتأخرين حتى عصرنا الحاضر. وقد سبق أن ذكر ذلك صراحة الأخ الدكتور إبراهيم اللاحم. وقد كتب الدكتور المليباري بعد كتابه السابق بحثاً آخر في الموضوع نفسه وعوَّل فيه على استعراض قدر كبير من المواضع والمناسبات المذكورة في كتب علوم الحديث لأجل ذكر شيء من الخلاف بين المتقدمين أو بعضهم وبين المتأخرين أو بعضهم فبدأ بذكر مجموعة من ذلك، وعقب عليها بقوله: (ص: 24) (من البحث). هذه النصوص تحمل إشارة واضحة إلى أن كلمة المتقدمين يقصدون بها نقاد الحديث باستثناء المعروفين منهم بالتساهل في التصحيح كابن خزيمة وابن حبان والحاكم. بينما يعنون بالمتأخرين من ليسوا بنقاد ممن كان يقبل الأحاديث ويردها بعد الدارقطني (ت 385هـ) من الفقهاء وعلماء الأصول وعلماء الكلام وغيرهم ممن ينتهج منهجهم أو يلفق بينه وبين منهج المحدثين النقاد. ثم يقول: ولذلك ينبغي أن يكون الحد الفاصل بينهم منهجياً أكثر من كونه زمنياً. أقول وبمقارنة كلامه هذا بما تقدم عنه في كتابه السابق يلاحظ اختلاف ظاهر فهو هناك حدَّد فاصلاً زمنياً بنهاية القرن الخاص الهجري على وجه التقريب ولم يستثن أحداً باعتبار التساهل أو التشدد، وهنا قرر استثناء كل من ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، باعتبار اتصافهم بالتساهل في التصحيح، مع أن أولهم وهو ابن خزيمة متوفي سنة 311هـ وآخرهم وهو الحاكم متوفي سنة 405هـ وبذلك أنقص وضيق تحديده السابق للمتقدمين، ثم عند الأمثلة التطبيقية وسَّع فذكر ابن الجوزي المتوفي سنة 5987هـ ضمن المتقدمين (ص: 19) كما جعل بداية المتأخرين هم من بعد الدارقطني المتوفي سنة 385هـن وذكر فيهم صراحة، الفقهاء والأصوليين والمتكلمين، ومن ينهج نهجهم - يعني في قبول ورد الأحاديث - أو من يلفق بين منهجهم ومنهج المحدثين النقاد، ويحدد منهج الفقهاء بأنه النظر في عدالة الراوة واتصال السند والتصحيح والتضعيف على ضوء ذلك لكنه ذكر طائفة ثانية من الأقوال وعقب عليها بأن مما تفيده: أن المتقدمين هم النقاد، وأن المتأخرين هم: الفقهاء وعلماء الكلام والأصول ومن تبعهم في المنهج من أهل الحديث دون النظر إلى الفصل الزمني في التفريق (ص: 29) وصرح في هذا الموضع أيضاً بما يدل على إدخاله المعاصرين في مصطلح المتأخرين. ثم ذكر طائفة ثالثة من الأقوال وعقب عليها بقوله: إن مصطلح المتأخرين هنا يشمل جميع علماء الطوائف الثلاث: أئمة الفقه وأئمة الأصول والكلام، وأهل الحديث. وأدخل في مصطلح المتأخرين هنا كلاً من البيهقي والخطيب البغدادي (ص: 32). أما الطائفة الرابعة من الأقوال التي ذكرها بعد ذلك فعقب عليها بقوله (ص: 35) في ضوء ما تقدم من النصوص نستطيع أن نلخص أن الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين هو سنة 500هـ، ثم يقول: وأن البيهقي هو خاتمة المتقدمين. ثم ذكر أن قائمة المتأخرين حتى السيوطي المتوفي سنة 911هـ تضم أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأصول وعدَّد من أهل هذه القائمة ابن المرابط والقاضي وعياض المغربيَّن وابن تيمية وابن كثير وعبد الغني المقدسي وابن الصلاح والذهبي وابن الحاجب والنووي وابن عبد الهادي والضياء المقدسي - صاحب المختارة - وابن القطان الفاسي والمنذري والدمياطي وتقي الدين السبكي وابن دقيق العيد والمزي وابن حجر العسقلاني. ثم إنه يعود مرة خامسة (ص: 35-36) فيذكر أن العوامل التاريخية أدت إلى وقوع تباين منهجي بين المتقدمين والمتأخرين بحيث اقتضت أن نقسمهما مرحلتين: الأولى: يمكن تسميتها بمرحلة الرواية - وتمتد من عصر الصحابة إلى نهاية القرن الخامس الهجري على وجه التقريب.. ثم يقول: وأما المرحلة الثانية فيمكن تسميتها بمرحلة ما بعد الرواية، وذكر عنها نحواً مما ذكره عنده في كتاب النظرات كما تقدم ذكر ملامحه فيما سبق. 5- أما تلميذي النجيب وأخي الفاضل الشيخ عبد الله السعد فذكر أنه لا فرق بين: أن يقال: مذهب أو منهج المتقدمين، وأن يقال: مذهب أو مناهج أهل الحديث أو أئمة الحديث، أو المحدثين (ص: 9 -10) ولا يخفى على فطنته أنه عند التأمل نجد فرقاً ظاهراً لا سيما في مجال تمييز المناهج وأصحابها، لأجل الأخذ والاستفادة، أو الرد، فإذا قلنا إنه لا فرق بين مفهوم كلمة (المتقدمين) ومفهوم كلمة (أهل الحديث) ومفهوم كلمة (أئمة الحديث) دخل في المتقدمين على هذا أمثال الحافظ العراقي (ت 806هـ) والحافظ ابن رجب الحنبلي (ت 795هـ) والحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفي سنة 852هـ وأمثالهم. في حين نجد الشيخ السعد - حفظه الله - يذكر الحافظ ابن كثير (ت 774هـ) أنموذجاً للمتأخرين الذي يستفاد منهم ويؤخذ بكلامهم. ثم يذكر فضيلته أن أهل العلم المتقدمين ليس لهم منهج واحد في الصناعة الحديثية، بل هم على مناهج متعددة، فلا بد من معرفة طريقتهم ثم السير عليها. 6- وأما تلميذي وأخي الفاضل النجيب الدكتور تركي الغميز فقد وقَفتُ له على ورقة عمل مفيدة، ومما ذكره فيها أن المتقدمين هم أئمة الحديث في عصور الازدهار، ومثل بجماعة، أولهم شعبة، وآخرهم النسائي (ت 303هـ). وذكر أنهم كانوا على نهج واحد، وطريق متحد في عمومه في الأصول العامة التي يسيرون عليها، وإنما ينتج الاختلاف في التطبيقات الجزئية، بحسب تفاوت الاطلاع، والفهم والتشدد والتسامح، دون الخروف عن الأصل العام الذي يسيرون عليه. أقول: وبهذا التوجيه لم يحتج إلى إخراج من أخرجهم سابقه لأجل التساهل في التصحيح كما مر. النتيجة: مما تقدم يتضح أن هؤلاء الأفاضل قد تنوعت أقوالهم وضوابطهم في تحديد مقصودهم بالمتقدمين والمتأخرين، بل نجد أن فضيلة الدكتور/ المليباري تعدد قوله من بحث إلى آخر. كما نجد في كلامهم اختلافاً في كون المتقدمين لهم منهج واحد مع الاختلاف في التطبيق، أو أن لكل واحد منجهاً خاصّاً به تقعيداً وتطبيقاً. هذا مع اتفاق جميعهم في الجملة على إطلاق القول بوجود تباين منهجي، وخلاف جوهري بين المتقدمين والمتأخرين. والذي يسمح به المقام الآن حيال ما اطلعت عليه في هذا الموضوع ما يلي : أولاً: أن عدداً ممن كتب في هذا الموضوع أعرفهم شخصياً وعلمياً، وأعرف أن دافعهم الأساسي إلى ما كتبوا هو الحماس المشكور والغيرة المحمودة على علوم السنة النبوية المطهرة التي لا يخفى عظيم مكانتها في نفوس المسلم وحياته الدنيا والآخرة. وكذلك أقدر قصدهم النبيل في خدمة هذه السنة وعلومها، وصيانتها من أي شوب أو دخيل. كما أقرر أن المعاصرين الذي يعملون في نشر تراث السنة وعلومها فيهم نماذج طيبة ومؤهلة لحمل مسؤولية هذه الأمانة الغالية على الجميع، وفيهم نماذج دون الأهلية المطلوبة، والأولون أصحاب الكفاءة والأهلية نتاجهم أقل من الطب المتزايد للاستفادة بهذا التراث العظيم. ومن هنا وَجد الآخرون أصحاب الأهلية الأدنى فرصتهم في ملء الفراغ، فصار نتاجهم هو الأظهر والمتداول بما فيه من قصور، وهذا مما حرك حماس هؤلاء الأخوة لما كتبوه، كما يظهر من تفاصيله وأمثلته. ثانياً: لكن هذا الحماس والانفعال بما لمسوه من قصور وتجاوز جعل فيما كتبوه بعض الملحوظات في الاستنتجاج وفي النتائج، بل حتى في صياغة الأفكار وتنسيقها، ولا تتسع مثل هذه العجالة إلا لبعض الأمثلة التي أرجو أن يعتبرها من يطلع عليها أنها من باب النصحية الخالصة - شهد الله - وتلك الأمثلة على النحو التالي: أ- جاء في شرح العلل لابن رجب - رحمه الله (1/377) ما يلي: نُقل عن يحيى بن معين (ت233هـ) أنه إذا روى عن الرجل مثلُ ابن سيرين والشعبي، وهؤلاء، أهل العلم، فهو غير مجهول..، وإذا رَوى عنه مثلُ سماك بن حرب وأبي إسحق - يعني السبيعي - ونحوهما فمن يروون عن مجهولين، فلا تزول جهالة المروي عنه، برواية واحد من أمثال هؤلاء. وعقب ابن رجب على ذلك بقوله: وهذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي (ت 258هـ) الذي تبعه عليه المتأخرون: أنه لا يَخُرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين. فهذا المثال يوضح وجود اختلاف بين قول ابن معين وقول الذهلي فيما ترتفع به جهالة الراوي، ويلاحظ أنه خلاف بين اثنين معدودين من المتقدمين، ولكن الذهلي متأخرَ الطبقة عن ابن معين كما يظهر من تاريخي وفاتهما ومراجعة ترجمتيهما في التقريب مثلاً. وقد استحسن الحافظ ابن رجب قولَ المتقدم منهما، وفي تطبيقات المتقدمين ما يؤيده، ولكن ابن رجب قرر أن المتأخرين تبعوا قول الذهلي المتأخر الطبقة، وإشارة ابن رجب إلى المتأخرين تنطبق على ما قرره الخطيب البغدادي (ت 463هـ) في الكفاية بشأن ما تزول به الجهالة ويؤيده غيرُ قولِ الذهلي أدلةً نقلية صحيحة ومعروفة. ورغم مخالفة الذهلي لقول ابن معين فإن ابن معين جاء عنه أنه كان يثني عليه ويشيد بجمعه لحديث الزهري. ويلاحَظُ أن الذهلي الذي يعتبر متأخراً عن ابن معين، يعتبر أيضاً متقدماً عن الخطيب. كما جاء عن الدارقطني (ت 385هـ) قولُه: من أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل حديث الزهري لمحمد بن يحيى (يعني الذهلي) فاعتبر الدارطقني نفسَه خلفاً متأخراً بالنسبة لسلفه المتقدم عليه وهو الذهلي. كما أن ابنَ رجب المعدودُ من المتأخرين قد اعتبر مَن بَعد الذهلي ممن وافقه على قوله متأخراً حتى عصر ابن رجب، كما هو مقتضى إطلاقه. ثم إنه صوف المتأخر الآخذ بقوله الذهلي متبعاً لقول من هو متقدم، ولم يصف قولَ المتقدم وهو ابنُ معين بالتفصيل في مواجهة المتأخرِ المخالفِ بالإطلاق إلا بكونه حسناً فقط، لم يصفه بأنه خلاف جوهري كما وصف بعض الأخوة مثل هذا الخلاف بالتقييد والإطلاق من المتأخرين لبعض ما جاء عن المتقدمين بأنه خلاف جوهري. فمثل هذا المثال وكثيرُ غيره يوضح أن مفهوم المتقدم والمتأخر أمي نسبي يسفر في كل موضع يذكر فيه بحسبه وأن التحديد المطلق زمنياً أو منهجياً للمتقدمين والمتأخرين لا يطرد بحسب واقع تراث علوم السنة الذي بين أيدينا. كما يوضح هذا المثال أيضاً أن الاختلاف المعتبر بين المتقدمين والمتأخرين له ما يؤيده من صنيع المتقدمين أيضاً. ب- ذكر الدكتور المليباري من أمثلة الخلاف الجوهري بين المتقدمين والمتأخرين مصلطح (المنكر) فقال: فإنه عند المتأخرين ما رواه الضعيف مخالفاً للثقات، غير أن المتقدمين لم يتقيدوا بذلك. وإنما عندهم كل حديث لم يعرف (إلا) (3) عن مصدره، ثقة كان راويه أم ضعيفاً، خالف غيره، أم تفرد، وهناك في كتب العلل والضعفاء أمثلة كثيرة توضح ذلك. فالمنكر في لغة(4) المتقدمين أعم منه عند المتأخرين، وهو أقرب إلى معناه اللغوي فإن المنكر لغة... معناه (جهله) وذكر آيتين كريمتين تأييد لذلك ثانيتهما قوله تعالى: (يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) [النحل: 83]. ثم قال فضيلته، وعلى هذا فإن المتأخرين خالفوا المتقدمين في مصطلح المنكر، بتضيق ما وسعوا (النظرات ص: 31). ومناقشة ما ذكره فضيلته هنا من وجوه: 1- التعريف الذي عزاه إلى المتأخرين مطلقاً هو تعريف الحافظ ابن حجر في شرح النزهة فقط، وغيره الحافظ من المتأخرين كابن الصلاح والسيوطي تبعاً له - يذكر كلها منهما أن المنكر قسمان: أحدهما: الفرد الثقة المخالف للثقات. وثانيهما: الفرد الضعيف دون مخالفة. ثم يذكر السيوطي ثالثاً، وهو الذي اقتصر المؤلف عليه، وقد عزاه السيوطي للحافظ ابن حجر وحده(5). 2- التعريف الذي نسب إلى المتأخرين عموماً في شخص الحافظ ابن حجر يرجع إلى المتقدمين ممثلين في الإمام مسلم حيث قال في مقدمة صحيحه: علامة المنكر في حديث المحدث، إذا عرضت روايته للحديث على روايته غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة(6). فعبارة الحافظ في تعريف المنكر مستقاة من عبارة مسلم هذه كما يلاحظ ذلك بأدنى تأمل. كما يلاحظ إشارة الإمام مسلم إلى المعنى اللغوي المناسب لتعريف، وهو المهجور وليس المجهول كما اختاره فضيلة المؤلف. كما أن الآية الثانية التي ذكرها فضيلته تأييداً للمعنى اللغوي الذي اختاره، فسرت النكارة فيها بمعنى الجحود لا بمعنى الجهالة لذكر العلم قبلها في قوله عز وجل: (يعرفون نعمة الله). ثم يلاحظ أيضاً أن تعريف الإمام مسلم هذا للمنكر يعتبر حسب توصيف الأخوة تعريفاً نظرياً، حيث ذكره في مقدمة صحيحه، ولم يذكر من أمثلته شيئاً، كما هو معروف. ثم إن الحافظ لم يقتصر على التعريف النظري بل ذكر له مثالاً مطابقاً ومن كتب العلل التي أشار فضيلة المؤلف إلى وجود المنكر فيها بما يخالف تعريف المتأخرين هذا. فقد مثل الحافظ للحديث المنكر بما رواه ابن أبي حاتم في العلل (2/182) من طريق حُبيِّب بن أخي حمزة الزيات عن أبي إسحق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وقرى الضيف، دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، وعلل ذلك بأن غير حُبيِّب الزيات - من الثقات رواه عن أبي إسحق موقوفاً. وحُبيِّب الزيات أكثر الأقوال فيه بتضعيفه، وقال ابن عدي حدث بأحاديث عن الثقات لا يرويها غيره/ اللسان 2 (ت 2322هـ). فاتفق حكم أبي حاتم بالنكارة مع تعريف مسلم الذي استفاد منه الحافظ تعريفه، كما أن قول ابن عدي السابق - وهو المتقدمين - في وصف راوي الحديث يفيد أنه ينفرد مع ضعفه بما يخالف رواية الثقات. فهل تعريف المتأخرين ممثلين في الحافظ ابن حجر للمنكر بما تقدم يعتبر من عند أنفسهم أو مما اتفق عليه أكثر من واحد من واحد ممن هم بلا خلاف من أعمدة نقاد الحديث المتقدمين؟ أما القول بأن هذا التعريف ضيق ما وسعه المتقدمون هكذا مطلقاً فهو أيضاً غير صحيح فلدينا من النقاد المتقدمين أحمد بن هارون البريديجي المتوفي سنة 301هـ جاء عنه تعريفه للمنكر بأنه الفرد الذي لا يعرف متنُه عن غيره روايه، ثم قال السيوطي وكذا أطلقه كثيرون(7). فيلاحظ أن هذا التعريف قيد النكارة بالمتن فقط، في حين لم تقيد بذلك في عبارة الإمام مسلم ولا الحافظ ابن حجر، وجاءت النكارة في الحديث الذي مثل بها من عند ابن أبي حاتم متعلقة بالسند، حيث ذكر فيه الرفع، مخالفاً للوقف، وإن كان كلا الوصفين يرجعان إلى المتن أيضاً. فهذا توسيع لما ضيق تعريف البريديجي وهو متقدم كما ترى. والله ولي التوفيق. كتبه د. أحمد معبد العبد الكريم أستاذ الحديث الشريف وعلومه ([1]) كذا عبارته والصواب دون بيان محدد متفق عليه. ([2]) تحرفت في نقله إلى (ثلاثمائة سنة). ([3]) في الكتاب لم تذكر (إلا) والكلام لا يستقيم معناه بدوها، وأيضاً التعريف الذي يشير إليه يفيد ثبوتها. ([4]) كذا والأولى (في استعمال) فليس للمتقدمين أيضاً لغة تضاف إليهم خاصة. ([5]) ينظر التدريب (1/276- 279). ([6]) ينظر فتح المغيث السخاوي (1/236)، ومقدمة صحيح مسلم (1/7). ([7]) التدريب (1/276). |
|
#25
|
|||
|
|||
|
رفيق زكرياء السني;294235] فضلا أخي ، هل لك أن تذكر من صرح من أصحاب هذا الاتجاه بضرب كل جهود المتأخرين؟ أخي رفيق زكرياء السني ؛إذا قال رجل قولاً ــ يُرى أنه يُفسد ــ ننتظره حتّى يصرّح !!هذا لا يقوله عاقل .. أما أنه يقصد(ون) أو لا يقصد (ون) فهذا لم يُكلّف به أحدٌ اللهم إلا إن ظهر .. ليست المسألة من مسائل الرياضيات أخي! فالمطلوب فهم طرائق الأئمة في أبواب العلل والسير عليها ولا يضر أن يختلف الأئمة في تصحيح حديث وإعلاله لأن الأمر حينئذ يكون من باب الاختلاف في توافر الشروط المعتبرة في قبول الأحاديث والمتأهل يرجح من الأقوال بحسب ما يقوى عنده من القرائن والملابسات المحتفة بكل رواية عدنا من حيث بدأنا (كيف يكون متأهلاً) وهو متأخّرٌ ؟؟!! وهل الاشكال إلا في الخلاف يا أخي (هل) رأيتَ أحداً من المتأخرين (بزعم أصحاب هذا المنهج) يرد على أهل الحديث أو يتعقبهم أو يوهم بعضهم ــ وهو طبعا كما (وصفتَ) متأهلٌ ) ..في غير موضع خلاف ؟ (أو نقول:في موضع اتفاق بين السلف)؟ ثمّ: سمّ لي متأخرا من أئمتنا (الكبار) لا يفهم طرائقَ الأئمة الكـبار في أبواب العلل !!؟ إذن (مكانك تراوح) فيه نظر فالمليباري يقول في ترجمته لنفسه أنه متأثر بكتب الحافظ ابن رجب الحنبلي والشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني فكيف يقال أن له منهجا جديدا لا أصل له البتة هكذا بهذا الإطلاق؟! التأثّر لا يعني (شيئاً) ..وهل المعلميّ متقدّم ؟ وأما الدراسات المتينة فلك تقرأ إن شاء الله في الرسائل الجامعية والبحوث العلمية المحكمة التي عالجت جملة من المسائل الجزئية في المصطلح وبعضها عالج مناهج الأئمة في العلل والجرح والتعديل كمنهج الإمام أحمد ومنهج الإمام البخاري وغيرها من البحوث لا شك أنك ستجد فيها مادة علمية دسمة وبعض الإشكالات التي تحتاج إلى حل! سبحان الله ! إذن تقصد أن مناهج الأئمة غير واضحة فاحتاجت دراسة (فكيف تنكر على المتأخر) إذا؟؟ و هل ورد ما يدل على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لا يجوز الاستدراك عليه ؟! لم أعن ذلك ـــ ولكني ــ قصدت أن من جاء بعده من الأئمة (سكتوا ) ــ على الأقلّ ــ [إن لم نقل أيّدوا] ابن حجر إلى أن جاء هؤلاء (فكأنهم أتو بما لم يأت به الأولون) ...وهنا المصيبة .. ما لنا نجوز لمن هو دون ابن المديني وأحمد وابن معين والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني ونظرائهم في الحفظ والدراية والاطلاع أن يتعقب عليهم . اثبت أحد .. إذا جوّزتَ ذلك ـــ هل بقي لك متقدّمٌ ــ تقدّمه ...؟؟ يا أخي يجوز ــ تخطئة العالم (بدليل) أيّا كان ثم لا نجوز لغيره أن يتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله مؤيدا بحوثه بالنقول عن بعض الحفاظ؟! ومن قال ذلك؟؟ ما دام الأمر كذلك فلم التشنيع إذن على من قدم أقوال أئمة العلل على من جاء بعدهم من الحفاظ؟! مع أن المنازع لا يجادل في أن معهم زيادة فضل على المتأخرين وأنهم أدرى بخبايا البيت! لا زلت تدور في (حلقة مفرغة) تجيب نفسك بنفسك .. وهل المتأخر ينفي فضل المتقدّم ؟؟!! ثم هل جميع المتأخرين والمعاصرين (يرجحون على وفق ما ذهب إليه المتقدمون و على نفس الشروط والضوابط والقواعد الحديثية)؟ ما رأيك مثلا في : -إطلاق الحافظ النووي قاعدة (قبول زيادة الثقة) ورده إعلال النقاد للزيادات بمثل هذه القاعدة؟ أما إطلاق النووي (فهذا) يحتاج إلى بحث..(1)ويكفي أنك تقول:[مذهب النووي] .. -مذهب السيوطي القائل بـ(تعضيد روايات الفساق والمتهمين و رفعها إلى درجة الضعف الخفيف)؟ وهذا كسابقه أيجوز نسبة ذلك (لجميع) المتأخرين ها أنت تقول (مذهب) [السيوطي] مذهب [النووي] !!! -الإطلاق المشهور في كتب المصطلح أن رواية الراوي إذا خالفت فتياه فـ(العبرة بما روى لا بما رأى) وهل اتفق عليها المتقدمون؟ حتّى نبحثها عند المتأخرين ؟ وهذه القاعدة صحيحة .. في حين يعل الإمام أحمد وجماعة من النقاد كثيرا من الأحاديث بمثل هذا؟ والأمثلة متعددة ! عدت إلى البحث العلميّ ( وهذه الإشكالات) خرجت عليكم حين فرقتم بين منهج المتقدمين والمتأخرين (و أنت نفسك) تقرّ بأن للمتقدمين أيضا (بعض القواعد) الخاصة بهم [فهل يسوغ] نسبتها إلى جميع المتقدمين؟؟... فهذا أيها الأخ الكريم من باب المدارسة وإثراء البحث ليس إلا. مرحبا ومنكم نستفيد أخي الكريم وإلا فللمسألة ذيول كثيرة كما تعلمون إن شاء الله وخير ما تحلى به المرء التأني والإنصاف وإلا وقع فيما يعيبه هو على (غلاة الجرح) والعلم عند الله تعالى أولا وآخرا بارك الله فيك أخي [/quote][/quote] (1) يقول المليباري :[ولعل من أكثر العوامل إسهاما في بقاء مسألة زيادة الثقة بعيدة عن منهج المحدثين النقاد في التنظير والتطبيق عند كثير من المعاصرين ما قد يلمس في مقدمة ابن الصلاح وما بعدها من كتب المصطلح من غياب الوحدة الموضوعية بين زيادة الثقة وبين ما يتصل بها من الأنواع كالشاذ والمنكر والعلة وغيرها، إذ كانت مطروقة في مواضع متباعدة منها].. ــــــــ التعليق(مني) ــــ هذا من العجلة و إلا فكتب المتأخرين طافحة بالكلام عن الشاذ و المنكر والعلة ومواضع ذلك و أسباب ذلك و شروط القبول لزيادة الثقة أو ردّها ،وهو وصف عارِ عن الصحة والبرهان بل ما في كتب المتأخرين توضيح و (تقريب) و (تهذيب) ..
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#26
|
|||
|
|||
ما أعز الإنصاف وما أقل أهله ! .
__________________
قال ابنُ رَجَب : (( وقد ابتلينا بجَهَلةٍ من النّاس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين...وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم )) أهـ. |
|
#27
|
|||
|
|||
|
الإنصاف هو إصابة الحقّ،لا التحقير من شأن المتأخرين ...
__________________
قال ابن تيمية:"و أما قول القائل ؛إنه يجب على [العامة] تقليد فلان أو فلان'فهذا لا يقوله [مسلم]#الفتاوى22_/249 قال شيخ الإسلام في أمراض القلوب وشفاؤها (ص: 21) : (وَالْمَقْصُود أَن الْحَسَد مرض من أمراض النَّفس وَهُوَ مرض غَالب فَلَا يخلص مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيل من النَّاس وَلِهَذَا يُقَال مَا خلا جَسَد من حسد لَكِن اللَّئِيم يبديه والكريم يخفيه). |
|
#28
|
|||
|
|||
|
[مِن الأرشيف: نُشر سنة 1428هـ]
وقفات مع فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز التخيفي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومَن والاه: أما بعد: فقد سمعتُ شريطاً –وهي المادة الصوتية الوحيدة على (صفحات الويب)!- لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن سعد التخيفي(1)-سدده الله-، بعنوان: «التصحيح والتضعيف بين المتقدمين والمتأخرين» (2)، فبدأ فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز التخيفي محاضرته بلفظ حديثٍ لا أصل له في كتب السنة؛ فقال: «في الحديث الصحيح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- «خير القرون قرني»... »! [د: 6:45] قلتُ: قال الألباني –رحمه الله-: «وبهذه المناسبة لا بد لي من وقفة أو جملة معترضة قصيرة, وهي أن الشائع اليوم على ألسنة المحاضرين والمرشدين والواعظين رواية الحديث بلفظ: «خير القرون قرني». هذا اللفظ لا نعرف له أصلاً في كتب السُّنّة مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأحاديث المتواترة لكثرتها, وإنما اللفظ الصحيح الذي جاء في «الصحيحين» وغيرهما إنما هو بلفظ: «خير الناس قرني»، ليس: (خير القرون قرني)، إنما هو: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» إلى آخر الحديث ... ». [«سلسلة الهدى والنور»- شريط (رقم 396)] وجاء في موقع (الإسلام: سؤال وجواب): «ومما هو جدير بالتنبيه أن لفظ الحديث الوارد في السؤال وهو: «خير القرون قرني»: لا أصل له بهذا اللفظ، وإن كثر استعماله في كتب أهل السنة، ثم هو خطأ من حيث المعنى، إذ لو كان هذا لفظه لقال بعده: «ثم الذي يليه»! لكن لفظ الحديث: «ثم الذين يلونهم»، ولفظ الحديث الصحيح: «خير الناس قرني»، و«خير أمتي قرني». والله أعلم». فنرجو من فضيلة الشيخ أن يخرج الحديث الذي ذَكره، مع ذِكر حكم المتقدمين عليه، وبيان موافقته أو مخالفة لهم!! والله الموفق. ومِن باب التنبيه والأمانة العلمية أنْ أقول: رُوي الحديث بلفظ: «خير القرون القرن الذي أنا فيهم، ثمّ الثاني، ثمّ الثالث، ثمّ الرابع لا يعبأ اللهُ بهم شيئاً». رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (4/172) وقال: «غريب مِن حديث الأعمش، لم يروه عنه إلا إسحاق». يتبع -بمشيئة الله-. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) المعلومات عن فضيلة الدكتور في (صفحات الويب) شحيحة جدًّا، ومما قيل عنه –سدده المولى-: «شيخنا الشيخ عبدالعزيز مِن المحدثين المعروفين بالعلم والفضل، وحسن السمت، وهو شيخ شيخنا عبدالله السعد». وقيل –أيضاً-: «أنه أول مَن قال بمنهج المتقدمين وشهره في عصرنا، وأكثر مِن استعماله الشيخ عبدالله السعد إلا أنَّ تقريرات الشيخ عبدالله السعد كانت أقوى وأشمل». ووعد أحد طلبة العلم بكتابة ما يتيسر له عن فضيلة الشيخ الدكتور التخيفي –عجّل الله خروجها!-، فـ«معرفة سير الأفراد مِن العلوم التي يُحتاج إليها، إذ به يَعرفُ الخلفُ أحوالَ السّلف...». [انظر مقدمة «إرشاد الطالبين»]، ولو سلكتُ منهج الإمام (ابن حبان) في «ثقاته» لما حرصتُ على ترجمة فضيلة الشيخ التخيفي الذي دافع عن منهجه بتعجل لا نرضاه له –كما سيأتي-! (2) وحبذا لو يقوم أحد طلبة الشيخ بتلخيص المحاضرة فيما يتعلق بعنوان المحاضرة–فقط-، فإني وجدت عنوان المحاضرة في واد، وما ذكره الشيخ في وادٍ آخر. فالعنوان يوحي أن الشيخ سيتكلم عن «الحكم بتصحيح الحديث، أو تضعيفه في اجتهاد الأئمة المتقدمين، ثم في اجتهاد والمتأخرين» -كما صرح بذلك في بداية الشريط-. وذكر في نهاية الشريط (د:53): (منهج المتأخرين في وصف شرائط الصحيح)؛ فقال: «ليسوا على وصف المتقدمين، دون المتقدمين في شرائط الصحيح وفي قوة الأحاديث، المتأخرون أمر آخر؛ لهم علم ولهم حفظ، ولهم فضل، ولهم جهادهم في حمل السنة في الذب عنها، ولكنهم دون المتقدمين في هذه الأوصاف كلها. ومن خصائص المتقدمين التي تميز حديثهم عن المتأخرين أذكر لكم بعض[...] حتى يتميز لك هذا الموضوع، فمن الأمور التي يتميز المتقدمين عن المتأخرين: أن معرفتهم بالسنة متوناً وأسانيد ورواة وعللاً وطرق فوق المتأخرين[...]، ومن ذلك –أيضاً- أن شيوخهم الذين أخذوا عنهم المرويات -من الطبقة التي قبلهم- أقدم وأحفظ من شيوخ المتأخرين، وأسانيدهم -غالباً- المتأخرون نازلة، أسانيدهم طويلة نازلة، بينما أسانيد المتقدمين -غالباً- عالية، وكلما كان السند عالياً كان مظنة لحفظه.. وإتقانه، بخلاف الأسانيد النازلة مظنة أن يقع فيها الخلل،.. المتأخرين حفاظ كبار، وأعلام، مثل: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم بن عبدالله صاحب «المستدرك»، ومثل ضياء المقدسي صاحب «المختارة»، هؤلاء لهم مؤلفات، ولهم دواوين، وهم متبحرون في السنة، أبو حاتم، محمد بن حبان البستي...، وغيرهم من أمثالهم هؤلاء لهم معرفة، ولهم حفظ ولهم دراية، وهم أئمة كبار، ومعرفتهم واسعة لكن الأمور ليست [....] المتقدم. أولاً: ابن حبان والحاكم صاروا يتوسعون في أمور العدالة، وأوصاف الرواة، فابن حبان...» إلخ. وسيأتي الكلام على الحاكم وابن حبان –هذا أولاً-، وثانياً: لم ننبّه على الأخطاء اللغويّة!! وما أكثرها! فائدة: قد يظن البعض أن جميع الأحاديث قد حُكِمَ عليها صحة وضعفاً، والأمر ليس كذلك كما لا يخفى على طلبة العلم –وقد يَخفى!-، وقد ذَكر الشيخ الألباني حديثاً ضعيفاً في «السلسلة الضعيفة» (2/427)، كان مِن دواعي تخريجه له وبيان علته أنه قال: «ففي هذه الحديث -ومثله كثير- لأكبر دليل على جهل مَن يزعم أنه ما مِن حديث إلا وتكلم عليه المحدثون تصحيحاً وتضعيفاً!». فائدة أخرى: وقال –رحمه الله- بعد استدراكاته على بعض الأئمة-: «...مصداقاً لقول القائل: «كم ترك الأول للآخر», ورداً على بعض [المقلدة] المغرورين القائلين: إن علم الحديث قد نضج بل واحترق. هداهم الله سواء السبيل». [«السلسلة الضعيفة» (3/160) و (12/511)] فائدة منهجية: وقال –أيضاً- في المصدر السابق (3/180): «...فتأمل كيف يقع الخطأ مِن الفرد, ثم يغفل عنه الجماعة ويتتابعون وهم لا يشعرون, ذلك ليصدق قول القائل: «كم ترك الأول للآخر», ويظل البحث العلمي مستمراً، ولولا ذلك لجمدت القرائح, وانقطع الخير عن الأمة». أما ما قاله فضيلة الشيخ التخيفي -عن اتساع المرويات- (د:24): « ثم بعد ذلك في (عهد متأخر) من نفس عهد المتقدمين رأوا أن الموضوع ليس هكذا، أن هناك مجموعات حديثية في الأمصار كثيرة، مجموعات مرويات ألوف الأحاديث ليس يسعهم أن يهملوها... بل لا بد من جمعها مع تمحيصها وفحصها؛ لأنهم لو أهملوها سوف تنتشر ويعمل الناس بالحديث الضعيف ويعملون بالباطل، فلم يروا أن يسعهم أن يهملوا هذه المرويات الكثيرة، وهكذا فعل سفيان الثوري، وهكذا فعل الأعمش، وهكذا فعل الذين جمعوا المرويات بكثرة، ثم بعد ذلك معمر بن راشد الأزدي ثم ابن المبارك... »، فيحتاج إلى نظر إذا قصد أن علم الحديث نضج واحترق! وأن الحُكْمَ على الأحاديث مُعلّبٌ جاهز!! وقد نبتت -في هذا العصر- نابتة(!) تدعو إلى الإلتزام بقبول ما صحَّحه المتقدمون، وتضعيف ما ضعّفوه؛ دون مناقشة، ومِن غير جدال –تسليماً مُطلقاً-!! وثمرةُ هذا –ولا بُدَّ- الاقتصار على تصحيحاتهم وتضعيفاتهم، وسدّ باب الاجتهاد المنضبط في هذا!! وإلا؛ فما مصير الأحاديث والآثار التي لم يحكم عليها أولئك الأئمة المتقدمون؟! وكيف سيحكم هؤلاء المعاصرون –ولا أقول: المتأخرون!- عليها؟! والرّد عليهم بالتفصيل ليس هذا موضعه –الآن-؛ ولكن أكتفي بـ(هامش) علمي كتبه الإمام الألباني قبل (60سنة) عام (1368هـ = 1947م)، في ردِّ قولٍ للحافظ ابن الصلاح لم يحالفه الصواب فيه؛ فقال الألباني: «في هذا الكلام إشارة إلى ما نقله العراقي وغيره عنه -أعني: ابن الصلاح- أنه لا يجوز للمتأخرين الإقدام على الحكم بصحة حديث لم يصححه أحد مِن المتقدمين؛ لأن هذا اجتهاد؛ وهو -بزعمه- قد انقطع منذ قرون، كما زعموا مثل ذلك في الفقه -أيضاً!-. وليت شعري لِمَ ألّف هو وغيره في أصول الحديث؟! ولم ألّفوا في أصول الفقه؟! أللتسلية والفُرجة وتضييع الوقت؟! أم للعمل بمقتضاها، وربط الفرع بأصولها؟! وهذا يستلزم الاجتهاد الذي أنكروه؟! ونحمد اللهَ تعالى أننا لا نُعْدَمُ في كل عصر مِن علماء يردون أمثال هذه الزلات مِن مثل هذا العالم، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر، وشيخه العراقي في شرحه عليه وغيرهما، كالسيوطي في «ألفيته». فقال بعد أن ذكر رأي ابن الصلاح في أحاديث «المستدرك»: جرياً على امتناع أن يصححا .... في عصرنا كما إليه جنحا وغيره جـوزه وهو الأبر ..... فاحكم هنا بما له أدّى النّظر». [«صحيح سنن أبي داود» -الكتاب الأم- (1/17)] ـ وهذه بعض الردود الألبانية (الصوتية) على هذه البدعة العصرية: - بدعة التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين : شريط رقم: (852) -هل مفهوم التدليس عند المتقدمين هو نفسه عند المتأخرين ؟ شريط رقم: (329) - مثال للتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين ( التدليس ) : شريط رقم: (636) - ما رأيكم فيمن يفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في التحديث؟ شريط رقم: (636) - لماذا حد الدار قطني الاجتهاد؟ شريط رقم: (852) - علم الدراية ينقسم إلى قسمين: شريط رقم: (852) - هل هناك مسألة في علم الحديث أخذ بها المتأخرون ولم يقل بها أحد من المتقدمين؟ شريط رقم: (852) - مناقشة بعض المسائل التي فرقوا فيها بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين كالتدليس والإختلاط وتحسين الأحاديث والشذوذ والتفرد ، النكارة ، زيادة الثقة:شريط رقم: (852) - ما حكم من سَبَرَ مرويات الراوي من أجل الحكم عليه وخاصة الرواة المختلف فيهم ؟ شريط رقم: (852) هل كلمة الحسن في الحديث الحسن ليست وصف للسند وإنما هو صلاحية العمل بالحديث؟ نرجوا التفصيل في ذلك: شريط رقم: (852) - كلام فضيلة الشيخ علي حسن الحلبي -حفظه الله-: شريط رقم: (852) - خطورة الإخلال بالقواعد المشهورة من أفراد ولو كانوا علماء ومن ذلك ما يدور على لسان بعضهم من التفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين في الحسن لغيره؟شريط رقم: (842) ملحوظة: هذه الفتاوى مأخوذة من (الباحث في فتاوى الألباني الصوتية).
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965) |
|
#29
|
|||
|
|||
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965) |
|
#30
|
|||
|
|||
__________________
«لا يزال أهل الغرب ظاهرين..»: «في الحديث بشارة عظيمة لمن كان في الشام من أنصار السنة المتمسكين بها،والذابين عنها،والصابرين في سبيل الدعوة إليها». «السلسلة الصحيحة» (965) |
 |
|
|
 |
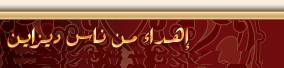 |