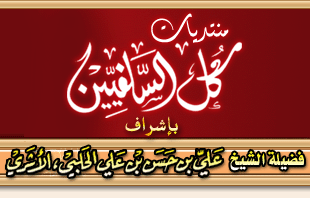

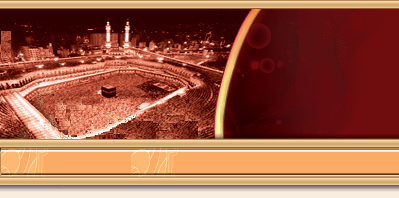
 |
 |
أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا
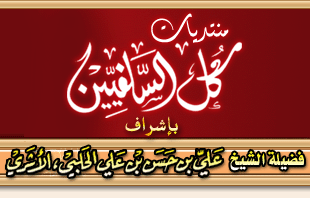 |
 |
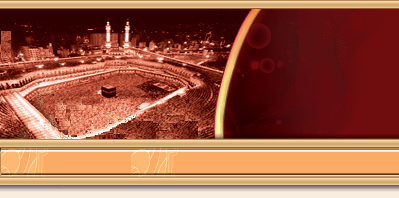 |
|||||
|
|||||||
| 25957 | 78704 |
|
#1
|
|||
|
|||
|
بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله (الدرس الأول) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ رَبِّ يَسِّرْ وَأَعِنْ بِرَحْمَتِكَ [الحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمًّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً.] افتتح المصنف هذه الرسالة ، بهذه الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة ، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها كلامه وخطبه عند مخاطبة الناس ، وهذه الخطبة ، خطبة عظيمة ، مشتملة على فوائد كبيرة منها: الثناء على الله عز وجل ، وحمد الله عز وجل بما هو أهل ، ثم الاستعانة بالله عز وجل ، والاستغفار من الذنب ، فإن هذه من أعظم أسباب التوفيق: الثناء على الله عز وجل ، والاستعانة به في فهم العلم ، وفي غيره من الأمور التي تشرع لها هذه الخطبة ، وكذلك الاستغفار من الذنوب ، فإن من أعظم ما يحول بين العبد وبين تحقيق المصالح والمطالب هو الذنب ، فإذا ما استغفر العبد من ذنوبه ، وفقه الله عز وجل لخير كثير ، ثم الاستعاذة من شرور النفس ، وشر النفس: هو ما توسوس به النفس ، فإن النفس أمارة بالسوء إلا من هداه الله عز وجل ووفقه ، (وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا) : أي من الذنوب والسيئات ، والأعمال: منها ما هو صالح حسن ، ومنها ما هو سيء قبيح ، والاستعاذة من شر الذنوب ، ومن شر السيئات التي هي سبب لحرمان العبد في الدنيا والآخرة ، ثم قال: (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ): هذا فيه تقرير أن الهداية بيد الله عز وجل ، وهذه هداية التوفيق (مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ) من هدى الله قلبه ووفقه ، فلا مضل له ، (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ): إن كتب عليه الضلال فإنه لا هادي له ، وأما هداية الإرشاد فإن الأمة خوطبت بها ، وأما هداية التوفيق فهي التي امتن الله عز وجل بها على من شاء ، فمن هداه الله فلا مضل له ، ومن أضله الله فلا هادي له ، ثم قال: (وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ): هذه شهادة توحيد ، وهذه الكلمة العظيمة التي عليها مدار الدين وهو تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ولهذا فهذ الخطبة مشتملة على فوائد عظيمة من استحضرها عند قولها ، وحققها لفظا ومعنى، واستحضارا لما يقول فإنه يوفق لخير كثير. قال رحمه الله: [لقد سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ «مُقَدِّمَةً» تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ، وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَالتَّمْيِيزِ -فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ- بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ، وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ] ثم ذكر المصنف سبب تأليف هذه الرسالة ، فقال: (لقد سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ «مُقَدِّمَةً» تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً) هذا مما على أن هذه الرسالة هي في إجابة سؤال ورد من بعض طلبة العلم أو من بعض أهل العلم. (بَعْضُ الإِخْوَانِ) أي في الدين ، وهذا مما يدل على حسن استجابة شيخ الإسلام لمن سأله عن ذلك ، ومراعاته لحقوق الأخوة والصحبة ، (لقد سَأَلَنِي بَعْضُ الإِخْوَانِ) ولم يسمه ؛ لأن المقصود هو معرفة المناسبة وليس السائل ، (أَنْ أَكْتُبَ لَهُ «مُقَدِّمَةً») المقدمة للشيء هو ما يتقدم الشيء وتضبط بـ "مقدِمة" و "مقدَمة" فمقدِمة هي ما يتقدم الشيء ، ومقدَمة ما يُقدم بها للشيء ، فيصح هذا وهذا. والمقصود أن هذه الرسالة هي متضمنة لمقدمة تتضمن القواعد الكلية في التفسير ، وإنما سماها مقدمة ؛ لأنها مقدمة لعلم واسع ؛ وهو علم التفسير ، ولهذا فهذه الرسالة تصلح لأن تكون مقدمة لكل كتاب من كتب التفسير ، ولهذا ذكر بعض أهل العلم ، أن الإمام ابن كثير استفاد من هذه الرسالة في مقدمة كتابه في التفسير ، (تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً) القواعد جمع قاعدة وهو حكم كلي يندرج تحته جزيئات ، فإذا عُرف الحكم الكلي عرف حكم الجزيئات ، ولهذا فالقواعد هي من أعظم ما يعين على معرفة جزئيات العلم ، والقواعد منها ما هو منصوص عليه يعرف بالنص ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " كل بدعة ضلالة" فإن هذه قاعدة ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات" فإن هذه قواعد ؛ لأنها يندرج تحتها الكثير من الجزيئات ، وهذه القواعد المنصوص عليها ، هي أقوى ما يكون في معرفة العلم ؛ لأنها معصومة من الخطأ ، ولأن هذه القاعدة منصوص عليها ، فكل ما يندرج تحتها من جزيئات هي صحيحة ، تبعا لصحة القاعدة. ومن القواعد ما هو مستنبط من النصوص ، أي لم يرد به النص ولكنه يعرف من خلال التتبع والسبر للنصوص ، مثل قول العلماء: "الأمر يدل على الوجوب" و" النهي يدل على التحريم" فهذه القواعد أخذها العلماء من تتبع النصوص والاستقراء التام للنصوص بحيث المستقرِء يقرر قاعدة ، يعلم أن الجزئيات كلها مندرجة تحت هذا الأصل ، وتحت هذه القاعدة. وعلى هذا فإن القواعد منها ما هو منصوص عليه ، وهذه القواعد هي التي جاءت بها الأدلة من الكتاب والسنة ، وهذه حق لا باطل فيها ، والاستدلال بها من جهتين ، من جهة أنها دليل شرعي ، ومن جهة أنها قاعدة. وأما كلام العلماء في تحرير القواعد فهو كاجتهاد العلماء في سائر المسائل ، فيؤخذ منه ويرد ، ولهذا قد تكون القاعدة صواب ، وقد تكون خاطئة. وقد نبه شيخ الإسلام على أن كثيرا ممن ألف في أصول الفقه ، ادخلوا في هذا العلم بعض القواعد التي لم تدل عليها الأدلة ، بل إنها أصبحت من أكثر أسباب خطأ الكثير في فهم هذا الباب ؛ بسبب سوء فهم هؤلاء في بعض الأصول والقواعد الشرعية. ولهذا سبق التنبيه على كثير مما قرره وقعد له بعض أهل الكلام ، مثل قولهم: "إن الله عز وجل منزه عن الحوادث" فهذه قاعدة نفوا بها الصفات ، قالوا: إن الصفات حوادث ، والله منزه عن الحوادث ، فالله منزه عن الصفات ، فيأتون ويقررون قواعد ومقدمات باطلة ، ثم يندرج تحتها أخطاء عظيمة ، ولهذا الخطأ في القواعد ليس كالخطأ في غيره ؛ لأن القاعدة كما يقال: (سلاح ذو حدين) ، إما أن تكون صحيحة فتدل على كثير من العلم ، وإما أن تكون خاطئة فتكون سبب لضلال كثير من الناس في أبواب شتى من أنواع العلوم. قال: (تَتَضَمَّنُ قَوَاعِدَ كُلِّيَةً ) والقاعدة الكلية هي القاعدة الكاملة التامة التي تندرج تحتها الجزئيات. قال: (تُعِينُ عَلَى فَهْمِ الْقُرْآنِ، وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ، وَالتَّمْيِيزِ -فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ-) هذه القواعد تعين على فهم القرآن ، والفهم: هو حسن التصور والإدراك للشيء وهو فوق العلم ، فقد يحصل العلم ولا يحصل الفهم ، قد يقف العالم على العلم وعلى النص ولكنه لا يرزق الفهم ، ولذلك فرق الله عز وجل بينهما في قوله: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} فأخبر الله عز وجل أن داوود وسليمان أوتيا علما ، ورزقهما الله علما ، ولكن الفهم في تلك المسألة خص الله عز وجل به سليمان ، فالفهم هو حسن التصور والإدراك للشيء ، والعلم هو إدراك الشيء وهو أن يدرك النص ويقف عليه ، ولكن الفهم للنص هو شيء زائد عن العلم. (وَمَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهِ وَمَعَانِيهِ) هنا يلاحظ دقة شيخ الإسلام في العبارات ، وما يتضمن كلامه من تقسيمات ، فإنه فرق بين التفسير والمعاني ، فالتفسير: أن يعرف المفسر تفسير كل مفردة وردت في الآية ، والمعنى: هو معرف المعنى الإجمالي لهذه الآية أو لهذا النص. والتفسير قد يكون بمعرفة معنى هذه الكلمة في لغة العرب ، والمعنى هو أوسع من ذلك ، بأن يعرف المراد منها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، مثال ذلك {الصراط المستقيم} فيفسر في اللغة بأنه الطريق القويم ، ولكن يأتي بيان معناه في الشرع ووروده في القرآن بأنه القرآن أو الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم ، ولن تجد في لغة العرب أن الصراط المستقيم هو النبي أو القرآن ، ولكن هذا المعنى يعرف من معرفة دلالات القرآن ، ومعرفة النصوص الأخرى . (وَالتَّمْيِيزِ فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ) التمييز هو التفريق بين الأشياء ، وهو أول مراتب العلم ؛ لأن أول مراتب العلم: أن يعرف المعاني والمقاصد ، وأن يفرق بين الألفاظ والمعاني ، ثم بعد ذلك يأتي دور تنزيل الأحكام بحسب التفريق ، ولهذا يلاحظ أن أكثر أخطاء العلماء ليس مرجعها إلى الجهل ن وإنما مرجعها إلى الاشتباه: أن يشتبه لفظ بلفظ ، أو معنى بمعنى ، أو حكم بحكم ، فإذا ما رزق العالم التفريق بين المسائل فإنه يتنبه إلى أنه لا يمكن أن تفترق المسألة ويكون حكمها واحدا ، فافتراق المسائل إذا ما افترقت إلى شيئين أو إلى أكثر ، فإنه مما يدل وينبه المتأمل إلى أنه هناك فرق في الحكم ، ولهذا نجد في كثير من الألفاظ في القرآن الأمر بالشيء والنهي عنه ، مثل: المجادلة ، ومثل: الهجر ، فالذي لا يتنبه إلى هذه الأقسام يظن أن ما يؤمر به هو ما ينهى عنه ، وإذا ما رزق التمييز بين الأشياء ، وأدرك أن الهجر يتنوع ، وأن المجادلة تتنوع ، وكذلك سائر المسائل التي تتنوع أحكامها ، يتنبه إلى أن الحكم إنما تنوع بحسب تنوع المسائل ، ومن هذا مما ذكره العلماء في قواعد التفسير ما جاء من الإخبار عن يوم القيامة ، فقد يأتي في بعض المواطن الإخبار عن شيء ، ثم يخبر في موطن آخر بشيء قد يظن الظان أن هذا معارض لذاك ، ويكون هذا من باب التنوع في الزمن ، ففي بعض المواطن يخبر عن شيء لكن هذا الشيء قد يخبر بوقوعه في موطن آخر أي في زمن آخر ، فإن يوم القيامة يوم طويل ، ولهذا التنبيه على التمييز بين الأشياء مما يعين على فهم الحكم الشرعي. (وَالتَّمْيِيزِ فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ) التمييز بين المنقول في التفسير والمنقول مرجعه إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى فهم الصحابة وهو ما يعرف بالتفسير بالرواية ، فإذا فسر لنا الطاغوت بأنه الشيطان كما نقل عن عمر رضي الله عنه فإن هذا من التفسير بالرواية ، وإذا ما فسر الطاغوت بأنه مجاوزة الحد ؛ لأن الطغيان هو مجاوزة الحد ، هذا التفسير مما يؤخذ من اللغة بالدراية وبالعقل والتأمل لمدلول اللغة ، (فِي مَنْقُولِ ذَلِكَ وَمَعْقُولِهِ) أي ما يعرف في التفسير بالمنقول والمعقول ، وليس المقصود بالمعقول هو أن يعمل المفسر عقله في النص دون أن يرجع إلى أصول ، بل لابد أن يرجع إلى أصول: إما إلى لغة العرب ، وإما إلى دليل آخر يستنبط منه الفهم ، لكنه عرفه بالنظر والتتبع. قال: (بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِ): لاحظوا هنا لم يجمع الحق ؛ لأن الحق واحد ، وجمع الأباطيل ؛ لأنها متنوعة ، ولهذا قرر شيخ الإسلام في قول من قال: "إن كل مجتهد مصيب" قال إن هذا خطأ ، فليس كل مجتهد مصيب ، إنما الصواب أن لكل مجتهد نصيب ، فالمجتهدون إذا ما كان اجتهادهم يفضي إلى اختلاف تضاد فإن الحق مع أحد المجتهدَين ، وإن كان الآخر قد سلك الطريق الصحيح فهو معذور بل مأجور على اجتهاده. (بَيْنَ الحَقِّ وَأَنْوَاعِ الأَبَاطِيلِلأن الأباطيل متنوعة أيضا ، كما أن البدع متنوعة ، كذلك أهلها الذين حرفوا النصوص عن مدلولاتها الصحيحة ، فإن أباطيلهم متنوعة ، وأهواءهم متفرقة. (وَالتَّنْبِيهِ عَلَى الدَّلِيلِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الأَقَاوِيلِ) التنبيه على الدليل الفاصل – الذي فيه الفصل- بين الأقاويل – أي بين أقوال الناس- ، ؛ لأن الفصل في الخصومات في الدين والدنيا إلى كتاب الله ، وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، فالدليل محكم في أقوال الناس ، وأقوال الناس ليست محكمة في الدليل ، والحق يعرف بالدليل ، ولهذا فالأقوال يؤخذ منها ويرد ، لا يؤخذ ما يؤخذ منها بهوى ، ويرد ما يرد منها بهوى ، وإنما يؤخذ منها ما وافق النص ، ففي كتاب الله عز وجل الفصل بين الخصومات ، والفصل بين أهل الخصومات ، ولهذا هو محكم في أقوال الناس. قال رحمه الله:[ فَإِنَّ الكُتُبَ المُصَنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بَالْغَثِّ وَالسَّمِينِ، وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ وَالْحَقِّ المُبِينِ. وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ، وَمَا سِوَى هذا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ، وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ.] ثم بعد أن ذكر أن مقصد هذه الرسالة وهو أنها تعين على فهم القرآن ، ومعرفة تفسيره ، والتمييز بين الحق والباطل ، نبه على مسألة مهمة ، وذلك أن في كتب التفسير الكثير من الأقوال الباطلة التي تزيد الفتنة ، ويحصل الاشتباه للناس بسبب وجود هذه الأقوال ، وهذا مما يؤكد معرفة هذه القواعد ؛ لأن الإنسان محتاج إليها ابتداء في فهم كتاب الله عز وجل ، فكيف إذا جاءت الشبه والأقوال الباطلة التي صرفت الكثير من الناس عن معرفة الحق. قال: (فَإِنَّ الكُتُبَ المُصَنَّفَةَ فِي التَّفْسِيرِ مَشْحُونَةٌ بَالْغَثِّ وَالسَّمِينِ): أي التي كتبت وصنفت في علم التفسير وهي كتب كثيرة ، وشيخ الإسلام متأخر عن عصر التدوين الذي بدأ في عصر مبكر ، فهو يُبين ما اشتملت عليه هذه الكتب ، فكتب التفسير مشحونة -أي مليئة- بالغث والسمين ، والغث: هو الهزيل ، والسمين: هو المعروف بالقوة والسِمن ممدوح في الأشياء ، والهزل مذموم -ولهذا مما يشرع في الأضحية أن تكون سمينة ، وأنه يحرص على أن تكون سليمة من الهزل ، وأن تكون مما يرغب فيه - فكذلك في الأقوال ما هو غث وسمين ، كذلك في كتب التفسير وما اشتملت عليه ، وهذه الكتب أيضا متنوعة منها ما يغلب عليه السِمن والغث فيه قليل ، ومنها ما يغلب عليه الغث والسمن فيه قليل ، بحسب مناهج ومراتب مصنفيها في العلم. (وَالْبَاطِلِ الْوَاضِحِ وَالْحَقِّ المُبِينِ) أي أنها مشتملة على الباطل الواضح الذي لا يشتبه على أهل العلم ، وعلى الحق المبين ، وإنما ذكر شيخ الإسلام هذا ؛ لأن الباطل الواضح ينبغي أن يحذر ويترك ، والحق المبين ينبغي أن يؤخذ به ولا يسع المسلم تركه ، وأما ما بين ذلك من الأمور المشتبهة ، فإنه ما زال العلماء يجتهدون في معرفة ذلك ، فالمقصود: ليس قصده بهذا هو أن يضع قواعد يعرف بها طالب العلم الأمور المشتبهة بين العلماء ، فإن الاشتباه الذي وقع بين أهل العلم في هذا الباب لا يمكن رفعه بمعرفة القواعد الكلية ، ولكن بالتتبع لأقوال العلماء ، ولمعرفة مآخذهم في الاستدلال ، وعلى قدرة الناظر في كلامهم على الاستنباط والفهم. قال: (وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ، وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ): هنا أشار إلى نوعين من أنواع العلم: النوع الأول: النص ، قال: (وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ عَنْ مَعْصُومٍ) وهذا هو النص ، ومداره على ركنين: على صدق المبلِغ ، وتصديق المبلغَ. ولهذا لا يكون هناك علم إلا بهذين الأمرين ، بأن يكون المبلغ صادق ، وأن أن يكون المبلغ مصدق له ، فيورث العلم ، وإلا فلو كان المبلِغ كاذب أو أن المبلغ لايصدق فإن هذا لا يورث علما ، فالعلم الذي مداره على النقل لابد أن يتوفر فيه هذان الأمران وهو: صدق المبلغ ، وتصديق المبلغ. قال: (وَالْعِلْمُ إِمَّا نَقْلٌ مُصَدَّقٌ) هذا تصديق من المخاطب ، (عَنْ مَعْصُومٍ) لأن المعصوم هو الذي لا يرد عليه الخطأ ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو معصوم فيما يبلغ عن الله عز وجل. ثم إن أمة الدعوة انقسموا في تصديقه إلى قسمين: من صدق بما جاء به فهذا أورثه تصديقه العلم ، ومن كذب فإنه لم يحصل له شيء ، ولهذا هذا هو النوع الأول وهو العلم الذي مداره على النقل المصدق من المعصوم ، فلا يمكن أن يتطرق إليه الخلل ؛ لأنه من صادق معصوم في خبره ، والذي يتلقاه مصدق له ، ولهذا الله عز وجل أثنى على النوعين {والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون} فأثنى على الصادق في خبره والمصدق له ، وقيل في تفسير هذه الآية {والذي جاء بالصدق} هو النبي صلى الله عليه وسلم {وصدق به} أبوبكر ، وهذا من تفسير هذه الألفاظ ببعض أجزائها ، وإلا فهذه الآية شاملة في كل من قال الصدق ، وكل من صدقه فيما قال. (وَإِمَّا قَوْلٌ عَلَيْهِ دَلِيلٌ مَعْلُومٌ) وهذا مرجعه إلى الفهم ، يعني ليس هو مما نص عليه ، ولكنه دل الدليل عليه ، وهذا هو الفهم الصحيح الذي دل عليه دليل ، ويقابل هذا القول الذي لم يدل عليه دليل معلوم وهو الباطل ، فإذن هنا العلم مرجعه إلى أحد أمرين: إما نقل ، وإما فهم صحيح دل عليه دليل. (وَمَا سِوَى هذا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ) المزيف هو: المغشوش ، والمردود هو: المتروك ، (و وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ) وإما متوقف فيه ، ما سوى ذلك إما أن يكون معلوم وهو الباطل الذي لا مرية فيه ، يعلم أنه مزيف مردود فيُترك ، وإما موقوف يتوقف فيه. وكأن شيخ الإسلام في قوله هنا: (وَمَا سِوَى هذا فَإِمَّا مُزَيَّفٌ مَرْدُودٌ) يشير إلى ما جاء في كتب التفسير من الباطل الذي لا يشتبه على المسلم أنه باطل ، وقال (وَإِمَّا مَوْقُوفٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّهُ بَهْرَجٌ وَلَا مَنْقُودٌ) وهذا ما جاء من الأخبار عن أهل الكتاب الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم ، قال: موقوف أي يتوقف فيه ، لا يعرف أنه بهرج ، والبهرج هو: المغشوش ، (وَلَا مَنْقُودٌ) والمنقود هو: السالم من الغش ، أي أنه ما خضع للنقد فيعرف أن سليم وأيضا لا يعرف أنه سلم من الغش فهو لا يعلم هل هو مغشوش أو منقود وإنما متوقف فيه ، وهذه مرتبة الشك ، والشك لا يفيد العلم ، فإذا حصل تردد بين أمرين هل هو مغشوش أم أنه منقود ، فإن هذا لا يفيد علما. قال رحمه الله: [وَحَاجَةُ الأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ القُرْآنِ الَّذِي هُوَ: حَبْلُ اللهِ المَتِينُ، وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الترديد، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبارٍ قَصَمَهُ اللهُ، وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله ] ثم ذكر شدة الحاجة لفهم القرآن قال: (وَحَاجَةُ الأُمَّةِ مَاسَّةٌ إِلَى فَهْمِ القُرْآنِ) لماذا ؟ لأنه حبل الله المتين وهذا كما جاء في بعض الأحاديث: " أن القرآن حبل الله المتين" وجاء في بعضها: "أنه حبل الله وأنه مدود بين الله وبين خلقه" والعرب تطلق على النور أنه حبل إذا كان موصلا إلى شيء كما قال الله عز وجل {حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود} وقصد بهذا نور النهار وظلمة الليل ، والقرآن نور ، وكأنه حبل ممدود من النور بين الله وبين خلقه ، فمن تمسك به أوصله إلى الله عز وجل ، ومن حاد عنه ضل ، (وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ) كما وصفه الله عز وجل {ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم} فهو ذكر فيه تذكير وفيه موعظة ، وهو حكيم كما أنه موصوف بالحكمة ، فالله عز وجل هو الحكيم ، وكتابه مبناه على الحكمة ، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها ، فليس فيه خلل ، وليس فيه اضطراب ، (وَالصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ) وهو أحد التفاسير في تفسير الصراط المستقيم أنه القرآن ، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم ، وقيل هو الدين ، ولا تعارض بين هذه التفاسير ؛ لأنه باعتبار المبلِغ عن هذا الصراط فهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصراط ، وباعتبار المنهج الذي خوطبت به الأمة والشريعة فهو الدين ، وباعتبار الدال على هذا من كلام الله عز وجل فهو القرآن. (الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ) أي من تمسك به لم يزغ به الهوى ويضل ؛ لأنه متمسك بهذا الحبل المتين (وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسُنُ) قيل الألسن هنا اللغات ، أي أنه لا تلتبس ، ولا يختلط في هذا القرآن اللغات الأخرى ، وإنما هو بلسان عربي مبين كما وصفه به الله عز وجل. (وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الترديد) أي لا يكون باليا قديما على كثرة الترديد ، كما أن كلام الناس إذا قرأته مرة مرتين يمله الإنسان ، ويقال هذا كلام قديم ، عرف من قديم ، فكتاب الله عز وجل كلما قرأه الناس وتدبروه ، كلما ظهر لهم من الفقه والفهم مالم يكن معروفا لديهم ، ولهذا على كثرة قراءته وسماع الناس له فإنهم لا يملون هذا الكلام ، وهذا مما يدل على إعجاز القرآن ، وأنه من كلام الله عز وجل. (وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ) أي لا ينقضي ما فيه العجائب والأمور التي تنبهر لها النفوس ؛ لأن مبناه على القوة والمكانة ، والناس فهمهم فيه ضعف وتقصير ، فكلما تأملوا كلما ظهر لهم من العجائب مالم يكن معلوما لديهم. (وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ) أي لا يكتفي بقراءة شيء منه العلماء ؛ لأن الشبع هو الاكتفاء من الشيء ، فالقرآن لا يشبع منه العلماء الذين يتدبرون كلام الله عز وجل. (مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ) أي من قال بالقرآن بأن أخبر عن كلام الله عز وجل أو ذكر معناه أو استدل به على قوله صدق ، ولهذا إنما يعرف صدق الرجل بموافقه للحق ، والحق إنما يعرف بالدليل. (وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ) من عمل بالقرآن كتب الله عز وجل له المثوبة والأجر على عمله به ، فالقائل به صادق ، والعامل به مأجور. (وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ) من حكم به في الناس عدل في حكمه. (وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) من دعا إلى القرآن ، هدى إلى صراط مستقيم ؛ لأنه هو الصراط المستقيم ، فالذي يدعو إلى القرآن يهدي الناس إلى صراط مستقيم (وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبارٍ قَصَمَهُ اللهُ) من تركه من جبار متكبر قصمه الله ، أي: أهلكه (وَمَنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ الله) من ابتغى الهدى والسلامة من غير القرآن ؛ أضله الله. وهذه الجملة في وصف القرآن ثبت بعضها في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ، وقد أخرجه الإمام الدارمي في أول كتاب فضائل القرآن من سننه ، وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ، والصحيح وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: [ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ ] ثم ذكر المصنف بعض الآيات الدالة على ما تقدم من أن هذا القرآن فيه هداية النفوس إلى الحق ، كما قال الله عز وجل : ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى﴾ والهدى الذي جاء من الله عز وجل هو القرآن ، قال: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ﴾ أي القرآن ﴿فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَى ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: "فلا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة". لأن الناس يوصفون في الدنيا في دينهم بالهدى والضلال ، ويوم القيامة بالسعادة أو الشقاء ، فمن تمسك بالقرآن واهتدى بهديه لم يضل في الدنيا ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا" أي في الدنيا ، ويوم القيامة من تمسك به كان من السعداء ، لا يضل في الدنيا ، ولن يشقى في الآخرة. قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ عن القرآن وعن تذكير الله عز وجل لعباده في القرآن ، ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً﴾ فالضنك هو الشدة والضيق ، وقيل هذا هو عذاب القبر: أن من أعرض عن كتاب الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا في القبر ، وقد روي في هذا بعض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أن المعيشة الضنكى هي عذاب القبر" وقيل الضنك في الدنيا ، في أنه لا طمأنينة له ولا انشراح وهذا كله صحيح ، فإن من أعرض عن كتاب الله عز وجل ، فإنه لا طمأنينة له ولا انشراح في الدنيا وله الضنك والشدة في القبر ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ قيل أنه يحشر أعمى البصيرة ، وقيل يحشر أعمى البصيرة والبصر ، أما أعمى البصيرة فهذا مما لا شك فيه ﴿قَالَ رَبِّ لَمْ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ هذا من باب الجزاء من جنس العمل ، أي أنه لما نسي آيات الله عز وجل ، والنسيان هنا بمعنى الترك ن وليس النسيان عن ذهوب ، فإن النسيان يرفع به الخطأ ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عفا الله لأمتي الخطأ والنسيان" وقال الله عز وجل : {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} لكن المقصود هنا بالنسيان: هو الترك ، فمن أعرض من القرآن يقال: ترك القرآن ، نسي القرآن ، قال: ﴿وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى﴾ أي تترك ، من هنا يتبين النسيان المضاف إلى الله عز وجل في أنه ليس المقصود به الذهول ، وإنما المقصود به الترك. قال رحمه الله: [ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾] أيضا هذا في معنى الآية السابقة ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ﴾هو كتاب الله عز وجل ، فهو نور للقلوب وهو مبين بين واضح ، ﴿ يهدي به الله من اتبع رضوانه ﴾أي من اتبع ما فيه مرضات الله عز وجل ﴿سبل السلام﴾أي طرق السلام ، وإنما جمعت السبل مع أن الطريق واحد كما قال الله عز وجل { وأن هذا صراطي مستقيما} قيل المقصود بالسبل هنا: شعب الإيمان التي تدل على الدين ، وتهدي إلى الإيمان ، فالسبيل قد يقال بأنه واحد ، وقد يقال أنها سبل ، وقد سئل شيخ الإسلام عن قول من قال: "إن السبل إلى الله كعدد الأنفاس" ، فقال : إذا كان المقصود بهذا أبواب الخير فهذا حق ، وإذا كان المقصود اختلاف الناس في الدين ، وافتراقهم في البدع والضلالات فهذا باطل ، لأن بعض الناس يقول: "الكل يعمل ، وكلنا نصل !" لا ليس الأمر كذلك ، إنما العمل بموافقة الشرع ، فإذا كان هذا يعمل ، ويبتغي الثواب من الله عز وجل ، يغلب عليه عمل من الاعمال الصالحة ، هذا يغلب عليه الصلاة ، وهذا يغلب عليه الصدقة ، وهذا يغلب عليه الجهاد ، وهذا يغلب عليه الأمر بالمعروف ، فقد دلت النصوص على أن أهل الجنة يدخلون ببعض هذه الأعمال ، ولكل عمل من هذه الأعمال له باب من الجنة ، فدل هذا على أن هذه الأعمال موصلة إلى الله عز وجل ، فالمقصود بالسبل هنا: سبل الخير ، وطرق الخير ، ﴿ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ﴾لأن الأصل في الإنسان أنه ضال ، كما قال الله عز وجل: "يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته" فيخرجهم من ظلمات الجهل والهوى إلى نور الإيمان واليقين والعلم ، ﴿ ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾وهو الدين والقرآن. قال رحمه الله: [وَقَالَ تَعَالَى: ﴿الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾] ثم أيضا ذكر المصنف مستدلا بقول الله عز وجل ﴿الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ فأخبر الله عز وجل بأنه بهذا الكتاب الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم ، يخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام: "أن الله يهدي بالأسباب" يهدي بالقرآن ، فالقرآن من أعظم أسباب الهداية ، ﴿لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾أي بهذا القرآن ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾أي بإذن الله وبتوفيقه ؛ لأن هذا القرآن ، نزل على الأمة وليس كل الناس اهتدوا به ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ؛ لأن الأمر يحتاج إلى هداية الإرشاد ، وهي التي نزل بها القرآن ، وإلى هداية التوفيق ، وهذه التي يمن الله بها على من شاء من خلقه ، ولهذا قال هنا ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾فهذا فيه إشارة إلى أنه ليس كل من خوطب باقرآن يهتدي ، وإنما الهداية بتوفيق الله عز وجل ، وهذه الهداية هي التي تسمى هداية التوفيق ، ﴿ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ الصراط مرة يضاف إلى الله ؛ لأنه هو الذي هدى إليه ، ومرة يضاف إلى العاملين الذين عملوا به {صراط الذين أنعمت عليهم} ، ولا تعارض ، فإنه أضيف إليهم ؛ لأنهم عملوا به ، وهو مضاف إلى الله عز وجل ؛ لأنه هو الذي هدى إليه ﴿ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ والعزيز من أسماء الله عز وجل المتضمن صفة العزة ، والحميد من أسماء الله المتضمن صفة الحمد ، والجمع بين العزة والحمد ، مما يدل على كمال فوق كمال ، فإن عزة الله مقترنة بالحمد ، وذلك لأنه ليس كل عزيز يحمد من المخلوقين ، وليس كل من يحمد فهو عزيز ، ولهذا يكثر العز في أهل الشرف والجاه ، وتقل فيهم صفات الحمد ، وتكثر صفات الحمد في العلماء وتقل فيهم صفات العزة ، والله عز وجل هو العزيز الحميد ، ﴿اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾أي أنه مع عزه وأنه محمود من كل وجه فله ملك السماوات والأرض. قال رحمه الله: [ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ ] ثم قال الله عز وجل ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا﴾ الروح هنا هو القرآن ، ولهذا ينبغي التنبه أن الروح مرة يضاف إلى الله عز وجل ويكون صفة من صفات الله عز وجل كما هو الشأن هنا فالروح هنا القرآن ، وأحيانا ترد الروح وتضاف إلى الله عز وجل ويراد بها الروح المخلوقة كما قال الله عز وجل {فنفخنا فيها من روحنا}. فالمقصود بالروح هنا هو القرآن ؛ وإنما سماه الله روحا ؛ لما فيه من حياة الأرواح والقلوب ، ﴿ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا﴾ أي بأمر الله عز وجل ، ﴿ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ ﴾ أي قبل نزول هذا القرآن ما كنت تعلم الكتاب ولا الإيمان ، فلما أنزل الله عز وجل عليه ذلك هداه الله عز وجل إلى معرفة الكتاب والإيمان ، ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ﴾ جعلناه بمعنى أنزلناه ، وهذا المعنى يعرف بنظائر هذا السياق في كتاب الله عز وجل ، كما قال عز وجل: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وقال: {إنا جعلناه قرآنا عربيا} فالذين لا ينتبهون لمثل هذا ، قد يضل بعضهم فيقول بأن جعل هنا بمعنى خلق ، لكنهم لو تنبهوا للسياق الآخر ، يعرفون أن جعل هنا بمعنى أنزل وصيّر {إنا جعلناه قرآنا عربيا} ، فالمقصود بالجعل: هو الإنزال ، فالقرآن كلام الله ليس هو مخلوق كما قالت المعتزلة والجهمية ؛ ولأن جعل إذا تعدت إلى مفعولين فإنها لا تكون بمعنى خلق ، ولكن بمعنى صيّر وأنزل ، ﴿ نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ جعله الله عز وجل نورا ثم بيّن أن هدايته لمن شاء من عباد الله عز وجل {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ لاحظوا هنا الفرق بين هداية التوفيق ، وهداية الإرشاد ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ هي هداية الإرشاد ، والهداية الأولى في وقوله ﴿ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ ﴾ هي هداية التوفيق ، ﴿صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ﴾ أي مرجع الأمور من أمور الدين والدنيا ، كلها مرجعها إلى الله عز وجل. قال رحمه الله: [وَقَدْ كَتَبْتُ هَذِهِ «المُقَدِّمَةَ» مُخْتَصَرَةً، بِحَسَبِ تَيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى، مِنْ إِمْلاءِ الفُؤَادِ، وَاللهُ الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ] ثم ذكر المصنف أنه كتب هذه المقدمة ، وهي مختصرة ( َبتيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى) وهذا من إسناد الفضل لصاحبه ، كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام هذا ، أن ما وفق إليه من العلم هو بتوفيق الله ، وبفضل الله ، قال: (تَيْسِيرِ اللهِ تَعَالَى، مِنْ إِمْلاءِ الفُؤَادِ) هذا مما يدل على أنه كتبها من إملائه ، ولم يرجع فيها إلى الكتب وينقل ، وإنما كان يصنف من إملائه ، ككثير من الرسائل والكتب ، ومن هذه الكتب هذه الرسالة التي كتبها من إملائه ، وهي مشتملة على نقول ، وعلى نصوص ، مما يدل على سعة علمه وحفظه رحمه الله تعالى. قال: (وَاللهُ الهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ) أي أنه الله عز وجل هو الذي بيده الهداية ، وهذا فيه أيضا الإشارة إلى أن هذه الرسالة وغيرها من الرسائل لن تكون هادية ، ولن تكون محققة للمقصود إلا لمن هداه الله عز وجل ، فإذا كان كتاب الله عز وجل لم يهتدي به بعض الناس – إلا بإذن الله- فمن شاء الله هدايته اهتدى ، فكذلك كلام أهل العلم ، مهما كان بينا واضحا ، فإنه لن يكون سببا لهداية الناس إلا من وفقه الله عز وجل لهذا. هذا والله أعلم وصلى الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
__________________
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إنّ سلعة الله غالية ، ألا إنّ سلعة الله الجنة ! " |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| أصول، التفسير |
|
|
 |
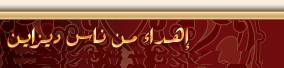 |